خطبة الجمعة للدكتور أحمد رمضان : سماحةُ الإسلامِ
للدكتور أحمد رمضان ، بتاريخ 6 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 29 أغسطس 2025م
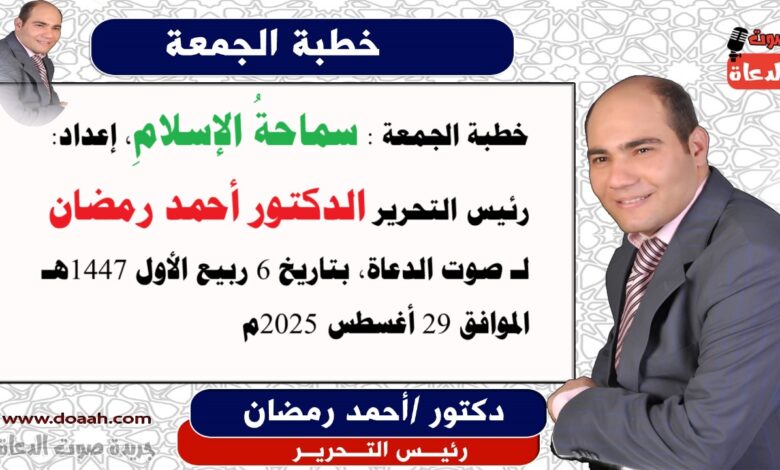
خطبة الجمعة : سماحةُ الإسلامِ، إعداد: رئيس التحرير للدكتور أحمد رمضان لـ صوت الدعاة ، بتاريخ 6 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 29 أغسطس 2025م.
بداية من هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالي سيتم وضع ملفات التحميل علي شكلين ملفات الخطبة word , pdf ، الملف الأول الخطبة كاملة من 7-9 صفحات وتحته الملف المختصر 4-5 صفحات.
الملف المحتصر 5 صفحات word
وكذلك : لتحميل خطبة الجمعة القادمة 29 أغسطس 2025م بصيغة pdf بعنوان : سماحةُ الإسلامِ ، لـ صوت الدعاة.
الملف المحتصر 5 صفحات pdf
-عناصر خطبة الجمعة القادمة 29 أغسطس 2025م بعنوان : سماحةُ الإسلامِ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان.
العنصر الأول: السَّمَاحَةُ فِي الإِسْلَامِ وَمَفْهُومُهَا
العنصر الثاني: مظاهرُ السَّماحةِ وصورُها
العنصر الثالث: وجوبُ نشرِ السَّماحةِ في واقعِنا وثمراتُها
العنصر الرابع: وَافَى رَبِيعٌ فَمَرْحَبًا بِهِلَالِهِ
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 29 أغسطس 2025م بعنوان : سماحةُ الإسلامِ إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان : كما يلي:
سَمَاحَةُ الإِسْلَامِ
6 ربيع الأول 1447هـ – 29 أغسطس 2025م
إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
المـــوضــــــــــوع
الحمدُ للهِ الحليمِ الكريم، الرَّحيمِ بعبادِه، شرعَ دينَه على العدلِ والرحمةِ والمصالح، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمّدًا عبدُه ورسولُه، أرسله رحمةً للعالمين، صلّى اللهُ عليه وعلى آله وصحبِه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.
أيُّها الأحبَّةُ، ما أشرَقَ نورُ المَولِدِ النَّبَوِيِّ حتّى انقشَعَتْ ظُلُماتُ الجاهليَّةِ، وإذا برسولِ اللهِ ﷺ يُؤسِّسُ لِدَعوَةٍ مَبناها السَّماحةُ، ومِحورُها الرَّحمةُ، ورُوحُها العَدلُ والإنصافُ.
لقدْ كانَ ﷺ بحرًا من الحِلمِ، وبَستانًا من الرِّفقِ، ما قابَلَ جَهلًا إلّا بالحِلمِ، ولا قَسوةً إلّا بالعَفوِ، ولا عُنفًا إلّا بالرَّحمةِ، قالَ تَعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾، فكانَتْ سَماحتُهُ ﷺ مَظهَرَ هذهِ الرَّحمةِ في أبهى صُوَرِها.
وقالَ ﷺ: «إنَّما بُعِثتُ لأُتَمِّمَ مَكارِمَ الأخلاقِ» [الموطأ 1614]، فالسَّماحةُ تاجُ الأخلاقِ، وبها يَسمو الإنسانُ على أهوائِهِ.
فالمَولِدُ النَّبَوِيُّ يا عبادَ اللهِ ليسَ ذِكرى تاريخيَّةً فحسب، بل هو نِداءٌ لِكُلِّ مُؤمِنٍ أنْ يَستَضيءَ بِنُورِ السَّماحةِ، وأنْ يَعيشَ بِخُلُقِ الرَّحمةِ في بَيتِهِ ومُجتَمَعِهِ وأُمَّتِهِ.
العنصر الأول: السَّمَاحَةُ فِي الإِسْلَامِ وَمَفْهُومُهَا
السَّماحةُ خلق من أخلاق الإسلام، أمر بها الله سبحانه وتعالي في كتابه، وطبقها النبي ﷺ في حياته، وأمر بها أتباعه، وهي تُطهِّر القلب من الغلِّ، وتُجسِّد صورةَ الإسلام في العيون قبل الآذان؛ ولهذا ارتبط انتشارُه في بقاعٍ واسعة بسلوكِ تجّاره ورفقِ دُعاته.
السَّمَاحَةُ لَيْسَتْ مَسْحَةَ لُطْفٍ عَابِرَةٍ، وَلَا زِينَةَ خُلُقٍ عَلَى الهَامِشِ؛ بَلْ هِيَ رُوحُ الشَّرِيعَةِ وَمَنْهَجُ الدِّينِ، بِهَا يَطْهُرُ القَلْبُ مِنَ الغِلِّ، وَتَبْدُو صُورَةُ الإِسْلَامِ فِي العُيُونِ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَهَا الأَسْمَاعُ؛ وَلِذَلِكَ اقْتَرَنَ اِنْتِشَارُهُ فِي آفَاقٍ وَاسِعَةٍ بِأَخْلَاقِ تُجَّارِهِ وَرِفْقِ دُعَاتِهِ. وَالسَّمَاحَةُ فِي مِيزَانِ الشَّرْعِ مَسْلَكٌ مُرَكَّبٌ: أَدَاءُ وَاجِبٍ بِيُسْرٍ بِلَا تَكَلُّفٍ، وَمُطَالَبَةُ حَقٍّ بِإِنْصَافٍ بِلَا اعْتِدَاءٍ، وَتَعَامُلٌ مَعَ الخَلْقِ بِرِفْقٍ وَعَفْوٍ بِلَا تَفْرِيطٍ فِي حَدٍّ وَلَا تَمْكِينٍ لِظُلْمٍ؛ فَهِيَ سَمَاحَةٌ مُؤَسَّسَةٌ عَلَى نَصٍّ صَحِيحٍ، وَمَقْصِدٍ رَاجِحٍ، وَمَصْلَحَةٍ مُعْتَبَرَةٍ، تَجْمَعُ بَيْنَ صَفَاءِ القَلْبِ، وَقُوَّةِ المَوْقِفِ، وَعَدْلِ المِيزَانِ.
التعريفُ اللغويّ والاصطلاحيّ
لغةً: أصلُ “السَّماحة” من السَّمْح والسماح: السهولةُ والجودُ وتركُ الشُّحّ؛ يقال: رجلٌ سَمْحٌ، أي ليّنُ العريكةِ، واسعُ الصدر، يُعطي ويعفو طِيبَ نفسٍ. ومنه: “سَمَحَ له بالشيء” أي أعطاه إيّاه راضيَ النفس.
اصطلاحًا شرعيًّا:
السَّماحةُ خُلُقٌ جامعٌ يُعبِّر عن أداءِ الحقوقِ بيسرٍ، ومطالبتِها بإنصافٍ، ومُعاشرةِ الخلقِ برفقٍ وعفوٍ على قاعدةِ العدلِ والالتزامِ بالشريعة؛ فهي تيسيرٌ مشروعٌ لا تمييعَ للدِّين، ولينُ جانبٍ لا تنازلَ عن واجب، وحِلمٌ عند الغضب لا قبولَ لظلم.
وتنتظم تحتها معاني: الرِّفق، والعفو، والحِلم، ولينُ الخطاب، وإقالةُ العثرة، مع صيانةِ ثوابت الشريعة وحقوقِ العباد.
مقاربةٌ جامعةٌ لمجالاتِ السَّماحة
مع الله تعالى: عبادةٌ بلا تكلّفٍ فوق الطاقة، وأخذٌ بالرُّخص عند العسر؛ قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
مع النفس: مجاهدةٌ بميزانٍ من التوازن؛ لا إرهاقَ ولا تتبُّعَ للوساوس، بل ثباتٌ واقتصاد.
مع الناس: لطفٌ وعدلٌ وإنصافٌ وكظمُ غيظٍ وإصلاح؛ على هَدْي قولِه ﷺ: «يسِّروا ولا تُعسِّروا، وبشِّروا ولا تُنفِّروا» متفقٌ عليه (البخاري: ح 69، مسلم: ح 1734).
التفريقُ بين السَّماحةِ وبعضِ قرائنِها
الرِّفق: لينٌ في الوسيلة مع ثباتِ المقصد (أي التمسُّكُ بالهدفِ الحقّ وعدمُ التنازلِ عنه).
الحِلم: ضبطُ النفس عند ثورانِ الغضب.
العفو: الصَّفحُ عمّن أخطأ مع القُدرةِ على الانتقامِ واستردادِ الحقّ.
التغافل: إظهارُ الغفلةِ عن الهفوةِ مع العلمِ بها؛ حفظًا للمودّةِ وإصلاحًا للقلوب.
والسَّماحةُ إطارٌ يضمُّ هذه المعاني ويُوازنها بميزانِ الشرع والعدل.
قواعدُها المقاصديّة
لخّص ابنُ القيّم –رحمه الله– روحَ التشريع فقال: “إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الحِكَمِ وَمَصَالِحِ العِبَادِ فِي المَعَاشِ وَالمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ العَدْلِ إِلَى الجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ المَصْلَحَةِ إِلَى المَفْسَدَةِ، وَعَنِ الحِكْمَةِ إِلَى العَبَثِ، فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ…» (إعلام الموقّعين، ج1، ص195، دار ابن الجوزي، تحقيق مشهور).
وقال القرطبي –رحمه الله– في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾: “وهذه الآيةُ تدخلُ في كثيرٍ من الأحكام، وهي ممّا خصَّ اللهُ به هذه الأمّة…» ثم ساق آثارَ التيسير وامتنانَه بها (تفسير القرطبي، ج12، ص100، دار الكتب المصرية).
أَحسِنْ إلى النّاسِ تَستعبدْ قلوبَهمُ ** لطالما استعبدَ الإنسانَ إحسانُ
فمن أخذَ بهذا الأصلِ في عبادتِه، وتربيتِه لنفسِه، ومُعاشرته للناسِ، أشرقَتْ به السُّننُ، وزَهَتْ به المعاملةُ، وصدَقَتْ فيه شهادةُ الدِّينِ على أنّه عدلٌ ورحمةٌ وحكمة.
العنصر الثاني: مظاهرُ السَّماحةِ وصورُها
سنمضي –عبادَ الله– عبر محاورَ متتابعةٍ تُظهِرُ صورَ السَّماحة في حياة المسلم، ثم نختم بوجوب نشرِها في واقعنا.
أولًا: السَّماحةُ في الاعتقادِ والعبادةِ والتكليف
قال تعالي: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]. أَيْ: لَا يُكَلِّفُ أَحَدًا فَوْقَ طَاقَتِهِ، وَهَذَا مِنْ لُطْفِهِ تَعَالَى بِخَلْقِهِ وَرَأْفَتِهِ بِهِمْ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، وَهَذِهِ هِيَ النَّاسِخَةُ الرَّافِعَةُ لِمَا كَانَ أَشْفَقَ مِنْهُ الصَّحَابَةُ، فِي قَوْلِهِ: (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) البقرة 284، أَيْ: هُوَ وَإِنْ حَاسَبَ وَسَأَلَ لَكِنْ لَا يُعَذِّبُ إِلَّا بِمَا يَمْلِكُ الشَّخْصُ دَفْعَهُ، فَأَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ مِنْ وَسْوَسَةِ النَّفْسِ وَحَدِيثِهَا، فَهَذَا لَا يُكَلَّفُ بِهِ الإِنْسَانُ” تفسير ابن كثير، ج1، ص572. ط. العلمية.
وعن النبي صلي الله عليه وسلم: «ما خُيِّر ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرَهما ما لم يكن إثمًا» (متفق عليه). ليس تهاونًا، بل فقهُ مقاصدٍ يَردّ التشديدَ غيرَ المأمور.
يقولُ محمّدُ سيِّد طنطاوي رحمه الله في تفسيرِ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾: “لِأَنَّهُ يُرِيدُ بِكُمُ اليُسْرَ وَالسُّهُولَةَ، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ وَالمَشَقَّةَ. قَالَ – تَعَالَى –: (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا) النساء 28، وَقَالَ تَعَالَى: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج 78. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ حِينَ بَعَثَهُمَا إِلَى اليَمَنِ: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا”. البخاري ح 4341، ومسلم ح 1733. الوسيط ج 1، ص 388.
ثانيًا: السَّماحةُ في الدعوةِ والخِطاب
قاعِدةُ البلاغ: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125]. يفسِّر طنطاوي الحكمة بأنّها وضعُ الشيءِ موضعَه، والقولُ الصوابُ الموافقُ للعقلِ والنقلِ، والموعظةُ الحسنة هي اللينُ الذي يفتحُ الأذنَ والقلب… وجادلهم: بأَنْ تَكُونَ مُجَادَلَتُكَ لَهُمْ مَبْنِيَّةً عَلَى حُسْنِ الإِقْنَاعِ، وَعَلَى الرِّفْقِ وَاللِّينِ وَسِعَةِ الصَّدْرِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي إِطْفَاءِ نَارِ غَضَبِهِمْ، وَفِي التَّقْلِيلِ مِنْ عِنَادِهِمْ، وَفِي إِصْلَاحِ شَأْنِ أَنْفُسِهِمْ، وَفِي إِيمَانِهِمْ بِأَنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ مِنْ وَرَاءِ مُجَادَلَتِهِمُ الوُصُولَ إِلَى الحَقِّ دُونَ أَيِّ شَيْءٍ سِوَاهُ”. التفسير الوسيط ج8، ص262.
نماذجُ نبوية:
الأعرابي الذي بالَ في المسجد؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: “أنَّ أعرابيّاً دخلَ المَسجِدَ ورسولُ الله ﷺ جالِسٌ، فصلَّى -قال ابن عَبْدة: ركعتين، ثمَّ قال: اللهم ارحَمني ومحمداً، ولا تَرحَم مَعَنا أحداً، فقال النبي ﷺ: “لقد تَحَجَّرتَ واسِعاً”، ثمَّ لم يَلبَث أن بالَ في ناحيةِ المَسجِدِ، فأسرَعَ الناسُ إليه، فنهاهم النبي ﷺ وقال: “إنما بُعِثتُم مُيَسِّرينَ، ولم تُبعَثوا مُعَسِّرينَ، صُبُّوا عليه سَجْلاً مِن ماءِ” أو قال: “ذَنوباً مِن ماءٍ“[رواه أبو داود ح 380 بإسناد صحيح].
وكان صلى الله عليه وسلم يراعي ضعف الناس واختلاف أحوالهم، فعن أنسٍ رضي الله عنه قال: “مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا“. رواه البخاري ومسلم.
وروي الطبراني: “إنَّ فَتًى شابًّا أتى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، ائْذَنْ لي بالزِّنا، فأقبَلَ القَومُ عليه فزَجَروه وقالوا: مَهْ، مَهْ! فقال: ادْنُهْ، فدَنا منه قَريبًا، قال: فجَلَسَ، قال: أتُحِبُّه لأُمِّكَ؟ قال: لا واللهِ، جَعَلَني اللهُ فِداءَكَ، قال: ولا النَّاسُ يُحِبُّونَه لأُمَّهاتِهم، قال: أفتُحِبُّه لابنتِكَ؟ قال: لا واللهِ، يا رسولَ اللهِ، جَعَلَني اللهُ فِداءَكَ، قال: ولا النَّاسُ يُحِبُّونَه لبَناتِهم، قال: أفتُحِبُّه لأُختِكَ؟ قال: لا واللهِ، جَعَلَني اللهُ فِداءَكَ، قال: ولا النَّاسُ يُحِبُّونَه لأَخَواتِهم، قال: أفتُحِبُّه لعَمَّتِكَ؟ قال: لا واللهِ، جَعَلَني اللهُ فِداءَكَ، قال: ولا النَّاسُ يُحِبُّونَه لعَمَّاتِهم، قال: أفتُحِبُّه لخالتِكَ؟ قال: لا واللهِ، جَعَلَني اللهُ فِداءَكَ، قال: ولا النَّاسُ يُحِبُّونَه لخالاتِهم، قال: فوَضَعَ يدَه عليه وقال: اللَّهُمَّ اغفِرْ ذَنبَه، وطَهِّرْ قَلبَه، وحَصِّنْ فَرْجَه، قال: فلمْ يَكُنْ بعدَ ذلك الفَتى يَلتفِتُ إلى شيءٍ”. أخرجه أحمد (22211) واللفظ له، والطبراني (8/190) (7679).
روي ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص 79، ط. دار المعرفة – بيروت، قال الشافعي: «مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا أَحْبَبْتُ أَنْ يُوَفَّقَ وَيُسَدَّدَ وَيُعَانَ، وَيَكُونَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ رِعَايَةٌ وَحِفْظٌ، وَمَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إِلَّا وَلَمْ أُبَالِ بَيَّنَ اللهُ الحَقَّ عَلَى لِسَانِي أَوْ لِسَانِهِ”. وأيضاً حلية الأولياء، ج 9، ص 123، ط. دار السعادة.
ثالثًا: السَّماحةُ في المعاملاتِ والديونِ والتجارة
أيها الإخوة الكرام، السَّماحةُ في البيع والشراء، والرفقُ في الاقتضاء، ونزاهةُ الكيل والوزن، ليست مجرد سلوكٍ حضاري، بل هي عبادةٌ وخلقٌ نبويّ، وميزانٌ لصدق التديُّن، وبرهانٌ على صفاء القلب. وقد أمرنا الله تعالى بها في كتابه، وحذّر من ضدها، فقال جل شأنه: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: 1]، ونهى عن التضييق على المعسرين، فقال سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280].
وهذا المعنى أكّده سيدنا رسول الله ﷺ في أحاديث جامعةٍ مانعة، فقال ﷺ: “رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى”. البخاري (2076).
وقال ﷺ: “مَن يَسَّرَ على مُعسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عليه في الدُّنيا والآخرة”. مسلم (2699).
وقال ﷺ: “مَن أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَعَ له، أَظَلَّهُ اللهُ في ظلِّه”. الترمذي (1306)، رواه أحمد (8711) حسن.
وقد علّق الإمام ابن بطّال – رحمه الله – على حديث «رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع…» فقال: فِيهِ: الحَضُّ عَلَى السَّمَاحَةِ وَحُسْنِ المُعَامَلَةِ، وَاسْتِعْمَالِ مَعَالِي الأَخْلَاقِ وَمَكَارِمِهَا، وَتَرْكِ المُشَاحَّةِ وَالرِّقَّةِ فِي البَيْعِ، وَذَلِكَ سَبَبٌ إِلَى وُجُودِ البَرَكَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَحُضُّ أُمَّتَهُ إِلَّا عَلَى مَا فِيهِ النَّفْعُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَأَمَّا فَضْلُ ذَلِكَ فِي الآخِرَةِ فَقَدْ دَعَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ تَنَالَهُ بَرَكَةُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَقْتَدِ بِهَذَا الحَدِيثِ وَيَعْمَلْ بِهِ”. شرح صحيح البخاري، مكتبة الرشد، ط2، 1423هـ، ج 6، ص 210، 211.
وللسماحة نماذج من سيرة نبينا ﷺ وصحابته، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله ﷺ قال: “كان رجلٌ يدايِنُ الناسَ، فكان يقولُ لفتَاهُ: إذا أتيتَ مُعْسِرًا فتجاوزْ عنه، لعلَّ اللهَ أنْ يتجاوَزَ عنَّا، فلَقِيَ اللهَ، فتجاوَزَ عنْهُ” البخاري (3480)، ومسلم (1562).
أيُّها الأحبَّةُ، انظروا إلى سَمَاحَةِ الصحابةِ – رضوانُ اللهِ عليهم – تجدوا فيها عجبًا: فهذا عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ رضي اللهُ عنهما، كان له دَيْنٌ على رجلٍ، فجاءه الرجلُ يومًا يريدُ قضاءَه، فأعطاه أكثرَ ممَّا عليه، فقال ابنُ الزبيرِ: ما هذا؟ قال: هذا جزاءُ صبرِكَ عليَّ، فقال: واللهِ لو زدتَّني ما أخذتُه، إنَّما صبرتُ للهِ لا طمعًا في زيادةٍ. (أخرجه ابن أبي شيبة في “المصنف”، كتاب البيوع، باب في السماحة في البيع والشراء، ج6، ص482، رقم 33114، تحقيق: كمال يوسف الحوت).
وفي واقعنا المعاصر، ما أحوجنا إلى التاجر الأمين الذي يجعل الاستبدالَ والإرجاعَ بسلاسةٍ واحترام، فيربح ثقةَ الناس قبل أموالهم، ويجسد في سلوكه قول النبي ﷺ: «رحم الله رجلًا سمحًا…” فلتكن سماحتنا في المعاملات صورةً ناطقةً عن ديننا، وشهادةً عمليةً على صدق إيماننا.
تَحلَّ بالسَّماحةِ والسَّخاءِ *** فكِلاهُما خُلقُ الكِرامِ
رابعًا: السَّماحةُ في الإصلاحِ وفضِّ الخصومات
أصلٌ قرآني: ﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: 114]، و﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [فصّلت: 34].
قواعدُ من السُّنّة: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ» [صحيح البخاري، ح 6114، ن عطاءات العلم، وصحيح مسلم، ح 2609]، وَفِي شَرْحِ ابْنِ بَطَّالٍ رَحِمَهُ اللهُ: أَرَادَ ﷺ أَنَّ الَّذِي يَقْوَى عَلَى مَلْكِ نَفْسِهِ عِنْدَ الغَضَبِ وَيَرُدُّهَا عَنْهُ هُوَ القَوِيُّ الشَّدِيدُ… فَدَلَّ هَذَا أَنَّ مُجَاهَدَةَ النَّفْسِ أَشَدُّ مِنْ مُجَاهَدَةِ العَدُوِّ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ مِنَ القُوَّةِ وَالشِّدَّةِ مَا لَيْسَ لِلَّذِي يَغْلِبُ النَّاسَ وَيَصْرَعُهُمْ”. شرح صحيح البخاري لابن بطّال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، ط2 (1423هـ)، ج9، ص296، «كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب».
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: “ومن ستر مسلمًا سترهُ اللهُ يومَ القيامةِ» البخاري (2442)، ومسلم (2580). أبو داود (4893) واللفظ له
ونحنُ نعيشُ ذِكرى مَولدِ خيرِ البريَّةِ ﷺ، نَستحضِرُ سَماحتَهُ العَظيمةَ الَّتي أشرَقَتْ في أشدِّ المواقِفِ قَسوةً؛ ففي الطائفِ لما آذَوه؛ خُيّر بين الهلاكِ لهم أو العفو، فقال: «بل أرجو أن يُخْرِجَ اللَّهُ مِن أصلابِهِم مَن يعبدُ اللَّهَ، لا يشرِكُ بِهِ شيئًا» البخاري (3231)، مسلم (1795).
يوم الفتح قال لأهلِ مكّة –وقد مَلكَ رقابَهم–: «اذهبوا فأنتم الطُّلَقاء»؛ كلمةٌ أنهت ثأرَ قرون. ابن حجر يعلّق على مواقفِ العفو: فيها اجتلابُ القلوبِ إلى الدّين.
أثرُ الخلفاء: عمرُ بن عبد العزيز: عدلي على الظالمِ رفقٌ بالمظلوم؛ إصلاحٌ بلا انتقام.
إذا قدِرتَ على العِدى فاجعلْ ** عفوَكَ شُكرًا للقُدرةِ
خامسًا: السَّماحةُ مع غيرِ المسلمين
تأصيل: ﴿لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8].
مواقفُ نبوية:
قام ﷺ لجنازةِ يهوديٍّ، فقيل: إنها يهودي، قال: «أليست نفسًا؟» (متفق عليه). كرامةُ الإنسان مُقدَّمة.
“ألا من ظلمَ مُعاهَدًا أو انتقصه… فأنا حجيجه يومَ القيامة» (أبو داود، صحيح).
استعارَ ﷺ دُروعَ صفوان –وهو مشرك– فقال: «بل عاريةٌ مضمونة»؛ عدلٌ وإنصاف.
أثرُ عمر: رأى شيخًا ذمّيًّا يسأل، فقال: ما أنصفناه! أكلنا شبيبته ثم نخذله عند هرمه، وأجرى له رزقًا من بيت المال (مصنّف ابن أبي شيبة).
سادسًا: السَّماحةُ في الأسرةِ والجوار
أصلٌ قرآني: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، ووصيةُ الجارِ قال تعالي: “وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ” [النساء: 36].
“خيرُكم خيرُكم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي» (الترمذي: حسن صحيح).
“ما زال جبريلُ يوصيني بالجار…» (متفق عليه).
“إذا طبختَ مرقةً فأكثر ماءَها وتعاهد جيرانَك» (مسلم).
آثارٌ عمليّة: ابنُ عمر يهدي جاريَه من ذبائحِه، ويقول: هذا ممّا أوصانا به النبي ﷺ.
شاهدٌ واقعي: أُسرةٌ تُداومُ على قضاءِ حوائجِ جارٍ كبيرِ السنّ؛ تتَّسعُ الدائرةُ إلى حيٍّ متراحِم.
سابعًا: سيرةٌ تهدي — قصصُ هدايةٍ بسماحة
قصةٌ شاهدةٌ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ؛ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ؛ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ. فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَصَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم”. مسلم (ح1764)، رواه البخاري مختصرًا (ح462).
ومن أروع المواقف التي تجسِّد هذه السَّماحة، ما رواه أنس رضي الله عنه: “كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ“. صحيح البخاري، ح 5809، وصحيح مسلم، ح 1057.
التاريخُ الاجتماعي: انتشارُ الإسلام في أرخبيلِ الملايو وشرقِ آسيا ارتبطَ بأمانةِ التجّارِ المسلمين وسماحتِهم، لا بحدِّ السيف؛ شهادةٌ حضاريةٌ على فاعليةِ الأخلاق.
ونتحدث عن نشر. السماحة، ثمراتها في العنصر الثالث
العنصر الثالث: وجوبُ نشرِ السَّماحةِ في واقعِنا وثمراتُها
أيها الأحبّة في الله، إن السَّماحةَ في شريعتنا ليست خيارًا يُترك للمزاج، ولا شعارًا يُرفع في المناسبات، بل هي واجبٌ شرعيٌّ أصيل، تُزيِّنُ به الأمةُ وجهَ الإسلام وتُصونُ جوهره. قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].
وإذا كانت السَّماحةُ واجبًا، فإن نشرها في حياتنا المعاصرة يبدأ من محاور واضحة:
التربية الإيمانية: غرسُ معاني الحِلم والعفو في البيوت، ليشبَّ النشء على رفقٍ ولين.
الخطاب العام: التمسك بوصية النبي ﷺ: «بشِّروا ولا تُنفِّروا» [البخاري (69)، مسلم (1734)]، باعتماد لغة الاحترام لا لغة الازدراء.
المؤسسات: صياغة لوائح وأنظمة عادلة رحيمة، وخدمةُ المتعاملين بسلوك سمح بعيد عن التعسير.
الإعلام والتعليم: نشرُ قصص العفو والرفق من السيرة النبوية وسِيَر السلف، وجعلها حيّةً في مناهجنا وبرامجنا.
فقه الخلاف: إدارةُ الاختلاف بالأخلاق؛ وقد قال الحسن البصري – رحمه الله –: «المؤمن سهلُ الجانب، لينُ الكلمة…»، وروى الترمذي (2002) «ما من شيءٍ أثقلُ في ميزانِ المؤمنِ يومَ القيامةِ من خُلقٍ حسنٍ وإنَّ اللهَ يُبغضُ الفاحشَ البذيءَ”. وأبو داود (4799) صحيح.
قاعدة ابن القيِّم: «حيثما وُجد العدل والرّحمة والمصلحة فثمّ شرع الله» [مدارج السالكين، ج1، ص 164]، فاجعلوا السَّماحةَ عنوانًا ثابتًا في مشاريعكم ومعاملاتكم.
وصدق الشاعر: أَحسِنْ إلى الناسِ تستعبدْ قلوبَهمُ لطالما استعبدَ الإنسانَ إحسانُ
ثمراتُ السَّماحة
إن السَّماحةَ بابٌ واسعٌ للخيرات في الدنيا والآخرة، ومن ثمراتها:
قبول الدعوة واجتماع القلوب: قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: 159]. فاللينُ وحسن الخلق يجمعان القلوب على الداعي ودعوته.
تفريج الكربات ونيل السَّعة: قال ﷺ: «من نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كُرَب الدنيا، نفَّس اللهُ عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة». مسلم (2699). الترمذي (1930).
عمارة السوق وتحقيق الأمن الاجتماعي: فالمعاملةُ السَّمحة تُطهّر الدورة الاقتصادية من الغشّ والشحّ، وتبني الثقة بين البائع والمشتري.
إطفاء الخصومات: العفوُ والإصلاح يقطعان سلسلة الثأر، ويشيعان روح الإخاء في المجتمع.
فالمَولِدُ النَّبَوِيُّ يا عبادَ اللهِ مَعرِضٌ لِسَماحةٍ تُضيءُ القُلوبَ، ورَحمَةٍ تُحيي الأرواحَ، فصلُّوا وسلِّموا على مَن جَعَلَ اللهُ سِيرتَهُ نُورًا، وسَماحَتَهُ هُدىً للعالَمينَ.
اللَّهُمَّ يا واسِعَ الرَّحمَةِ، بمَولِدِ نبيِّكَ مُحمَّدٍ ﷺ اجعلْنا من أهلِ الحِلمِ والسَّماحةِ، واملأْ قلوبَنا عَفوًا ورِفقًا وإحسانًا، اللَّهُمَّ أصلِحْ بيوتَنا، وبارِكْ في أولادِنا، وألِّفْ بينَ قلوبِنا، واجعلْنا على خُلُقِ نبيِّكَ هُداةً للخيرِ سَدًّا في وجوهِ الشَّرِّ، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.
الخطبة الثانية:
الحمدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي ذِكْرَى أَيَّامِهِ مَجَالِسَ لِلذَّاكِرِينَ، وَمَنَابِعَ نُورٍ لِلْمُتَّقِينَ، وَفَوَاحِينِ رَحْمَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ. الحمدُ للهِ الَّذِي أَطَلَّ عَلَى الدُّنْيَا بِنُورِ حَبِيبِهِ الْمُصْطَفَى، فَانْقَشَعَتْ سُحُبُ الجَهْلِ، وَانْجَلَتْ غَيَاهِبُ الشِّرْكِ، وَتَفَتَّحَتْ أَزْهَارُ الْهِدَايَةِ عَلَى ثَرَى الْأَرْضِ. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، خيرُ الورى، وسيدُ الدُّعاة، وإمامُ أهل السماحة والرحمة. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ، النبيِّ الأميِّ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
العنصر الرابع: وَافَى رَبِيعٌ فَمَرْحَبًا بِهِلَالِهِ
المولد النبوي حدث غيَّر مجرى التاريخ
أيها الأحبة في الله، وافى ربيعٌ فمرحبا بهلاله؛ ففيه بزغ نور محمد ﷺ، النورُ الَّذِي بَهَرَ أَبْصَارَ الْبَصَائِرِ قَبْلَ أَنْ يُبْهِرَ الأَبْصَارَ.
روت السيدة آمنة: «رَأَيْتُ حِينَ وَلَدْتُهُ نُورًا خَرَجَ مِنِّي أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ» [مسند أحمد، رقم (17163)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ج 28 ص 385، إسناده صحيح].
فَلَيْسَ مِيلَادُهُ ﷺ حَدَثًا عَابِرًا؛ بَلْ هُوَ بَدَايَةُ عَهْدٍ جَدِيدٍ لِلْبَشَرِيَّةِ، عَهْدٍ تُهْدَمُ فِيهِ أَصْنَامُ الْوَثَنِيَّةِ، وَتُبْنَى مَعَالِمُ التَّوْحِيدِ، عَهْدٌ تَخْرَسُ فِيهِ أَلْسِنَةُ الْكُهَّانِ، وَتُسْمَعُ فِيهِ آيَاتُ الْقُرْآنِ، عَهْدٌ تَنْقَشِعُ فِيهِ ظُلُمَاتُ الْجَهْلِ، وَتُشْرِقُ شُمُوسُ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 15]، قَالَ الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ: «النُّورُ: هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ: هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ» [جَامِعُ الْبَيَانِ، ط. هَجَر، ج10، ص 397].
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، إِنَّ مِيلَادَهُ ﷺ هُوَ الْمَفْصِلُ الْأَعْظَمُ فِي مَسِيرَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ؛ فَكَمَا يَنْقَسِمُ الزَّمَانُ إِلَى مَا قَبْلَ الْمِيلَادِ وَمَا بَعْدَهُ، فَإِنَّ الْبَشَرِيَّةَ انْقَسَمَتْ إِلَى مَا قَبْلَ مَوْلِدِهِ ﷺ وَمَا بَعْدَهُ؛ إِذْ تَغَيَّرَتِ الْمَوَازِينُ، وَتَبَدَّلَتِ الْقُلُوبُ، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِعَدْلِ الْإِسْلَامِ وَنُورِ الْقُرْآنِ.
فَرَحُ الْكَوْنِ بِقُدُومِ خَيْرِ الْأَنَامِ ﷺ
لَقَدْ فَرِحَ الْكَوْنُ كُلُّهُ بِمِيلَادِ خَيْرِ الْوَرَى ﷺ. فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ أَوَّلُ ذَلِكَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ» [المُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ، رَقْم (4228)، ج 2 ص 608، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ].
إِنَّهُ مِيلَادٌ لَمْ يَفْرَحْ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَحْدَهُمْ، بَلْ فَرِحَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَفَرِحَتْ بِهِ الْكَائِنَاتُ جَمِيعًا؛ فَقَدْ كَانَ مِيلَادُهُ ﷺ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الْأَنْبِيَاء: 107].
قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ: «الرَّحْمَةُ هُنَا عَامَّةٌ، دَخَلَ فِيهَا الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ؛ فَالْمُؤْمِنُ رَحْمَةٌ لَهُ بِهَدَايَتِهِ، وَالْكَافِرُ رَحْمَةٌ لَهُ بِكَفِّ الْعَذَابِ الْمُسْتَأْصِلِ عَنْهُ» [الْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ، ط. الرِّسَالَةِ، ج13، ص 350].
أَيُّهَا الأَحِبَّةُ، مَنْ لَمْ يَفْرَحْ بِمِيلَادِ النَّبِيِّ ﷺ فَبِمَاذَا يَفْرَحُ؟ وَمَنْ لَمْ يَسْعَدْ بِذِكْرَى ظُهُورِهِ، فَعَلَامَ يَسْعَدُ؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يُونُس: 58]. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: فَضْلُ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، وَرَحْمَتُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ [تَفْسِيرُ الْبَغَوِيِّ، ج 2 ص 406].
مَشْرُوعِيَّةُ الْفَرَحِ بِالْمَوْلِدِ وَأَقْوَالُ الْأَئِمَّةِ
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، لَقَدْ أَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْفَرَحِ بِمِيلَادِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَدُّوا ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ (ت 902هـ): «مَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالْمُدُنِ الْعِظَامِ يَحْتَفِلُونَ فِي شَهْرِ مَوْلِدِهِ ﷺ، وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، وَيَزِيدُونَ فِي الْمَبَرَّاتِ، وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِيهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيمٍ» [الْأَجُوبَةُ الْمَرْضِيَّةُ، ص 136].
فَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ الْجَلِيلَةِ؟! إِنَّ الْفَرَحَ بِمِيلَادِهِ ﷺ لَيْسَ مُجَرَّدَ عَادَةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ، بَلْ هُوَ تَعْبِيرٌ عَنِ الْإِيمَانِ، وَتَجْدِيدٌ لِلْعَهْدِ مَعَ الْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى ﷺ.
كَيْفَ نُحْيِي الْمَوْلِدَ النَّبَوِيَّ عَمَلِيًّا؟
أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ، لَيْسَ الِاحْتِفَالُ بِالْمَوْلِدِ مُجَرَّدَ شِعَارَاتٍ أَوْ أَصْوَاتٍ، بَلْ هُوَ تَجْسِيدٌ حَيٌّ لِمَحَبَّتِهِ ﷺ.
وَمِنْ أَعْظَمِ صُوَرِ الِاحْتِفَالِ الْمَشْرُوعِ:
- الْإِكْثَارُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ ﷺ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الْأَحْزَاب: 56].
- قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ؛ فَفِيهَا حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَنُورُ الْأَبْصَارِ.
- إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّدَقَةُ عَلَى الْفُقَرَاءِ؛ قَالَ ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ» [مُسْنَدُ أَحْمَدَ، رَقْم (23408)، ج 37 ص 475، إِسْنَادُهُ حَسَنٌ].
- إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ فَإِنَّ أَعْظَمَ مَا نُقَدِّمُهُ فِي ذِكْرَى مَوْلِدِهِ ﷺ أَنْ نَكُونَ دُعَاةَ وَحْدَةٍ وَرَحْمَةٍ.
- تَعْلِيمُ الْأَبْنَاءِ مَحَبَّةَ النَّبِيِّ ﷺ عَبْرَ الْقَصَصِ وَالْمَدَائِحِ، حَتَّى يَنْشَؤُوا قُلُوبًا بَيْضَاءَ مُتَعَلِّقَةً بِهِ.
فَوَاللهِ مَا أُحْيِيَتْ ذِكْرَاهُ بِالْمَدَائِحِ إِلَّا ازْدَادَتِ الْقُلُوبُ حُبًّا لَهُ، وَمَا أُقِيمَتِ الْمَجَالِسُ لِذِكْرِهِ إِلَّا تَنَزَّلَتِ الرَّحْمَاتُ، وَمَا فَاضَتْ دُمُوعُ الشَّوْقِ إِلَيْهِ إِلَّا طَابَتِ الْأَرْوَاحُ بِنُورِ هَدْيِهِ.
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، إِنَّ ذِكْرَى مَوْلِدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ تَارِيخٍ يُسْتَذْكَرُ، وَلَا حَدَثٍ يُرْوَى، بَلْ هِيَ مِيثَاقُ إِيمَانٍ، وَعَهْدُ وَلَاءٍ، نُجَدِّدُ فِيهِ مَحَبَّتَنَا لِنَبِيِّ الرَّحْمَةِ ﷺ، وَنُعَاهِدُ رَبَّنَا عَلَى الِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي كُلِّ دُرُوبِ الْحَيَاةِ.
فَأَظْهِرُوا فَرَحَكُمْ بِهِ ﷺ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَاحْفَظُوا ذِكْرَاهُ بِسُنَّتِهِ، وَانْشُرُوا سَمَاحَتَهُ فِي الْبُيُوتِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ كَمَا كَانَ هُوَ شَهِيدًا عَلَيْنَا.
اللَّهُمَّ يَا مَن بَشَّرْتَ الْوُجُودَ بِنُورِ مِيلَادِهِ ﷺ، اجْعَلْنَا مِنَ الْفَرِحِينَ بِهِ، الْمُقْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، الْمُتَخَلِّقِينَ بِسَمَاحَتِهِ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَفِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
المراجع: القرآن الكريم، كتب الحديث: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي (الجامع الكبير)، سنن النسائي، مسند أحمد، المعجم الكبير للطبراني. المصنف لابن أبي شيبة.
ثالثًا: كتب التفسير وشروح الحديث وغيرهما: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، تفسير ابن كثير، الوسيط لطنطاوي، تَفْسِيرُ الْبَغَوِيِّ، شرح البخاري لابن حجر، شرح البخاري لابن بطال، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، حلية الأولياء، مَدَارِجُ السَّالِكِينَ لابْنُ القَيِّمِ، الْأَجُوبَةُ الْمَرْضِيَّةُ للسخاوي.
خُطبةُ صوتِ الدعاةِ – إعداد رئيس التحرير: الدكتور أحمد رمضان
_______________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
وأيضا للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة
–للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
وكذلك للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
-كذلك للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
وأيضا للمزيد عن مسابقات الأوقاف












