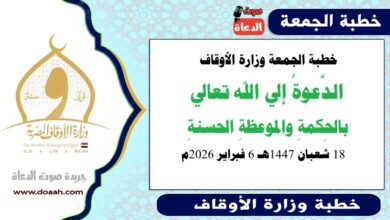خطبة الجمعة 21 نوفمبر : كُنْ جَمِيلًا تَرَ الْوُجُودَ جَمِيلًا ، للدكتور أحمد رمضان
(الحطبة الثانية): مبادرة تصحيح المفاهيم التي أطلقتها وزارة الأوقاف: (عدم الاعتداء على الجار)
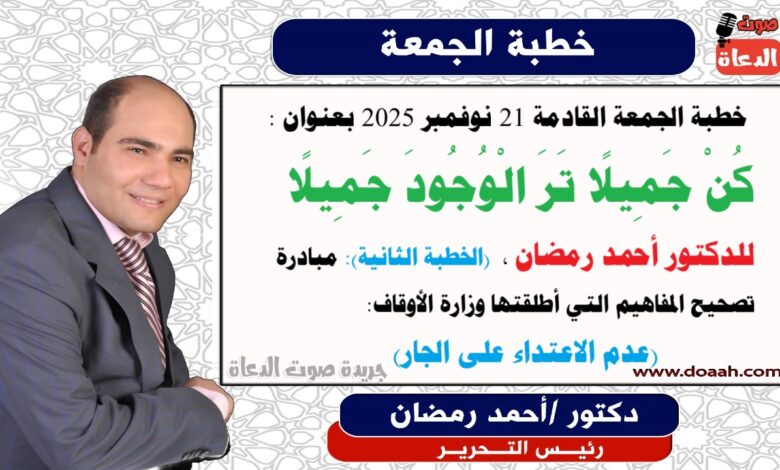
خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر 2025 بعنوان : كُنْ جَمِيلًا تَرَ الْوُجُودَ جَمِيلًا ، إعداد: رئيس التحرير الدكتور أحمد رمضان لـ صوت الدعاة ، بتاريخ 30 جمادي الأولي 1447هـ ، الموافق 21 نوفمبر 2025م. (الحطبة الثانية): مبادرة تصحيح المفاهيم التي أطلقتها وزارة الأوقاف: (عدم الاعتداء على الجار)
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر 2025م بصيغة word بعنوان : كُنْ جَمِيلًا تَرَ الْوُجُودَ جَمِيلًا ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان لـ صوت الدعاة.
انفراد لتحميل خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر 2025م بصيغة pdf بعنوان : كُنْ جَمِيلًا تَرَ الْوُجُودَ جَمِيلًا ، للدكتور أحمد رمضان.
عناصر خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر 2025م بعنوان : كُنْ جَمِيلًا تَرَ الْوُجُودَ جَمِيلًا، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان.
العنصر الأول: جمال معرفة الله وجمال النظر في الكون وخلقه
العنصر الثاني: جمالُ النفسِ والأخلاقِ والمظهرِ الحسن
العنصر الثالث: جَمَالُ الْمُعَامَلَةِ فِي الِاخْتِلَافِ
العنصرُ الرابع (الحطبة الثانية): مبادرة تصحيح المفاهيم التي أطلقتها وزارة الأوقاف: (عدم الاعتداء على الجار)
جمالُ المعاملةِ مع الجارِ وصبغةُ الجمالِ في الجوارِ
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر 2025م : كُنْ جَمِيلًا تَرَ الْوُجُودَ جَمِيلًا ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان : كما يلي:
كُنْ جَمِيلًا تَرَ الْوُجُودَ جَمِيلًا
30 جمادي الأولي 1447هـ – 21 نوفمبر 2025م
إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
المـــوضــــــــــوع
الحمدُ لله الذي خلق السماواتَ والأرضَ وما بينهما، وجعل لكل شيءٍ آيةً تدلُّ على قدرته وعظمته، وجعل للإنسانِ جمالًا في القلبِ والبدن، وجعل النظرَ إلى خلقه وسيلةً للتأملِ في حكمته وعلمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلواتُ الله وسلامهُ عليه وعلى آله وصحبه أجمعينَ. أما بعد…
عناصر الخطبة:
العنصر الأول: جمال معرفة الله وجمال النظر في الكون وخلقه
العنصر الثاني: جمالُ النفسِ والأخلاقِ والمظهرِ الحسن
العنصر الثالث: جَمَالُ الْمُعَامَلَةِ فِي الِاخْتِلَافِ
العنصرُ الرابع: جمالُ المعاملةِ مع الجارِ وصبغةُ الجمالِ في الجوارِ
أيها الأحبةُ في الله: إن من أعظمِ نعمِ اللهِ على عبادهِ، أن جعلَ لهم من الجمالِ نورًا يهديهم في حياتهم، ومن النظرِ في الكونِ درسًا يربّي القلبَ، ويعلّمهم عظمةَ الخالقِ، ومن حسنِ الأخلاقِ والمظهرِ والخلقِ سببًا لزيادة محبةِ الناس، وسعةِ الرضا، وصفاءِ النفس.
العنصر الأول: جمال معرفة الله وجمال النظر في الكون وخلقه
أيها الإخوةُ المؤمنونَ: لقد جعلَ اللهُ عزَّ وجلَّ جمالَه تعالى على أربعِ مراتبٍ، كما بيّنها ابنُ القيمِ رحمهُ اللهُ في الفوائد (ص182): “وجماله سُبْحَانَهُ على أَربع مَرَاتِب جمال الذَّات وجمال الصِّفَات وجمال الْأَفْعَال وجمال الْأَسْمَاء فأسماؤه كلهَا حسنى وَصِفَاته كلهَا صِفَات كَمَال وأفعاله كلهَا حِكْمَة ومصلحة وَعدل وَرَحْمَة وَأما جمال الذَّات وَمَا هُوَ عَلَيْهِ فَأمر لَا يُدْرِكهُ سواهُ وَلَا يُعلمهُ غَيره وَلَيْسَ عِنْد المخلوقين مِنْهُ إِلَّا تعريفات تعرّف بهَا إِلَى من أكْرمه من عباده”.
ومن أعظمِ طرقِ معرفةِ اللهِ أن يتفكرَ الإنسانُ في خلقِ اللهِ، في السماءِ والأرضِ وما بينهما، في الليلِ والنهارِ، في الشمسِ والقمرِ والنجومِ، في البحرِ والأنهارِ، وفي النباتِ والأشجارِ والجبالِ. كلُّ شيءٍ فيها مرآةٌ لجمالِ اللهِ وعظمتهِ. قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ [الكهف:7].
وَمِنْ دلائلِ مَحَبَّةِ اللهِ الجميلِ للجمالِ أنَّهُ خَلَقَ الجمالَ، فَنَسَجَ حُلَلَهُ في صفحاتِ الكونِ، وبثَّ آياتِه في الآفاقِ والأكوانِ، فأبدعَ في الخلقِ والتقديرِ، وصوَّرَ فأحسنَ التصويرَ، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾. [المؤمنون: 14].
خلقَ الإنسانَ في أكملِ هيئةٍ، وأجملِ صورةٍ، وأتقنِ بنيةٍ، جمالُ خلقةٍ لا يعتريهِ نقصٌ، وكمالُ صنعةٍ لا يلحقُها خللٌ، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4]، ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾. [غافر: 64].
يا أيها الإنسانُ: ارفعْ بصركَ إلى ملكوتِ ربِّكَ، وأطلقْ عينيكَ في محرابِ السماءِ، تبصرْ جمالًا يأسرُ النفوسَ، وحسنًا يدهشُ العقولَ، ﴿رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾. [النازعات: 28-29].
سماءٌ مرفوعةٌ بلا عمدٍ، مرصوصةٌ بلا فتوقٍ، صافيةٌ لا خروقَ تشينُها، ولا خللَ يخالطُها، ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾. [ق: 6].
ثم زادَها خالقُها حسنًا فوقَ حسنٍ، وبهاءً فوقَ بهاءِ، فزينَها بالنجومِ والكواكبِ، وجعلَها مصابيحَ تضيءُ، وجواهرَ تتلألأُ، ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [الملك: 5].، ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾. [الصافات: 6].
تأملوا عبادَ اللهِ في الشمسِ والقمرِ: إشراقُهما وغروبُهما، وفي النجومِ والكواكبِ وهي تنثرُ البهاءَ في السماءِ، وفي البحرِ والأنهارِ ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل:14].
وفي الأرضِ، حدائقٌ غنّاءُ ومروجٌ خضراءُ، وأشجارٌ مثمرةٌ وزهورٌ يانعةٌ، كلُّ ذلك جمالٌ بديعٌ يذكّرنا بجمالِ الخالقِ وقدرتهِ.
وروي عن الحسنِ البصريِّ رحمهُ اللهُ في الزهد للإمام أحمد (ص317): «حُسْنُ الخُلُقِ بَذْلُ الْمَعْرُوفِ، وَكَفُّ الْأذى، وَطَلَاقَةُ الْوَجْهِ»، أي أن جمالَ الخلقِ مرتبطٌ بفهمِ حكمةِ الخالقِ والتأملِ في صنعِه.
أيها الأحبةُ: فلنجعل التأملَ في الكونِ وسيلةً لتعظيمِ اللهِ، وزيادةِ معرفةِ القلبِ بربِّه، وتهذيبِ النفسِ، ولنعتبر كلَّ جمالٍ في السماواتِ والأرضِ مرآةً لجمالِ اللهِ وعظمتهِ، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:11].
قال الشاعر: وَالَّذي نَفسُهُ بِغَيرِ جَمالٍ لا يَرى في الوُجودِ شَيئاً جَميلا
أَيُّهَذا الشاكي وَما بِكَ داءٌ كُن جَميلاً تَرَ الوُجودَ جَميلا
العنصر الثاني: جمالُ النفسِ والأخلاقِ والمظهرِ الحسن
أيها الإخوةُ المؤمنونَ: لقد جاء عن عبد الله بن مسعودٍ رضي اللهُ عنه أن النبيَّ ﷺ قال: “لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَن كانَ في قَلْبِهِ مِثْقالُ ذَرَّةٍ مِن كِبْرٍ قالَ رَجُلٌ: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أنْ يَكونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا ونَعْلُهُ حَسَنَةً، قالَ: إنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ، الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ، وغَمْطُ النَّاسِ (رواه مسلم 91، كتاب الإيمان).
هذا الحديثُ الشريفُ يبينُ لنا أصلين عظيمين:
الأول: معرفةُ اللهِ بالجمالِ: أن ندركَ أنَّ اللهَ تعالى جميلٌ يحبُّ الجمالَ في ذاتهِ وأسمائهِ وصفاتهِ وأفعالهِ، وأن جمالَه تعالى يتجلّى في كلِّ شيءٍ حولَنا.
الثاني: السلوكُ بالجمالِ: أن نعبدهُ بالجمالِ الذي شرعهُ لنا، من خلال:
القلبِ: بالإخلاصِ، والمحبةِ، والإنابةِ، والتوكلِ.
الأقوالِ: بالصدقِ واللسانِ الجميلِ.
الأعمالِ: الصلاةِ، الصيامِ، الصدقِ، والطاعاتِ.
الأخلاقِ: التواضعُ، الحلمُ، الشجاعةُ، الكرمُ، السخاءُ.
الجوارحِ: بالطاعةِ والعبادةِ، وإظهارِ النعمةِ في اللباسِ والنظافةِ.
ومن أهم أنواع الجمال، جمال الأخلاق: “الدِّينُ كُلُّهُ خُلُقٌ. فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ: زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ. وَكَذَلِكَ التَّصَوُّفُ”. قَالَ الْكِنَانِيُّ: التَّصَوُّفُ هُوَ الْخُلُقُ، فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ: فَقَدْ زَادَ عَلَيْكَ فِي التَّصَوُّفِ. «الرسالة القشيرية» (ص 578). وانظر: «تاريخ بغداد» (3/ 75)، و «إحياء علوم الدين» (3/ 52)، و «سير أعلام النبلاء» (14/ 534). وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ بَذْلُ النَّدَى، وَكَفُّ الْأَذَى، وَاحْتِمَالُ الْأَذَى. «حلية الأولياء» (3/ 37 )، و «إحياء علوم الدين» (3/ 53). وَقِيلَ: حُسْنُ الْخُلُقِ: بَذْلُ الْجَمِيلِ، وَكَفُّ الْقَبِيحِ. وَقِيلَ: التَّخَلِّي مِنَ الرَّذَائِلِ، وَالتَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ.
وقال ابن القيم في مدارج السالكين (2/ 294): “وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَقُومُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ لَا يُتَصَوَّرُ قِيَامُ سَاقِهِ إِلَّا عَلَيْهَا: الصَّبْرُ، وَالْعِفَّةُ، وَالشَّجَاعَةُ، وَالْعَدْلُ.
فَالصَّبْرُ: يَحْمِلُهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَكَفِّ الْأَذَى، وَالْحِلْمِ وَالْأَنَاةِ وَالرِّفْقِ، وَعَدَمِ الطَّيْشِ وَالْعَجَلَةِ.
وَالْعِفَّةُ: تَحْمِلُهُ عَلَى اجْتِنَابِ الرَّذَائِلِ وَالْقَبَائِحِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَتَحْمِلُهُ عَلَى الْحَيَاءِ. وَهُوَ رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ. وَتَمْنَعُهُ مِنَ الْفَحْشَاءِ، وَالْبُخْلِ وَالْكَذِبِ، وَالْغَيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ.
وَالشَّجَاعَةُ: تَحْمِلُهُ عَلَى عِزَّةِ النَّفْسِ، وَإِيثَارِ مَعَالِي الْأَخْلَاقِ وَالشِّيَمِ، وَعَلَى الْبَذْلِ وَالنَّدَى، وَالْعَدْلُ: يَحْمِلُهُ عَلَى اعْتِدَالِ أَخْلَاقِهِ، وَتَوَسُّطِهِ فِيهَا بَيْنَ طَرَفَيِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ. فَيَحْمِلُهُ عَلَى خُلُقِ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ … وَمَنْشَأُ جَمِيعِ الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ”.
أيها الأحبةُ: إن جمالَ الظاهرِ من نعمِ الله، كما أن جمالَ الباطنِ من أعظمها، فاللهُ تعالى جمعَ بينهما في قولهِ: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقوى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف:26]،
فزينةُ البدنِ باللباسِ، وزينةُ القلبِ بالتقوى، فإذا اجتمعت، اكتملَ جمالُ المؤمنِ في ذاتهِ ومظهرهِ.
وقد كان نبينا ﷺ يحرصُ على جمالِ الهيئةِ والمظهرِ، فقد ورد عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي اللهُ عنه: “ما شَمَمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ، وَلَا مِسْكًا، وَلَا شيئًا أَطْيَبَ مِن رِيحِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَلَا مَسِسْتُ شيئًا قَطُّ دِيبَاجًا، وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مَسًّا مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ“ (البخاري (3561)، ومسلم (2330) ).
وكان ﷺ يتطيبُ للجمعةِ والأعيادِ، ويعتني بالملابسِ، ويهتمُّ بالسواكِ ونظافةِ الشعرِ واللحيةِ، قال ﷺ: “من اغتَسلَ يومَ الجمُعةِ ولبسَ مِن أحسَنِ ثيابِهِ، ومَسَّ مِن طيبٍ إن كانَ عندَهُ، ثمَّ أتى الجمُعةَ فلم يتخطَّ أعناقَ النَّاسِ، ثمَّ صلَّى ما كَتبَ اللَّهُ لَهُ، ثمَّ أنصَتَ إذا خرجَ إمامُهُ حتَّى يفرُغَ مِن صلاتِهِ كانَت كفَّارةً لما بينَها وبينَ جمعتِهِ الَّتي قبلَها”. أبو داود (343) واللفظ له، وأحمد (11768) باختلاف يسير، وابن حبان (2778). صحيح.
كما ورد أنه ﷺ أشارَ إلى رجلٍ دخلَ المسجدَ رأسُه ثائرٌ ولحيتهُ مشوهةٌ، فقال: «أليس هذا خيرًا من أن يأتي أحدُكم ثائرَ الرأسِ كأنَّه شيطانٌ» (أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/949)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6462)حديث مرسل).
أيها الإخوةُ: ومن فضلِ الله على عباده، أن جعل لهم الجمالَ في الصوتِ أيضًا، فقد أحبَّ النبي ﷺ حسنَ الصوتِ في القرآنِ فقال: «ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآنِ» (رواه البخاري 7527)، وقال أيضًا: «حسِّنوا القرآنَ بأصواتِكم فإنَّ الصوتَ الحسنَ يزيدُ القرآنَ حُسْنًا» (ابن ماجه (1342) ، والدارمي (3501) واللفظ له، والحاكم (2125) صحيح).
فلنحرص جميعًا على أن يكون جمالُنا ظاهرًا وباطنًا، بأن نجمع بين: التقوى وحسنِ الخلقِ، المظهرِ الحسنِ والنظافةِ، الصدقِ في الكلامِ والأمانةِ في العملِ، الطيبةِ في القلبِ والتواضعِ في التعاملِ.
العنصر الثالث: جَمَالُ الْمُعَامَلَةِ فِي الِاخْتِلَافِ
أيها الإخوةٌ المؤمنونَ: إن اختلافَ البشرِ سنةٌ ربانيةٌ في الحياةِ، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود:118]، هُنَا يَبَرْزُ جَمَالُ الْأَخْلَاقِ، وَعُلُوُّ الرُّوحِ، وَسُمُوُّ الْأَنْفُسِ.
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، في اختلاف الصديق مع عمر رضي الله عنهما قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي» مَرَّتَيْنِ، فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا. [البخاري 3661].
فجمالُ المعاملةِ في الاختلافِ خلقٌ نبيلٌ وخلقٌ كريمٌ، وقد كان نبينا ﷺ قدوةً في ذلك، فقد قال ﷺ: “لَا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ، حتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (البخاري 13، ومسلم 45).
فكانَ الاختلافُ، ثُمَّ كانتِ المحبَّةُ، ثُمَّ غلبَ الأدبُ والإيمانُ علَى النُّفوسِ.
اختلفَ الأئمَّةُ الأربعةُ، وما تباغضُوا
الإمام مالك والشافعي: كان الشافعي يقول: “مالِكٌ أستاذي، وعنه أخذنا العلمَ، وما أحدٌ أمنُ عليَّ من مالِكٍ، وجعلتُ مالِكًا حجَّةً بيني وبينَ اللهِ تعالى، وإذا ذُكِرَ العلماءُ فمالِكٌ النَّجمُ الثاقبُ، ولم يبلغْ أحدٌ مبلغَ مالِكٍ في العلمِ لحفظِه وإتقانِه وصيانتِه، وقالَ: العلمُ يدورُ على ثلاثةٍ: مالِكٍ، والليثِ، وسفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ”. ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض، ج1، ص86. وراجع أيضا: مناقب الشافعي للبيهقي 1/273 . تهذيب التهذيب لابن حجر ج10، ص8. شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي ج1، ص460. المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، علي جمعة ص39. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ابن دقيق العيد ج1، ص472. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، ابن عبد البر ص23.
وقال مالكٌ رحمه اللهُ عن الشافعيِّ: «إني أرى اللهَ قد ألقى على قلبِكَ نورًا، فلا تُطفِئْهُ بظُلمةِ المعصيةِ». الحواب الكافي لابن القيم ص188، وسير أعلام النبلاءِ 10/69 . ومع ذلكَ خالفَه الشافعيُّ في مئاتِ المسائلِ الفقهيةِ، ولم يُنقَلْ عنه طعنٌ ولا سبٌّ ولا ازدراءٌ.
قال اللَّيثُ: لقيتُ مالكًا بالمدينةِ، فقلتُ له: إني أراك تمسَح العرقَ عن جبينكَ. قال: عرَقْتُ مع أبي حَنِيفةِ، إنَّه لَفقيهٌ يا مصريٌّ؛ ثم لقيتُ أبا حَنيفةَ فقلتُ: ما أحسَنَ قولَ ذلك الرجلِ فيكَ! فقال يقصد مالك: واللهِ ما رأيتُ أسرَعَ منهُ بجوابٍ صادقٍ وزهدٍ تامٍ”. ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض، ج1، ص152.
وقال الشافعي: من أراد أن يتبحر في الفقهِ فهو عيالٌ على أبي حنيفةِ”. طبقات الفقهاء للشيرازي ص86، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج13، ص346.
الإمام أحمد والشافعي: قال أحمد بن حنبل: «ما صلَّيتُ صلاةً منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي”. طبقات الحنابلة 1/161.
وقال الشافعي عنه: «خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أورع من أحمد”. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/316 – دار إحياء التراث. اختلفوا في الفروع، لكنَّ قلوبهم اتحدت على التقوى والاحترام والولاء لله.
مِعْيَارُ الْجَمَالِ فِي الْخِلَافِ عِنْدَ السَّلَفِ
قال سفيان الثوري رحمه الله: “إذا بلغك عن أخيك ما تكره، فالتمس له العذر الواحد إلى السبعين”. حلية الأولياء 7/34.
وقال جعفر بن محمد لسفيان الثوري: “إذا جاءك ما تكره فأكثر من: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار “. حلية الأولياء 3/ 197.
رابعًا – شَوَاهِدُ جَمَالِ التَّعَامُلِ فِي الْخِلَافِ
اختلاف الصحابة في قتال مانعي الزكاة: أنكر بعضهم على أبي بكرٍ رأْيَه، فقال عمر: «فواللَّهِ ما هوَ إلَّا أن رأيتُ أنَّ اللَّهَ قد شرحَ صدرَ أبي بَكرٍ للقتالِ فعرفتُ أنَّهُ الحقُّ“. البخاري (7284، 7285)، ومسلم (20) . فكان خلافٌ ثم اتفاق، وكانت رحمةٌ، وما شتم أحدٌ أحدًا.
وهكذا نرى أنَّ الخلافَ مهما اشتدَّ، ما دام مقيدًا بالأدبِ والإنصافِ، ومن هذا المعنى ينتقلُ بنا الإمامُ الشعراوي رحمهُ الله إلى لَفْتَةٍ قرآنيةٍ بديعةٍ، فيربطُ الجمالَ بأصعبِ المواطنِ، فيقولُ: “ولكَ أنْ تلحظْ أنَّ لفظَ الجمالِ يأتي في القرآنِ مع الأمورِ الصعبةِ التي تحتاجُ شِدَّةً، واقرأْ قولَهُ تعالى: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ [يوسف:٨٣]، ﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب:٢٨]، ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [المزمل:١٠]. والصبرُ يكونُ جميلًا حينَ لا يُصاحِبُهُ ضَجَرٌ، أو شَكْوَى، أو خروجٌ عن حدِّ الاعتدالِ. ويُقالُ: «اصبرْ عن كذا» إذا كان الصبرُ فيهِ إيلامٌ لكَ. والصبرُ يكونُ جميلًا حينما لا تكونُ فيهِ شكوى أو جَزَعٌ”. راجع تفسير الشعراوي ج11، ص 6891 – ج19، ص12005.
الخطبة الثانية (مبادرة تصحيح المفاهيم)
الحمدُ لله الذي كرّم الجوارَ في الإسلام، وجعل حق الجار من مكارم الأخلاق، وأنزل في كتابه آيات تتضمن عنايته بالجار وحقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله، صلواتُ الله وسلامهُ عليه وعلى آله وصحبه أجمعينَ.
أيها الإخوة المؤمنون: من أهم موضوعات مبادرة تصحيح المفاهيم التي أطلقتها وزارة الأوقاف: (عدم الاعتداء على الجار)
العنصرُ الرابع: جمالُ المعاملةِ مع الجارِ وصبغةُ الجمالِ في الجوارِ
إن من جمالِ الإسلامِ أن يعلي قيمة الجار، ليس فقط في حق الجوار الماديّ، بل في خلق التعامل، وفي المودة، وفي التراحم. فحين نجمع بين “جمال القلب” و “جمال التعامل” مع الجار، نُحَقّق جوّارًا مؤمنًا، وجارًا محبوبًا، وجيرةً متماسكة.
في القرآن: التوصيةُ بالإحسانِ إلى الجارِ قال تعالي: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ…﴾. [النساء:36].
وقال النبي ﷺ قوله: “ما زالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بالجارِ، حتَّى ظَنَنْتُ أنَّه سَيُوَرِّثُهُ“. البخاري (6014)، ومسلم (2624). وقال أيضًا لما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: “كيف لي أن أعلمَ إذا أحسنتُ وإذا أسأتُ قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا سمعتَ جيرانَك يقولون أن قد أحسنتَ فقد أحسنتَ وإذا سمعتَهم يقولون قد أسأتَ فقد أسأتَ“. ابن ماجه (4223) واللفظ له، وأحمد (3808). حديث صحيح.
قصة الرجل الذي اشتكى جاره للنبي ﷺ: في حقوق الجوار، جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يشكو جارَه، فقال: اذهب فاصبرْ فأتاه مرتين أو ثلاثًا فقال: اذهب فاطرحْ متاعَك في الطريق. فطرح متاعَه في الطريق، فجعل الناسُ يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناسُ يلعنونَه: فعل اللهُ به، وفعل، وفعل، فجاء إليه جارُه فقال له : ارجعْ لا ترى مني شيئًا تكرهه”. أبو داود (5153) واللفظ له، وأبو يعلى (6630)، وابن حبان (520). حديث صحيح.
كيف يتجسّد الجمالُ في الجوارِ
جمالُ الرحمةِ والرفقِ: يكونُ الجارُ الجميلُ من يُرافقُ جارهُ في المرضِ، ويُواسيهُ في الحزنِ، ويُباركُ لهُ في السراءِ، ويُقدّمُ لهُ المعروفَ بلا كللٍ ولا مللٍ، فالحسنُ في الجوارِ يثمرُ مودةً وطمأنينةً بين القلوبِ.
جمالُ العدلِ: لا يُؤذي الجارُ جارهُ بعبثٍ، ولا يمنعهُ من حقوقهِ الشرعيةِ، بل يكونُ العدلُ ميزانَهُ في كلِّ شؤونِ الحياةِ، سواءٌ في التشاركِ في الميراثِ، أو في الحقوقِ اليوميةِ، فالعدلُ جمالٌ يزدادُ أثرهُ في النفوسِ ويُقوّي روابطَ الألفةِ.
جمالُ الصمتِ والسترِ: لا يتتبَّعُ الجارُ عثراتِ جارهِ، ولا ينظرُ إلى خصوصياتهِ، بل يحفظُ سرهُ، ويغضُّ بصرَهُ عمّا لا يليقُ، فيكونُ بذلك رمزًا للثقةِ والأمانةِ، ويُجسّدُ جمالَ التعاملِ الذي يرفعُ شأنَ الجوارِ.
جمالُ النصحِ والإرشادِ: الجارُ المؤمنُ ينصحُ جارهَ إن أخطأ بلينٍ ورفقٍ، دون تجريحٍ ولا إذلالٍ، فيُبقي النقاشَ في جوٍّ من المودةِ والبناءِ، ويعلّمُ قيمَ الحقِّ والحكمةِ، فهذا النصحُ الجميلُ يُزَيِّنُ حياةَ الجوارِ ويجعلها مُثمرةً وروحانيةً.
إنَّ الجارَ في الإسلامِ ليسَ مجردَ من يسكنُ بجوارِكَ، بل هو ركيزةٌ من ركائزِ المجتمعِ الجميلِ المتآلفِ. فحين نمارسُ حسنَ الجوارِ بقلوبٍ جميلةٍ وأفعالٍ جميلةٍ، نكونُ قد تجسّدنا جمالًا في تعاملاتِنا، وجعلنا من دينِنا جسرًا لا جدارًا، ومن جوارِنا نعمةً لا عبئًا.
فلنُجَلِّ جيرانَنا بالإحسانِ، ولنُظهرْ في معاملتِنا معهم ما يعكسُ «جمالَ المعرفةِ باللهِ» و«جمالَ الذاتِ» و«جمالَ الروحِ» الذي تعلمناهُ، فبتلكَ الخصالِ يعلو الجارُ، ويرتقي المجتمعُ، وتُزَيِّنُ حياتَنا بقيمةِ الجوارِ التي أمرنا اللهُ بها وأرشدنا إليها رسولهُ ﷺ.
أيها الأحبةُ في اللهِ: إن اللهَ تعالى خلقَ الإنسانَ ووهبه نعمةَ البصرِ والقلبِ والروحِ، ليعرف به جمالَ الكونِ وإبداعَ الخالقِ، قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا﴾ [ق:6]، فمن تأمل خلقَ الله ورأى الآياتِ في السماءِ والبحرِ والأرضِ والنباتِ، عظم قلبه وعلت روحه.
فلنجمع هذه الجمالاتِ في حياتنا: جمالَ النظرِ لمعرفةِ الله، وجمالَ النفسِ والمظهرِ، وجمالَ المعاملةِ، وجمالَ الجوارِ، فبهذا يكتمل جمالُ المؤمنِ في قلبهِ وروحهِ وسلوكِه.
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَمَالِ وَالْكَمَالِ وَالْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ، وَاحْفَظْ مِصْرَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ.
المراجع: القرآن الكريم
كتب الحديث: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، وابن ماجه، سنن الترمذي، مسند أحمد، سنن النسائي، المعجم الأوسط للطبراني، المستدرك للحاكم، وسنن الدرامي، شعب الإيمان للبيهقي، الموطأ لمالك.
ثالثًا: كتب التفسير وشروح الحديث وغيرهما: الزهد للإمام أحمد، الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، إحياء علوم الدين للغزالي، سير أعلام النبلاء للذهبي، حلية الأولياء للأصبهاني، مدارج السالكين لابن القيم، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض، مناقب الشافعي للبيهقي، تهذيب التهذيب لابن حجر، شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، علي جمعة، شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ابن دقيق العيد، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، ابن عبد البر، الحواب الكافي لابن القيم، طبقات الفقهاء للشيرازي، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي.
د. أحمد رمضان
خُطبةُ صوتِ الدعاةِ – إعداد رئيس التحرير: الدكتور أحمد رمضان
___________________________________
خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف علي صوت الدعاة
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
و للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع
و للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف