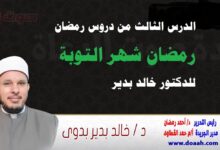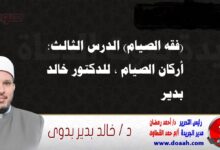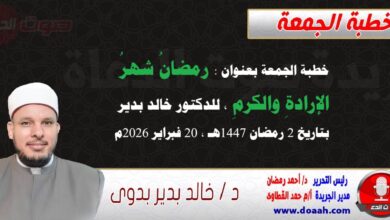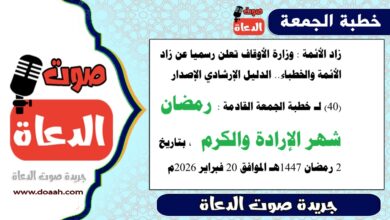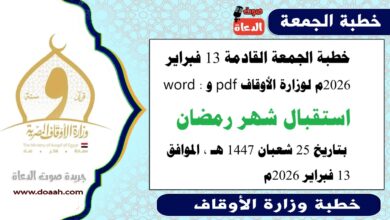خطبة الجمعة القادمة للدكتور أحمد رمضان : هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟
هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟ الدكتور أحمد رمضان، بتاريخ 23 جمادي الأولي 1447هـ ، الموافق 14 نوفمبر 2025م

خطبة الجمعة القادمة بعنوان : هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟ ، إعداد: رئيس التحرير الدكتور أحمد رمضان لـ صوت الدعاة ، بتاريخ 23 جمادي الأولي 1447هـ ، الموافق 14 نوفمبر 2025م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 14 نوفمبر 2025م بصيغة word بعنوان : هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان لـ صوت الدعاة.
انفراد لتحميل خطبة الجمعة القادمة 14 نوفمبر 2025م بصيغة pdf بعنوان : هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟ ، للدكتور أحمد رمضان.
عناصر خطبة الجمعة القادمة 14 نوفمبر 2025م بعنوان : هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان.
العنصرُ الأوّلُ: القلوبُ بيدِ اللهِ وحدَهُ
العُنْصُرُ الثاني: حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ وَالنَّاسِ سَبِيلُ سَلَامَةِ الْقَلْبِ
العنصرُ الثالثُ: حقوقُ الإنسانِ في الإسلامِ حصنٌ ضدَّ التشددِ
العنصر الرابع: تزكيةُ القلوبِ بالتربيةِ الإيمانيةِ سبيلُ النجاةِ من الغلوِّ
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 14 نوفمبر 2025م : هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان : كما يلي:
هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟
23 جمادي الأولي 1447هـ – 14 نوفمبر 2025م
إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
المـــوضــــــــــوع
الحمدُ للهِ الذيِ جعلَ حفظَ النفوسِ منْ أعظمِ القرباتِ، وحرمَ سفكَ الدماءِ بغيرِ حقٍ وعدهُ منْ أكبرِ الموبقاتِ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ، أمرَ بالعدلِ والإحسانِ، ونهى عنِ البغيِ والظلمِ والعدوانِ، وأشهدُ أنَ سيدَنا ونبينا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبهِ، وسلمَ تسليمًا كثيرًا إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ..
عناصر الخطبة:
العنصرُ الأوّلُ: القلوبُ بيدِ اللهِ وحدَهُ
العُنْصُرُ الثاني: حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ وَالنَّاسِ سَبِيلُ سَلَامَةِ الْقَلْبِ
العنصرُ الثالثُ: حقوقُ الإنسانِ في الإسلامِ حصنٌ ضدَّ التشددِ
العنصر الرابع: تزكيةُ القلوبِ بالتربيةِ الإيمانيةِ سبيلُ النجاةِ من الغلوِّ
أيها الإخوةُ المسلمونَ… موعدُنا اليومَ معَ حديثٍ عظيمٍ، وقاعدةٍ كبرى منْ قواعدِ الإسلامِ في حفظِ النفوسِ وإقامةِ الحقوقِ. إنهُ الحديثُ الذيِ جرى يومًا بينَ رسولِ اللهِ ﷺ وبينَ أسامةَ بنِ زيدٍ رضيَ اللهُ عنهُ، قال: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ. فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ. فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا. فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ. فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم” أَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ؟ ” قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ. قَالَ” أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا”. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ» (رواه مسلم 69، والبخاري 4269).
العنصرُ الأوّلُ: القلوبُ بيدِ اللهِ وحدَهُ
القلبُ سرُّ اللهِ في الإنسانِ: أيُّها الأحبَّةُ الكرامُ… إنَّ القلبَ سرٌّ عجيبٌ من أسرارِ الخلقِ، ومعدنٌ خفيٌّ من جواهرِ الإنسانِ. هو الوعاءُ الذي تُسكبُ فيه المعارفُ، والميدانُ الذي تجولُ فيه الخواطرُ، والمحرابُ الذي تُرفعُ فيه الدعواتُ. فإذا صلحَ أشرقَ الجسدُ كلُّه، وإذا فسدَ أظلمَ الكيانُ بأسرِه.
القلبُ ليسَ ملكًا للعبدِ، ولا هو في يدِه يتصرَّفُ فيه كيف يشاءُ، بل هو مُلكٌ للواحدِ القهّارِ، بيدِه وحدَه يقلبُهُ كيفَ يشاءُ ويصرّفُهُ حيثُ أرادَ. قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24]. وقال سبحانه: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} [ق: 37].
وقد شبَّه الحكيمُ الترمذيُّ القلبَ بخزانةِ اللهِ، فقال: «قلبُ المؤمنِ خزانةُ اللهِ تعالى، فيهِ كنوزُ المعرفةِ، وكنوزُ العلمِ بآلائِه، ولم يملكهُ أحدٌ، ولم يطَّلعْ عليهِ أحدٌ، ولم يَكِلْهُ اللهُ إلى أحدٍ، فهو في قبضتِه، وبينَ إصبعينِ من أصابعِ الرحمنِ يقلبُهُ كيفَ يشاءُ» [الأمثال من الكتاب والسنة، ص199]. وما أجملَ هذا التصويرَ المدهشَ! إنَّ الخزانةَ تحفظُ أثمنَ ما يملكُ صاحبُها، فما أعظمَ أن يكونَ قلبُ المؤمنِ خزانةً للهِ جلَّ جلالُه، مودعًا فيهِ كنوزَ الإيمانِ، ولطائفَ الأسرارِ، وأنوارَ الهدايةِ.
فسبحانَ من جعلَ القلوبَ بيدِه وحدَه، لا سلطانَ لأحدٍ عليها سواه! ولهذا كان دُعاءُ رسولِ اللهِ ﷺ كثيرًا: «يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ قالَت: فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ما أكثرُ دعاءكَ يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ؟ قالَ: يا أمَّ سلمةَ إنَّهُ لَيسَ آدميٌّ إلَّا وقلبُهُ بينَ أصبُعَيْنِ من أصابعِ اللَّهِ، فمَن شاءَ أقامَ، ومن شاءَ أزاغَ. فتلا معاذٌ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا» [رواه الترمذي (3522)، وأحمد (26679)، وأبو يعلى (6986) صحيح].
يا لها من آيةٍ تهزُّ القلوبَ! إنَّ القلوبَ لا تستقيمُ إلّا إذا ثبَّتها اللهُ، ولا تزيغُ إلّا إذا أزاغَها اللهُ بعدلِه. وما أجملَ أن يرفعَ المؤمنُ يديه متضرّعًا بهذا الدعاءِ القرآنيِّ العظيمِ، يُردِّده بخشوعٍ: ربَّنا لا تزغْ قلوبَنا بعد إذ هديتَنا، وهبْ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهابُ.
تَقَلُّبُ القلوبِ بيدِ اللهِ وحدَه: أيُّها الأحبّةُ الكرامُ… إنَّ القلوبَ بينَ أصابعِ الرحمنِ، يُصرّفُها كيفَ يشاءُ، يُثبتُها على الإيمانِ إن شاءَ، ويزيغُها عن الحقِّ إن شاءَ، كلُّ ذلك بعدلِه وحكمتِه. وقد جاء في صحيح مسلمٍ أنّ النبيَّ ﷺ قال: “إنَّ قلوبَ بني آدمَ كلَّها بينَ إصبعينِ من أصابعِ الرحمنِ كقلبٍ واحدٍ، يُصرِّفُه حيثُ يشاءُ، ثمَّ قال رسولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ مُصرِّفَ القلوبِ صرِّفْ قلوبَنا على طاعتِك» [رواه مسلم 2654].
قَصَصٌ مُؤَثِّرَةٌ وَمَوَاقِفٌ تُحَرِّكُ القُلُوبَ:
من ذلك ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ في قصةِ امرأةٍ بَغِيٍّ من بغايا بني إسرائيلَ، مرَّت بكلبٍ يُطيفُ برَكيَّةٍ، يكادُ يموتُ من العطشِ، فنزعت موقَها وسقته، فشكرَ اللهُ لها فغفرَ لها [البخاري 3467، مسلم 2245].
أيُّها الأحبةُ… غفرَ اللهُ لبغيٍّ بسقيها كلبٍ! ما الذي دفعَها؟ قلبٌ رقَّ للحيوانِ، فأنزلَ اللهُ عليهِ رحمته. إنَّه الدليلُ أن القلوبَ بيد اللهِ، يقلبها في لحظةٍ من الغفلةِ إلى لحظةِ رحمةٍ ومغفرةٍ.
ومن لطائفِ الأخبارِ ما روي عن الفضيلِ بنِ عياضٍ رحمهُ الله، وقد كان في شبابهِ قاطعَ طريقٍ يخيفُ الناسَ، فإذا به يسمعُ يومًا تاليًا يتلو: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} [الحديد: 16]. فوقعت الكلمةُ في قلبِه موقعًا عظيمًا، وقال: بلى واللهِ قد آنَ. كتاب التوابين لابن قدامة ص127. فانقلبَ من قاطعِ طريقٍ إلى عابدٍ زاهدٍ، يُذكَرُ بالعلمِ والورعِ والدموعِ. فما الذي بدّلَ حالَه؟ قلبٌ أشرقَ عليه نورُ هذه الآيةِ، فقاده إلى رحابِ اللهِ.
وروي عن سفيانَ الثوريِّ رحمهُ الله أنَّه قال: “مَا عَالَجْتُ شَيْئًا أَشَدَّ مِنْ سِرِّ قَلْبِي مَرَّةً لِي، وَمَرَّةً عَلَيَّ”. أحاديث أبي الحسين الكلابي ص38، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج1، ص317 إلا أنه قال: أشد علي من نيتي.
دُرُوسٌ وَعِبَرٌ وَنَتَائِجُ عَمَلِيَّةٌ: أيُّها الأحبّةُ الكرامُ… إذا كان القلبُ بيدِ اللهِ وحدَه، فلا يملكُ أحدٌ أن يزكِّي قلبَه بنفسِه، ولا أن يثبّتَه بجهدِه فقط، بل كلّ ذلك بفضل اللهِ ورحمتِه.
ولهذا فإن أوّل ما نستفيدُه أنَّ علينا أن نلجأَ دائمًا إلى اللهِ بالدعاءِ والابتهالِ، نسأله الثباتَ والهدى، كما كان سيّدُ الخلقِ ﷺ يُكثِرُ أن يقولَ: «يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبّت قلبي على دينِك». فإذا كان قلبُ النبيِّ ﷺ يستلزم الدعاءَ الدائمَ، فكيف بقلوبِنا نحنُ الضعفاءُ؟
ثانيًا: أنَّ القلبَ هو محلُّ نظرِ اللهِ، لا الصورُ ولا الأموالُ ولا المظاهرُ. قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ لا يَنظُرُ إلى صورِكم ولا أموالِكم، ولكن يَنظُرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم» [رواه مسلم 2564]. فإذا صلحَ القلبُ، صلحت الجوارحُ تبعًا له، وإذا فسدَ، فسدَت. ولهذا قال ﷺ: «ألا وإنَّ في الجسدِ مضغةً إذا صلحت صلحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فسدت فسدَ الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلبُ» [البخاري 52، مسلم 1599].
ثالثًا:. أنَّ القلوبَ لا تُصلَحُ بالهوى والشهواتِ، بل بالذكرِ والدعاءِ والقرآنِ. قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: 28]. فذكرُ اللهِ حياةُ القلبِ، وتركُه موتٌ قاسٍ لا يُجدي معه صلاحُ الظاهرِ.
رابعًا: أنَّ القلبَ سريعُ التقلُّبِ، فلا ينبغي للعبدِ أن يغترَّ بإيمانِه أو صلاحِه، ولا أن ييأسَ إذا وقع في ذنبٍ أو خطأٍ.
خامسًا: أنَّ اللهَ إذا أحبَّ عبدًا ملأ قلبَه نورًا، وشرح صدرَه للإيمانِ، قال تعالى: {فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} [الأنعام: 125]. فشرحُ الصدرِ هبةٌ ربانيّة، وضيقُه علامةُ الحرمانِ.
أيُّها الأحبّةُ… لقد ظهر لنا من هذه الشواهدِ أنَّ القلوبَ خزائنُ للمعرفةِ والإيمانِ، وأنها أمانةٌ بيدِ اللهِ وحدَه. فاجعلوا قلوبَكم أوعيةً للنورِ، واطلبوا من اللهِ أن يملأها حبًّا وخشيةً ورجاءً. وأكثروا من هذا الدعاءِ.
اللَّهُمَّ اجعل قلوبَنا عامرةً بذِكرِك، واجعلها أوعيةً لرحمتِك، ولا تزِغ قلوبَنا بعد إذ هديتَنا، وهبْ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب.
العُنْصُرُ الثاني: حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ وَالنَّاسِ سَبِيلُ سَلَامَةِ الْقَلْبِ
أيها الأحبّةُ في اللهِ… إذا كان رسولُ اللهِ ﷺ قد قالَ لأسامةَ بنِ زيدٍ رضيَ اللهُ عنه: «أفلا شققتَ عن قلبهِ؟» [رواه مسلم]، فهو يعلّمنا أن ما في القلوبِ للهِ وحدَه، وأن المطلوبَ من العبدِ أن يحسنَ الظنَّ بربهِ، ثم يحسنَ الظنَّ بالناسِ.
أولًا: حسنُ الظنِّ باللهِ تعالى
قالَ تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53]. وقالَ سبحانهُ: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} [الأعراف: 156]. فمن أساءَ الظنَّ باللهِ، فقد ضيّقَ ما وسّعَهُ اللهُ، ومن أحسنَ الظنَّ بربهِ، وسّعَ اللهُ عليهِ رحمتَه.
وفي الحديثِ القدسي: «أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بي، وأنا معهُ إذا ذَكَرَنِي» (رواه البخاري 7405، 2675 ومسلم). وهذا أصلٌ من أصولِ الدينِ، يبينُ أن العبدَ بحسنِ ظنهِ بربه.
وفي لحظةِ الموتِ، أوصى النبيُّ ﷺ فقال: «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلَّا وَهو يُحْسِنُ الظَّنَّ باللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (رواه مسلم 2877).
وأخرج مسلم في صحيحه (192)، قال النبي ﷺ: “يخرُجُ رجُلانِ مِن النَّارِ فيُعرَضانِ على اللهِ ثمَّ يُؤمَرُ بهما إلى النَّارِ فيلتفتُ أحدُهما فيقولُ: يا ربِّ ما كان هذا رجائي قال: وما كان رجاؤُك؟ قال: كان رجائي إذ أخرَجْتَني منها ألَّا تُعيدَني فيرحَمُه اللهُ فيُدخِلُه الجنَّةَ”. قدّم حسن ظنه بربه في آخر لحظاته، فكان من سبب نجاته. حتى ضعفه وعجزه جعله جسرًا لحسن ظنه بالله.
ولذلك قالَ ابنُ القيمِ رحمهُ اللهُ: «أكثرُ الناسِ يظنّونَ باللهِ ظنَّ السوءِ فيما يخصّهم وفيما يفعلهُ بغيرِهم، ولا يسلمُ من ذلك إلا من عرفَ اللهَ وأسماءَه وصفاتِه» (زاد المعاد 3/206، مدارجُ السالكينَ 2/ 211).
ثانيًا: حسنُ الظنِّ بالناسِ
أيها الإخوةُ الأحبّةُ.. إذا كان حسنُ الظنِّ باللهِ يورثُ الطمأنينةَ، فإن حسنَ الظنِّ بالناسِ يورثُ السلامةَ بين القلوبِ. وقد نهى اللهُ عن إساءةِ الظنِّ فقالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12].
قالَ سفيانُ الثوريُّ: الظنُّ ظنّانِ: أحدُهما إثمٌ، وهو أن تظنَّ وتتكلمَ به، والآخرُ ليس بإثمٍ، وهو أن تظنَّ ولا تتكلمَ. تفسير البغوي 7/345. وقالَ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنه: «لا تظنّنَّ بكلمةٍ خرجت من أخيكَ المؤمنِ شرًّا وأنتَ تجدُ لها في الخيرِ محملًا» (تفسير ابن كثير 7/379).
وقالَ عبدُ اللهِ بنُ المباركِ رحمهُ اللهُ: «المؤمنُ يطلبُ المعاذيرَ، والمنافقُ يطلبُ العثراتِ“. إحياء علوم الدين ج2، ص177.
إنّ سوءَ الظنِّ بالناسِ يقطعُ أواصرَ الأخوةِ، ويزرعُ العداوةَ، ويهدمُ الثقةَ، ويحوّلُ المجتمعَ إلى غابةٍ من الريبةِ والتهمةِ. بينما حسنُ الظنِّ يشيعُ المحبةَ، ويغلقُ أبوابَ الغيبةِ والبهتانِ، ويشعرُ الناسَ بالأمانِ.
قال النبي ﷺ: “ما أَطْيَبَكِ، وما أَطْيَبَ رِيحَكِ؟ ما أعظمَكَ وما أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ. والذي نَفْسُ محمدٍ بيدِهِ لَحُرْمَةُ المُؤْمِنِ عِنْدِ اللهِ أعظمُ حُرْمَةً مِنْكِ؛ مالِهِ ودَمِهِ [وأنْ نَظُنَّ بهِ إِلَّا خيرًا” ابن ماجه (3932)، والطبراني في مسند الشاميين (1568). صحيح لغيره.
العنصرُ الثالثُ: حقوقُ الإنسانِ في الإسلامِ حصنٌ ضدَّ التشددِ
أيُّها الأحبَّةُ الكرامُ… قام الإسلام على المبادئِ الراسخةِ التي تحفظُ للإنسانِ إنسانيَّتَه، وتصونُ كرامتَه، وتؤمِّنُ له حقوقَه. وهذه الحقوقُ التي كفلَها الإسلامُ منذُ أربعةَ عشرَ قرنًا هي نفسُها التي يُنادي بها العالمُ اليومَ تحت مسمَّى “حقوقُ الإنسانِ”، غيرَ أنَّها في شريعتِنا أوضحُ وأعدلُ وأشملُ. ولقد جاءت نصوصُ الوحيَيْنِ لتجعلَ حفظَ حقوقِ الإنسانِ مقصدًا عظيمًا من مقاصدِ الشريعةِ، وبسطَ ذلك وبيَّنَه العلماءُ في كتبِ المقاصدِ والأحكامِ.
أوَّلًا: حقُّ الحياةِ وصيانَتُها
أوَّلُ الحقوقِ وأعظمُها حقُّ الحياةِ؛ فهي عطيةُ اللهِ ومنَّتُه، ولا يملكُ أحدٌ أن يعتديَ عليها. قال اللهُ تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء: 33].
وقال سبحانه: {مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]. ومن تأمَّل سنَّةَ النبيِّ ﷺ وجد أنَّه أقام دولةً كاملةً على أساسِ حرمةِ الدماءِ، ففي خطبةِ الوداعِ قال: “إنَّ دِماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم حرامٌ عليكم، كحُرمةِ يومِكم هذا، في شهرِكم هذا، في بلدِكم هذا» [البخاري 1739، ومسلم 1679].
فلا مجال للتشدد الذي يستبيح الأرواح، أو للتكفير الذي يفتح أبواب الدماء، لأنّ الإسلام سدّ كل طريقٍ إلى ذلك.
ثانيًا: حق الكرامة الإنسانية والمساواة
لقد أقرَّ الإسلامُ أنَّ جميعَ الناسِ سواسيةٌ في أصلِ الخلقةِ والكرامةِ، فقال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70].
وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13].
وأكّدَ النبيُّ ﷺ هذا الأصلَ في خطبةِ الوداعِ، فقالَ: “يا أيُّها الناسُ إنَّ ربَّكمْ واحِدٌ ألا لا فضلَ لِعربِيٍّ على عجَمِيٍّ ولا لِعجَمِيٍّ على عربيٍّ ولا لأحمرَ على أسْودَ ولا لأسودَ على أحمرَ إلَّا بالتَّقوَى إنَّ أكرَمكمْ عند اللهِ أتْقاكُمْ» [أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/100)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5137)، صحيح].
ثالثًا: حقُّ العدالةِ والإنصافِ
من أعظمِ ما جاءتْ به الشريعةُ إقامةُ العدلِ، الذي به تستقيمُ الحياةُ وتُرفعُ المظالمُ. قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: 90]، وقال سبحانه: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام: 152]. والعدلُ واجبٌ مع الجميعِ، حتى مع الخصومِ والأعداءِ، قال جلَّ شأنُه: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8].
ومنَ القصصِ المشرقةِ: أنَّ عليًّا بنَ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ وقفَ خصمًا أمامَ يهوديٍّ: وَجَدَ عليٌّ بنُ أبي طالبٍ دِرعًا لَهُ عندَ يهوديٍّ فالتقطَها فعرفَها، فقالَ: دِرعي سقطتْ عن جملٍ لي أورقَ، فقالَ اليهوديُّ: دِرعي وفي يدي، ثم قالَ لهُ اليهوديُّ: بيني وبينكَ قاضي المسلمينَ. فأتَوا شُريحًا، .. فقالَ شُريحٌ: صدقتَ واللهِ يا أميرَ المؤمنينَ، إنّها لدرعُك، ولكن لا بدَّ من شاهدَينِ، فدعا مولاهُ والحسنَ بنَ عليٍّ فشهِدا أنّها لدرعِه، فقالَ شُريحٌ: أمّا شهادةُ مولاكَ فقد أجزناها، وأمّا شهادةُ ابنِكَ لكَ فلا نجيزُها. ثم قالَ لليهوديِّ: خذِ الدِرعَ. فقالَ اليهوديُّ: أميرُ المؤمنينَ جاءَ معي إلى قاضي المسلمينَ فقضى عليه ورضي! صدقتَ، واللهِ يا أميرَ المؤمنينَ، إنّها لدرعُكَ سقطتْ عن جملٍ لكَ فالتقطتُها. أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمّدًا رسولُ اللهِ). حلية الأولياء ج4، ص140. فالعدلُ إذا أُقيمَ ذابتْ أسبابُ التشددِ، وسكنتِ القلوبُ، وأُطفئتْ نيرانُ الغلوِّ.
رابعًا: حقُّ الحرّيّةِ وضماناتُها
أيّها الإخوةُ… الحرّيّةُ في الإسلامِ ليستْ فوضى، بل هي تحرّرٌ من عبوديّةِ الهوى إلى عبوديّةِ اللهِ. ولهذا قالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ: “متى استعبدتمُ الناسَ وقد ولدتْهُم أمهاتُهُم أحرارًا؟» [أبو يوسف، كتاب الخراج، ص124].
الإسلامُ كفلَ حرّيّةَ الاعتقادِ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256].
وكفلَ حرّيّةَ التعبيرِ في إطارِ الأدبِ والصدقِ، قالَ النبيُّ ﷺ: “المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسانِهِ ويَدِهِ» [رواه البخاري 10، ومسلم 40]. فالحرّيّةُ إذا ضُبطتْ بالشرعِ، كانتْ جسرًا إلى الوسطيّةِ، وسدًّا في وجهِ التشددِ.
الأثرُ في مواجهةِ التشددِ
أيّها الأحبّةُ… عندما تُصانُ الحقوقُ، ويشعرْ كلُّ إنسانٍ أنّ دمَهُ ومالَهُ وعرضَهُ وكرامتَهُ محفوظةٌ، تسقطْ دعاوى الغلوِّ التي تقومُ على التمييزِ والظلمِ والإقصاءِ. فالتربيةُ على هذه الحقوقِ تُنشئْ أجيالًا سويّةً، متصالحةً مع نفسها، متوازنةً في فكرِها، فتكونَ بحقٍّ «أمّةً وسطًا» تشهدُ على الناسِ وتدعوهم إلى الحقِّ.
لقد قدّمَ الإسلامُ للعالمِ أرقى منظومةٍ لحقوقِ الإنسانِ، سبقتْ كلَّ دساتيرِ الأرضِ، وحقّقتْ التوازنَ بينَ الفردِ والمجتمعِ، بينَ الحرّيّةِ والمسؤوليةِ. فإذا أردنا أن نطفئَ نيرانَ التشددِ، فعلينا أن نرجعَ إلى هذه الحقوقِ، وأن نُحسنَ توعيةَ الناسِ بها، لتبقى قلوبُنا مطمئنةً، ومجتمعاتُنا آمنةً، وأمّتُنا وسطيّةً شاهدةً على العالمينَ.
العنصر الرابع: تزكيةُ القلوبِ بالتربيةِ الإيمانيةِ سبيلُ النجاةِ من الغلوِّ
أيّها الأحبّةُ الكرامُ… إنّ الغلوَّ ليس إلّا مرضًا يَعشِّشُ في القلوبِ إذا غابَ عنها نورُ التزكيةِ والتربيةِ الإيمانيةِ. وما أصدقَ قولَ اللهِ تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 9-10].
فصلاحُ القلبِ بالتزكيةِ هو صمامُ الأمانِ، وفسادُه بالتَّدْسِيَةُ هو سبيلُ الهلاكِ، ومن هنا كانت التربيةُ الإيمانيةُ هي الطريقَ إلى النجاةِ من الانحرافِ والغلوِّ.
لقد جاء الإسلامُ بمنهاجٍ ربانيٍّ يربطُ العبدَ بربِّه، ويغسلُ قلبَه من أدرانِ الأهواءِ والشبهاتِ، ويُنمّي فيه الخوفَ والرجاءَ، ويُعَلِّمُه التوازنَ بين الخوفِ والرجاءِ، فلا يُقصِّرُ فيقعُ في التسيُّبِ، ولا يُغالِي فيقعُ في التشددِ.
قال اللهُ تعالى: {يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 88-89]. فالقلبُ السليمُ هو القلبُ الذي زُكِّيَ بالإيمانِ، وطُهِّرَ من الغلِّ والكبرِ والعُجبِ، وبه وحده تُنالُ النجاةُ.
وسائل التزكية الإيمانية في مواجهة الغلوّ: الذكرُ والقرآنُ غذاءُ القلب
القلبُ لا يحيا إلّا بذكرِ الله، ولا يصفو إلّا بالقرآن، قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: 28].
الصحبةُ والقدوةُ الصالحة
لقد ربّى النبيُّ ﷺ أصحابه على التزكيةِ العمليةِ؛ كان يُقرنُ التعليمَ بالقدوةِ، ويجمعُ بين العلمِ والعملِ، فيخرجُ جيلًا وسطيًّا متوازنًا. وقد حذّر القرآنُ من صحبةِ أهلِ الغلوِّ والزيغِ: {فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} [النجم: 29].
المجاهدةُ والتربيةُ على الخوف والرجاء
القلبُ إذا غلبه الخوفُ وقع في القنوط، وإذا غلبه الرجاءُ وقع في الأمنِ من مكر الله، ولكن التربيةَ الإيمانيةَ تُعَلِّمُه الجمعَ بينهما. قال الحسنُ البصري: «المؤمنُ أحسنَ الناسِ عملًا وأشدُّهم خوفًا» [حلية الأولياء 2/147].
الأثر العملي للتزكية في مواجهة الغلوّ
إذا زُكّيت القلوبُ صَفَت، وإذا صَفَت لانَت، وإذا لانَت اعتدلت، وإذا اعتدلت سقط الغلوُّ والتشدّدُ. إنّ الغلوَّ يبدأ من قلبٍ مظلمٍ، والتزكيةُ تزرع فيه النورَ، فتجعله رفيقًا رفيعًا، رحيمًا رقيقًا، كما قال النبي ﷺ: “ألا أخبركم بأحبِّكم إليّ وأقربِكم منّي مجلسًا يوم القيامة؟ أحاسنُكم أخلاقًا، الموطّئون أكنافًا، الذين يألفون ويُؤلفون» [رواه أحمد 23408، حسن].
فالتربيةُ الإيمانيةُ تحوِّلُ القلبَ من منبعِ تشددٍ وغلوٍّ إلى منارةِ هدايةٍ ورحمةٍ.
المراجع: القرآن الكريم
كتب الحديث: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، وابن ماجه، سنن الترمذي، مسند أحمد. شعب الإيمان للبيهقي، مسند الشاميين للطبراني، مسند أبي يعلي
ثالثًا: كتب التفسير وشروح الحديث وغيرهما: تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تَفْسِيرُ، تفسير البغوي، فتح الباري لابن حجر، إحياء علوم الدين للغزالي، حلية الأولياء لأبي نعيم، زاد المعاد ومدارجُ السالكينَ لابن القيم، الأمثال من الكتاب والسنة للحكيم الترمذي. أحاديث أبي الحسين الكلابي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبي الخطيب البغدادي.
د. أحمد رمضان
خُطبةُ صوتِ الدعاةِ – إعداد رئيس التحرير: الدكتور أحمد رمضان
_______________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة