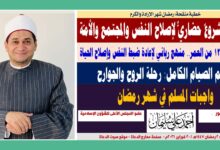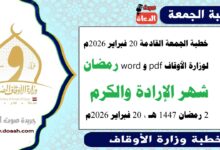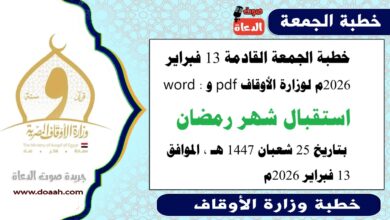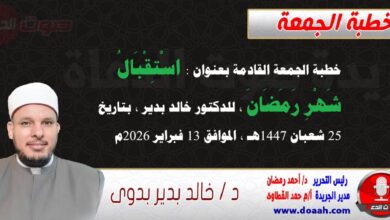خطبة الجمعة القادمة 11 يوليو : لله دَرُّكَ يا ابن عباس ، للدكتور محروس حفظي
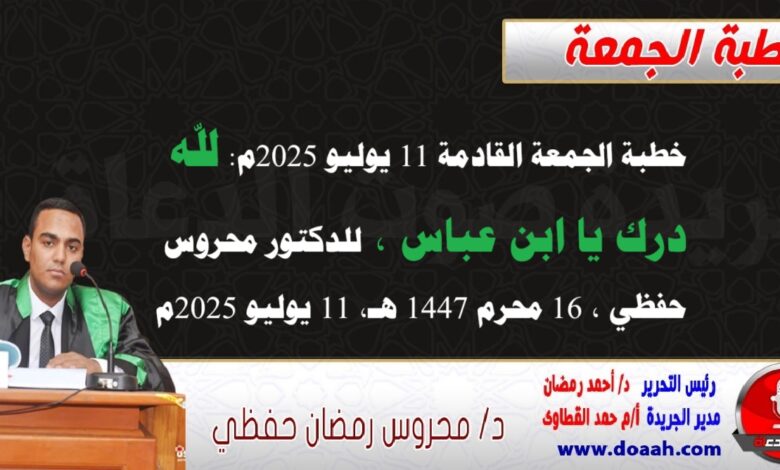
خطبة الجمعة القادمة
خطبة الجمعة القادمة 11 يوليو 2025 م بعنوان : لله دَرُّكَ يا ابن عباس ، للدكتور محروس حفظي بتاريخ 16 محرم 1447هـ ، الموافق 11 يوليو 2025م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 11 يوليو 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : لله دَرُّكَ يا ابن عباس.
ولتحميل خطبة الجمعة القادمة 11 يوليو 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : لله دَرُّكَ يا ابن عباس ، بصيغة word أضغط هنا.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 11 يوليو 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : لله دَرُّكَ يا ابن عباس ، بصيغة pdf أضغط هنا.
___________________________________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
.
عناصر خطبة الجمعة القادمة 11 يوليو 2025م بعنوان : لله دَرُّكَ يا ابن عباس ، للدكتور محروس حفظي :
(1) مناظرة عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما- مع “الخوارج”.
(2) منهج حبر الأمة، وترجمان القرآن – رضي الله عنه- في مواجهة “الخوارج”، وسبل الاستفادة منه.
(3) خطوات عملية لمواجهة التطرف.
(4) الضمير في الإسلام.
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 11 يوليو 2025م بعنوان: لله دَرُّكَ يا ابن عباس ، للدكتور محروس حفظي : كما يلي:
لله درك يا ابن عباس
بتاريخ 16 محرم 1447هـ = الموافق 16 يوليو 2025 م
الحمد لله حمداً يوافي نعمه، ويكافىء مزيده، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أما بعد ،،،
العنصر الأول من خطبة الجمعة القادمة 11 يوليو : لله دَرُّكَ يا ابن عباس ، للدكتور محروس حفظي
(1) مناظرة عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما- مع “الخوارج”:
رد عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- عليهم رداً مقنعاً حيث فكك هذه الأفكار الهدامة، فلم يملكوا سوى التسليم والخضوع لما قاله، وكيف أنه وجه النصوص توجيهاً سليماً، وجمع بينها، وأزال عنها ما يوهم ظاهرها التعارض، فترتب على هذا رجوع الكثير منهم؛ وفي هذا برهان ساطع على أن الفكر المنبط القائم على المنهجية العلمية السليمة عندم يصطدم مع هؤلاء المتطرفين، فإنهم سرعان ما ينهزمون، ويظهر عوارهم، ويختل ميزان القوى لديهم.
فلما دخل عليهم ابن عباس – رضي الله عنهما-: «قَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَزَلَ الْوَحْيُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تُحَدِّثُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنُحَدِّثَنَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرُونِي مَا تَنْقِمُونَ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَنِهِ، وَأَوَّلِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ؟ قَالُوا: نَنْقِمُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالُوا: أَوَّلُهُنَّ أَنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57]، قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: وَقَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، لَئِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّتْ لَهُ أَمْوَالُهُمْ، وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ لَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: وَمَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ. فرد عليهم ابن عباس: قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ الْمُحْكَمِ، وَحَدَّثْتُكُمْ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا تُنْكِرُونَ، أَتَرْجِعُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ.
– قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللهِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] إِلَى قَوْلِهِ {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95]، وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35]، أَنْشُدُكُمُ اللهَ أَحُكْمُ الرِّجَالِ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ أَحَقُّ أَمْ فِي أَرْنَبٍ ثَمَنُهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ؟ قَالُوا: اللهُمَّ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ.
– وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، أَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ، أَمْ تَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا؟ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِأُمِّكُمْ فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَخَرَجْتُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6]، فَأَنْتُمْ تَتَرَدَّدُونَ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، فَاخْتَارُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ، أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ.
– قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَقَالَ: “اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ”، فَقَالُوا: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: «وَاللهِ إِنِّي لِرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ يَا عَلِيُّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ»، فَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ، أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ. فَرَجَعَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ أَلْفًا، وَبَقِيَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَقُتِلُوا» (رواه الطبراني، وأحمد ببعضه، ورجالهما رجال الصحيح).
-لقد زعم هؤلاء ومن على شاكلتهم أن من حكم بغير القرآن ولو في حكم واحد، فقد رد أحكام الله: وبناء على هذا استحلوا دماء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ودماء الأبرياء؛ مستندين في ذلك إلى الآيات التي وردت في سورة المائدة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]، دون التفرقة بين من ارتكب ذنباً مستحلاً له، وبين من غلبته نفسه، وهو مقر بخطئه. لكن سيدنا ابن عباس – رضي الله عنهما- رد عليهم رداً علمياً محكماً؛ فقد ورد عنه أنه قَالَ رضي الله عنهما: «إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقِلُ عَنِ الْمِلَّةِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ» (رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي)، فالمراد من “الكفر” هنا ليس “الكفر الاصطلاحي”، وإنما معنى “الستر والتغطية”، قال ابن رجب: (والكفر قد يطلق، ويراد به الكفر الذي لا ينقل عن الملة مثل كفران العشير ونحوه عند إطلاق الكفر) (فتح الباري،1/ 137).
وهذا الفهم إنما توارثه الصحابة جيلاً بعد جيلٍ؛ فورد عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أنه قال: «إن هذه الآيات نزلت كلها في الكفار» (رواه مسلم في “صحيحه” معلقاً)، ولم يصح بالإسناد الصحيح عن الصحابة في تفسير هذه الآية إلا هذان التفسيران: تفسير ابن عَبَّاسٍ، والْبَرَاء بن عَازِبٍ، وعلى ذلك درج فقهاء الشريعة إلى زمن قريب من منتصف القرن الرابع عشر الهجري.
وعن ابن أبي دواد قال: «أدخل رجل من الخوارج على المأمون، فقال: ما حملك على خلافنا؟ قال: آية في كتاب الله، قال: وما هي؟ قال قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، فقال له المأمون: ألك علم بأنها منزلة، قال: نعم، قال: وما دليلك؟ قال: إجماع الأمة، قال فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل، فارض بإجماعهم في التأويل قال: صدقت السلام عليك يا أمير المؤمنين» (تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي).
العنصر الثاني من خطبة الجمعة القادمة 11 يوليو : لله دَرُّكَ يا ابن عباس ، للدكتور محروس حفظي
(2) منهج حبر الأمة، وترجمان القرآن- رضي الله عنه- في مواجهة “الخوارج”، وسبل الاستفادة منه:
لقد تبنى عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما– الذي تميز بغزارة العلم، وحسن الفهم؛ فهو ترجمان القرآن، والمدعو له بفهم التأويل- مع هؤلاء منهج الحكمة، والصبر، والوعي والعلم، والجسارة، والإلحاح على بيان أخطائهم، وكان حريصاً على توجيههم للحق، وحماية المجتمع من شرورهم وفتنهم من خلال تفنيد أفكارهم، ورد شبهاتهم التي تمسكوا بها، فهم لعبوا دوراً خطيراً في شرخ الأمة، وإثارة القلاقل الداخلية حتى استنزفوا طاقة الأفراد والمجتمعات، وصدق الله حيث قال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].
قال الحافظ ابن عبد البر: (كان للخوارج تأويلات في القرآن، ومذاهب سوء مفارقة لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان الذين أخذوا الكتاب والسنة عنهم، وتفقهوا معهم، فخالفوا في تأويلهم ومذاهبهم الصحابة والتابعين، وكفروهم، …، وكفروا المسلمين بالمعاصي، واستحلوا بالذنوب دماءهم، وكان خروجهم فيما زعموا تغيير للمنكر، ورد الباطل، فكان ما جاءوا به أعظم المنكر، وأشد الباطل إلى قبيح مذاهبهم، …، ولم يكن يتجاوز القرآن حناجرهم ولا تراقيهم؛ لأنهم كانوا يتأولونه بغير علم بالسنة المبينة، فكانوا قد حُرموا فهمه، والأجر على تلاوته، فلا ينتفعون بقراءته كما لا ينتفع الآكل والشارب من المأكول والمشروب بما لا يجاوز حنجرته) أ.ه. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (23/323).
وفيما بيان لمنهج عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما- في مواجهة “الخوارج”، ومن على شاكلتهم، وسبل الاستفادة منه:
أولاً: الوعظ والنصح والإرشاد: كان يواجههم بالحكمة والرفق، ويحذرهم من عواقب اتباع الزيغ والضلال، ممتثلاً قول الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}[النحل: 125]، وهذا يوجب علينا مناقشة أفكارهم مهما كانت ولو بدت هشة ضعيفة، وعدم الاستخفاف بها، أو ازدراء متبنيها؛ لأنه قد تأثر على فئة غير قليلة في المجتمع.
ثانياً: خلخلة مواقف هؤلاء وتشكيكهم في معتقداتهم، وأفكارهم: حتى يسهل انقيادهم للحق، فقد تعمد ابن عباس – رضي الله عنهما- قبل مناظرة “الخوارج” لبس أحسن الثياب وترجَّل قال رضي الله عنهما: «وَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ، فَأَتَيْتُهُمْ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي دَارٍ، وَهُمْ قَائِلُونَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ، فَمَا هَذِهِ الْحُلَّةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ، وَنَزَلَتْ: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]» (رواه البيهقي في “السنن الكبرى”)، وهو يعلم أنهم سينكرون عليه ذلك، فبيَّن لهم أن النبي– صلى الله عليه وسلم- فعله، وأن الإسلام أنكر على من حرَّمه، وبهذا تضعف ثقتهم بأفكارهم، والإنسان قد توجهه– غالباً- كثرة الصدمات من موقفه.
ثالثاً: عدم الاغترار بصلاح السمت أو الحال: فالدين مبناه على العلم والفهم والعمل جميعاً لا العمل فحسب كما هو سمة “الخوارج”؛ فابن عباس قال عنهم: «لَمْ أَرَ قَوْمًا قَطُّ أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ، أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا ثَفِنُ الْإِبِلِ، وَوُجُوهُهُمْ مُعَلَّبَةٌ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ» (رواه الطبراني في “المعجم الكبير”)، وكما قال صلى الله عليه وسلم: «قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ» (رواه البخاري)، فكيف يفقهون ما يقرؤون؟!، وكيف يستشعرون روح النص؟!، كثير من أهل الضلال والتطرف، يغتر الناس بطاعتهم، وحسن مظهرهم، فيقعون في المِحن ما ظهر منها وما بطن؛ فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ …، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ» (رواه أبو داود، وأحمد).
قال محمد بن الحسين الآجري: (قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، ويموهون على المسلمين، فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلاً كان الإمام أو جائراً، فخرج، وجمع جماعة وسل سيفه، واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه “مذهب الخوارج”، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين) أ.ه. (الشريعة 1/345).
رابعاً: مجابهتم بالحجة والبرهان، والحوار؛ إذ “الفكر لا يواجه إلا بالفكر”: هم حرفوا معاني النصوص، وأخرجوها عن سياقاتها، ولم يفهموها فهماً صحيحاً، فاستخدم – رضي الله عنهما – معهم إيراد الحجج والبراهين النقلية والعقلية التي لا يسوغ لهم إنكارها، والتي تفضح فكرهم الباطل، فهو قابل مسائل من جنس ما يقرأون من القرآن، ولكنهم أخذوا آية، وتركوا أخرى، ومن حسن سياسته معهم ومناظرته لهم، أنه ضبط عملية الحوار والنقاش حتى لا يتشعب الكلام، واشترط عليهم الإذعان للحق إن وضح وبان، واستعمل أحسن القياس وأوضحه، واستخدم ضرب المثل؛ قال لهم: «هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه» (رواه النسائي في “السنن الكبرى”)، ثم اشترط عليهم: «هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: «حسبنا هذا» قلت: لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله – جل ثناؤه- وسنة نبيه ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: «نعم»(رواه النسائي في “السنن الكبرى”).
خامساً: المواجهة الحتمية، و”الكي” آخر العلاج، وسن قانون يُجرِّم “التطرف بجميع صوره وأشكاله“: لك أن تتعجب من حال هؤلاء، فهم حرب على المسلمين، سِلم على الكافرين؛ فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقْتُلُونَ، أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ» (متفق عليه).
ولو تمكن هؤلاء من الخلق؛ لعاثوا في الأرض فساداً، وباتوا سيفلاً مسلطاً على رقاب الخلق؛ قال وَهْب بن مُنَبِّه: (وَلَوْ مَكَّنَ اللهُ لَهُم مِنْ رَأْيِهِم، لَفَسَدَتِ الأَرْضُ، وَقُطِعَتِ السُّبُلُ وَالحَجُّ، وَلَعَادَ أَمْرُ الإِسْلاَمِ جَاهِلِيَّةً، وَإِذاً لَقَامَ جَمَاعَةٌ كُلٌّ مِنْهُم يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ الخِلاَفَةَ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم أَكْثَرُ مِنْ عَشْرَةِ آلاَفٍ، يُقَاتِلُ بَعْضُهُم بَعْضاً، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ بِالكُفْرِ، حَتَّى يُصْبِحَ المُؤْمِنُ خَائِفاً عَلَى نَفْسِهِ وَدِيْنِهِ وَدَمِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، لاَ يَدْرِي مَعَ مَنْ يَكُوْنُ) أ.ه. (سير أعلام النبلاء 4/555).
وقد حاول ابن عباس – رضي الله عنهما- ثني هؤلاء أولاً بالمناظرة والبرهان {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115]، فحقق تقدماً عظيماً حيث رجع الكثير منهم قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَرَجَعَ مِنَ الْقَوْمِ أَلْفَانِ» (رواه البيهقي في “السنن الكبرى”)، وأفقدت الثلة الباقية مصداقيتها الدينية، ثم حفاظاً على الأنفس والأعراض والأموال كان لا بد من اقتلاع هذه الجرثومة التي ستشرى في جسد هذه الأمة الوسط، فقاتلهم سيدنا علي بن أبي طالب في محضر الصحابة وإجماعهم قَالَ ابْن عَبَّاسٍ:«وَقُتِلَ سَائِرُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ» (رواه الحاكم “وصححه، ووافقه الذهبي”).
قال الإمام الغزالي: (أطباء الدين وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فالعاصي إن علم عصيانه، فعليه طلب العلاج من الطبيب، وهو العالم، …، وكل مريض لم يقبل العلاج بمداواة العالم، يسلم إلى السلطان؛ ليكف شره كما يسلم الطبيب المريض الذي لا يحتمي أو الذي غلب عليه الجنون إلى القيم؛ ليقيده بالسلاسل والأغلال، ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس) أ.ه. (إحياء علوم الدين، 4/50).
العنصر الثالث من خطبة الجمعة القادمة 11 يوليو : لله دَرُّكَ يا ابن عباس ، للدكتور محروس حفظي
(3) خطوات عملية لمواجهة التطرف: هناك عدة خطوات ينبغي أن نسلكها خاصة مع الشباب لمواجهة ظاهرة التطرف، وفيما يلي لمحة عن ذلك:
أولاً: أخذ العلم عن المتخصصين: من أبرز عوامل التطرف في هذا العصر “الاكتفاء بالتثقيف الذاتي”، و”اختلاط المفاهيم، وعدم الإلمام بدلالات الألفاظ”: وقد ضع القرآن والسنة قاعدة عظيمة لمن أراد أن يحصِّل علماً ما، وهو أن يستقيه من أهله قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، وقديماً قالوا: “لا تأخذ العلم من صُحفي، ولا القرآن من مصحفي”. وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قال: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ، فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ، فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ» (رواه أحمد في “مسنده”).
قال الإمام الغزالي: (والعامي يَفْرَحُ بِالْخَوْضِ فِي الْعِلْمِ؛ إِذِ الشَّيْطَانُ يُخَيِّلُ إليه أنك مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَأَهْلِ الْفَضْلِ، وَلَا يَزَالُ يُحَبِّبُ إليه ذلك حتى يتكلم في العلم بما هو كفر وهو لا يدري، وكل كبيرة يرتكبها العامي فهي أسلم له من أن يتكلم في العلم لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته) أ.ه. (إحياء علوم الدين، 3/163).
ومن الكلمات التي جرت على ألسنة هؤلاء المتطرفين “البدعة”، ووسم كل ما لم يكن معروفاً أيام النبي – صلى الله عليه وسلم- بها، فقسموا المسلمين شيعاً وأحزاباً، ورموهم بالفسق والكفر والعصيان {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36]، وعن ابْن عُمَرَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ” (رواه مسلم).
قال الإمام الغزالي: (لعن أوصاف المبتدعة خطر؛ لأن معرفة البدعة غامضة، ولم يرد فيه لفظ مأثور، فينبغي أن يمنع منه العوام؛ لأن ذلك يستدعي المعارضة بمثله، ويثير نزاعاً بين الناس وفساداً) أ.ه. (إحياء علوم الدين، 3/123).
ثانياً: الإغراق التام لكل منصات التواصل الاجتماعي بالوعي والعلم الصحيح، وإعادة تشغيل مصانع الحضارة في عقل الإنسان المسلم بحيث يحول آيات القرآن الكريم إلى مراصد فلكية، ومدارس تعليم لرعاية الإنسان، ومنهج ابن عباس يعلمنا كيف يستعمل هؤلاء نصوص الوحيين في غير موضوعهما خاصة مع الشباب والسذج من العوام حيث استدل الخوارج على ترك السماع منه رضي الله عنهما؛ لأنه قريشي، واللهَ يَقُولُ عن قريش: {بَل هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} [الزخرف: 58]» (رواه البيهقي في “السنن الكبرى”)، فالآية نازلة في “مشركي قريش” الذين خاصموا النبي – صلى الله عليه وسلم- بالباطل، وابن عباس إنما جاء ليردهم إلى حظيرة الإسلام، وآلية الرد عنده “الكتاب والسنة”، فكيف يسقطون هذه الآية عليه؟!
وهذا الفكر لم ينته، ولن يكف، فهم مستمرون حتى خروج الدجال؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ، أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً، حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ» (سنن ابن ماجه).
لذا يجب تجفيف منابع الفكر المتطرف، ومحاربة الفقر والجهل في المجتمعات، وتقوية النزعة الإنسانية لدى الشباب، وتزويدهم بمهارة التفكير النقدي، وتقوية القيم الأخلاقية.
ثالثاً: غرس الوسطية والاعتدال في نفوس الأطفال: يجب علينا أن نعزز قيم الوسطية والاعتدال، ويبدأ ذلك أولاً من الأسرة ثم المدرسة، ولوسائل الإعلام دور كبير في تحقيق ذلك، وكذا مؤسسات المجتمع المدني، وهكذا لا بد من اصطفاف الجميع في سبيل مقاومة هذا الفكر الضال المضل مصداقاً لقوله تعالى:﴿فَلَوْلا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ﴾، فالطفل عندما ينشأ ويربى على الوسطية والاعتدال، وغرس ثقافة البناء والتعمير، والبعد عن الكراهية والتدمير لا شك أن كل دعوى تواجهه بعد ذلك – في سبيل زعزعة هذه القيم المجتمعية- سيكون قادراً على ردها ودحرها بأيسر برهان، وصدق أبو العلاء المعري حيث قال:
وينشأ ناشئ الفتيان منا … على ما كان عليه أبوه
وما دان الفتي بحجي ولكن … يعلمه التدين أقربوه
العنصر الرابع من خطبة الجمعة القادمة 11 يوليو : لله دَرُّكَ يا ابن عباس ، للدكتور محروس حفظي
(4) الضمير في الإسلام:
إن من أبرز مظاهر غياب “الضمير”: اتباع الهوى، والبُعد عن منهج الله، ونسيان الآخرة، والحرص على الحياة، والتكالب عليها، والإهمال في العمل خاصة فيما يتعلق بمصالح العامة؛ وعندما يموت الضمير الإنساني، يموت الإحساس، ثم ينتشر الفساد، وتكثر الجرائم بكافة صورها وأشكالها؛ وبالتالي يصير باطن الأرض أفضل من ظاهرها؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ” (رواه مسلم).
لذا يجب على الإنسان أن يستشعر قرب الله- عز وجل منه-، ومراقبته لأقواله وأفعاله قال تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} [الحديد:4]، وقال: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر:19]، وقال سبحانه: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} [المجادلة:7]. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ:«أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» (متفق عليه).
إن استشعار أن “اللَّه معي، اللَّه ناظر إليَّ، اللَّه شاهدي”، يوقظ “الضمير”، ويحي النفس، ويبعث فيها بوادر الخير والبر؛ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» (رواه مسلم).
وعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: «جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: «يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» (رواه أحمد في “مسنده”).
فما أحوجنا إلى إحياء الضمير، وإيقاظه من ثباته العميق؛ ليعود الإنسان عاملاً فاعلاً، متواصلاً، مثمراً مجتهداً، نافعاً لنفسه، ومجتمعه، وأمته، فالأمم لن تتقدم ولن ترتقي بكثرة القوانين، إنما تزدهر وترقى برقي الضمائر الإنسانية؛ إنه “الضمير” الذي حمل يوسف – عليه السلام- أن يواجه امرأة العزيز بكل قوة، ولا يطواعها فيما أقدمت عليه قال تعالى: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} [يوسف: 23].
وقد ضرب السلف الصالح – رضي الله عنهم- أروع الأمثلة في “مراعاة الضمير”؛ قال نَافِعٌ: “خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ فَوَضَعُوا سُفْرَةً لَهُمْ فَمَرَّ بِهِمْ رَاعٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: هَلُمَّ يَا رَاعِي فَأَصِبْ مِنْ هَذِهِ السُّفْرَةِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ الشَّدِيدِ حَرُّهُ، وَأَنْتَ بَيْنَ هَذِهِ الشِّعَابِ فِي آثَارِ هَذِهِ الْغَنَمِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْجِبَالِ تَرْعَى هَذِهِ الْغَنَمَ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟! فَقَالَ الرَّاعِي: أُبَادِرُ أَيَّامِيَ الْخَالِيَةَ، فَعَجِبَ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعَنَا شَاةً مِنْ غَنَمِكَ نَجْتَرِزُهَا نُطْعِمُكَ مِنْ لَحْمِهَا مَا تُفْطِرُ عَلَيْهِ، وَنُعْطِيكَ ثَمَنَهَا؟ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِي إِنَّهَا لِمَوْلايَ. قَالَ: فَمَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ لَكَ مَوْلاكَ إِنْ قُلْتَ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ؟ فَمَضَى الرَّاعِي، وَهُوَ رَافِعٌ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يَقُولُ: فَأَيْنَ اللَّهُ؟. قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ الرَّاعِي: فَأَيْنَ اللَّهُ! فَمَا عَدَا أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَ إِلَى سَيِّدِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ الرَّاعِيَ وَالْغَنَمَ، فَأَعْتَقَ الرَّاعِيَ، وَوَهَبَ لَهُ الْغَنَمَ” (لطائف المعارف لابن رجب).
نسأل الله أن يرزقنا حسن العمل، وفضل القبول، إنه أكرم مسؤول، وأعظم مأمول، وأن يجعل بلدنا مِصْرَ سخاءً رخاءً، أمناً أماناً، سلماً سلاماً وسائر بلاد العالمين، ووفق ولاة أُمورنا لما فيه نفع البلاد والعباد .
كتبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان د / محروس رمضان حفظي عبد العال
مدرس التفسير وعلوم القرآن – كلية أصول الدين والدعوة – أسيوط
_____________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
وللإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف