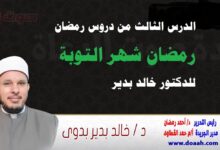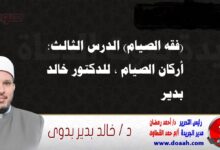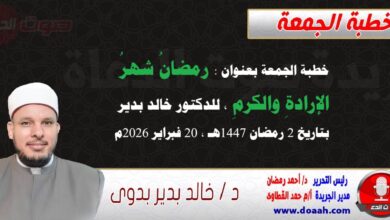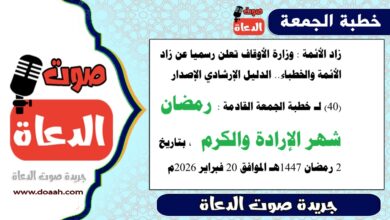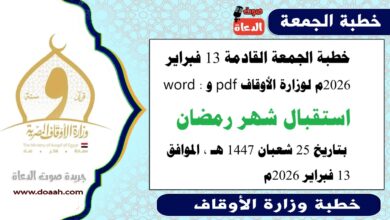خطبة الجمعة القادمة 12 سبتمبر : وَكُن رَجُلاً إِن أَتَوا بَعدَهُ يَقولونَ مَرَّ وَهَذا الأَثَر، للدكتور محروس حفظي
وَكُن رَجُلاً إِن أَتَوا بَعدَهُ يَقولونَ مَرَّ وَهَذا الأَثَر

خطبة الجمعة القادمة
خطبة الجمعة القادمة 12 سبتمبر 2025م بعنوان : وَكُن رَجُلاً إِن أَتَوا بَعدَهُ يَقولونَ مَرَّ وَهَذا الأَثَر، للدكتور محروس حفظي بتاريخ 20 ربيع الأول 1447هـ ، الموافق 12 سبتمبر 2025م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 12 سبتمبر 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : وَكُن رَجُلاً إِن أَتَوا بَعدَهُ يَقولونَ مَرَّ وَهَذا الأَثَر.
ولتحميل خطبة الجمعة القادمة 12 سبتمبر 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : وَكُن رَجُلاً إِن أَتَوا بَعدَهُ يَقولونَ مَرَّ وَهَذا الأَثَر، بصيغة word أضغط هنا.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 12 سبتمبر 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : وَكُن رَجُلاً إِن أَتَوا بَعدَهُ يَقولونَ مَرَّ وَهَذا الأَثَر، بصيغة pdf أضغط هنا.
___________________________________________________________
عناصر خطبة الجمعة القادمة 12 سبتمبر 2025م بعنوان : وَكُن رَجُلاً إِن أَتَوا بَعدَهُ يَقولونَ مَرَّ وَهَذا الأَثَر ، للدكتور محروس حفظي :
(1) القرآنُ الكريمُ يرشدُ المؤمنَ أنْ يكونَ ذَا أثرٍ في حياتِهِ، وبعدَ مماتِهِ.
(2) ترغيبُ النبيِّ ﷺ المسلمينَ في حسنِ الأثرِ.
(3) نماذجُ تحملُوا المسؤوليةَ، وتركُوا أثراً طيباً في حياةِ غيرِهِم.
(4) ذمُّ الشخصيةِ المتخاذلةِ المنغلقةِ على نفسِهَا.
(5) حسنُ الأثرِ دليلٌ على محبةِ اللهِ للعبدِ.
(6) افعلْ الخيرَ دونَ انتظارِ شُهرةٍ أو تحصيلِ مدحٍ دنيويٍّ، بل ارجُو ثوابَ الآخرةِ.
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 12 سبتمبر 2025م بعنوان: وَكُن رَجُلاً إِن أَتَوا بَعدَهُ يَقولونَ مَرَّ وَهَذا الأَثَر ، للدكتور محروس حفظي : كما يلي:
وكُنْ رجلًا إنْ أَتَوا بعدَهُ يقولونُ: “مرَّ، وهذَا الأثَر”
بتاريخ 20 ربيع الأول 1447هـ = الموافق 12 سبتمبر 2025 م
الحمدُ للهِ حمداً يُوافِي نعمَهُ، ويُكافِىءُ مزيدَهُ، لك الحمدُ كما ينبغِي لجلالِ وجهِكَ، ولعظيمِ سلطانِكَ، والصلاةُ والسلامُ الأتمانِ الأكملانِ على سيدِنَا مُحمدٍ ﷺ، أمَّا بعدُ ،،،
-
القرآنُ الكريمُ يرشدُ المؤمنَ أنْ يكونَ ذَا أثرٍ في حياتِهِ، وبعدَ مماتِهِ:
– قالَ اللهُ في وصفِ عيسَى – عليهِ السلامُ-: {وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ} [مريم: 31].
قالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: «مُعَلِّمٌ لِلْخَيْرِ» (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر).
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: “قَوْلُ عِيسَى:{وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ}، قَالَ: «جَعَلَنِي نَفَّاعًا أَيْنَ اتَّجَهْتُ». (رواه “الأصفهاني” في “حلية الأولياء”).
– أرشدَ القرآنُ أنْ يجتهدَ المسلمُ في فعلِ الصالحاتِ حتَّى يتركَ أثراً حسناً بعدَ موتِهِ، ولذا كانَ مِن دعاءِ إبراهيمَ – عليهِ السلامُ- {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ} [الشعراء: 84]. قال ابنُ زيدٍ بنُ أسلمَ : “اللسانُ الصدقُ”: الذكرُ الصدقُ، والثناءُ الصالحُ، والذكرُ الصالحُ في الآخرينَ مِن الناسِ والأممِ”. (جامع البيان للطبري).
روىَ أشهبُ قَالَ مَالِكٌ: “لَا بَأْسَ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ أَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ صَالِحًا؛ وَيُرَى فِي عَمَلِ الصَّالِحِينَ، إذَا قَصَدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، وَهُوَ الثَّنَاءُ الصَّالِحُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي} [طه: 39]”. (أحكام القرآن لابن العربي المالكي).
قالَ الإمامُ ابنُ العربِي المالكِي: (قَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ شُيُوخِ الزُّهْدِ: فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى التَّرْغِيبِ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي يُكْسِبُ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ). أ.ه. (أحكام القرآن، 3/459).
– اتركْ أثراً يرقَى بكَ، ويسمُو بروحِكَ في دارِ الفناءِ والبقاءِ، {يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ} [غافر: 39]، {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [العنكبوت: 64]. – وللهِ درُّ القائلِ:
قد ماتَ قومٌ وما ماتَتْ مكارمُهُم *** وعاشَ قومٌ وهُم في الناسِ أمواتُ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ» فَقِيلَ: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ المَوْتِ» (رواه الترمذي، وأحمد، وابن حبان).
– أخبرَ اللهُ أنَّهُ يسجلُ للخَلقِ آثارَهُم التي تركوهَا بعدَ موتِهِم، سواءٌ أكانت صالحةً كعلمٍ نافعٍ أو صدقةٍ جاريةٍ أم غيرِ صالحةٍ كشيءٍ يضرُّ الناسَ، وكرأيٍ مِن الآراءِ الباطلةِ التي اتبعَهَا مَن جاءَ بعدَهُم، وسيجازِيهِم على ذلكَ بمَا يستحقون، {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ} [يس: 12].
قالَ الحافظُ ابنُ كثيرٍ: (وفي قولِهِ: {آثارَهُمْ} قولانِ: أحدهُمَا: ونكتُبُ أعمالَهُم التي باشرُوهَا بأنفسِهِم، وآثارَهُم التي أثرُوهَا أي:- تركُوهَا- مِن بعدِهِم، فنجزيَهُم على ذلكَ- أيضاً-، إنْ خيراً فخير، وإنْ شراً فشر. الثانِي: أنَّ المرادَ آثارُ خطاهُم إلى الطاعةِ أو المعصيةِ؛ فعن أَنَسٍ: «أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْرُوا المَدِينَةَ، فَقَالَ: «أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ» قَالَ مُجَاهِدٌ: «خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ، أَنْ يُمْشَى فِي الأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ» (رواه البخاري)) أ.ه. (تفسير القرآن العظيم).
– ورَدَ «أنَّ كسرَى خرجَ يوماً يتصيدُ، فوجدَ شيخاً كبيراً يغرسُ شجرَ جوزِ الهندِ، فوقفَ عليهِ وقالَ لهُ: يا هذا أنتَ شيخٌ هرِمٌ وهذا لا يثمرُ إلَّا بعدَ ثلاثينَ سنةً فلِمَ تغرسْهُ فقالَ: أيُّهَا الملكُ زرعَ لنَا مَن قبلَنَا فأكلنَا، فنحنُ نزرعُ لِمَن بعدَنَا فيأكل، فأعطاهُ كسرَى ثلاثةَ آلافِ دينارٍ، وقالَ: إنْ أطلنَا الوقوفَ عندَهُ نفدَ ما فِي خزائِنِنَا» (فيض القدير شرح الجامع الصغير) .
*ازرعْ الخيرَ، وستجنِي ثمرتَهُ في عَقِبِكَ مَن بعدك، إنْ لم ترَ ثمرتَهُ في حياتِكَ:
{وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ} [الكهف: 82].
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا} [الكهف: 82] قَالَ: “حَفِظَهُمَا بِصَلَاحِ أَبِيهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهُمَا صَلَاحًا”. (رواه الحاكم في “المستدرك” وصححه، ووافقه الذهبي).
(2) ترغيبُ النبيِّ ﷺ المسلمينَ في حسنِ الأثرِ:
– لا يستقلُّ العبدُ أيَّ عملٍ يتيسرُ لهُ ما دامَ مشروعاً، فإنَّهُ لا يدرِي ما الذي يكونُ سبباً في نجاتِهِ، وأعظمَ بركةً عندِ اللهِ.
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ:«مَا عِنْدِي»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ ﷺ:«مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» (رواه مسلم).
قالَ الإمامُ الصنعانِيُّ: (دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى الْخَيْرِ يُؤْجَرُ بِهَا الدَّالُّ عَلَيْهِ كَأَجْرِ فَاعِلِ الْخَيْرِ، وَالدَّلَالَةُ تَكُونُ بِالْإِشَارَةِ عَلَى الْغَيْرِ بِفِعْلِ الْخَيْرِ، وَعَلَى إرْشَادِ مُلْتَمِسِ الْخَيْرِ عَلَى أَنَّهُ يَطْلُبُهُ مِنْ فُلَانٍ وَالْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ وَتَأْلِيفِ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ، وَلَفْظُ: “خَيْرٍ”: يَشْمَلُ الدَّلَالَةَ عَلَى خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلِلَّهِ دَرُّ الْكَلَامِ النَّبَوِيِّ مَا أَشْمَلَ مَعَانِيَهُ وَأَوْضَحَ مَبَانِيَهُ وَدَلَالَتَهُ عَلَى خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) أ.ه. (سبل السلام، 2/639).
– عَن أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: «سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وهُو فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ» (رواه البيهقي في “شعب الإيمان”).
– وغيرهَا مِن الأعمالِ التي نصَّتْ عليهَا الأحاديثُ الصحيحةُ، وقد جمعَهَا الإمامُ السيوطيُّ فبلغتْ “أحدَ عشرَ” ونظمَهَا فِي قَوْلِهِ: إِذا مَاتَ ابْنُ آدمَ لَيْسَ يجْرِي … عَلَيْهِ مِن فعالٍ غيرِ عشْرٍ
عُلُومٌ بثهَا وَدُعَاءُ نجلٍ … وغرسُ النّخلِ وَالصَّدقَاتُ تجْرِي
وراثةُ مصحفٍ ورباطُ ثغرٍ … وحفرُ الْبِئْرِ أَو إِجْرَاءُ نهرٍ
وَبَيتٌ للغريبِ بناهٌ يأوِي … إِلَيْهِ أَو بِنَاءُ مَحلِّ ذكرٍ
وَتَعْلِيم لقرآن كريم … فَخذهَا مِن أَحَادِيثَ بحصرٍ
(الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، 4/228).
*انفعْ غيرَكَ بالتبليغِ، والتعليمِ، والفقهِ إنْ كنتَ متخصصًا: ولو بآيةٍ قصيرةٍ مِن القرآنِ؛ لأنَّ تلكَ الآيةَ مع قلةِ ألفاظِهَا قد تحملُ مِن المعانِي والأحكامِ ما يستفيدُ منهُ الغيرُ الشيءَ الكثيرَ، فعَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً». (رواه البخاري)، وإنَّمَا قالَ: “ولو آيةً” ولم يقلْ: “ولو حديثاً”؛ لأنَّهُ إذا كانت الآيةُ القرآنيةُ التي تكفَّلَ اللهُ بحفظِهَا، وصونِهَا عن الضياعِ والتحريفِ، ومع انتشارِهِ، وكثرةِ حملتِه، واجبةَ التبليغِ، فتبليغُ الحديثِ مِن بابِ أولَى”. (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري).
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ» (متفق عليه).
(3) نماذجُ تحمّلُوا المسؤوليةَ، وتركُوا أثراً طيباً في حياةِ غيرِهِم:
*”حبيبُ النّجارِ” “صاحبُ يس”: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [يس: 20: 21]، إنَّهُ رجلٌ جاء مِن أقصَى المدينةِ يسعَى لا لغرضٍ، ولا خوفاً على نفسِهِ مِن فواتِ صفقةٍ، وإنَّمَا لإنقاذِ الموقفِ، وإعلانِ كلمةِ الحقِّ، لكنْ نصيحتُهُ لم تصادفْ أذناً واعيةً بل إنَّ سياقَ القصةِ ليوحِي بأنَّ قومَهُ قتلوهُ، فهذا رجلٌ واحدٌ جاءَ يسعَى بكلِّ قوتِهِ؛ لأنَّهُ استشعرَ أنَّهُ مسؤولٌ، ويرَى أنَّهُ ينبغِي أنْ يبلِّغَ هذه الدعوةَ في وقتِهَا المناسبِ.
قالَ مولانَا أ.د/ مُحمد طنطاوي: (والتعبيرُ بقولِهِ: “يَسْعَى”: يدلُّ على صفاءِ نفسِهِ، وسلامةِ قلبِهِ، وعلوِّ همتِهِ، ومضاءِ عزيمتِهِ حيثُ أسرعَ بالحضورِ إلى الرسلِ وإلى قومِهِ؛ ليعلنَ أمامَ الجميعِ كلمةَ الحقِّ، ولم يرتضِ أنْ يقبعَ في بيتِهِ- كمَا يفعلُ الكثيرونَ- بل هرولَ نحوَ قومِهِ؛ ليقومَ بواجبِهِ في الأمرِ بالمعروفِ، والنهيِ عن المنكرِ) أ.ه. (التفسير الوسيط للقرآن الكريم).
*حشرةٌ صغيرةٌ: حكَى اللهُ ما قالتْهُ نملةٌ عندمَا رأتْ جيشَ سليمانَ– عليهِ السلامُ- العظيمَ المنظمَ: {حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} [النمل: 18].
تأملْ كيفَ تحملتْ نملةٌ واحدةٌ مسؤوليةَ الإنذارِ والتحذيرِ وصاحتْ في النملِ، ولم تكتفِ بجناة.ك نفسِهَا بل حرصتْ على نجاةِ الجميعِ، وأتَى التعبيرُ: “قَالَتْ نَمْلَةٌ” منكراً لا معرفاً، وجاءتْ المخاطبةُ كمَن يعقلُ؛ لأنَّهَا أمرتْهُم بمَا يؤمرُ بهِ مَن يعقلُ.
يقولُ أبو السعودِ: (كأنَّهَا لمَّا رأتهُم متوجهينَ إلى الوادِي، فرَّتْ منهُم فصاحتْ صيحةً، تنبهتْ بهَا ما بحضرتِهَا مِن النملِ لمرادِهَا، فتبعَهَا في الفرارِ فُشبِّهَ ذلكَ بمخاطبةِ العُقلاءِ، ومناصحتِهِم، فأُجرُوا مُجراهُم حيثُ جُعلتْ هي قائلةً وما عداهَا مِن النملِ مقولاً لهُم) أ.ه. (إرشاد العقل السليم) .
*ذُو القرنينِ: {فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا * آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} [الكهف: 95: 96].
توسمُوا فيهِ القوةَ والصلاحَ، فعرضُوا عليهِ أنْ يقيمَ لهُم سداً يحولُ بينَهُم وبينَ يأجوجَ ومأجوج، فتحمّلَ ذُو القرنينِ المسؤوليةَ، ولم يتعللْ بأنَّهُ لا تربطهُ بهِم سابقُ معرفةٍ! ثُمَّ أشركَ الجميعَ وجعلَهُم مسؤولينَ عن إتمامِ هذا العملِ {فَأَعِينُونِي}، {آتُونِي}، {انْفُخُوا}، {آتُونِي}؛ فاستغلَّ جميعَ الطاقاتِ والإمكانياتِ، فصنعُوا السدَّ بإحكامٍ وإتقانٍ، وبقيَ أثرُهُ الإيجابِيّ، {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا} [الكهف: 97].
(4) ذَمُّ الشخصيةِ المتخاذلةِ المنغلقةِ على نفسِهَا: ذَمَّ القرآنُ الكريمُ الشخصيةَ المنغلقةَ على نفسِهَا التي تحملُ معانِي التقوقعِ، والبلادةِ، والانغلاقِ، فهو شخصٌ يدورُ حولَ نفسِهِ لا تتجاوزُ اهتماماتُهُ أرنبةَ أنفِهِ، ولا يمدُّ يدَهُ نحوَ الآخرينَ، ولا يخطُو إلى الأمامِ: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَم لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم} [النحل: 76]، فتأملْ لفظَ: “كَلٌّ” التي تدلُّكَ على أنَّهُ شخصٌ غيرُ فعَّالٍ في محيطِهِ، وقبلَ هذَا فهُوَ “أَبْكَمْ”: لا يرتفعُ لهُ صوتٌ خاصةً حينمَا يتوجبُ عليهِ دفعُ ظلمٍ، أو جلبُ حقٍّ.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ» (رواه ابن ماجه).
– {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} [هود: 117]، ولم يقلْ “صالحون” إنَّمَا قالَ: “مُصْلِحُونَ”، وهناكَ فارقٌ، ف “الصالحُ”: صلاحُهُ بينَهُ وبينَ خالقِهِ، أمَّا “المصلحُ”: فإنَّهُ يقومُ بإصلاحِ نفسِهِ، ويسعَى لهدايةِ غيرِهِ، فالذي يشعرُ بالمسؤوليةِ يصنعُ الأحداثَ، بينمَا السلبيُّ تصنعُهُ الأحداثُ، الأولُ: ينظرُ للمستقبلِ بينمَا الآخرُ يخافُ المستقبلَ، والذي يستشعرُ غايتَهُ يزيدُ في هذه الدنيا، أمَّا السلبِيُّ: فهو زائدٌ عليهَا.
– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «…، إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ- لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ» (رواه الإمام أحمد).
– الإسلامُ لا يريدُ أناسًا منغلقينَ على أنفسِهِم، متغافلينَ نفعَ غيرِهِم بل مَن يفعلُ ذلكَ معرضٌ لسخطِ أحكمِ الحاكمينَ، واستمعْ إلى ما جاءَ على لسانِ المتقينَ- على جهةِ التوبيخِ لهؤلاءِ المجرمينَ-:﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [المدثر:42: 44]، فهم اعترفُوا أنَّهُم استوجبُوا “سقرَ” نتيجةَ تخليهِم عن إطعامِ الجائعِ وكسوتِهِ، ورعايتِهِ.
حينمَا عرفَ كلُّ فردٍ دورَهُ ومهمتَهُ أسَّسَ المسلمون الأوائلُ حضارةً لم يعرفْ لهَا التاريخُ مثيلاً، لم يرتضُوا أنْ يكونُوا على هامشِ الحياةِ ليسَ لهُم دورٌ إيجابِيٌّ في حركتِهَا، ومن ثمَّ خَلّفُوا لنَا آثاراً علميةً ما زالتْ البشريةُ ترتشفُ مِن عبيرِهَا حتى اليوم.
– بالأثرِ الطيبِ تنتظمُ شؤونُ الحياةِ، وبهِ تُحفَظُ الحقوقُ، وتُنجَزُ الأعمالُ، وهو سببُ سعادةِ المجتمعاتِ، وعندمَا يتخطَّى الإنسانُ ذلكَ تُشلُّ حركةُ الحياةِ، وتشقَى البشريةُ، ويصبحُ العالمُ غابةً لا ضابطَ لهَا، ولا وازعَ.
* الإنسانُ إمَّا مُسْتَرِيحٌ أو مُسْتَرَاحٌ منهُ:
مَن لم يجلبْ لنفسِهِ ومَن حولَهُ سوَى التعبِ والمعاناةِ، ولم يتركْ أثراً حسناً يُذكَرُ بهِ، فهذا مستراحٌ منهُ، والعكسُ كذلكَ.
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ، وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ، وَالْبِلَادُ، وَالشَّجَرُ، وَالدَّوَابُّ» (متفق عليه).
(5) حسنُ الأثرِ دليلٌ على محبةِ اللهِ للعبدِ: آثارُ الأعمالِ المحمودةِ المعجلةِ مِن البشرَى، إذ يحببُ اللهُ العبدَ إلى الخَلقِ ثم يُوضَعُ لهُ القبولَ في الأرضِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ» (رواه مسلم).
قال ابنُ هبيرةَ: (في هذا الحديثِ مِن الفقهِ: الدلالةُ على أنَّ حمدَ الناسِ المؤمنَ على خيرٍ فعلَهُ بُشرَى مِن اللهِ تعجلهَا؛ إذْ هُم شهودُ اللهِ في أرضِهِ؛ لأنَّ المؤمنينَ لا يستجيزونَ أنْ يمدحُوهُ، ويثنُوا عليهِ إلَّا فيمَا يكونُ للهِ رضَى، كمَا أنَّهُم لا يستجيزونَ أنْ يذمُّوا إلَّا على مَا هو غيرُ رضَى). أ.ه. (الإفصاح عن معاني الصحاح).
*(العبادةُ المتعديةُ خيرٌ مِن القاصرةِ): هي التي يمتدُّ أثرُهَا على مَن حولَهُ كالتعاونِ على الخيرِ، وبذلِ المساعدةِ للآخرينَ، والمشاركةِ في بناءَ الوطنِ، والأمرِ بالمعروفِ، والنهيِ عن المنكرِ،{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ} [آل عمران: 106].
“الأمةُ التي تهملُ الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكرِ لا يمكنُ أنْ تكونَ خيرَ أمةٍ، بل لا توصفُ بالخيريةِ قط؛ لأنَّهُ لا خيرَ إلَّا في الفضائلِ والحقِّ والعدلِ، وكثرةِ الدعاةِ إلى الخيرِ، والناهينَ عن الشرِّ، ويكونُ لدعوتِهِم آثارُهَا القويةُ التي تحيَا معهَا الفضائلُ، وتزولُ بهَا الرذائلُ.
وكأنَّهُ- سبحانَهُ- قد أخرَ «الإيمانَ باللهِ» عن «الأمرِ بالمعروفِ، والنهيِ عن المنكرِ»؛ ليكونَ كالباعثِ عليهمَا؛ لأنّهُ لا يصبرُ على تكاليفهِمَا، ومتاعبهِمَا إلَّا مؤمنٌ يبتغِى وجهَ اللهِ، ويركنُ في كفاحِهِ إليهِ، فهذا الإيمانُ باللهِ هو الباعثُ للآمرينَ بالمعروفِ، والناهينَ عن المنكرِ على أنْ يبلغُوا رسالاتِ اللهِ، دونَ أنْ يخشُوا أحدًا سواهُ. وقِيلَ: إنَّمَا أخَّرَ الإيمانَ عليهمَا مع تقدمِهِ عليهمَا وجوداً ورتبةً كما هو الظاهرُ؛ لأنَّ الإيمان مشتركٌ بينَ جميعِ الأممِ دونَ الأمرِ بالمعروفِ، والنهيِ عن المنكرِ، فهمَا أظهرُ في الدلالةِ على الخيريةِ للأمةِ الإسلاميةِ”.(التفسير الوسيط، أ.د/محمد طنطاوي).
– قالَ الإمامُ القرافِيُّ: (وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الرِّيَاءِ: قَصْدُ اشْتِهَارِ النَّفْسِ بِالْعِلْمِ لِطَلَبِ الِاقْتِدَاءِ بَلْ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ، فَإِنَّهُ سَعْى فِي تَكْثِيرِ الطَّاعَاتِ، وَتَقْلِيلِ الْمُخَالَفَاتِ؛ وَلِهَذَا الْمَعْنَى أَشَارَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ- بِقَوْلِهِ: “إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاث..، علم ينْتَفع بِهِ”، حَضًّا عَلَى نَشْرِ الْعِلْمِ؛ لِيَبْقَى بَعْدَ الْإِنْسَانِ؛ لِتَكْثِيرِ النَّفْعِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: 4] عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ، وَقَالَ الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ: يَنْبَغِي لِلْعَابِدِ السَّعْيُ فِي الْخُمُولِ، وَالْعُزْلَةِ؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى السَّلامَة، وَلِلْعَالِمِ السَّعْيُ فِي الشُّهْرَةِ، وَالظُّهُورِ، تَحْصِيلًاً لِلْإِفَادَةِ). أ.ه. (الذخيرة، 1/49).
(6) افعلْ الخيرَ دونَ انتظارِ شهرةٍ أو تحصيلِ مدحٍ دنيويٍّ، بل ارجُو ثوابَ الآخرةِ:
– النبيُّ ﷺ يبينُ أنَّ “الصدقةَ والوقفَ والتبرعَ وغيرهَا مِن وجوهِ النفعِ” يبقَى ثوابُهَا، وأثرُهَا بعدَ الموتِ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: “إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ” (رواه مسلم).
قالَ الإمامُ النوويُّ: (معنَى الحديثِ أنَّ عملَ الميتِ ينقطعُ بموتِهِ، وينقطعُ تجددُ الثوابِ لهُ إلَّا في هذهِ الأشياءِ الثلاثةِ لكونِهِ كانَ سببهَا، فإنَّ الولدَ مِن كسبِهِ وكذلكَ العلمُ الذِي خلَّفَهُ مِن تعليمٍ أو تصنيفٍ، وكذلكَ الصدقةُ الجاريةُ وهي الوقفُ، وفيهِ دليلٌ لصحةِ أصلِ الوقفِ، وعظيمِ ثوابِهِ وبيانِ فضيلةِ العلمِ، والحثِّ على الاستكثارِ منهُ، والترغيبِ في توريثِهِ بالتعليمِ والتصنيفِ والإيضاحِ، وأنَّهُ ينبغِي أنْ يختارَ مِن العلومِ الأنفعَ فالأنفعَ) أ.ه. (شرح النووي على مسلم).
– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ ، قَالَ:«مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» (مسلم).
قالَ الإمامُ النوويُّ: (هذا الحديثُ صريحٌ في الحثِّ على استحبابِ سنِّ الأمورِ الحسنةِ، وتحريمِ سنِّ الأمورِ السيئةِ، وأنَّ مَن دعَا إلى هدَى كانَ لهُ مثلُ أجورِ متابعيهِ أو إلى ضلالةٍ كانَ عليهِ مثلُ آثامِ تابعيهِ سواءٌ كان ذلكَ الهدَى والضلالةُ هو الذي ابتدأهُ أم كان مسبوقاً إليهِ، وسواءٌ كان ذلكَ تعليمُ علمٍ أو عبادةٍ أو أدبٍ أو غيرِ ذلكَ، سواءٌ كانَ العملُ في حياتِهِ أو بعدَ موتِهِ) أ.ه. (شرح النووي على مسلم).
علينَا جميعاً: وجوبُ استشعارِ “أهميةِ الأثرِ الطيبِ”: يجبُ على الأسرةِ تنشئةُ أولادِهَا على تعظيمِ الأثرِ الطيبِ منذُ نعومةِ أظفارِهِم، وغرسِ حبِّ الخيرِ، والعملِ، وحبِّ الوطنِ، والدفاعِ عنهُ، والتمسكِ بالقيمِ والأخلاقِ.
قالَ الإمامُ الغزالِيُّ: (الصبيُّ أمانةٌ عندَ والديهِ، وقلبُهُ الطاهرُ جوهرةٌ ساذجةٌ خاليةٌ مِن كلِّ نقشٍ وصورةٍ، وهو قابلٌ لكلِّ ما نقشَ، ومائلٌ إلى كلِّ ما يمالُ بهِ إليهِ، فإنْ عُوِّدَ الخيرَ وعلمَهُ، نشأَ عليهِ، وسعدَ في الدنيا والآخرةِ أبواهُ، وكلُّ مُعلِّمٍ لهُ، ومؤدِّبٍ، وإنْ عوِّدَ الشرَّ، وأُهْمِلَ إهمالَ البهائمِ، شقيَ وهلكَ، وكان الوزرُ في رقبةِ القيِّمِ عليهِ، والوالِي لهُ) أ.ه. (إحياء علوم الدين، 3/72).
– النبيُّ ﷺ ربَّى أصحابَهُ على ذلكَ، فهذا أسامةُ بنُ زيدٍ – رضي اللهُ عنهمَا- في سنِّ السابعةِ عشرةَ يكلفُهُ ﷺ قيادةَ جيشٍ فيهِ الشيخان– رضي اللهُ عنهمَا-، وينتقلُ ﷺ إلى جِوارِ ربِّهِ، فينفذُ أبو بكرٍ بعثَ أسامةَ، ويعودُ محققاً الغايةَ التي مِن أجلِهَا أُرسِلَ.
نسألُ اللهَ أنْ يرزقَنَا حسنَ العملِ، وفضلَ القبولِ، إنَّهُ أكرمُ مسؤولٍ، وأعظمُ مأمولٍ، وأنْ يجعلَ بلدَنَا مِصْرَ سخاءً رخاءً، أمناً أماناً، سلماً سلاماً وسائرَ بلادِ العالمين، ووفقْ ولاةَ أُمورِنَا لِمَا فيهِ نفعُ البلادِ والعبادِ.
كتبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان د / محروس رمضان حفظي عبد العال
مدرس التفسير وعلوم القرآن – كلية أصول الدين والدعوة – أسيوط
_____________________________________
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف