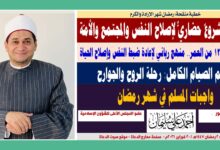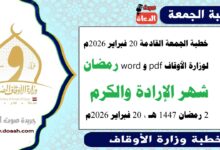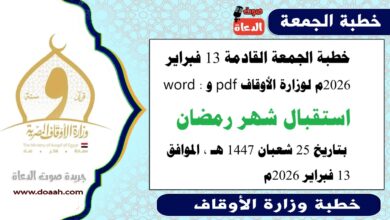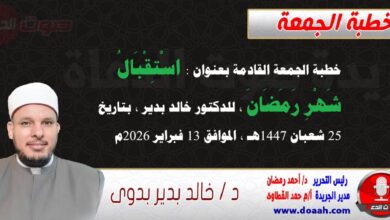خطبة الجمعة القادمة 15 أغسطس : إِعْلَاءُ قِيمَةِ السَّعْيِ وَالْعَمَلِ ، للدكتور محروس حفظي
بتاريخ 21 صفر 1447 هـ ، الموافق 15 أغسطس 2025م

خطبة الجمعة القادمة
خطبة الجمعة القادمة 15 أغسطس 2025 م بعنوان : إِعْلَاءُ قِيمَةِ السَّعْيِ وَالْعَمَلِ ، للدكتور محروس حفظي بتاريخ 21 صفر 1447هـ ، الموافق 15 أغسطس 2025م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 15 أغسطس 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : إِعْلَاءُ قِيمَةِ السَّعْيِ وَالْعَمَلِ.
ولتحميل خطبة الجمعة القادمة 15 أغسطس 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : إِعْلَاءُ قِيمَةِ السَّعْيِ وَالْعَمَلِ، بصيغة word أضغط هنا.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 15 أغسطس 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : إِعْلَاءُ قِيمَةِ السَّعْيِ وَالْعَمَلِ، بصيغة pdf أضغط هنا.
___________________________________________________________
عناصر خطبة الجمعة القادمة 15 أغسطس 2025م بعنوان : إِعْلَاءُ قِيمَةِ السَّعْيِ وَالْعَمَلِ ، للدكتور محروس حفظي :
(1) القرآنُ الكريمُ ربطَ بينَ “الإيمانِ والعملِ”.
(2) ضرورةُ الأخذِ بالأسبابِ، والسعيِ في الأرضِ مع التوكلِ على اللهِ.
(3) لا تستنكفْ ولا تتأففْ مِن عملٍ شريفٍ، يعفُّكَ عن الخَلْقِ، وأكلِ الحرامِ.
(4) الصحابةُ – رضيَ اللهُ عنهُم- مثالٌ يُحتذَى بهِ في السعيِ والعملِ.
(5) الإنسانُ بينَ الإخفاقِ والسعيِ، والنجاحِ والرسوبِ.
(6) حثُّ الإسلامِ على ضرورةِ التكاتفِ، والتعاطفِ.
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 15 أغسطس 2025م بعنوان: إِعْلَاءُ قِيمَةِ السَّعْيِ وَالْعَمَلِ ، للدكتور محروس حفظي : كما يلي:
إعلاءُ قيمةِ السعيِ والعملِ
بتاريخ 21 صفر 1447هـ = الموافق 15 أغسطس 2025 م
الحمدُ للهِ حمداً يُوافِي نعمَهُ، ويُكافِىءُ مزيدَهُ، لك الحمدُ كما ينبغِي لجلالِ وجهِكَ، ولعظيمِ سلطانِكَ، والصلاةُ والسلامُ الأتمانِ الأكملانِ على سيدِنَا مُحمدٍ ﷺ، أمَّا بعدُ ،،،
(1) القرآنُ الكريمُ ربطَ بينَ “الإيمانِ والعملِ: لا تخلُو آيةٌ في كتابِهِ العزيزِ إلَّا وقرنَ فيهَا بينَ الإيمانِ، والعملِ الصالحِ، وقد وردَ لفظُ “العملِ” ومشتقاتُهُ في القرآنِ الكريمِ «360» مرةً، تضمنتْ الحديثَ عن أحكامِ العملِ، ومسؤوليةِ العاملِ، وعقوبتِهِ ومثوبتِهِ في الدنيا والآخرةِ، كقولِهِ تعالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا} [الكهف: 107]، {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: 97].
ومِن لطائفِ هذا العددِ أنَّهُ موزعٌ على عددِ أيامِ السنةِ كلِّهَا تقريباً، وكأنَّ القرآنَ الكريمَ ينبهُ الإنسانَ على ضرورةِ السعيِ، ومواصلةِ الكدِّ؛ لدفعِ حركةِ الحياةِ، وعجلةِ التنميةِ، فالأممُ المتقدمةُ لا تعرفُ التوقفَ أو الانزواءَ عن العملِ، {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} [الشرح: 7].
قال أ.د/ موسَى شاهين لاشين: (إنَّ الإسلامَ دينُ كفاحٍ، وعملٍ، وإنتاجٍ، يبنِي الدنيَا ويعملُ للآخرةِ، يدعو المسلمَ للعملِ في دنياهُ كما لو كان يعيشُ أبداً، ويعملُ لآخرتِهِ كأنَّهُ يموتُ غداً، حينَ أمرَهُ بتركِ البيعِ والشراءِ مِن أجلِ صلاةِ الجمعةِ عَقِبَ صلاتِهَا بالدعوةِ للعملِ: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]، وفي سبيلِ بناءِ الحياةِ الدنيا، وجَّهَ إلى العملِ والإنتاجِ، وحذَّرَ مِن الكسلِ والخذلانِ.
إنَّ السؤالَ نفسَهُ ذلٌّ، وإنَّ ما يأتِي عن طريقِهِ سحتٌ، فلا يحلُّ السؤالُ وما يحصلُهُ إلَّا في حالاتٍ ثلاث: الأولَى: أنْ يتحملَ الرجلُ غرماً لإصلاحِ ذاتِ البينِ، ولا تغطِي أموالُهُ هذا الغرمَ، فلَهُ أنْ يسألَ لسدادِ هذا الغرمِ، فهو مسئوليةُ المسلمينَ. الثانيةُ: أنْ يُصابَ بكارثةٍ علنيةٍ مفاجئةٍ تأتِي على مالِهِ، فلَهُ أنْ يسألَ حتى يُحصِّلَ ما بهِ كفافَهُ. الثالثةُ: أنْ يخسرَ في عملِهِ، فيفصلُ مِن وظيفتِهِ، أو تخسرُ تجارتُهُ، أو تكسدُ صنعتُهُ، ويحتاجُ العونَ، فيشهدُ بحالتِهِ العالمونَ بأمرِهِ، فيحلُّ لهْ أنْ يسألَ ما بهِ كفافهُ، ولقد خشي الصحابةُ مِن كثرةِ التحذيرِ مِن السؤالِ حتى ابتعدُوا عن سؤالِ العونِ في الشيءِ الحقيرِ) أ.ه.
(2) ضرورةُ الأخذِ بالأسبابِ، والسعيِ في الأرضِ مع التوكلِ على اللهِ: قالَ تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 2]. قال الإمامُ البقاعِيُّ: (وحرفُ الاستعلاءِ “علَى”؛ للإشارةِ إلى أنَّهُ قد حملَ أمورَهُ كلَّهَا عليهِ سبحانَهُ؛ لأنَّهُ القويُّ الذي لا يعصيهِ شيءٌ، والكريمُ الذي يحسنُ حملَ ذلكَ ورعيهِ، والعزيزُ الذي يدفعُ عنهُ كلَّ ضارٍّ، ويجلبُ لهُ كلَّ سارٍّ إلى غيرِ ذلكَ مِن المعانِي الكبار…، فمَن توكلَ استفادَ الأجرَ، وخَفَّفَ عنهُ الألمَ، وقذَفَ في قلبِهِ السكينةَ، ومَن لم يتوكلْ، لم ينفعْهُ ذلكَ، وزادَ ألمُهُ، وطالَ غمُّهُ بشدةِ سعيهِ، وخيبةُ أسبابِهِ التي يعتقدُ أنَّهَا هي المنجحةُ) . أ.ه. (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور).
وأمرُ الله ُبالمشيِ في الأرضِ؛ طلباً للرزقِ الحلالِ، فقالَ تعالى:{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك: 15]، فقولُه: {في مَنَاكِبِها} قال الماورديُّ: (فيه أوجهٌ: أحدُهَا: في جبالِهَا، قالَهُ ابنُ عباسٍ وقتادةُ وبشيرُ بنُ كعبٍ. الثاني: في أطرفاهَا وفجاجِهَا، قالهُ مجاهدٌ والسديٌّ. الثالثُ: في طرفهَا. الرابعُ: في منابتِ زرعِهَا، وأشجارِهَا، قالَهُ الحسنُ) أ.ه. (النكت والعيون).
– السماءُ لا تمطرُ ذهباً ولا فضةً، ولكن تمطرُ ماءً يشقُّ الأرضَ، فيجنِي الإنسانُ ثمارَهَا، ويعفُّ نفسَهُ، وينفعُ مجتمعَهُ؛ لذا عليهِ أنْ يأخذَ بالأسبابِ، فعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا» (رواه الترمذي وحسنه).
قال القرطبيُّ– عند تفسيرِ قولِ اللهِ تعالى: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ} [الأنبياء: 80]-: (هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي اتِّخَاذِ الصَّنَائِعِ، وَالْأَسْبَابِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعُقُولِ وَالْأَلْبَابِ، لَا قَوْلُ الْجَهَلَةِ الْأَغْبِيَاءِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا شُرِعَ لِلضُّعَفَاءِ، فَالسَّبَبُ سُنَّةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ فَمَنْ طَعَنَ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ طَعَنَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَنَسَبَ مَنْ ذَكَرْنَا إِلَى الضَّعْفِ وَعَدَمِ الْمِنَّةِ).
وقد أمرَ اللهُ السيدةَ مريمَ – عليهَا السلامُ- بهزِّ الجذعِ اليابسِ الذي لا رأسَ لهَا ولا ثمرَ مع قدرتِهِ- سبحانَهُ- على إنزالِ الرطبِ إليهَا مِن غيرِ هزٍّ أو تحريكٍ فقالَ: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} [مريم: 25].
قال ابنُ عجيبةَ: (إنَّ تحريكَ الأسبابِ الشرعيةِ لا يُنافِي التوكلَ، لقولِهِ تعالَى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ} لكنْ إذا كانت خفيفةً مصحوبةً بإقامةِ الدينِ غيرَ معتمدٍ عليهَا بقلبِهِ، فإنْ كان متجردًا فلا يرجعُ إليهَا حتى يكمِّلَ يقينَهُ، ويتمكنَ في معرفةِ الحقِّ تعالَى، وقد كانت في بدايتِهَا تأتِي إليهَا الأرزاقُ بغيرِ سببٍ كمَا في «سورةِ آلَ عمران»، وفي نهايتِهَا قالَ لهَا: {وَهُزِّي إِلَيْكِ}.
قال الشيخُ أبو العباسِ المرسِي – رضي اللهُ عنهُ-: “كانت في بدايتِهَا متعرفًا إليهَا بخرقِ العاداتِ، وسقوطِ الأسبابِ، فلَمَّا تكمَّلَ يقينُهَا رجعتْ إلى الأسبابِ، والحالةُ الثانيةُ أتمُّ مِن الحالةِ الأولَى”) أ.ه. (البحر المديد في تفسير القرآن المجيد).
وللهِ درُّ القائلِ:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِمَرْيَمَ … وَهُزِّي إِلَيْكَ الْجِذْعَ يَسَّاقَطِ الرُّطَبُ
وَلَوْ شَاءَ أَنْ تَجْنِيَهُ مِنْ غَيْرِ هَزِّهِ … جَنَتْهُ وَلَكِنْ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ سَبَبُ
(3) لا تستنكفْ ولا تتأففْ مِن عملٍ شريفٍ، يعفُّكَ عن الخَلْقِ، وأكلِ الحرامِ: عندمَا تقرأُ في سيرِ الرسلِ والأنبياءِ– عليهمُ السلامُ- تجدُ أنَّهُم باشرُوا الأعمالَ المختلفةَ، والحِرفَ المتنوعةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ»، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ» (رواه البخاري)، ونحنُ قد أُمرْنَا بالتأسِي بهِم {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90].
يقولُ الإمامُ القرطبِيُّ – عندَ تفسيرِ قولِ اللهِ تعالى: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ} [الأنبياء: 80]-: (وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْ نَبِيِّهِ دَاوُدَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- أَنَّهُ كَانَ يَصْنَعُ الدُّرُوعَ، وَكَانَ أَيْضًا يَصْنَعُ الْخُوصَ، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَكَانَ آدَمُ حَرَّاثًا، وَنُوحٌ نَجَّارًا، وَلُقْمَانُ خَيَّاطًا، وَطَالُوتُ دَبَّاغًا، وَقِيلَ: سَقَّاءً، فَالصَّنْعَةُ يَكُفُّ بِهَا الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَنِ النَّاسِ، وَيَدْفَعُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ الضَّرَرَ وَالْبَأْسَ) أ.ه . (الجامع لأحكام القرآن).
وعَنِ المِقْدَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ – عَلَيْهِ السَّلاَمُ- كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» (رواه البخاري).
قالَ ابنُ حجرٍ: (والحكمةُ في تخصيصِ “داودَ” بالذكرِ؛ أنَّ اقتصارَهُ في أكلِهِ على ما يعملُهُ بيدِهِ لم يكنْ مِن الحاجةِ؛ لأنَّهُ كان خليفةً في الأرضِ كمَا قالَ اللهُ، وإنَّمَا ابتغَى الأكلَ مِن طريقِ الأفضلِ، ولهذَا أوردَ النبيُّ ﷺ قصتَهُ في مقامِ الاحتجاجِ بهَا على ما قدَّمَهُ مِن أنَّ خيرَ الكسبِ عملُ اليدِ، وهذا بعدَ تقريرِ أنَّ “شرعَ مَن قبلنَا شرعٌ لنَا”، ولا سيَّمَا إذَا وردَ في شرعِنَا مدحُهُ، وتحسينُهُ مع عمومِ قولِهِ تعالَى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}، وفي الحديثِ أنَّ التكسبَ لا يقدحُ في التوكلِ) أ.ه. (فتح الباري).
وقالَ لقمانُ الحكيمُ لابنِهِ: “يا بُنيَّ استغنِ بالكسبِ الحلالِ عن الفقرِ؛ فإنَّهُ ما افتقرَ أحدٌ قط إلَّا أصابَهُ ثلاثَ خصالٍ: رقةٌ في دينِهِ، وضعفٌ في عقلِهِ، وذهابُ مروءتِهِ، وأعظمُ مِن هذه الثلاثِ استخفافُ الناسِ بهِ” (إحياء علوم الدين).
أمَّا أنْ يترفعَ الإنسانُ عن العملِ ويستنكفَ، ويحتقرَ مهنةً معينةً، ويستسهلَ التسولَ، فهذا يخلُّ بالمروءةِ، ويحطُّ مِن قيمةِ الرجولةِ، ولذَا كرِهَ رسولُنَا ﷺ للعبدِ سؤالَ الناسِ، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» (رواه مسلم).
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ» (متفق عليه).
لقد جعلَ النبيُّ ﷺ بديلَ “البطالةِ” العملَ والسعيَ، وذاكَ في أشقِّ المهنِ “الاحتطاب”، فإنْ لم يجدْ غيرَهُ مِن الحرفِ، مع ما فيهِ مِن امتهانِ المرءِ نفسَهُ، ومِن المشقةِ خيرٌ لهُ مِن المسألةِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» (رواه البخاري).
قال القسطلانِيُّ: (وغايةُ ما في هذا الحديثِ تفضيلُ الاحتطابِ على السؤالِ، وليسَ فيهِ أنَّهُ أفضلُ المكاسبِ، فلعلَّهُ ذكرَهُ لتيسرهِ لا سيَّمَا في بلادِ الحجازِ؛ لكثرةِ ذلكَ فيهَا) .أ.ه. (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري).
ويرسخُ ﷺ مبدأَ ضرورةِ العملِ وأنَّهُ بابُ “مغفرةِ الذنوبِ”، و”محبةِ اللهِ”، عن ابنِ عباسٍ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَن أمسَى كالًّا مِن عملِ يديهِ أمسَى مغفوراً لهُ» (رواه الطبراني في “المعجم الأوسط”).
وللهِ درُّ القائلِ:
لحملِي الصخرَ مِن قمَمِ الجبالِ *** أحبُّ إليَّ مِن مننِ الرِّجَالِ
يقولُ الناسُ في الكسبِ عارٌ *** فقلتُ العارُ في ذُلِّ السُّؤَالِ
وعن عُبَيْدِ اللَّهِ عن النبيِّ ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ» (رواه الطبراني في “المعجم الأوسط”) .
(4) الصحابةُ – رضيَ اللهُ عنهُم- مثالٌ يُحتذَى بهِ في السعيِ والعملِ: كانَ للصحابةِ أعمالٌ، ومهنٌ مختلفةٌ، فكانَ أبُو بكرٍ تاجرَ أقمشةٍ، وعمرُ بنُ الخطابِ دلالاً، وعثمانُ بنُ عفانَ تاجراً، وعليٌّ بنُ أبِي طالبٍ عاملاً، وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ تاجراً، والزبيرُ بنُ العوامِ خياطاً، وسعدُ بنُ أبِي وقاصٍ نَبَّالاً أي: يصنعُ النبالَ، وعمرُو بنُ العاصِّ جزاراً، وكان ابنُ مسعودٍ، وأبُو هريرةَ لديهِم مزارعَ يزرعونَهَا، وكان عمّارُ بنُ ياسرٍ يصنعُ المكاتِلَ، ويضفرُ الخوصَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أجمعين.
وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: «قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ وَعِنْدَ الأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ، وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ» (رواه البخاري).
(5) الإنسانُ بينَ الإخفاقِ والسعيِ، والنجاحِ والرسوبِ: بيَّنَ اللهُ في كتابِهِ العزيزِ أنَّ سنتَهُ الكونيةَ اقتضتْ أنَّهُ خلقَ البشرَ مِن أجلِ السعيِ والعملِ وإلَّا لمَا كانَ للحياةِ طعمٌ أو مذاقٌ، {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ} [البلد: 4]، ومَن فهمَ هذا القانونَ الربانيَّ، عافرَ، وحاولَ مرةً بعدَ أُخرَى بغيةَ الوصولِ إلى ما يريدُ، والإنسانُ الكائنُ الوحيدُ مِن بينِ الكائناتِ الذي يرفضُ قانونَ «الجهدِ المهدورِ» “قانونَ رجالِ الأعمالِ، والعباقرةِ الجسامِ، فتجدُ الأسودَ مثلاً لا تنجحُ في الصيدِ إلَّا في ربعِ محاولاتِهَا أي تفشلُ في 75% مِن صيدِهَا ومع ذلكَ لا تيأسُ مِن محاولاتِ المطاردةِ، والسعيِ للانقضاضِ على فريستِهَا، ونصفُ مواليدِ الدببةِ تموتُ قبلَ البلوغِ، ونصفُ بيوضِ الأسماكِ يَتِمُّ التهامُهَا … إلخ، ولا يزالُ هذا القانونُ الإلهيُّ مستمراً لا ينقطعُ عن نواميسِ الطبيعةِ”، بينمَا الإنسانُ إذا أخفقَ في عملٍ ما، توقفَ عن السعيِ والمثابرةِ، واستسلمَ للظروفِ، ومِن ثمَّ تراهُ يسلكُ أعمالاً غيرَ مشروعةٍ، وما يُؤتَى بدونِ عَرَقٍ يذهبُ سُدَى.
وللهِ درُّ القائلِ:
بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ المعَالِي *** ومَنْ طلبَ العُلَا سَهرَ اللَّيالِي
ومَن طلبَ العُلَا مِن غيرِ كَدٍّ *** أَضَاعَ العُمْرَ في طلبِ الْمُحَالِ
يقولُ الإمامُ القِنَّوجِيُّ: (قَالَ عُلَمَاؤُنَا: أَوَّلُ مَا يُكَابِدُ قَطْعَ سُرَّتِهِ، ثُمَّ يُكَابِدُ الِارْتِضَاعَ، وَلَوْ فَاتَهُ لَضَاعَ، ثُمَّ يُكَابِدُ نَبْتَ أَسْنَانِهِ، وَتَحَرُّكَ لِسَانِهِ، ثُمَّ يُكَابِدُ الْفِطَامَ، ثُمَّ يُكَابِدُ الْخِتَانَ، وَالْأَوْجَاعَ، وَالْأَحْزَانَ، ثُمَّ يُكَابِدُ الْمُعَلِّمَ وَصَوْلَتَهُ، وَالْمُؤَدِّبَ وَسِيَاسَتَهُ، وَالْأُسْتَاذَ وَهَيْبَتَهُ، ثُمَّ يُكَابِدُ شُغْلَ التَّزْوِيجِ وَالتَّعْجِيلَ فِيهِ، ثُمَّ يُكَابِدُ شُغْلَ الْأَوْلَادِ، وَالْخَدَمِ وَالْأَجْنَادِ، ثُمَّ يُكَابِدُ شُغْلَ الدُّورِ، وَبِنَاءِ الْقُصُورِ، ثُمَّ الْكِبَرَ وَالْهَرَمَ، وفِي مَصَائِبَ يَكْثُرُ تَعْدَادُهَا، وَنَوَائِبَ يَطُولُ إِيرَادُهَا، وَيُكَابِدُ مِحَنًا فِي الْمَالِ وَالنَّفْسِ، وَلَا يَمْضِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا يُقَاسِي فِيهِ شِدَّةً، وَلَا يُكَابِدُ إِلَّا مَشَقَّةً، ثُمَّ الموت بعد ذلك كله، ثم مسألة الْمَلَكِ، وَضَغْطَةَ الْقَبْرِ وَظُلْمَتَهُ، ثُمَّ الْبَعْثَ وَالْعَرْضَ عَلَى اللَّهِ إِلَى أَنْ يَسْتَقِرَّ بِهِ الْقَرَارُ، إِمَّا فِي الْجَنَّةِ وَإِمَّا فِي النَّارِ) أ.ه. (فتحُ البيان في مقاصد القرآن).
– العملُ والسعيُ وقتُ البكورِ: أرشدَنَا ﷺ أنْ نغتنمَ “ساعةَ البكورِ” في العملِ والسعيِ، فعَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، قَالَ: قَالَ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، قَالَ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَثْرَى، وَكَثُرَ مَالُهُ» (رواه ابن ماجه).
قالَ ابنُ بطَّالٍ: (وإنّمَا خصَّ ﷺ “البكورَ” بالدعاءِ بالبركةِ فيهِ مِن بينِ سائرِ الأوقاتِ؛ لأنَّهُ وقتٌ يقصدُهُ الناسُ بابتداءِ أعمالِهِم، وهو وقتُ نشاطٍ، وقيامٍ مِن دعةٍ، فخصَّهُ بالدعاءِ؛ لينالَ بركةَ دعوتِهِ جميعُ أمتِهِ) أ.ه.
(6) ينبغِي أنْ يُضَمَّ للعملِ والسعيِ، الإتقانُ والجودةُ: إتقانُ العملِ مقصدٌ شرعِيٌّ حرِيٌّ بنَا تطبيقُهُ في كافةِ المجالاتِ؛ كي يتحققَ للوطنِ السيادةُ والريادةُ، {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، والإحكامُ والإتقانُ صفةٌ مِن صفاتِ اللهِ جلَّ وعلَا، {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل: 88].
وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: “إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ”. (شعب الإيمان).
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» (رواه مسلم).
قالَ الطاهرُ بنُ عاشورٍ: (وقولُهُ: {وَأَحْسِنُوا} “الْإِحْسَانُ”: فِعْلُ النَّافِعِ الْمُلَائِمِ، وَفِي حَذْفِ مُتَعَلِّقِ: {أَحْسِنُوا}: تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْإِحْسَانَ مَطْلُوبٌ فِي كُلِّ حَالٍ؛ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ») أ.ه. (التحرير والتنوير).
وقد ضربَ لنَا النبيُّ ﷺ مثلاً عملياً في تدريبِ النشءِ على إتقانِ العملِ، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ:«تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ، قَالَ: فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبْطِ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: هَكَذَا يَا غُلَامُ فَاسْلُخْ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ ماء» (رواه ابن حبان)، لم يستكبرْﷺ أنْ يُعلِّمَ الغلامَ ما خفيَ مِن إتقانِ السلخِ!!، إنَّهَا مهمةُ المعلمِ، وإحساسُ المُربِّي بمسئوليةِ التقويمِ الدائمِ في كلِّ وقتٍ، وفي كلِّ عملٍ.
– المستقرىءُ للقرآنِ يجدُ أنَّ اللهَ ضربَ نماذجَ فريدةً في “إتقانِ العملِ”: كإتقانِ ذِي القرنينِ بناءَ السدِّ حيثُ استخدمَ أعلَى مواصفاتِ التقنيةِ، {قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا} [الكهف: 95]، فكانت النتيجةُ الحتميةُ، {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا} [الكهف: 97].
وفي قصةِ داودَ – عليهِ السلامُ-: {وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ} [سبأ: 11]، “والتقديرُ هنَا بمعنَى الإحكامِ والإجادةِ وحسنِ التفكيرِ في عملِ الشيءِ، والسردُ: نسجُ الدروعِ وتهيئتُهَا لوظيفتِهَا”. (التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مولانا أ.د/ محمد سيد طنطاوي).
قال الإمامُ البقاعيُّ: “أي: النسجُ بأنْ يكونَ كلُّ حلقةٍ مساويةً لأختِهَا مع كونِهَا ضيقةٌ؛ لئلَّا ينفذُ منهَا سهمٌ، ولتكنْ في تحتِهَا بحيثُ لا يقلعُهَا سيفٌ، ولا تثقلُ على الدارعِ، فتمنعُهُ خفةُ التصرفِ، وسرعةُ الانتقالِ في الكرِّ والفرِّ، والطعنِ والضربِ، في البردِ والحرِّ”. أ.ه. (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 15/459).
وتأملْ قمةَ الإتقانِ الذي شيّدَ بهِ سليمانُ- عليهِ السلامُ- قصرَ بلقيسٍ، فلَمَّا عاينتْ، علمتْ أنَّهُ نبيٌّ، فرجعتْ إلى رشدِهَا {قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ} [النمل: 44]، وغيرهُ مِمَّا قصَّهُ علينَا القرآنُ الكريمُ مِمَّا يثيرُ في المسلمِ حماسةَ “الإتقانِ في العملِ” بمَا يسمحُ للمنتجِ الوطنِيِّ مِن غزوِ الأسواقِ، ورواجِ الصناعةِ على أكملِ وجهٍ.
– عملُكَ أمانةٌ ستسألُ عنهُ يومَ القيامةِ، {وَالَّذِينَ هُمْ لَأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المؤمنون: 8]، وإهمالُ العاملِ في عملِهِ يُعَدُّ خيانةً للأمانةِ؛ لأنَّهُ مؤتمنٌ على العملِ الذي وُكِّلَ إليهِ، وكُلِّفَ بهِ حيثُ لم يُؤدِّهِ على الوجهِ المطلوبِ مع تقاضيهِ أجراً عليهِ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي ﷺ قَالَ:“آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ” (متفق عليه) .
– الإهمالُ في العملِ يوهنُ الوطنَ، وينحدرُ بمستواهُ الفكرِي والاجتماعِي والاقتصادِي، وهذا الإخلالُ ناتجٌ عن ضعفِ الإيمانِ باللهِ، إذ الإتقانُ ثمرةٌ مِن ثمراتِ المراقبةِ لهُ سبحانَهُ؛ لأنَّهُ مطلعٌ علينَا، فالمسلمُ بحقٍّ هو الذي لا يراقبُ رئيسَهُ في العملِ، بل يراقبُ الخالقَ: {وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [يونس: 61].
– وجوبُ الضمانِ، والحَجْرُ على مَن لا يحسنُ عملاً، ويباشرُهُ: مِن أجلِ حفظِ أرواحِ الناسِ، وترغيبِهِم في السعيِ والعملِ، وتقدمِ المجتمعاتِ، أوجبَ الفقهاءُ الضامنَ على الذي لا يحسنُ عملاً، ويباشرُهُ، فيفسدُ حياةَ الخلقِ، فعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ» (رواه ابن ماجه).
قالَ الكاسانِيُّ: (رُوِيَ عن أبي حنيفةَ- رحمَهُ اللهُ- أنَّهُ كانَ لا يجرِي الحجرَ إلَّا على ثلاثةٍ: المفتِي الماجنِ، والطبيبِ الجاهلِ، والمُكارِي المفلسِ، يمنعُ هؤلاءِ الثلاثةُ عن عملِهِم حساً؛ لأنَّ المفتِي الماجنَ: يُفسدُ أديانَ المسلمينَ، والطبيبَ الجاهلَ: يُفسدُ أبدانَ المسلمينَ، والمُكارِي المفلسَ: يُفسدُ أموالَ الناسِ في المفازةِ) أ.ه. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع).
(6) حثُّ الإسلامِ على ضرورةِ التكاتفِ، والتعاطفِ: دينُنَا أرشدَنَا أنْ يعطفَ بعضُنَا على البعضِ خاصةً وقتُ البلايَا والمصائبِ، فعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وشبك أصابعه (متفق عليه)، وصورُ التعاونِ كثيرةٌ ومتنوعةٌ لا تقفُ عندَ حدٍّ مُعينٍ، ومنها التعاونُ المعنويُّ والماديُّ، وها هو رسولُنَا يوجهُنَا إلى حسنِ التعاطفِ والترابطِ فيمَا بينَنَا فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ» (الْبَزَّار، وَإِسْنَاده حَسَنٌ)، وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قال ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ» (رواه مسلم).
إنَّ مِن مقوماتِ المجتمعِ الآمنِ وجودَ التعاطفِ بينَ أعضائِهِ، كلُّ فردٍ فيهِ ينظرُ إلي أخيهِ الإنسانِ يسددُهُ بالنصيحةِ إذَا كانَ محتاجاً لهَا، ويقدمُ لهُ المالَ عندَ الحاجةِ، ويعرضُ عليهِ خدماتِهِ كلّمَا ألمَّتْ بهِ مصيبةٌ، وهكذا يشعرُ الإنسانُ أنّهُ ليسَ وحدَهُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» (رواه مسلم) .
وقال ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (رواه مسلم).
نسألُ اللهَ أنْ يرزقنَا حسنَ العملِ، وفضلَ القبولِ، إنَّهُ أكرمُ مسؤولٍ، وأعظمُ مأمولٍ، وأنْ يجعلَ بلدَنَا مِصْرَ سخاءً رخاءً، أمناً أماناً، سلماً سلاماً وسائرَ بلادِ العالمينَ، ووفقْ ولاةَ أُمورِنَا لِمَا فيهِ نفعُ البلادِ والعبادِ.
كتبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان د / محروس رمضان حفظي عبد العال
مدرس التفسير وعلوم القرآن – كلية أصول الدين والدعوة – أسيوط
_____________________________________
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف