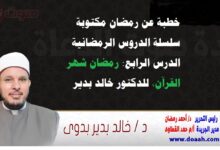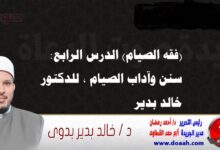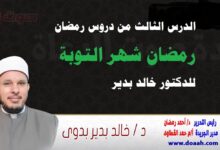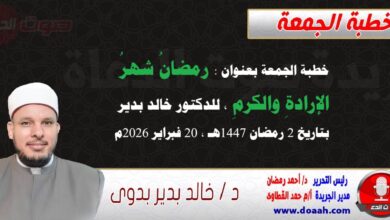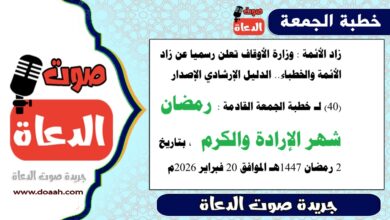خطبة الجمعة القادمة 22 أغسطس : إنَّ من الشجر شجرةً لا يَسقطُ ورقُها ، للدكتور محروس حفظي
إنَّ من الشجر شجرةً لا يَسقطُ ورقُها، بتاريخ 28 صفر 1447 هـ ، الموافق 22 أغسطس 2025م
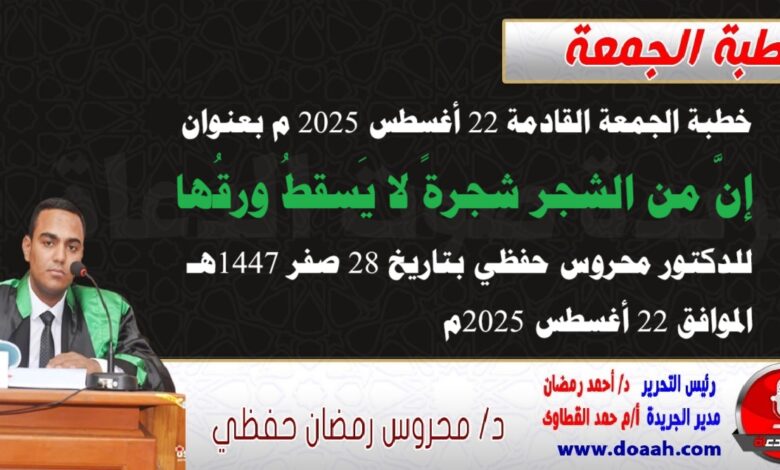
خطبة الجمعة القادمة
خطبة الجمعة القادمة 22 أغسطس 2025 م بعنوان : إنَّ من الشجر شجرةً لا يَسقطُ ورقُها ، للدكتور محروس حفظي بتاريخ 28 صفر 1447هـ ، الموافق 22 أغسطس 2025م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 22 أغسطس 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : إنَّ من الشجر شجرةً لا يَسقطُ ورقُها.
ولتحميل خطبة الجمعة القادمة 22 أغسطس 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : إنَّ من الشجر شجرةً لا يَسقطُ ورقُها، بصيغة word أضغط هنا.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 22 أغسطس 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : إنَّ من الشجر شجرةً لا يَسقطُ ورقُها، بصيغة pdf أضغط هنا.
___________________________________________________________
عناصر خطبة الجمعة القادمة 22 أغسطس 2025م بعنوان : إنَّ من الشجر شجرةً لا يَسقطُ ورقُها ، للدكتور محروس حفظي :
(1) التفكيرُ فريضةٌ وعبادةٌ دينيةٌ.
(2) ذَمُّ التقليدِ الأعمَى، ورفضُ التبعيةِ الفكريةِ المبنيةِ على الظنونِ والأوهامِ.
(3) مجالاتُ التفكيرِ في الإسلامِ.
(4) النبيُّ ﷺ يرغبُ في التفكيرِ والنقدِ.
(5) التفكرُ عندَ الصحابةِ والتابعينَ.
(6) أساليبُ تنميةِ “التفكيرِ النقدِي”.
(7) ضوابطُ التفكيرِ النقدِي.
(8) ضرورةُ الحفاظِ على النفسِ الإنسانيةِ.
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 22 أغسطس 2025م بعنوان: إنَّ من الشجر شجرةً لا يَسقطُ ورقُها ، للدكتور محروس حفظي : كما يلي:
إنَّ مِن الشجرِ شجرةً لا يسقطُ ورقُهَا
بتاريخ 28 صفر 1447هـ = الموافق 22 أغسطس 2025 م
الحمدُ للهِ حمداً يُوافِي نعمَهُ، ويُكافىءُ مزيدَهُ، لكَ الحمدُ كما ينبغِي لجلالِ وجهِكَ، ولعظيمِ سلطانِكَ، والصلاةُ والسلامُ الأتمانِ الأكملانِ على سيدِنَا مُحمدٍ ﷺ، أمَّا بعدُ ،،،
(1) التفكيرُ فريضةٌ وعبادةٌ دينيةٌ: لفظُ: «العقلِ» لمْ يأتِ في القرآنِ الكريمِ جامِداً، إنَّمَا جاءت اشتقاقاتُهُ المختلفةُ؛ وذلك للدلالةِ أنَّ على المطلوبِ هو قيامُ هذا العقلِ بوظائفِهِ المتعددةِ، فوردَ بالصيغةِ الفعليةِ في تِسْعٍ وأربعينَ آيةً، ولفظُ «النظرِ» في مائةٍ وتسعٍ وعشرينَ آيةً، و«التفكيرُ» في مائةٍ وثمانٍ وأربعينَ آيةً، و«التدبرُ» في أربعِ آياتٍ، و«التفكرُ» في ستِّ عشرةَ آيةً، و«الاعتبارُ» في سبعِ آياتٍ، و«التفقهُ» في عشرينَ آيةً، و«التذكرُ» في مائتينِ وتسعٍ وستينَ آيةً.
– القرآنُ الكريمُ ذمَّ ووبّخَ مَنْ ألغَى عقلَهُ، ويرفضُ طريقتَيِ التفكيرِ “السطحِي والسلبِي” فقالَ سبحانَهُ: {وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ* قُلِ انْظُرُوا ماذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ} [يونس: 101: 102]، وقالَ: {وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} [يوسف: 105].
بل حطَّ القرآنُ الكريمُ مِن شأنِ مَن لا يستخدمُ عقلَهُ وتفكيرَهُ بأنْ جعلَهُ أدنَى درجةً مِن الحيوانِ، {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ} [الأنفال: 22].
– ولعلكَ تستنتجُ مِن قصةِ إبراهيمَ- عليهِ السلامُ- ونظرِهِ في ملكوتِ السمواتِ والأرضِ، وحوارِهِ مع قومِهِ حولَ عبادةِ الأصنامِ الدعوةَ إلى عدمِ تغييبِ العقلِ والنظرِ، وإعمالِ الفكرِ في الأمورِ، ولذا قادَهُ تفكيرُهُ السليمُ إلى الإذعانِ بالحقيقةِ المطلقةِ: {يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[الأنعام: 78: 79].
– وكثيراً ما يذييلُ أو يختمُ اللهُ الآيةَ القرآنيةَ بقولِهِ تعالَى:﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾، ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾؛ ليحفزَ العقلَ البشريَّ على ممارسةِ التفكيرِ بجميعِ أنواعِهِ فيمَا يُتلَى عليهِ مِن أحكامٍ، وكذَا كثُرَ مجيءُ الاستفهامِ التوبيخِي والتقريعِي إنكاراً على مَن ألغَى عقلَهُ وفكرَهُ، وأمرَ الإنسانَ بالسيرِ في الأرضِ، والبحثِ فيهَا لأخذِ العظةِ والعبرةِ مِن الأممِ السابقةِ حتى لا يصيرُ العقلُ متبلداً يسلمُ بمَا يسمعُهُ فقط، {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ} [الروم: 42].
– وحثت السنةُ المطهرةُ على “التفكرِ والاعتبارِ”، فعن عَائِشَةَ قَالَ ابْنُ عُمَيْرٍ: «أَخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي» قُلْتُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ قُرْبَكَ، وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الْأَرْضَ، فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ؟، قَالَ:«أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا، لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ، وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ}». [صحيح ابن حبان].
– الأستاذُ الكبيرُ/ عباس العَقَّاد أطلقَ على أحدِ مؤلفاتِه عنوان: «التفكيرُ فريضةٌ إسلاميةٌ»، وقد صدَّرَ “مقدمتَهُ” بقولِه: “مِن مزايَا القرآنِ الكثيرةِ، مزيةٌ واضحةٌ يقلُّ فيهَا الخلافُ بينَ المسلمينَ وغيرِ المسلمين؛ لأنَّهَا تثبتُ مِن تلاوةِ الآياتِ ثبوتاً تؤيدُهُ أرقامُ الحسابِ، ودلالاتُ اللفظِ اليسيرِ، قبلَ الرجوعِ في تأييدِهَا إلى المناقشاتِ والمذاهبِ التي تختلفُ فيهَا الآراءُ..، وتلك المزيةُ هي: “التنويهُ بالعقلِ، والتعويلُ عليهِ في أمرِ العقيدةِ، وأمرِ التبعةِ والتكليفِ”…” أ.ه.
وكلَّلَ كتابَهُ بخاتمةٍ جاءَ فيهَا: “كتبنَا هذه الفصولَ عسى أنْ يكونَ فيهَا جوابٌ هادٍ لأناسٍ مِن الناشئينَ يتساءلون: هل يتفقُ الفكرُ والدينُ؟ .. وهل يستطيعُ الإنسانُ العصريُّ أنْ يقيمَ عقيدتَهُ الإسلاميةَ على أساسٍ مِن التفكيرِ؟ ونرجُو أنْ تكونَ هذه الفصولُ تعزيزاً للجوابِ بكلمةِ “نعم” على كلٍّ مِن هذينِ السؤالين: نعم يتفقُ الفكرُ والدينُ، ونعم يدينُ المفكرُ بالإسلامِ وله سندٌ مِن الفكرِ، وسندٌ مِن الأديانِ” أ.ه. [التفكير فريضة إسلامية].
– والفيلسوفُ «ابنُ رُشدٍ» اعتبرَ التفكير، أو ما أطلقَ عليهِ «النظرَ العقليَّ» في الموجوداتِ واجباً شرعياً حيثُ يساهمُ في إعدادِ المسلمِ للتعاملِ مع ظروفِ الحياةِ، واستغلالِ طاقاتِ المجتمعِ مِمَّا يحدثُ تنميةً شاملةً ماديةً كانت أم معنويةً.
(2) ذَمُّ التقليدِ الأعمَى، ورفضُ التبعيةِ الفكريةِ المبنيةِ على الظنونِ والأوهامِ: لقد دعَى القرآنُ الكريمُ إلى إعمالِ العقلِ، {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [الأعراف: 179].
وحذَّرَنَا رسولُنَا ﷺ مِن التَّقليدِ الأعمَى، فعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا» (رواه الترمذي وحسنه)، فهو لمْ يرتضِ للمسلمينَ أنْ يكونُوا مُقلِّدينَ يسيرونَ وراءَ كلِّ ناعقٍ، فيصبحُوا كالرِّيشةِ في مهبِّ الرِّياحِ تميلُهَا حيثُ شاءتْ، بل عليهم أنْ يُحكِّمُوا عقولَهُم حتى يصبحَ لهَم سبقٌ إيجابيٌّ في حركةِ الحياةِ، حيث ذهبت بعضُ الدراساتِ إلى أنَّ العقلَ البشريَّ لم يُستَثمَرْ منهُ حتى الآن إلَّا نحو15% ، مِمّا يدفعُ المسلمَ لاكتشافِ كلِّ جديدٍ في شتَّى المجالاتِ.
وفي سبيلِ “إقادةِ الفكرِ، وإعمالِ العقلِ”، جاءَ التحذيرُ مِن ملىءِ البطنِ بالطعامِ حتى لا يعوقَ الذهنَ عن التفكيرِ الصحيحِ، فعن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِب الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثُ طَعَامٍ، وَثُلُثُ شَرَابٍ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ» [رواه أحمد].
قال الإمامُ المناويُّ: (وإنَّمَا كان ملءُ البطنِ شرًا؛ لِمَا فيهِ مِن المفاسدِ الظاهرةِ، دينيةٍ، ودنيويةٍ، فالشبعُ يورثُ البلاءَ، ويعوقُ الذهنَ عن التفكيرِ الصحيحِ، وهو أيضًا مداعاةُ الكسلِ، والنومِ، فمَن أكلَ كثيرًا، نامَ كثيرًا، ومَن نامَ كثيرًا، ضيّعَ وقتَهُ، وقتلَهُ، وهو رأسُ مالِهِ في الحياةِ العمليةِ، فيخسرُ كثيرًا مِن مصالحِهِ الدينيةِ، والدنيويةِ، ومِن وصايا لقمانَ لابنِهِ: “يا بُنَيَّ! إذا امتلأتْ المعدةُ، نامتْ الفكرةُ، وخرستْ الحكمةُ، وقعدتْ الأعضاءُ عن العبادةِ”، هذا حالُ الشبعِ، وأمَّا حالُ الإقلالِ مِن الطعامِ والشرابِ: فالقلبُ يصفُو، والقريحةُ تنتقدُ، والبصيرةُ تنفذُ، والشهوةُ مغلوبةٌ، والنفسُ مقهورةٌ على أمرِهَا) أ.ه. (الإتحافات السنية).
(3) مجالاتُ التفكيرِ في الإسلامِ: حثّ القرآنُ الكريمُ على استنفارِ العقلِ البرهانِي؛ للبحثِ عن حجتهِ مِن غيرِ التفاتٍ إلى الأمانِي والظُنُونِ الباطلةِ، ولم يقبلْ إلَّا الدليلَ الناصعَ الذي لا يقبلُ الشكَّ أو الترددَ خاصةً في القضايا العقديةِ، {أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} [النمل: 64]، {وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} [القصص: 75].
– وقد شملَ التفكيرُ مجالاتٍ متعددةً منهَا: “السننُ الاجتماعيةُ” التي تتعلقُ بتاريخِ الأممِ السالفةِ، والنظرِ في عواقبِهَا، وما طرأَ عليهَا مِن تغييرٍ {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} [آل عمران: 137].
وهذه السننُ قوانينُ ثابتةٌ لا تختلفُ ولا تتبدلُ، مِمَّا يبعثُ في النفسِ الالتزامَ بالخيرِ، والبعدَ عن الشرِّ، فيُحفظُ المجتمعُ مِن الانحلالِ والغرورِ، {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الأنفال: 53]، {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11].
– كما شملَ التفكيرُ “الآياتِ الكونيةَ في العوالمِ العلويةِ والسفليةِ”: {إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ* فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأنعام: 95: 97].
– “وشملَ أيضاً “الآياتِ في النفسِ، والخلقِ والنشأةِ”: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} [الذاريات: 21]، {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ} [الطارق: 5].
قالَ الإمامُ الغزالِيُّ: (فمِن آياتِهِ: “الْإِنْسَانُ الْمَخْلُوقُ مِنَ النُّطْفَةِ”، وَأَقْرَبُ شَيْءٍ إِلَيْكَ نَفْسُكَ، وَفِيكَ مِنَ الْعَجَائِبِ الدَّالَّةِ عَلَى عَظَمَةِ اللَّهِ مَا تَنْقَضِي الْأَعْمَارُ فِي الْوُقُوفِ على عشر عشيره، وأنت غافل عنه، فيامن هُوَ غَافِلٌ عَنْ نَفْسِهِ، وَجَاهِلٌ بِهَا كَيْفَ تَطْمَعُ فِي مَعْرِفَةِ غَيْرِكَ، وَقَدْ أَمَرَكَ اللَّهُ بِالتَّدَبُّرِ فِي نَفْسِكَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ، وذكر أنك مَخْلُوقٌ مِنْ نُطْفَةٍ قَذِرَةٍ …، فَارْجِعِ الْآنَ إِلَى النُّطْفَةِ، وَتَأَمَّلْ حَالَهَا أَوَّلًا وَمَا صَارَتْ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَتَأَمَّلْ أَنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ عَلَى أَنْ يَخْلُقُوا لِلنُّطْفَةِ سَمْعًا أَوْ بَصَرًا أَوْ عَقْلًا أَوْ قُدْرَةً أَوْ عِلْمًا أَوْ رُوحًا أَوْ يَخْلُقُوا فِيهَا عَظْمًا أَوْ عِرْقًا أَوْ عَصَبًا أَوْ جِلْدًا أَوْ شَعْرًا، هَلْ يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ؟! بَلْ لَوْ أَرَادُوا أَنْ يَعْرِفُوا كُنْهَ حَقِيقَتِهِ، وَكَيْفِيَّةَ خِلْقَتِهِ بَعْدَ أَنْ خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ لَعَجَزُوا عَنْهُ) [إحياء علوم الدين].
ومِن ضوابطِ التفكيرِ: إشغالُ العقلِ بالأفكارِ الشريفةِ التي تحققُ النفعَ في الآجلِ والعاجلِ، ويكونُ لهَا أثرُهُا في الارتقاءِ بالمجتمعاتِ، فهذا العصرُ لا مجالَ فيهِ للخاملينَ والعاجزينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ» (رواه مسلم).
أمَّا الأفكارُ الردئيةُ الباليةُ، فهي أساسُ الانحطاطِ والتخلفِ عن ركبِ الحضارةِ، ولذَا نهَى الإسلامُ عن التفكرِ أو السؤالِ فيمَا لا يعودُ بالخيرِ على الإنسانِ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْها وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ} [المائدة: 101: 102].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ..، نَظَرْتُ أَسْفَلَ مِنِّي فَإِذَا أَنَا بِرَهْجٍ وَدُخَانٍ وَأَصْوَاتٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يُحَرِّفُونَ عَلَى أَعْيُنِ بَنِي آدَمَ، أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَوْا الْعَجَائِبَ” (رواه أحمد في “المسند”).
(4) النبيُّ ﷺ يرغِّبُ في التفكيرِ والنقدِ: كما يشملُ أيضاً “العلومَ الشرعيةَ”: لتخرجَ عن نمطِ الحفظِ والتلقينِ إلى أفقِ التدبرِ، والخوصِ في أسرارِ ومقاصدِ الشريعةِ بمَا يخدمُ الأفرادَ والمجتمعاتِ، {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]، {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: 24]؛ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه].
– وقد أقرَّ ﷺ البابَ الأوسعَ والدعوةَ الصريحةَ للاستنباطِ وإعمالِ العقلِ واجتهادِ الرأيِ في حديثِ معاذٍ: «لمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ» [رواه أبو داود].
– كمَا وجَّهَ الرسولُ ﷺ أصحابَهُ، وشجعَهُم على التفكيرِ والاستدلالِ العقلِي فيمَا يُستجدُ مِن مشكلاتِ الحياةِ مِمَّا لم يردْ فيهِ حكمٌ في القرآنِ والسنةِ، وأوصَي الحكامَ بالاجتهادِ بالرأيِ، ورغبَهُم في ذلكَ بالثوابِ في الآخرةِ، فعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» [متفق عليه].
– بل أطلقَ ﷺ للإنسانِ العنانَ؛ ليفكرَ في كلِّ شيءٍ إلّا الغيبياتِ التي لا يستطيعُ إدراكَهَا؛ لقصورِ عقلِهِ، وأمرَهُ بتفويضِ العلمِ فيهَا للهِ وحدَهُ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللَّهِ، وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ»، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: «تَفَكَّرُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ». (رواه الطبراني في “المعجم الأوسط”، والبيهقي في “الأسماء والصفات”)، وقال ابنُ حجرٍ: «مَوْقُوفٌ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ» . (فتح الباري 13/ 383).
(5) التفكرُ عندَ الصحابةِ والتابعينَ:
– عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: “تَفَكُّرُ لَحْظَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ”. (التبصرة لابن الجوزي).
– عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قِيلَ لِأُمِّ الدَّرْدَاءِ: “مَا كَانَ أَفْضَلُ أَعْمَالِ أَبِي الدَّرْدَاءِ؟ قَالَتْ: “التَّفَكُّرُ” (شعب الإيمان).
– قَالَ وَهْبُ بْنُ منبه: “ما طالت فكرةُ امرىءٍ قَطُّ إِلّا عَلِمَ، وَلا عَلِمَ إِلا عَمِلَ”. (إحياء علوم الدين).
– قال الحسنُ البصريُّ: “الْفِكْرُ مِرْآةٌ تُريك حَسَنَاتِكَ وَسَيِّئَاتِكَ، مَنْ لَمْ يَكُنْ كَلامُهُ حِكْمَةً فَهُوَ لَغْوٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ سُكُوتُهُ تَفَكُّرًا فَهُوَ سَهْوٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ نَظَرُهُ اعْتِبَارًا فَهُوَ لَهْوٌ”.
(6) أساليبُ تنميةِ “التفكيرِ النقدِي”: للتفكيرِ النقدِي دورٌ مهمٌ خاصةً في ظلِّ الانفجارِ المعرفِي، والتطورِ التقنِي السريعِ، ولهُ آثارٌ إيجابيةٌ منهَا: الردُّ على الأفكارِ المنحرفةِ، والتمييزُ بينَ الحقائقِ والأكاذيبِ، واتخاذُ القراراتِ الصائبةِ مِمَّا يسهمُ في حلِّ المشكلاتِ وإيجادِ حلولٍ مبتكرةٍ؛ لمعالجةِ التحدياتِ العالميةِ كالبيئةِ والإلحادِ .. إلخ، ويعززُ القدرةَ على التواصلِ مع الآخرين، وفهمِ وجهاتِ نظرِهِم المختلفةِ، مِمَّا يخلقُ بناءَ مجتمعٍ قويٍّ، يقومُ على المعرفةِ، ومِن وسائلِ تنميتِهِ:
أولاً: حفظُ القرآنِ الكريمِ بمَا فيهِ مِن شواهدَ واستدلالاتٍ، محفزاً للعقلِ، وعاملاً رئيساً مِن عواملَ تنميةِ مهاراتِ “التفكيرِ النقدِي” حسبمَا دلتْ عليهِ الدراساتُ العلميةُ المعاصرةُ، والوسائلُ التجريبيةُ الحديثةُ، لذا يجبُ ربطُ النشءِ بالقرآنِ الكريمِ، والحرصُ على تحفيظِهِم إيَّاهُ بتدبرٍ وتفكرٍ، وفهمٍ لمعانيهِ، وضرورةُ عدمِ الاكتفاءِ بمجردِ إتقانِهِم لتلاوتِهِ وحفظِهِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ – أي: رديء التمر-، وَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ؟ «إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ» (رواه أحمد).
ثانياً: أسلوبُ “الحوارِ والمناقشةِ” أداءةٌ لتنميةِ التفكيرِ النقدِي: استخدمَ القرآنُ الكريمُ أسلوبَ الحِوارِ والنِّقاشِ كأداةٍ مِن أدواتِ “التفكيرِ النقدِي”، سواءٌ كان هذا الحوارُ بينَ اللهِ وملائكتِهِ، أو بينَ رُسلِهِ وأنبيائِهِ، أو بينَ الرُّسلِ وأقوامِهِم، أو بينَ المؤمنينَ والكافرينَ والمُنافقينَ، أو بينَ الآباءِ والأبناءِ أو العكس، أو بينَ أصحابِ الجَنَّةِ والنَّارِ.
الحوارُ والمناقشةُ يساعدانِ على وضوحِ التفكيرِ وسلامتِهِ، والتخلصِ مِن العوائقِ التي تحولُ دونَ الوصولِ إلى الحقيقةِ حيثُ تتضحُ جوانبُ المشكلةٍ، وتتحددُ معالمُهَا، ولذا كانَ النبيُّ ﷺ يناقشُ أصحابَهُ، ويستشيرُهُم، ففي معركةِ بدرٍ اطمأنَّ إلى موافقةِ الأنصارِ على القتالِ، كما استشارَهُم حولَ موقعِ المعركةِ وفي أمرِ الأسرَى، وتشاورَ مع أصحابِهِ أيضاً في غزوةِ الخندقِ، وقَبِلَ رأيَ سلمانَ الفارسِي بحفرِ الخندقِ حولَ المدينةِ.
ثالثاً: «أسلوبُ التعلمِ بالاسْتكشافِ» أو «العَصفِ الذهنِي»: يعتمدُ على إثارةِ ذهنِ السامعِ وعدمِ تلقينِهِ للمعلومةِ الجاهزةِ، بل يتركُهُ فترةً يفكرُ ويراجعُ مخزونَهُ الفكرِي؛ لتتهيأَ نفسُهُ للإصغاءِ لِمَا يقولُهُ لهُم بعدَ ذلَك، فهو أسلوبٌ تعليميٌّ يُستخدَمُ مِن أجلِ توليدِ أكبرِ عددٍ مِن الأفكارِ للمشاركينَ في حلِّ مش.كلةٍ مفتوحةٍ خلالَ فترةٍ زمنيةٍ محددةٍ، في جوٍّ تسودُهُ الحريةُ والأمانُ في طرحِ الأفكارِ بعيداً عن المصادرةِ، فعَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَنِ السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ، وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ، وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ» (رواه أحمد).
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ المُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ» فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ» (متفق عليه).
قال الإمامُ النوويُّ: (وفي هذا الحديثِ فوائدُ منهَا: استحبابُ إلقاءِ العالمِ المسألةَ على أصحابِهِ؛ ليختبرَ أفهامَهُم، ويرغبَهُم في الفكرِ والاعتناءِ، وفيهِ ضربُ الأمثالِ والأشباهِ) أ.ه. (شرح النووي على مسلم).
قال أ.د/ موسى شاهين لاشين: (أرقى أساليبِ التربيةِ تحصرُ طرقِ التدريسِ في طريقتينِ: الطريقةُ الإلقائيةُ، والطريقةُ الاستنباطيةُ، وقد استعملهُمَا ﷺ في التدريسِ لأمتِهِ، فاستعملَ الطريقةَ الإلقائيةَ في خطبةِ الجمعةِ والعيدينِ والاستسقاءِ وفي الحجِّ وفي المناسباتِ، واستعملَ طريقةَ الاستنباطِ والسؤالِ والجوابِ في دروسِ العلمِ، وكان تارةً يقولُ: “اسألونِي”، ويجيبُ على أسئلتِهِم، وتارةً يسألُ، وينتظرُ جوابَهُم؛ ليثيرَ فيهِم حبَّ البحثِ، والفهمِ كمَا في هذا الحديثِ، وتارةً يسألُ ولا ينتظرُ الجوابَ بل يجيبُ هو، وفائدةُ سؤالِهِ في هذه الحالةِ؛ إثارةَ انتباهِهِم للجوابِ؛ ليتمكنَ في نفوسِهِم.
ثم إنَّهُ ﷺ كثيراً ما يشبّهُ المعقولَ بالمحسوسِ، مستخدماً وسائلَ الإيضاحِ الميسورةِ في البيئةِ، وأكثرُ ما يشدُّ انتباههُم، ويعمقُ استفادتهُم، واستيعابهُم، فيمثلُ المؤمنَ في أنّهُ خيرٌ لمجتمعِهِ ولنفسِهِ مِن وجوهٍ كثيرةٍ بالنخلةِ، ويقلبُ التشبيهَ المقصودَ، فيشبّهُ النخلةَ بالمؤمنِ؛ ليجعلَ المؤمنَ أصلاً وأقوىَ في وجهِ الشبهِ) أ.ه. (فتح المنعم شرح صحيح مسلم).
رابعاً: تنميةُ القدرةِ على التخيلِ ” وهو التفكيرُ خارج الصندوقِ”: مِن أقوى الأساليبِ التي استعملتْ في تنميةِ التفكيرِ، أنْ يرَى الإنسانُ بعينِ الخيالِ مشاهدَ حيةً ذاتَ أبعادٍ مختلفةٍ، فيتولدُ عندَهُ إحساسٌ ذاتِيٌّ، فتترجمُ المشاهدُ إلى معانٍ وأفكارٍ، فيشعرُ بالتجاوبِ، فيُنمِّي الفكرَ، ويُوقِدُ القريحةَ، وينمِّي الذوقَ الأدبِيَّ لديهِ.
وقد صورَ القرآنُ أشياءَ كأنَّها مُشاهدةٌ محسوسةٌ، وواقعةٌ ملموسةٌ، وأطلقَ العنانَ فيهَا للخيالِ، {ذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ *إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ * إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ * طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ} [الصافات: 62: 65].
العربُ كانوا لا يعرفونَ رؤوسَ الشياطينِ، وإنَّما شبَّههَا بهَا؛ “لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ أَنَّ الشَّيَاطِينَ قَبِيحَةُ الْمَنْظَر، كَأَنَّهُ قِيلَ: إِنَّ أقبحَ الأشياءِ في الوهمِ والخيالِ هو رؤوسُ الشَّيَاطِينِ، فَهَذِهِ الشَّجَرَةُ تُشْبِهُهَا فِي قُبْحِ النَّظَرِ، وَتَشْوِيهِ الصُّورَةِ، وَالَّذِي يُؤَكِّدُ هَذَا أَنَّ الْعُقَلَاءَ إِذَا رَأَوْا شَيْئًا شَدِيدَ الِاضْطِرَابِ، مُنْكَرَ الصُّورَةِ، قَبِيحَ الْخِلْقَةِ، قَالُوا إِنَّهُ شَيْطَانٌ، وَإِذَا رَأَوْا شَيْئًا حَسَنَ الصُّورَةِ وَالسِّيرَةِ، قَالُوا إِنَّهُ مَلَكٌ”. (مفاتيح الغيب = التفسير الكبير؛ للفخر الرازي).
خامساً: النبيُّ ﷺ يضربُ مثالاً عملياً للتدريبِ على استخدامِ “مهارةِ الاستنباطِ” كإحدَى أدواتِ “التفكيرِ النقدِي”، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَنَّى ذَلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ» (متفق عليه).
سادساً: أسلوبُ “لفتِ الأنظارِ إلى ما ألفَهُ الناسُ واعتادُوا عليهِ”: الألفةُ غشاوةٌ تحجبُ عن الإنسانِ ما يبعثُ على التفكيرِ والتأملِ، {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الصافات: 138]، {أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ} [الغاشية: 17: 20].
(7) ضوابطُ التفكيرِ النقدِي: وضعَ الشارعُ الحكيمُ عدةَ ضوابطَ للتفكيرِ النقدِي، منهَا:
أولاً: أنْ يكونَ الهدفُ المنشودُ هو الوصولُ إلى الحقيقةِ المجردةِ، وعدمِ الاستسلامِ للسائدِ والمألوفِ: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [سبأ: 24]، وقد عابَ القرآنُ على المشركينَ كيفَ قادَهُم تفكيرُهُم دونَ الحقيقةِ، وعدمِ قدرتِهِم على تقليبِ الأفكارِ، ووزنِ الأمورِ بعقولِهِم، فقالَ تعالَى: {إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* ثُمَّ نَظَرَ* ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ * إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ} [المدثر: 19]؛ ولذلك تقولُ الحكمةُ: “كُن كالماءِ، ولا تستسلمْ سريعاً..عاجلاً أو آجلاً سيجدُ الشقوقَ، وينفذُ منهَا”.
ثانياً: الابتعادُ عن المؤثراتِ السلبيةِ، وموجهاتِ التفكيرِ: أمرَ اللهُ نبيَّهُ ﷺ أنْ يوجّهَ مشركِي مكةَ أنْ يجنبُوا تفكيرَهُم في أمرِ الدعوةِ عن عصبيتِهِم وأهوائِهِم، والمؤثراتِ السائدةِ، والعاداتِ المتوارثةِ {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} [سبأ: 46].
وقد حذّرَ القرآنُ مِن مغبةِ “اتباعِ الهوَى والعصبيةِ” كأحدِ العواملِ التي تجرفُ بالتفكيرِ إلى ما لا يحمدُ عواقبُهُ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8].
ولذا وجهت السنةُ النبويةُ إلى ضرورةِ تحرِّي “الموضوعيةِ”؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ» (متفق عليه).
(8) ضرورةُ الحفاظِ على النفسِ الإنسانيةِ: خلقَ اللهُ الإنسانَ بيدِهِ، ونفخَ فيهِ مِن روحهِ، وأسجدَ لهُ ملائكتَهُ، وأرسلَ لهُ الرسلَ والأنبياءَ، ووضعَ لهّ دستوراً يضمنُ لهُ السعادةَ والراحةَ، وعمارةَ الأرضِ {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ} [البقرة: 30]، ولذا جعلَ الإسلامَ الحفاظَ على النفسِ إحدَى “المقاصدِ الكليةِ الخمس”، وهي: “حفظُ الدينِ، والنفسِ، والنسلِ، والعقلِ، والمالِ” فلا يحقُّ لأحدٍ كائناً مَن كانَ أنْ يزهقَ روحَهُ التي وهبَهَا مِن اللهِ بأيِّ وسيلةٍ كانت كالانتحارِ، فهي بمثابةِ الوديعةِ أو العاريةِ، ليس لصاحبِهَا إلا حراستهَا حتى تُستَوفَى منهُ، قالَ تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، وعن عَلِيٍّ بْن شَيْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ– يعني حائط-، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ» (أبو داود).
لذا مَن ينتحرُ أو يزهقُ روحَهُ، يظنُّ أنّهُ بفعلتهِ الشنعاء أنّهُ سيستريحُ مِن عناءِ الحياةِ، ونصبِهَا وصخبِهَا، ألَا يعلمُ أنّهُ – إنْ لم تدركْهُ رحمةُ اللهِ- قد ينتقلُ إلى عذابٍ أنكَى مِمّا هو كان فيهِ في دارَ الفناءِ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا» (متفق عليه).
مع العلمِ أنَّ قاتلَ نفسَهُ ليسَ بكافرٍ عندَ أهلِ السنةِ والجماعةِ، قال ابنُ حبانٍ: «هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَعْنَاهَا: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، يُرِيدُ جَنَّةً دُونَ جَنَّةِ، الْقَصْدِ مِنْهُ، الْجَنَّةُ الَّتِي هِيَ أَعْلَى وَأَرْفَعُ، يُرِيدُ مَنْ فَعَلَ هَذِهِ الْخِصَالَ، أَوِ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، أَوْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الَّتِي هِيَ أَرْفَعُ الَّتِي يَدْخُلُهَا مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ تِلْكَ الْخِصَالَ؛ لِأَنَّ الدَّرَجَاتِ فِي الْجِنَانِ يَنَالُهَا الْمَرْءُ بِالطَّاعَاتِ، وَحَطُّهُ عَنْهَا يَكُونُ بِالْمَعَاصِي، الَّتِي ارْتَكَبَهَا» (صحيح ابن حبان).
وفي سبيلِ الحفاظِ على النفسِ الإنسانيةِ، نهَى الشارعُ الحكيمُ عن تمنِي الموت: عندَ نزولِ البلاءِ بهِم، وهذا مِن بابِ الترقِّي في النهيِ؛ لأنَّ “النهيَ عن الأدنَى فيهِ دلالةٌ على شناعةِ الجريمةِ العُليا ألَا وهي “إزهاقُ النفسِ” بأيِّ صورةٍ، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي” (متفق عليه).
ليس كلّمَا ألمتْ بالإنسانِ مصيبةٌ يهرعُ إلى إزهاقِ روحِه، فالدنيا دارُ امتحانٍ وابتلاءٍ، فقد أوذِيَ الأنبياءُ والصالحونَ، ونزلتْ بهِم حوادثُ يشيبُ لهَا الولدانُ ومع ذلكَ صبرُوا، ولم تخر عزائمُهُم، فلنقارنْ حالَنَا بحالِهِم، فأيُّهَا المبتلَى لتصبرْ، ولتحتسبْ، فعن أبي بَكْرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123]، فَكُلَّ سُوءٍ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَمْرَضُ؟ أَلَسْتَ تَنْصَبُ؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ» (رواه أحمد).
نسألُ اللهَ أنْ يرزقنَا حسنَ العملِ، وفضلَ القبولِ، إّنُه أكرمُ مسؤولٍ، وأعظمُ مأمولٍ، وأنْ يجعلَ بلدَنَا مِصْرَ سخاءً رخاءً، أمناً أماناً، سلماً سلاماً وسائرَ بلادِ العالمين، ووفقْ ولاةَ أُمورِنَا لِمَا فيهِ نفعُ البلادِ والعبادِ.
كتبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان د / محروس رمضان حفظي عبد العال
مدرس التفسير وعلوم القرآن – كلية أصول الدين والدعوة – أسيوط
_____________________________________
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف