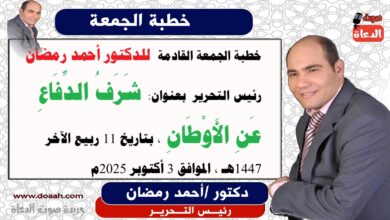خطبة الجمعة بعنوان : فِقْهُ الحَيَاةِ ، للدكتور أحمد رمضان – 10 أكتوبر
فِقْهُ الحَيَاةِ ، إعداد: رئيس التحرير الدكتور أحمد رمضان لـ صوت الدعاة ، بتاريخ 18 ربيع الثاني 1447هـ ، الموافق 10 أكتوبر 2025م
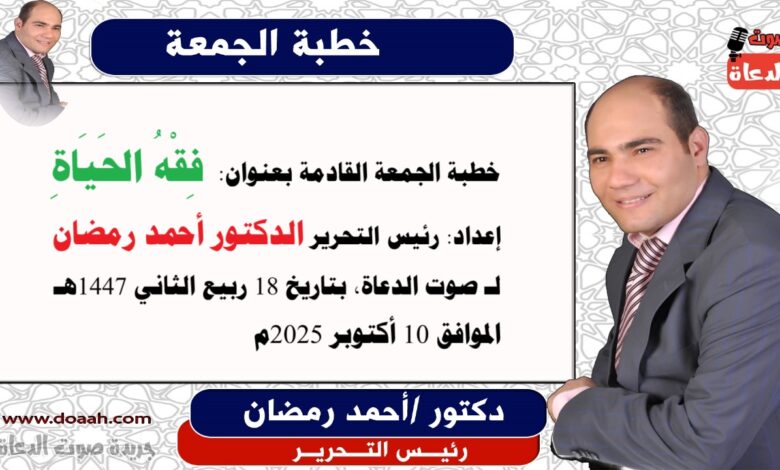
خطبة الجمعة القادمة بعنوان : فِقْهُ الحَيَاةِ ، إعداد: رئيس التحرير الدكتور أحمد رمضان لـ صوت الدعاة ، بتاريخ 18 ربيع الثاني 1447هـ ، الموافق 10 أكتوبر 2025م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 10 أكتوبر 2025م بصيغة word بعنوان : فِقْهُ الحَيَاةِ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان لـ صوت الدعاة.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 10 أكتوبر 2025م بصيغة pdf بعنوان : فِقْهُ الحَيَاةِ ، للدكتور أحمد رمضان.
عناصر خطبة الجمعة القادمة 10 أكتوبر 2025م بعنوان : فِقْهُ الحَيَاةِ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان.
العنصر الأول: الإسلام دينُ حياةٍ وصناعةٌ للحياة
العُنْصُرُ الثَّانِي: الحِفَاظُ عَلَى الحَيَاةِ مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ
العُنْصُرُ الثَّالِثُ: فِقْهُ الحَيَاةِ بَيْنَ العِبَادَةِ وَالعَمَلِ
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 10 أكتوبر 2025م : فِقْهُ الحَيَاةِ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان : كما يلي:
فِقْهُ الحَيَاةِ
18 ربيع الثاني 1447هـ – 10 أكتوبر 2025م
إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
المـــوضــــــــــوع
الحمدُ للهِ الحيِّ القيُّومِ، خالقِ الحياةِ والموتِ، ومُصرِّفِ الأقدارِ والأزمانِ، الذي أرسلَ رسولَه بالهدى ودينِ الحقِّ؛ ليُقيمَ بهِ معالمَ الحياةِ، ويُنيرَ بهِ دروبَ البشريةِ، ويهديها إلى صراطٍ مستقيمٍ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، شهادةً تُحيي القلوبَ بالإيمانِ. وأشهدُ أنَّ سيِّدَنا محمّدًا عبدُه ورسولُه، أرسله اللهُ رحمةً للعالمينَ، وحُجَّةً على الخلقِ أجمعينَ، صلواتُ ربي وسلامُه عليه وعلى آلهِ وصحبِه أجمعينَ. أمّا بعدُ:
عناصر الخطبة:
العنصر الأول: الإسلام دينُ حياةٍ وصناعةٌ للحياة
العُنْصُرُ الثَّانِي: الحِفَاظُ عَلَى الحَيَاةِ مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ
العُنْصُرُ الثَّالِثُ: فِقْهُ الحَيَاةِ بَيْنَ العِبَادَةِ وَالعَمَلِ
أيّها الأحبّةُ في اللهِ، حديثُنا اليومَ عن موضوعٍ جليلٍ هو أساسُ بقاءِ الأممِ ورُقيِّها، وسِرُّ سعادةِ الإنسانِ وهنائِه، ألا وهو: فِقْهُ الحَيَاةِ.
إنّ الإسلامَ جاءَ ليُحيي القلوبَ بالإيمانِ، ويُقيمَ العقولَ على العلمِ، ويُشيعَ الأمنَ في المجتمعاتِ، ويُعمِّرَ الأرضَ بالعمرانِ. إنّهُ دينٌ يَحفظُ الحياةَ، ويَصنعُ الحياةَ، ويُقدِّسُ الحياةَ.
العُنْصُرُ الأَوَّلُ: الإِسْلَامُ دِينُ حَيَاةٍ وَصِنَاعَةٍ لِلْحَيَاةِ
عبادَ اللهِ: الإسلامُ ليس دينًا انعزاليًّا يُبعِدُ الإنسانَ عن واقعِه، ولا دعوةً إلى الموتِ والفناءِ كما يتوهّمُ البعضُ، بل هو دينُ الحياةِ بكلِّ أبعادِها ومعانيها. جاء ليُحيي القلوبَ بالإيمانِ، ويُحيي العقولَ بالعلمِ، ويُحيي المجتمعاتِ بالعدلِ، ويُحيي الأرضَ بالعمرانِ.
وقد سمّى اللهُ دعوتَه في كتابه العظيم دعوةً إلى الحياةِ، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24].
قال المفسِّرون: «مَا يُصْلِحُ أَحْوَالَكُمْ، وَيَرْفَعُ دَرَجَاتِكُمْ، مِنَ الأَقْوَالِ النَّافِعَةِ، وَالأَعْمَالِ الحَسَنَةِ، الَّتِي بِالتَّمَسُّكِ بِهَا تَحْيَوْنَ حَيَاةً طَيِّبَةً، وَتَظْفُرُونَ بِالسَّعَادَتَيْنِ: الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ» (الوسيط لطنطاوي 96، ص73).
وقال القرطبي: «أَيْ إِلَى مَا يُحْيِيكُمْ، أَيْ يُحْيِي دِينَكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ. وَقِيلَ: أَيْ إِلَى مَا يُحْيِي بِهِ قُلُوبَكُمْ فَتُوَحِّدُوهُ، وَهَذَا إِحْيَاءٌ مُسْتَعَارٌ، لِأَنَّهُ مِنْ مَوْتِ الْكُفْرِ وَالْجَهْلِ» (تفسير القرطبي ج7، ص389).
فالإيمانُ حياةٌ للقلوبِ، والعدلُ حياةٌ للمجتمعِ، والعملُ حياةٌ للأرضِ. ومن هنا جعلَ اللهُ رسالتَنا رسالةَ حياةٍ، لا رسالة موتٍ، ورحمةً للخلق أجمعين. قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107].
قال ابن كثير: «أَيْ: أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لَهُمْ كُلَّهُمْ، فَمَنْ قَبِلَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ وَشَكَرَ هَذِهِ النِّعْمَةَ، سَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ رَدَّهَا وَجَحَدَهَا خَسِرَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» (تفسير ابن كثير، ج5، ص385).
وبيّن الله تعالى الفرق بين حياة الكفر المظلمة وحياة الإيمان المضيئة فقال: ﴿أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: 122].
ويقول الدكتور أحمد رمضان في كتاب الجانتية في ميزان الإسلام: (فالكافرُ يمشي بينَ الناسِ وقلبُهُ ميتٌ، تحوطُهُ ظلماتٌ لا حدَّ لها، ويرتعُ في بحورِ الغفلةِ والجهلِ. هو حيٌّ في صورةٍ، ولكنهُ ميتٌ في الحقيقةِ، كما قالَ تعالى: ﴿ظلماتٌ بعضُها فوقَ بعضٍ إذا أخرجَ يدَهُ لم يكدْ يراها ومنْ لم يجعلِ اللهُ لهُ نورًا فما لهُ منْ نورٍ﴾ [النور: 40].
وأما المؤمنُ فقد أحياهُ اللهُ بعدَ مواتٍ، وأنعمَ عليهِ بنورٍ يمشي بهِ بينَ الناسِ، يرى بنورِ اللهِ ما يعجزُ غيرُهُ عنْ رؤيتِهِ، ويبصرُ مسالكَ الحقِّ فيتبعُها، وطرقَ الباطلِ فيجتنبُها. هو كالمسافرِ في ليلٍ بهيمٍ أُعطيَ مصباحًا ينيرُ طريقَهُ، فسارَ مطمئنًّا إلى مقصدِهِ، لا تضلُّ خطاهُ، ولا تتشتتُ مساعيهِ). راجع/ الجانتية ص 365 – 367.
أيّها الأحبّة: ومن يتأمّل سيرةَ النبي ﷺ يجدها كلَّها صناعةً للحياةِ وبناءً للحضارةِ. فقد بادر في المدينة ـ فور هجرته ـ إلى بناء المسجد، ليكون مركزًا للعبادةِ والعلمِ والشورى. ثم آخى بين المهاجرينَ والأنصارِ ليبني مجتمعًا متماسكًا، ثم وضع «صحيفةَ المدينة» لتكون أولَ دستورٍ مدنيٍّ في الإسلامِ، يضمنُ الحقوقَ ويُعزِّزُ العيشَ المشتركَ. أليست هذه ـ عباد الله ـ أعظمَ الشواهدِ على أن الإسلام دينُ حياةٍ، لا دينُ هدمٍ ولا موتٍ؟ فهذه التعاليم ليست مجرد وصايا أخلاقية، بل هي صناعةُ حياةٍ يسودُها الجمالُ، ويغمرُها الكرمُ، ويُظلِّلُها الإحسانُ.
ومن أجمل القصص في هذا الباب، ما أخرجه مسلم (ح 3005)، حيث حاول الملك قتل الغلام عدة مرات ولم بنجح في ذلك والحديث طويل ” … فَذَهَبُوا به، فَقالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بما شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إلى المَلِكِ، فَقالَ له المَلِكُ: ما فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قالَ: كَفَانِيهِمُ اللَّهُ. فَقالَ لِلْمَلِكِ: إنَّكَ لَسْتَ بقَاتِلِي حتَّى تَفْعَلَ ما آمُرُكَ به، قالَ: وَما هُوَ؟ قالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي علَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِن كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ في كَبِدِ القَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: باسْمِ اللهِ رَبِّ الغُلَامِ، ثُمَّ ارْمِنِي؛ فإنَّكَ إذَا فَعَلْتَ ذلكَ قَتَلْتَنِي، فجَمَع النَّاسَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ علَى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِن كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ في كَبْدِ القَوْسِ، ثُمَّ قالَ: باسْمِ اللهِ، رَبِّ الغُلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ في صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ في صُدْغِهِ في مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ، فَقالَ النَّاسُ: آمَنَّا برَبِّ الغُلَامِ، آمَنَّا برَبِّ الغُلَامِ، آمَنَّا برَبِّ الغُلَامِ...”.
يا اللهُ! غلامٌ صغيرٌ يهبُ حياتَهُ ليصنعَ حياةَ الإيمانِ في قلوبِ الناسِ. لم يكنْ في يدِهِ جيشٌ ولا سلطانٌ، لكنَّهُ امتلكَ الإيمانَ واليقينَ، فصارَ موتُهُ ولادةً لعقيدةٍ، وأصبح استشهادُهُ حياةً لأمةٍ بأكملِها. إنَّ هذا المشهدَ يختصرُ فقهَ الحياةِ: أن تعطيَ روحَكَ ليحيا غيرُكَ بالحقِّ، وأن تتحولَ دماؤُكَ إلى بذورٍ تنبتُ إيمانًا في قلوبِ الملايينَ.
العُنْصُرُ الثَّانِي: الحِفَاظُ عَلَى الحَيَاةِ مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ
أيها الأحبّةُ في الله: إذا كان الإسلامُ دينَ حياةٍ وصناعةٍ لها، فإنّه في الوقتِ نفسِه دينُ حمايةٍ وصيانةٍ لهذه الحياة. بل جعلَ حفظَ النفسِ مقصدًا عظيمًا من المقاصدِ الكليّةِ الخمسة التي بُنيت عليها الشريعةُ: (حفظُ الدين، وحفظُ النفس، وحفظُ العقل، وحفظُ النسل، وحفظُ المال).
وقد دلّ على ذلك القرآنُ الكريمُ في مواضع كثيرة، منها قولُه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء: 33]. قال محمد سيد طنطاوي: «أى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، إلا بالحق الذي يبيح قتلها شرعا، كردة، أو قصاص، أو زنا يوجب الرجم» (التفسير الوسيط، ج8، ص343).
فالأصلُ هو حُرمةُ الحياةِ، والاستثناءُ أن تُزهق بحقٍّ مشروع.
وقال سبحانه: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].
قَالَ ابْنُ كَثِير (ج2، ص108)ٍ: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْ قِصَاصٍ، أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ، وَاسْتَحَلَّ قَتْلَهَا بِلا سَبَبٍ وَلَا جِنَايَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا … (وَمَنْ أَحْيَاهَا) أَيْ: حَرَّمَ قَتْلَهَا وَاعْتَقَدَ ذَلِكَ، فَقَدْ سَلِمَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ».
أيها الإخوةُ الكرام: لقد عظّم الإسلامُ شأنَ الدماءِ حتى جعلها أعظمَ من حرمةِ البيتِ الحرام. قال النبي ﷺ في خطبةِ الوداع: “إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (صحيح البخاري، ج1، ص34، رقم 67؛ وصحيح مسلم، ج2، ص885، رقم 1679).
وكان السلفُ الصالحُ في غاية التحرّزِ من الدم الحرام. قال عبدُ الله بنُ عمرَ رضي اللهُ عنهما: “إنَّ مِن ورَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتي لا مَخْرَجَ لِمَن أوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بغيرِ حِلِّهِ» (صحيح البخاري، ج6، ص2516، رقم 6533).
ويوم فتح مكة، حين تمكّن النبي ﷺ من أعدائه الذين آذوه وحاربوه، لم ينتقم منهم، بل قال: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ» [السنن الكبرى للبيهقي، ج9، ص199، ح 18276، ط. دار الكتب العلمية، ضعيف بهذا اللفظ، لكن التسمية ثابتة في السيرة (ابن هشام، ج4، ص54)].
إنه مشهدٌ خالدٌ يفيضُ رحمةً وسماحةً، يُعلِّمُ الدنيا أن صيانةَ الحياةِ مقدَّمةٌ على نزعاتِ الانتقام، وأن التسامحَ أسمى من الثأر.
قواعد الحرب في الإسلام
بل حتى في أجواءِ القتالِ وضع الإسلامُ قوانينَ تحفظُ الحياة. نهى عن قتل النساءِ والأطفالِ والشيوخِ والرهبانِ، ونهى عن التمثيلِ بالجثثِ. قال ﷺ: “اغْزُوا باسْمِ اللهِ في سَبيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَن كَفَرَ باللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا…» (صحيح مسلم، ج3، ص1357، رقم 1731).
أليس هذا دينًا يُعلِّمُ الإنسانيةَ أن الحياةَ مصونةٌ حتى في أشدِّ لحظاتِ الصراع؟
روى مسلم في صحيحه: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: “وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» (صحيح البخاري 3015، مسلم، رقم 1744).
تأملوا – رحمكم اللهُ – هذا المشهدَ المهيبَ: جيشٌ يتحركْ، معركةٌ قائمةٌ، ودماءٌ تسيلْ، لكنْ رسولُ اللهِ ﷺ يلتفتْ إلى امرأةٍ مقتولةٍ فيغضبْ ويستنكرْ، ليعلنْ مبدأً خالدًا: أنَّ الحياةَ في الإسلامِ لا تؤخذْ ظلمًا، وأنَّ الحربَ ليستْ للإبادةِ، بلْ لإقامةِ الحقِّ وردِّ العدوانِ.
أليسَ هذا أبلغَ صورِ فقهِ الحياةِ؟ حيثُ تتوقفْ المعركةُ ليصانْ الضعيفُ، وتحمى المرأةُ والطفلُ، وترسمْ معالمُ حضارةٍ لا تعرفْ الغدرَ ولا العدوانَ؟
ومن صفحات التاريخ المضيئة: أن عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه رأى شيخًا يهوديًّا يسأل الناسَ صدقةً، فقال: «مَا أَنْصَفْنَاكَ؛ أَكَلْنَا شَبَابَكَ ثُمَّ نَذَرْنَاكَ فِي كِبَرِكَ»، فأجرى له ولأمثالِه عطاءً من بيت مال المسلمين (أبو يوسف، كتاب الخراج، ص126).
انظروا – رحمكم الله – كيف حفظ الإسلامُ حياةَ غير المسلمينَ، ورعاهم في شيخوختِهم، وأعطاهم حقوقَهم من بيت المال، ليبقى المجتمعُ في ظلِّ الإسلامِ مجتمعَ عدلٍ ورحمةٍ وإنصاف.
الخُطْبَةُ الثَّانِيَة
الحمدُ للهِ رب العالمين وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وبعد:
العنصر الثالث: فِقْهُ الحَيَاةِ بَيْنَ الدُّنْيَا الزَّائِلَةِ وَالآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ
إنَّ الإنسانَ يعيشُ بينَ حياتينِ: حياةٍ دنيا قصيرةٍ زائلةٍ، وحياةٍ آخرةٍ خالدةٍ باقيةٍ، فمنْ أدركَ حقيقةَ الدنيا وأنَّها ممرٌّ إلى الآخرةِ، لمْ يركنْ إلى زينتِها، ولمْ يفتتنْ بزخرفِها، بلِ اتخذَ منها زادًا يبلغهُ دارَ القرارِ. وهكذا يكونُ فقهُ الحياةِ: أنْ تعيشَ الدنيا بعينِ الراحلِ عنها، وتستعدَّ للآخرةِ بقلبِ المقبلِ عليها.
- الحَيَاةُ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ
أيها المؤمنونَ، إنَّ هذه الحياةَ الدنيا التي نعيشُها ليست دارَ قرارٍ ولا موطنَ خلودٍ، وإنما هي دارُ ممرٍّ وامتحانٍ، ومرحلةُ ابتلاءٍ واختبارٍ، ليُميِّزَ اللهُ الخبيثَ منَ الطيبِ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿وما الحياةُ الدنيا إلا متاعُ الغرورِ﴾ [آل عمران: 185].
والغرورُ ـ كما قالَ المفسرونَ ـ هو ما يَغُرُّ الإنسانَ فيخدعُهُ، فهي متاعٌ زائلٌ، وظلٌّ عابرٌ، وحلمٌ سرعانَ ما ينقضي. ولو نظرَ العاقلُ إلى الدنيا بعينِ البصيرةِ، لرآها كما وصفَها النبيُّ ﷺ حين قالَ: “ما لي وما للدُّنيا ، ما أنا في الدُّنيا إلَّا كراكبٍ استَظلَّ تحتَ شجرةٍ ثمَّ راحَ وترَكَها” [الترمذي (2377)، وابن ماجه (4109)، وأحمد (3709) صحيحٌ].
وقالَ سبحانهُ: ﴿وابتغِ فيما آتاكَ اللهُ الدارَ الآخرةَ ولا تنسَ نصيبَكَ منَ الدنيا﴾ [القصص: 77]. أي اجعلْ ما رزقَكَ اللهُ من مالٍ وصحةٍ وعمرٍ وسلطانٍ وسيلةً للآخرةِ، ولا تنسَ أنَّ لك في الدنيا نصيبًا حلالًا تستعينُ بهِ على طاعةِ اللهِ.
ثمَّ وعدَ اللهُ عبادَهُ المؤمنينَ الذينَ يجمعونَ بينَ إيمانٍ صحيحٍ وعملٍ صالحٍ بحياةٍ طيبةٍ في الدنيا، وجزاءٍ كريمٍ في الآخرةِ، فقالَ جلَّ وعلا: ﴿منْ عملَ صالحًا منْ ذكرٍ أو أنثى وهوَ مؤمنٌ فلنحيينَّهُ حياةً طيبةً ولنجزينَّهُم أجرَهُم بأحسنِ ما كانوا يعملونَ﴾ [النحل: 97].
قالَ ابن كثير: “هذا وعدٌ منَ اللهِ تعالى لمنْ عملَ صالحًا ـ .. بأنْ يحييهِ اللهُ حياةً طيبةً في الدنيا، وأنْ يجزيَهُ بأحسنِ ما عملَهُ في الدارِ الآخرةِ. والحياةُ الطيبةُ تشملُ وجوهَ الراحةِ منْ أيِّ جهةٍ كانتْ”. تفسير ابن كثير ج 4، ص601.
قالَ الحسنُ البصريُّ رحمهُ اللهُ: “الدنيا دارُ منْ لا دارَ لهُ، ومالُ منْ لا مالَ لهُ، لها يجمعُ منْ لا عقلَ لهُ” [الزهد للإمامِ أحمدَ، ص: 248]. إنها دارُ ابتلاءٍ، فمنْ صبرَ واحتسبَ أثابَهُ اللهُ، ومنْ غفلَ وركنَ إليها خسرَ الخسرانَ المبينَ.
- الحَيَاةُ الآخِرَةُ هِيَ الحَيَاةُ الحَقِيقِيَّةُ
أيها المسلمون، إذا كانت الدنيا ممرًّا، فإن الآخرة مقرٌّ، وإذا كانت الدنيا دار ابتلاء، فإن الآخرة دار جزاء. قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ [العنكبوت: 64]. أي هي الحياة الحقيقية الكاملة التي لا موت فيها ولا فناء.
وفي الحديث الصحيح: «الكَيِّسُ مَن دان نفسَه وعمِل لما بعدَ الموتِ والعاجِزُ مَن أتبَع نفسَه هَواها وتمنَّى على اللهِ الأمانِيَّ» [الترمذي (2459)، صحيح، وأحمد وابن ماجه].
فَتَأمَّلوا يا عبادَ اللهِ: نحنُ نعيشُ في الدنيا سنواتٍ معدودةً، ثمَّ ننتقلُ إلى حياةٍ لا نهايةَ لها: إمَّا نعيمٌ أبديٌّ في الجنةِ، أو عذابٌ سرمديٌّ في النارِ. فهلْ يَعْقِلُ أنْ نبيعَ الباقيةَ بالفانيةِ، أو الخلودَ بالزوالِ؟
- التَّوَازُنُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ
أيها الأحبةُ، لمْ يأمرْنا الإسلامُ بتركِ الدنيا واعتزالِها، ولا بالغرقِ في شهواتِها والانشغالِ بها، وإنَّما أمرَنا أنْ نتوازنَ، فنجعلَها طريقًا إلى الآخرةِ. قالَ تعالى: ﴿وابتغِ فيما آتاكَ اللهُ الدارَ الآخرةَ﴾ [القصص: 77].
«الدنيا مزرعةُ الآخرةِ». فمنْ زرعَ خيرًا هنا حصدَ نعيمًا هناكَ، ومنْ زرعَ شرًّا جنى عذابًا أليمًا.
وكانَ عليٌّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ: “إنَّ الدنيا قدِ ارتحلتْ مدبرةً، وإنَّ الآخرةَ قدِ ارتحلتْ مقبلةً، ولكلِّ واحدةٍ منهما بنونَ، فكونوا منْ أبناءِ الآخرةِ، ولا تكونوا منْ أبناءِ الدنيا، فإنَّ اليومَ عملٌ ولا حسابَ، وغدًا حسابٌ ولا عملَ” [البخاري في الأدبِ المفرد (1201)، صحيح].
فالتوازنُ أنْ تعملَ لدنياكَ كأنكَ تعيشُ أبدًا، وتعملَ لآخرتكَ كأنكَ تموتُ غدًا؛ تبني وتعمرُ وتسعى، لكنْ قلبُكَ معلَّقٌ بالآخرةِ، وعملُكَ زادٌ للقبرِ وما بعدَهُ.
عبادَ اللهِ، بينَ الحياتينِ طريقٌ قصيرٌ، والدنيا وإنْ طالتْ فهي قصيرةٌ، والآخرةُ وإنْ غابتْ عنْ أعينِنا فهي قريبةٌ. فاعملوا لدارٍ تبقى، ولا تنشغلوا بدارٍ تفنى.
عبادَ اللهِ، إنَّ للتوازنِ بينَ الدنيا والآخرةِ ثمراتٍ عظيمةً، يظهرُ أثرُها في الدنيا قبلَ الآخرةِ. فمنْ ثمراتِه في الدنيا: أنْ يرزقَ اللهُ المؤمنَ حياةً طيبةً هادئةً، قوامُها الطمأنينةُ والرضا والقناعةُ، وأنْ يُباركَ له في رزقِه وعمرِه وأهلهِ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾ [الأنبياء: 94]. فالحياةُ الطيبةُ ليستْ بكثرةِ الأموالِ ولا بعلوِّ المنازلِ، ولكنْ براحةِ القلبِ ونورِ الصدرِ ورضا النفسِ.
وأمَّا في الآخرةِ، فأعظمُ الثمراتِ الفوزُ العظيمُ برضوانِ اللهِ وجنَّتِهِ، حيثُ لا نصبَ ولا تعبَ، ولا خوفَ ولا همَّ، وإنما نعيمٌ مقيمٌ ولذةٌ دائمةٌ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿فمنْ زحزحَ عنِ النارِ وأدخلَ الجنةَ فقدْ فازَ وما الحياةُ الدنيا إلا متاعُ الغرورِ﴾ [آل عمران: 185].
فيا عبادَ اللهِ، التوازنُ الحقُّ أنْ نأخذَ منَ الدنيا ما يُعينُنا على طاعةِ اللهِ، ونجعلَ قلوبَنا متعلقةً بالآخرةِ، نستعدُّ للرحيلِ في كلِّ لحظةٍ، كأنَّ الموتَ على الأبوابِ، وكأنَّ البعثَ غدًا، وكأنَّ الوقوفَ بينَ يديِ اللهِ آتٍ لا محالةَ.
اللَّهُمَّ اجعلنا من عبادِكَ الصالحين، ووفِّقنا لصناعةِ حياةٍ على منهجك القويم.
اللَّهُمَّ اجعل حياتَنا طيبةً، ومماتَنا شهادةً في سبيلك، ولقاءَنا في الفردوس الأعلى مع نبيك محمد ﷺ.
المراجع: القرآن الكريم
كتب الحديث: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، مصنف ابن أبي شيبة، المعجم الكبير للطبراني. الأدب المفرد للبخاري
ثالثًا: كتب التفسير وشروح الحديث وغيرهما: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير، تفسير الوسيط لطنطاوي، سيرة لابن هشام، كتاب الخراج لأبي يوسف. الزهد للإمامِ أحمدَ، الجانتية في ميزان الإسلام للدكتور أحمد رمضان
د. أحمد رمضان
خُطبةُ صوتِ الدعاةِ – إعداد رئيس التحرير: الدكتور أحمد رمضان
_______________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
وأيضا للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة
–للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
وكذلك للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
-كذلك للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
وأيضا للمزيد عن مسابقات الأوقاف