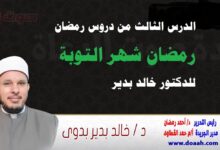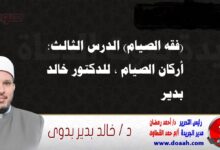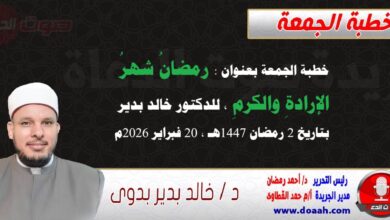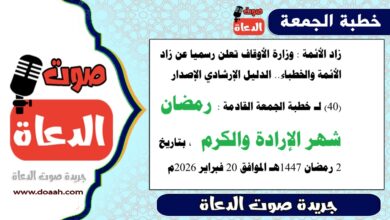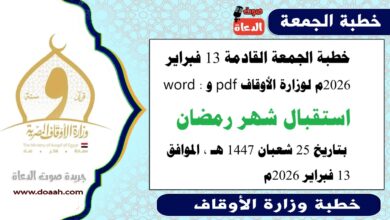خطبة الجمعة : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
بتاريخ 14 صفر 1447هـ، الموافق 8 أغسطس 2025م

خطبة الجمعة القادمة بعنوان : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان لـ صوت الدعاة ، بتاريخ 14 صفر 1447هـ، الموافق 8 أغسطس 2025م.
لتحميل خطبة الجمعة لا تغلو في دينكم بخط أبيض أسود صغير
لتحميل خطبة الجمعة لا تغلو في دينكم بالألوان كبير
-عناصر خطبة الجمعة القادمة 8 أغسطس 2025م بعنوان : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان.
العنصر الأول: خَطَرُ الْغُلُوِّ عَلَى الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ
العنصر الثاني: الرِّفْقُ وَسَمَاحَةُ الدِّينِ… سِرُّ جَمَالِ الْإِسْلَامِ
العنصر الثالث: أهمية الصداقة
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 8 أغسطس 2025م بعنوان : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان : كما يلي:
لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فَإِنَّ الرِّفْقَ مَا كَانَ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ
14 صفر 1447هـ – 8 أغسطس 2025م
إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
المـــوضــــــــــوع
الحمدُ للهِ الذي هَدَانَا لِدِينٍ قَوِيمٍ، وَجَنَّبَنَا سُبُلَ الْغُلُوِّ وَالتَّفْرِيطِ، وَحَفِظَ عَلَيْنَا دِينَ الْفِطْرَةِ وَالسَّمَاحَةِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، دَاعِي الرِّفْقِ وَالرَّحْمَةِ، وَهَادِمُ صُرُوحِ الْغُلُوِّ وَالتَّشَدُّدِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
أَمَّا بَعْدُ
إنَّ من أَعْظَمِ آفَاتِ الدِّينِ وَمِمَّا يُشَوِّهُ صُورَتَهُ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ الْغُلُوُّ وَالتَّشَدُّدُ، وَقَدْ حَذَّرَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 77]. وحذرنا منه رَسُولُ اللهِ ﷺ: “إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ”. رواه ابن ماجه (رقم 3029)، صحيح.
الغُلُوُّ هُوَ: تَجَاوُزُ الحَدِّ المَشْرُوعِ فِي الِاعْتِقَادِ أَوِ القَوْلِ أَوِ الفِعْلِ، بِالمُبَالَغَةِ أَوِ التَّشْدِيدِ فِيمَا شَرَعَ اللهُ، قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ الله: الغُلُوُّ هُوَ التَّعَمُّقُ فِي الشَّيْءِ وَمُجَاوَزَةُ الحَدِّ فِيهِ“. شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، (16/ 220).
تابع / خطبة الجمعة : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
العنصر الأول: خَطَرُ الْغُلُوِّ عَلَى الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ
الغُلُوُّ هُوَ: تَجَاوُزُ الحَدِّ المَشْرُوعِ، إنَّ الغلوَّ في الدينِ ليسَ مجرَّدَ زيادةٍ في العبادةِ أو إكثارٍ من الطاعةِ، بل هو انحرافٌ عن الصراطِ المستقيمِ، وخروجٌ عن المنهجِ النبويِّ القويم، الذي جاء ليُقِيمَ الدينَ على قَاعِدَةِ اليسرِ والسماحةِ، لا على المشقةِ والعسرِ؛ قال اللهُ تعالى محذِّرًا أهلَ الكتاب ومؤدِّبًا المؤمنين:
﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 77]. قال الإمامُ الطبري في تفسيره (10/ 376): المعنى: لا تُجَاوِزُوا الحَدَّ الَّذِي شَرَعَهُ اللهُ فِي دِينِهِ، وَلَا تُدْخِلُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ”.
قال (ابن كثير في تفسيره 2/ 106): أَيْ لَا تَتَجَاوَزُوا الحَدَّ فِيمَا شَرَعَهُ اللهُ، وَلَا تَزِيدُوا عَلَيْهِ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ.
وعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ” قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَتَعَرَّضُ مِنْ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُهُ” [رواه أحمد ح 23444، وابن ماجة ح 4016 وهو حسن بشواهده.
فالغلُوُّ أيها الإخوة، يُخْرِجُ العبدَ مِنْ دائرةِ الطاعةِ إلى التنطُّع، ومن جادةِ الوسطيةِ إلى شططِ الإفراط.
تابع / خطبة الجمعة : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
آثار الغلوّ على الفرد والمجتمع:
فَالدِّينُ يَسْهُلُ عَلَى مَنْ تَعَلَّمَهُ بِالرِّفْقِ، وَيَشُقُّ عَلَى مَنْ تَنَاوَلَهُ بِالتَّشَدُّدِ وَالْمُبَالَغَةِ. وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحُثُّ أُمَّتَهُ عَلَى التَّيْسِيرِ وَالتَّدَرُّجِ فِي الْعِبَادَاتِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التَّنَطُّعِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيمَا يُجَاوِزُ الْحَدَّ الَّذِي شَرَعَهُ اللهُ. وَهَذَا مَعْنًى بَيَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: “إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ”. رواه البخاري ح 39.
أَيُّهَا الأَحِبَّةُ، إِنَّ الْغُلُوَّ يَسُوقُ إِلَى التَّنْفِيرِ مِنَ الدِّينِ وَيَفْتَحُ بَابَ الْإِعْرَاضِ، وَقَدْ جَاءَ فِي قِصَّةِ بَقَرَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ دَرْسٌ بَالِغٌ فِي هَذَا الْبَابِ؛ فَلَمَّا أَمَرَهُمُ اللهُ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً، لَمْ يَقْبَلُوا الأَمْرَ بِبَسَاطَتِهِ وَيُبَادِرُوا بِالتَّنْفِيذِ، بَلْ أَخَذُوا يُشَدِّدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَالتَّفْرِيطِ فِي الِامْتِثَالِ، فَقَالُوا: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ [البقرة: 68]، ثُمَّ قَالُوا: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا﴾ [البقرة: 69]، ثُمَّ عَادُوا فَقَالُوا: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: 70]. فَشَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ، حَتَّى لَمْ يَجِدُوا إِلَّا بَقَرَةً وَاحِدَةً تُشَابِهُ صِفَاتِهَا مَا طَلَبُوا، فَذَبَحُوهَا وَهُمْ كَارِهُونَ.
آثَارُ الغلو عَلَى الفَرْدِ:
أيها الإخوةُ الأحباب، إنَّ الغلوَّ حينَ يستولي على قلبِ المرءِ، يُحوِّلُ العبادةَ الَّتي شُرِعَتْ للتيسيرِ والرَّاحةِ والسُّكونِ، إلى عِبْءٍ يُثقِلُ كاهلَ العبدِ، ويُرهقُ جسدَهُ، ويُعذِّبُ روحَهُ. ومِنْ أبرزِ آثاره على الفرد ما يلي:
1- الانقطاع عن العبادة لشدة المشقة:
إنَّ العِبادةَ إذا فُعِلَتْ بِغُلُوٍّ ومشقةٍ تُخالفُ طبيعةَ الشريعةِ، انقلبتْ إلى نفورٍ وتركٍ. فقد قال اللهُ تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
وقد علق الإمام ابن القيم علي قصة الرجل الذي نذر الوقوف في الشمس: روى البخاري (6704) أن النبي ﷺ رأى رجلًا قائمًا في الشمس، فقيل: إنه نذر أن يصوم، ويقف ولا يستظل، ولا يتكلم. فقال ﷺ: «مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلْ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ”. قال ابن القيم في مدارج السالكين (1/451): “كل من شدّد على نفسه شدّد الله عليه، والدين لا يحتمل التعنت، بل هو مبني على الرفق والرحمة“.
2- الوسوسة في الطهارة والصلاة:
الوسوسة القهرية في أمور العبادات، وخاصة الطهارة والصلاة، ترى بعضهم يُعيد الوضوء مراتٍ لا تنتهي، ويظن أن النجاسة لم تزل، أو أن الوضوء بطل، أو يعيد الصلاة مراتٍ عديدة لأنه يعتقد أنه أخطأ في القراءة أو الركوع، قال النبي ﷺ: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ» (رواه أحمد: 15553.
قصة واقعية: كان بعض السلف يُوصون الموسوس في الطهارة بأن يكتفي بالوضوء مرةً واحدة، ولا يلتفت إلى الشك، وقالوا: “من استرسل مع الوسواس أهلك نفسه وأضاع وقته”.
تابع / خطبة الجمعة : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
3- الميل إلى تكفير المجتمع بغير حق:
إن الغلوَّ يفتح باب التكفير بلا علمٍ ولا بصيرة. فيرى الغاليُ الناسَ جميعًا مقصّرين، ويعتقد أنهم خارجون عن الدين إلا هو ومن تبعه، وهنا يبدأ طريق الخوارج، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36].
وروى البخاري (5057) أن النبي ﷺ وصف الخوارج بقوله: «يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»، أي يخرجون من الدين بسرعةٍ بعد أن يتوهموا أنهم متمسكون به.
لما حكم عليٌّ رضي الله عنه في قضية التحكيم، خرجت طائفة من جيشه وكفّرته، وقالوا: “لا حكم إلا لله”. فقال: “كلمة حق أريد بها باطل” مسلم، فهؤلاء كانوا غالين، فحكموا على الأمة بالضلال، ورفعوا السيف على المسلمين.
أَيُّهَا الإِخْوَةُ، إِنَّ الغُلُوَّ لَيْسَ شَأْنًا فَرْدِيًّا فَقَطْ، بَلْ هُوَ خَطَرٌ عَلَى الْمُجْتَمَعِ كَامِلًا: فإذا كان الغلو آفةً مدمّرةً للفرد، فإن أثره على المجتمع أدهى وأخطر، فهو ليس مرضًا شخصيًّا يُحبس في صدور المتشددين، بل نارًا إذا اشتعلت في قلب واحد سرعان ما تمتدّ إلى الصفوف، فتُفرّق شمل الأمة، وتُضعف قوتها، وتشوّه صورتها في أعين العالم. ولذا كان التحذير من الغلو ليس للفرد وحده، بل للأمة جمعاء.
ومن آثار الغلو على المجتمع والأمة:
- 1- تفريق الصفوف وإضعاف وحدة الأمة:
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46]، قال ابن كثير (4/20): أي: لا تختلفوا فتفشلوا وتزول قوتكم وسلطانكم”.
إن الغلو يُحوِّل أبناء الصف الواحد إلى خصوم متنازعين، يكفّر بعضهم بعضًا، ويطعنون في دين إخوانهم، حتى تنشغل الأمة بصراعاتها الداخلية. وقد قال ﷺ: “لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (رواه البخاري: 121).
- 2- تشويه صورة الإسلام عالميًا:
أيها الأحبة، ما أبشع أن يُستغلّ الغلو لتشويه الإسلام في أعين غير المسلمين!، لقد جعلت تصرفات الغالين، من تكفيرٍ وتفجيرٍ وتشديدٍ، أعداءَ الدين يرفعون أصواتهم بأن الإسلام دين عنفٍ ودماء، بينما الحقيقة أنّه دين رحمةٍ وعدلٍ، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].
قال السعدي (تفسيره 5/326): “أي رحمة عامة شملت الخلق كلهم، فمن آمن به نال رحمة الدين، ومن كفر نال دفع البلاء به”.
-
تابع / خطبة الجمعة : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
3- زرع الفتن وسفك الدماء
الغلو لا يقف عند حدود الجدال والخصومة الفكرية، بل يتجاوزها إلى حمل السلاح، وسفك الدماء بغير حق. وهذا ما وقع من الخوارج الذين رفعوا السيف على المسلمين، وكفّروا الصحابة، وقتلوا الأبرياء، حتى اغتالوا عليًّا رضي الله عنه وهو قائم يصلي.
وما أمر تلك الجماعات المتشددة عبر العصور، التي حملت أفكار التكفير والغلو، وأغرقت المجتمعات في الفوضى ببعيد. وقد قال ﷺ في وصف هؤلاء: “يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ» (رواه البخاري: 3344).
وما أكثر ما نشاهد اليوم من تطبيق هذا الحديث واقعًا مؤلمًا حين يُسفك دم المسلم باسم الدين.
- 4- أثر ذلك على الأمن والاستقرار:
الأمة التي ينخرها الغلو تفقد أمنها، فتضيع التجارة، ويتوقف العمران، وينشغل الناس بخوفهم على حياتهم بدل البناء والتقدم.
- 5- هدم القيم الاجتماعية والأسرية:
إن الغلو ينعكس على البيوت والمجتمعات الصغيرة أيضًا: الأب الغالي يُضيّق على أسرته حتى يُنفرهم من الدين. والشاب المتشدد يُخاصم أهله بحجة أنهم مقصرون، المرأة الموسوسة تُرهق بيتها بتشدد لا يطيقه الناس.
قال الإمام مالك: “من جعل الدين غلوًّا خرج منه كما يخرج السهم من الرمية”، أي أن المبالغة والتشدد تُخرج صاحبها من روح الدين الحقيقية، فلا يبقى منه إلا القسوة والتنفير.
-
تابع / خطبة الجمعة : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
6- ضياع المقاصد الكبرى للشريعة:
الشريعة جاءت لحفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض. والغلو يعطل هذه المقاصد: بدعوى حماية الدين، يكفر الناس ويهدم المساجد. بدعوى الزهد، يترك العمل والإعمار. بدعوى الطهارة، يهمل واجباته الاجتماعية.
قال الشاطبي في الموافقات (2/497): “المتشدد في الدين يُعرض عن مقاصده الكبرى ويشتغل بجزئياته حتى يضيّع الكليات.
الطريق إلى علاج الغلو في المجتمع، إن مواجهة هذه الآثار المدمرة لا تكون إلا عبر: نشر العلم الشرعي الصحيح بفهم السلف الصالح، الرجوع إلى العلماء الثقات الذين يزنون الأمور بميزان الشرع، التربية على الوسطية والرحمة، كما قال ﷺ لمعاذ وأبي موسى: «بَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا» (رواه مسلم: 1732).
إحياء القدوات المعتدلة من الصحابة والسلف، الذين جمعوا بين العبادة الصحيحة والاعتدال في الحياة.
قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: “الدِّينُ بَيْنَ الغَالِي وَالجَافِي، فَالْزَمُوا الوَسَطَ” (البَيْهَقِيُّ، الزُّهْدُ الكَبِيرُ) صـ 301. وَحَذَّرَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ التَّكْفِيرِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَقَالَ: “إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (رَوَاهُ البُخَارِيُّ: 6104، وَمُسْلِمٌ: 60).
قصةٌ نبويةٌ بليغةٌ في ذم التشدد: روى البخاري (6106) ومسلم (1401) أنَّ ثلاثةَ رهطٍ جاءوا إلى بيوتِ أزواجِ النبي ﷺ يسألون عن عبادتهِ، فلما أُخبِروا كأنَّهم تقالُّوها، فقالوا: أما أنا فأصلي الليلَ أبدًا.
وأما أنا فأصومُ الدهرَ ولا أفطر.
وأما أنا فأعتزلُ النساء فلا أتزوج أبدًا.
تابع / خطبة الجمعة : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
فجاء النبي ﷺ فقال: “أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟! أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي”.
إِنَّهَا رِسَالَةٌ وَاضِحَةٌ بِأَنَّ الدِّينَ وَسَطٌ بَيْنَ الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَأَنَّ التَّشَدُّدَ خُرُوجٌ عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّ السَّيْرَ عَلَى نَهْجِ الِاعْتِدَالِ هُوَ عَلَامَةُ الْخَشْيَةِ الصَّادِقَةِ لِلَّهِ.
من أقوال السلف في التحذير من الغلو:
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: “اقْتَصِدُوا فِي السُّنَّةِ، وَلَا تُفَرِّطُوا فِيهَا، وَلَا تَغْلُوا فِيهَا”. رواه ابن وضاح في “البدع والنهي عنها” (ص 49). قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحمهُ الله: سُنَّتُكُمْ وَسَطٌ بَيْنَ الغَالِي وَالجَافِي، فَلَيْسَ فِي الغُلُوِّ خَيْرٌ” أبو نعيم، “حلية الأولياء (5/ 292).
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: “اتَّبِعْ طُرُقَ الهُدَى، وَلَا يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ، وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الهَالِكِينَ” الاعتصام للشاطبي (1/ 54).
قال ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما: “كُلُّ غُلُوٍّ فِي الدِّينِ يُفْسِدُ العِبَادَةَ، وَمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَوْسَعُ مِمَّا يَظُنُّ النَّاسُ”. أبو نعيم في “الحلية (1/ 305).
أيها الإخوة، إنَّ الغلوَّ داءٌ قاتلٌ، يطمسُ معالمَ الرحمة، ويقلبُ سماحةَ الدينِ إلى حرجٍ وضيق، فلا بقاءَ لأمةٍ غلت، ولا صلاحَ لمجتمعٍ تنطَّع، ولا أمنَ لفردٍ شذَّ عن المنهج القويم. فلْنَحْذَرْ هذا الداءِ قبلَ أن يستفحلَ، ولْنَجْعَلْ شعارَنا: دينٌ يُسْرٌ، وعبادةٌ بغيرِ غلوٍّ، وطاعةٌ على بصيرة.
العنصر الثاني: الرِّفْقُ وَسَمَاحَةُ الدِّينِ… سِرُّ جَمَالِ الْإِسْلَامِ
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، إِنَّ الدِّينَ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لَا يَقُومُ إِلَّا عَلَى الرِّفْقِ وَاللِّينِ، وَلَا يَزْدَهِرُ إِلَّا بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الرِّفْقَ قِوَامَ الأَخْلَاقِ، وَأَسَاسَ الْمُعَامَلَةِ، فَقَالَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: “إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ“. رواه مسلم (رقم 2594).
فَهَذَا الحَدِيثُ يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّ الرِّفْقَ لَيْسَ خُلُقًا كَمَالِيًّا فَحَسْبُ، بَلْ هُوَ ضَرُورَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَحَيَاتِيَّةٌ، تُصْلَحُ بِهَا الْقُلُوبُ، وَتَنْتَظِمُ بِهَا شُؤُونُ الْمُجْتَمَعَاتِ، وَتُقَامُ بِهَا الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ فِي أَبْهَى صُوَرِهَا.
الرِّفْقُ مَنْهَجُ الأَنْبِيَاءِ فِي الدَّعْوَةِ:
إِنَّ الْمُتَأَمِّلَ فِي سِيرَةِ الأَنْبِيَاءِ يَجِدْ أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى اللهِ قَامَتْ عَلَى الرِّفْقِ لَا عَلَى الشِّدَّةِ، وَعَلَى الْحِكْمَةِ لَا عَلَى الْغِلْظَةِ. فَهَذَا نَبِيُّ اللهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، يُرْسِلُهُ اللهُ إِلَى فِرْعَوْنَ، أَعْتَى الطُّغَاةِ، فَيَقُولُ لَهُ: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طَه: 144.
قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه: دَعَا إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ الَّذِي كَانَ صَنَمِيًّا مُعَانِدًا بِأَلْطَفِ الْعِبَارَاتِ: ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ [مريم: 44-45].
وَهَذَا نَبِيُّنَا ﷺ، يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَيَبُولُ فِيهِ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ أعرابيّاً دخلَ المَسجِدَ ورسولُ الله ﷺ جالِسٌ، فصلَّى -قال ابن عَبْدة: ركعتين، ثمَّ قال: اللهم ارحَمني ومحمداً، ولا تَرحَم مَعَنا أحداً، فقال النبي ﷺ: “لقد تَحَجَّرتَ واسِعاً”، ثمَّ لم يَلبَث أن بالَ في ناحيةِ المَسجِدِ، فأسرَعَ الناسُ إليه، فنهاهم النبي ﷺ وقال: “إنما بُعِثتُم مُيَسِّرينَ، ولم تُبعَثوا مُعَسِّرينَ، صُبُّوا عليه سَجْلاً مِن ماءِ” أو قال: “ذَنوباً مِن ماءٍ”[رواه أبو داود ح 380 بإسناد صحيح].
تابع / خطبة الجمعة : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
وكان صلى الله عليه وسلم يراعي ضعف الناس واختلاف أحوالهم، فعن أنسٍ رضي الله عنه قال: “مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا“. رواه البخاري ومسلم.
لقد تَرَكَ لنا النبي ﷺ مواقفَ خالدةً في الرِّفْقِ بأصحابه في العبادة، منها:
قصة معاذ رضي الله عنه: كان معاذٌ يُطِيلُ الصلاة بالناس، فشكا أحدُهم للنبي ﷺ، فغضب وقال: “أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟» ثم قال: «إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“. متفق عليه، وهذا دليلُ على وجوبِ مراعاةِ أحوالِ المصلينَ.
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ: ﷺ: “حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ“. رواه البخاري.
إنَّ الاقتداء بِنَبِيِّ الرِّفْقِ ﷺ يقتضي: الوسطية في العبادة: قال النبي ﷺ: “هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ“ (رواه مسلم)، أي المتشددون المتعمقون في الدين.
والرفق في الدعوة والتعليم: كان ﷺ يتلطف مع أصحابه حتى في الإنكار، كما في قوله للرجل الذي بال في المسجد: “إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ” رواه مسلم.
وتذكير الأمة برحمة الله: قال ﷺ: “إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ”. متفق عليه.
فالرِّفْقُ في العبادة والدعوة والتعامل سببٌ لنيل رحمة الله في الدنيا والآخرة.
وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ “بيْنَا أنَا أُصَلِّي مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقُلتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي القَوْمُ بأَبْصَارِهِمْ، فَقُلتُ: واثُكْلَ أُمِّيَاهْ، ما شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَيْدِيهِمْ علَى أفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَبِأَبِي هو وأُمِّي، ما رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ ولَا بَعْدَهُ أحْسَنَ تَعْلِيمًا منه، فَوَاللَّهِ، ما كَهَرَنِي ولَا ضَرَبَنِي ولَا شَتَمَنِي، قالَ: إنَّ هذِه الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شيءٌ مِن كَلَامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ”. صحيح مسلم (537).
يَا عِبَادَ اللهِ، تَأَمَّلُوا فِي عَظَمَةِ التَّرْبِيَةِ النَّبَوِيَّةِ: مَا كَانَ فِيهَا صَوْتُ زَجْرٍ، وَلَا وَقْعُ صَوْتٍ عَلَى الْخُدُودِ، وَلَا قَسْوَةُ أَلْسِنَةٍ، بَلْ حِلْمٌ يَحْتَوِي الْخَطَأَ، وَرِفْقٌ يُصْلِحُ الْخَاطِئَ، وَكَلِمَاتٌ تُدَثِّرُ الْقَلْبَ بِوَدٍّ لَا يُنْسَى.
مَا كَهَرَهُ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى التَّأْدِيبِ؛ بَلْ أَخَذَ بِيَدِ الْجَاهِلِ لِيَرْقَى بِهِ سُلَّمَ الْمَعْرِفَةِ، فَتَحَوَّلَ الْمَوْقِفُ مِنْ حَرَجٍ إِلَى دَرْسٍ يَشُعُّ حِلْمًا وَحِكْمَةً.
هَكَذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا؛ يُقَوِّمُ بِلَا قَسْوَةٍ، وَيُؤَدِّبُ بِلَا أَذًى، حَتَّى انْطَبَعَتْ مَحَبَّتُهُ فِي قُلُوبِ أَصْحَابِهِ طَابِعًا لَا يُمْحَى.
إِنَّهُ نِدَاءٌ لِكُلِّ مُرَبٍّ وَدَاعِيَةٍ: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَ قَلْبًا، فَابْدَأْ بِالرِّفْقِ، وَإِنْ طَمِحْتَ أَنْ تَبْنِيَ إِيمَانًا، فَاسْلُكْ طَرِيقَ الْحِلْمِ؛ فَبِالرَّحْمَةِ تُفْتَحُ الْقُلُوبُ قَبْلَ الْآذَانِ، وَبِالْحِكْمَةِ تُصَاغُ الأُمَمُ عَلَى مِثَالِ النُّبُوَّةِ.
إِنَّهَا مَدْرَسَةُ النُّبُوَّةِ فِي الرِّفْقِ وَاللِّينِ، تُعَلِّمُنَا أَنَّ إِصْلَاحَ النُّفُوسِ لَا يَكُونُ بِالْغَضَبِ وَلَا بِالتَّجْرِيحِ، بَلْ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّوْجِيهِ الْحَكِيمِ.
الرفق في التعامل مع الناس:
قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: 159.
فَمَا جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ حَوْلَهُ إِلَّا بِاللِّينِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ، حَتَّى شَهِدَ لَهُ رَبُّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آلُ عِمْرَانَ: 159].
قَالَ الإِمَامُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (2/ 122)، أَيْ: بِرَحْمَةٍ جَعَلَهَا اللهُ فِي قَلْبِكَ يَا مُحَمَّدُ، كُنْتَ لَيِّنًا لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا عَنْكَ.
أَثَرُ الرِّفْقِ فِي إِصْلَاحِ الأُمَّةِ:
إِنَّ الأُمَّةَ الَّتِي تُشِيعُ الرِّفْقَ بَيْنَ أَفْرَادِهَا هِيَ أُمَّةٌ مُتَمَاسِكَةٌ، مُتَحَابَّةٌ، بَعِيدَةٌ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالشَّحْنَاءِ. وَقَدْ قَالَ ﷺ: “إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ“. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رَقْم 6927) وَمُسْلِمٌ (رَقْم 2593).
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرِّفْقَ يَشْمَلُ الْعِبَادَةَ وَالْمُعَامَلَةَ، وَالدَّعْوَةَ وَالْحُكْمَ، بَلْ يَشْمَلُ حَتَّى إِصْلَاحَ الأَخْطَاءِ؛ إِذْ مَا كَانَتِ الشِّدَّةُ فِي عِلَاجِهَا إِلَّا زَادَتْهَا تَعْقِيدًا، وَمَا دَخَلَهَا الرِّفْقُ إِلَّا أَصْلَحَهَا وَزَانَهَا.
نَمَاذِجُ مِنَ السَّلَفِ فِي الرِّفْقِ:
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ رَحِمَهُ اللهُ: “الرِّفْقُ يُؤَمِّنُ الْمَخَاوِفَ، وَيَزِيدُ فِي الأَرْزَاقِ، وَيُورِثُ الْمَحَبَّةَ بَيْنَ النَّاسِ”. حِلْيَةُ الأَوْلِيَاءِ لِأَبِي نُعَيْمٍ، 8/167.
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لِعُمَّالِهِ: “عَلَيْكُمْ بِالرِّفْقِ فِي أُمُورِ النَّاسِ، وَلَا تُحَمِّلُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فِتْنَةً”. المُصَنَّفُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، 6/134.
أَيُّهَا الأَحِبَّةُ، إِنَّ الأُمَّةَ الَّتِي تَسِيرُ عَلَى نَهْجِ الرِّفْقِ تَزْدَادُ قُوَّةً بِوَحْدَتِهَا، وَسُمُوًّا بِحِكْمَتِهَا، وَهِيَ بِهَذَا تُقِيمُ الدِّينَ عَلَى الوَجْهِ الأَكْمَلِ: دِينٌ يَجْمَعُ وَلَا يُفَرِّقُ، يُلَيِّنُ القُلُوبَ وَلَا يُقَسِّيهَا، وَيُحَبِّبُ الخَلْقَ فِي شَرِيعَةِ رَبِّهِمْ بَدَلَ أَنْ يُنَفِّرَهُمْ مِنْهَا.
تابع / خطبة الجمعة : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
الوسطية طريق النجاة (التوازن بين الدين والدنيا)
لقد جاء الإسلامُ بمنهجٍ وسطٍ متوازن، لا يميل إلى إفراطٍ يرهق النفوس، ولا إلى تفريطٍ يميتها، بل هو الدينُ الذي قال الله فيه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143].
قال الإمام الطبري في تفسيره (3/143): أي عدولاً خيارًا، لا غلوّ فيكم … وسط بين الإفراط والتفريط”.
وَإِذَا تَأَمَّلْنَا سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَجَدْنَاهَا مَدْرَسَةً فِي التَّوَازُنِ؛ فَالنَّبِيُّ ﷺ يُرَبِّي أُمَّتَهُ عَلَى أَنْ يَسْلُكُوا طَرِيقَ الِاعْتِدَالِ، فَلَا يُحَمِّلُوا أَنْفُسَهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَلَا يَتَسَاهَلُوا حَتَّى يُضَيِّعُوا الْفَرَائِضَ. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: “إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ”. البخاري (1968).
فَهَذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ جَامِعَةٌ لِمِيزَانِ الْوَسَطِيَّةِ، تُعَلِّمُنَا أَنْ نُؤَدِّيَ الْحُقُوقَ كُلَّهَا بِانْتِظَامٍ، فَلَا نُغْفِلُ حَقَّ اللهِ فِي الْعِبَادَةِ، وَلَا نُهْمِلُ حَقَّ أَنْفُسِنَا فِي الرَّاحَةِ وَالْمُبَاحَاتِ، وَلَا نَقْصُرُ فِي حَقِّ الْأَهْلِ وَالنَّاسِ فِي الْمُعَامَلَاتِ، وَهُنَا نُدْرِكُ أَنَّ التَّوَازُنَ فِي الإِسْلَامِ حِكْمَةٌ تَبْنِي الإِنْسَانَ، فَيُصْبِحُ أَقْدَرَ عَلَى الثَّبَاتِ وَالِاسْتِمْرَارِ فِي طَاعَةِ اللهِ دُونَ انْقِطَاعٍ أَوْ كَلَلٍ.
وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: “سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ”. رواه البخاري (رقم 40).
أي: التوازن في العبادة والعمل، والرفق بالنفس، سبب للثبات والاستمرارية.
تابع / خطبة الجمعة : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
نماذج نبوية للوسطية:
في العبادة: كان ﷺ يُصلي حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له في ذلك قال: “أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا“. [البخاري (1130) ومسلم (2820)، ومع ذلك كان ينام، ويأكل، ويخالط الناس، ويبتسم، ويزور المرضى.
في الدعوة: كان إذا أرسل أصحابه قال: “يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا“. البخاري (69) ومسلم (1732.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ” “خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا.” الزهد لابن أبي عاصم، ص 74.
وقال الإمام مالك: “لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها”: اعتدالٌ في الدين، واتباعٌ للسنة”. القاضي عياض في “ترتيب المدارك” (1/48) بسنده إلى الإمام مالك. ونقله الشاطبي في “الاعتصام (1/ 49).
عباد الله، الغلو آفة، والتفريط مذلة، والوسطية نجاة؛ فلنلزم هدي النبي ﷺ، ولنكن دعاة رفق ورحمة.
اللهم اجعلنا أمة وسطًا، واحفظنا من الغلو والجفاء، واهدنا سبل الرشاد.
الخطبة الثانية: العنصر الثالث: أهمية الصداقة
اَلْـحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِالتَّآلُفِ، وَنَهَى عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّدَابُرِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ وَاصَلَ أَصْحَابَهُ وَأَحَبَّهُمْ. وبعد:
الصَّدَاقَةُ فِي ضَوْءِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
إِنَّ الصَّدَاقَةَ الصَّادِقَةَ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ؛ بِهَا تَتَقَوَّى الْقُلُوبُ، وَتَسْلَمُ النُّفُوسُ، وَتَتَحَقَّقُ مَعَانِي الْأُلْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: 67].
قال ابن كثير: “أي: كل صداقة كانت على غير طاعة الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان في الله ولله” (تفسير ابن كثير، ج7، ص 232).
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ» (رواه أبو داود، ح4833، صحيح).
قِيلَ لِلإِمَامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: مَنْ نُجَالِسُ؟ قَالَ: “جَالِسُوا مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ، وَيَزِيدُكُمْ عِلْمًا مَنْطِقُهُ، وَيَرْغَبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ” (حلية الأولياء، ج2، ص147).
تابع / خطبة الجمعة : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. فإن الرِّفْقَ ما كان فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
آثَارُ الصَّدَاقَةِ الصَّالِحَةِ عَلَى الْفِكْرِ وَالدِّينِ
إِنَّ الصَّدِيقَ الْمُخْلِصَ يُعِينُكَ عَلَى طَاعَةِ رَبِّكَ، وَيَرُدُّكَ إِذَا زَلَلْتَ، وَيُقَوِّمُ فِكْرَكَ إِذَا أَخْطَأْتَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ… وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَنَافِخِ الْكِيرِ» (رواه البخاري، ح5534 ومسلم، ح2628).
الصديق الصالح كالمرآة الصافية، تريك عيوبك فتُصلحها، بينما جليس السوء يُفسد قلبك ويُشوِّه فكرك، رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ– كَانَ يَأْخُذُ بِيَدِ أَبِي بَكْرٍ –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ– وَيَقُولُ: “هَذَا سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا” (البخاري، ح3667). فَهَذِهِ صَدَاقَةٌ تُظْهِرُ الْحُبَّ وَالتَّقْدِيرَ فِي اللَّهِ.
كَيْفَ نَبْنِي صَدَاقَةً تُنْمِي الْفِكْرَ وَالدِّينَ؟
اختر صديقك على أساس الدين والعقل: فَإِنَّ الْعَقْلَ وَالدِّينَ قَاعِدَتَا الصُّحْبَةِ.
احرص على الصديق الناصح: الَّذِي يَرُدُّكَ إِلَى الْحَقِّ.
تبادل النصيحة والتواصي بالحق: كما قال تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 3].
تجنّب صحبة الغافلين: فإنها تورث القلب قسوة.
الصَّدِيقُ الصَّالِحُ دُرَّةٌ نَادِرَةٌ، وَمِرْآةٌ صَادِقَةٌ، وَسَبِيلٌ لِسَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فَابْتَغُوا صُحْبَةَ أَهْلِ الْخَيْرِ، وَتَوَاصَوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.
أيها الأحبة، الصداقة في الإسلام ليست لهوًا ولا مصلحة، بل رِبَاطٌ إِيمَانِيٌّ يُثْمِرُ نَصْرًا وَثَبَاتًا وَهُدًى. قال النبي ﷺ: المُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ» (رواه الترمذي، ح2390، صحيح). فلْنَكُنْ مِمَّنْ تَحَابُّوا فِي اللَّهِ، وَتَنَاصَحُوا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.
د. أحمد رمضان
المراجع: القرآن الكريم
كتب الحديث: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، مسند أحمد، صحيح ابن خزيمة، المصنف لابن أبي شيبة، سنن الدارمي.
ثالثًا: كتب التفسير وشروح الحديث وغيرهما: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، تفسير ابن كثير، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، شعب الإيمان للبيهقي، الزهد للبيهقي، الزهد لابن أبي عاصم، حلية الأولياء لأبي نعيم، الاعتصام للشاطبي، البدع والنهي عنها لابن وضاح، ترتيب المدارك للقاضي عياض، الاعتصام للشاطبي.
د. أحمد رمضان
خُطبةُ صوتِ الدعاةِ – إعداد رئيس التحرير
_______________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
وأيضا للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة
–للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
وكذلك للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
-كذلك للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
وأيضا للمزيد عن مسابقات الأوقاف