زاد الأئمة : وزارة الأوقاف تعلن عن زاد الأئمة والخطباء.. لـ خطبة الجمعة القادمة : بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، بتاريخ 25 ربيع الثاني 1447هـ ، الموافق 17 أكتوبر 2025م

زاد الأئمة : وزارة الأوقاف تعلن رسميا عن زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لـ خطبة الجمعة القادمة حول : بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، بتاريخ 25 ربيع الثاني 1447هـ ، الموافق 17 أكتوبر 2025م.
ننفرد بنشر زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لخطب الجمعة القادمة : بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، بصيغة WORD
pdf (14 صفحة) ننشر زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لخطب الجمعة القادمة : بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، بصيغة pdf
pdf (21 صفحة) ننشر زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لخطب الجمعة القادمة : بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، بصيغة pdf
ولقراءة زاد الأئمة والخطباء.. لـ خطبة الجمعة القادمة : بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، كما يلي:
﷽
الخطبة الأولى: بالتي هي أحسن
الهدف: التوعية بأخلاقيات وآداب الاتفاق والاختلاف وضرورة استيعاب الآخر.
الخطبة الثانية: التحرش آفة قبيحة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن (ادفع بالتي هي أحسن) قاعدة قرآنية، وأساس تربوي، وأسلوب رفيع في التعامل مع الآخر، خاصة في مواطن الخلاف والإساءة، وهو سلوك قائم على الاستجابة للأمر الإلهي والتوجيه النبوي، وليس مجرد رد فعل عاطفي نستجلب به رضا الآخرين فحسب.
والمتأمل في صفحات الكون يدرك أن الاختلاف سنة إلهية، وآية كونية، تدل عليها شواهدُ التفكر في اختلاف الليل والنهار، وتنوع ما تُنبتُه الأرضُ من زروع وثمار، وقد قرر هذا كلَّه القرآنُ الكريم، كما قرر أيضًا أن من آيات الله تعالى في الخلق؛ اختلافَ ألسنتهم وألوانهم، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ} [الروم: ٢٢].
وأخبر عن اختلافهم في الإيمان بالله ورسله فقال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} [هود: ١١٨-١١٩]، فالناس يختلفون ليس في صورهم، وألسنتهم، بل حتى في عقائدهم وأفكارهم.
وقد يتحول الاختلاف الذي هو سنة كونية إلى خلق مذموم، وسلوك مرفوض، وذلك حسب الدوافع والأسباب والآثار والنتائج التي تترتب عليه.
وهنا يضع الإسلام مبدأ (بالتي هي أحسن) لتكون منهجا ربانيا أساسه الاحترام واستيعاب الآخر، يسود من خلاله الوئام وتُجتنب مواطن الفرقة والخلاف. وبيان هذا من خلال عدة أمور:
-
الاختلاف في الرأي قد يكون محمودًا وقد يكون مذمومًا
الاختلاف نوعان:
اختلافُ تنوُّعٍ: وهو الذي يتمثل في الأقوال المتعددة التي لا تضاد ولا تناقض بينها في المجمل، وإنما تصب في معِين واحد، وهذا ما يعرف ب “الخلاف اللفظي”، وهو غالب نتاج الشريعة الغراء، وما تمخض عن أقوال الفقهاء والعلماء على اختلاف مشاربهم.
وهذا الاختلاف ليس مذمومًا إذا روعي فيه حدود الأدب والأخلاق، فهو نتيجة الاجتهاد، وتفاوت الأفهام في مسائل متفاوتة بل إن صاحبه مأجور إذا كان من أهل العلم؛ فعَنْ سيدنا عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ» [متفق عليه].
هذا الاختلاف يقود إلى النجاح، وتُثمر عنه الإنجازات، ولا يفسد للود قضية، وتُحفظ فيه الحقوق، وتُصان فيه الأعراض؛ ولهذا صنف رجل كتابًا في “الاختلاف”، فقال الإمام أحمد بن حنبل: لا تسمِّه “الاختلاف”، ولكن سمِّه “السعة”.
اختلافُ تضادٍ: وهو الأقوال والآراء المتضادة أو المتناقضة التي لا يمكن الجمع بينها وبين قواعد الشريعة ومقاصدها، كمن ينكر أمرًا متفقًا عليه، أو عبادة مجمعًا عليها، فهذا النوع لا يمكن أن يجري فيه الخلاف؛ لأن الشرع فيه محكم، قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: ٨٢]، {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٤].
قال الإمام السبكي: “والذي نقطع به أن الاتفاق خير من الاختلاف، وأن الاختلاف على ثلاثة أقسام: أحدها: في الأصول، ولا شك أنه ضلال، وسبب كل فساد، وهو المشار إليه في القرآن. والثاني: في الآراء، والحروب ويشير إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: «تطاوعا ولا تختلفا»، ولا شك أيضًا أنه حرام؛ لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية. والثالث: في الفروع كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما، والذي نقطع به أن الاتفاق خير منه أيضًا). ا.هـ. [الإبهاج في شرح المنهاج].
-
الاختلاف المذموم.. المخاطر والآفات
إذا افتقدنا آداب الاختلاف وأخلاقياته أدى ذلك إلى إيغار الصدور، وزرع الشحناء والخصومات، وتمزيق الوحدة، وعدم الاجتماع والتكاتف، قال تعالى: {وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: ٤٦].
وقال تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: ١٠٥].
ويتجلى هذا المعنى في الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام وهو يسوي صفوفهم للصلاة: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ» [رواه أبو داود في “السنن”] ولا يخفى ما تحمله هذه الكلمات النبوية من أن الخلاف في الظاهر (في القول والفكر والرأي)؛ ينتج عنه خلافٌ باطنيٌّ، لا شك أنه أكبر وأخطر، تتجلى معانيه في الكراهية والعداوة والنزاع وربما الاعتداء باللفظ أو ما يتجاوز اللفظ.
كما حذرنا صلى الله عليه وسلم من السبيل الذي يسلكه الشيطان ليدفعنا إلى الاختلاف وما يترتب عليه من نزاع وعداوة وحقد وكراهية وبغضاء، فعَن سيدنا جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ» [رواه مسلم]. و”التحريش”: الإغراء على الشيء بنوع من الخِداع أي: إيقاع الفتنة، والعداوة، والخصومة.
ويقول الإمام الجصاص الحنفي رحمه الله: “وفي التنازع والاختلاف فساد ذات البين وذهاب الدين والدنيا؛ قال الله عز وجل: {وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: ٤٦] [أحكام القرآن].
وقد أحسن شوقي حين قال:
إِلاَمَ الخُلْفُ بَيْنَكُمُ إِلاَمَا = وَهَذِي الضَّجَّةُ الكُبْرَى عَلاَمَا
وَفِيمَ يَكِيدُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ = وَتُبْدُونَ العَدَاوَةَ وَالخِصَامَا
إِذَا كَانَ الرُّمَاةُ رُمَاةَ سَوْءٍ = أَحَلُّوا غَيْرَ مَرْمَاهَا السِّهَامَا
-
بالتي هي أحسن.. منهج رباني ومبدأ إيماني ومعلم قرآني
رسخ القرآن لهذا المبدأ في ستة مواضع، اثنان منها في حديثه عن مال اليتيم، وتحذير الأوصياء من الاقتراب منه وأكله، فقال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: ١٥٢]، وقال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الإسراء: ٣٤].
وموضعان في المجادلة، فقال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: ١٢٥].
فلم يقل: {وجادلهم بالتي هي حسن} بل قال: {بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ} فجعل الجدال مع غير المسلمين ليس بالقبيح ولا بالحسن، بل بالتي هي أحسن، قال العلماء: أي: ألِنْ لهم جانبك، وجادلهم الحجة بالحجة، والدليل بالدليل، غير فظٍّ، وَلَا غليظ، بل قدِّم العفو والصفح واللين معهم على الدوام، وهو نفس الخطاب الذي أرسل الله تعالى به موسى وهارون إلى فرعون الذي ادَّعى الألوهية والربوبية، قال الله تعالى لهما: {فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى} [طه: ٤٤].
ويقول سبحانه: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت: ٤٦].
وموضعان في مواطن دفع الاختلاف وأسباب الفرقة، حيث أمر المؤمنين أن يدفعوا هذه الأسباب بما أثمرته فيهم العبادات والقربات والأذكار والدعوات من خلق حسن يُستدعى في مثل هذه المواقف التي قلَّما ينجو فيها إلا من تحصَّن فيها بالمواريث النبوية من الأخلاق الحسنة والسلوكيات الرفيعة، فقال سبحانه: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ} [المؤمنون: ٩٦]، ويقول: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} [فصلت: ٣٤].
-
يقولوا التي هي أحسن.. خطاب لعباد الله الصادقين
قال تعالى: {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا} [الإسراء: ٥٣].
لا يخفى ما تضمنته هذه الآية من شرف الانتساب إلى الله تعالى حيث قال: {قُلْ لِعِبَادِي}، كما لا يخفى أيضا أنه لا يقوم بهذا الأمر الرباني إلا من تجردت سريرته لله تعالى، وخلصت نفسه من الركون إلى الأهواء والشهوات، وسلم قلبه من الاستجابة إلى النزغات، إذ ليس له على المؤمنين سبيل.
أساس نبذ الخلاف القول الحسن، والكلمة الطيبة، فقد أودع الله فيها من الأسرار والحكم والعطايا ما يجعلها بمثابة الشفاء للقلوب، إذ تمتص غضب النفس، وتحول العدو إلى ولي حميم، وسفير القلوب، للتعارف والتقارب والتفاهم، وسلاح ناعم به تتحق كثير من مصالح عباد الله.
أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين، أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك، نزغ الشيطان بينهم، وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، فعداوته ظاهرة بينة.
وقد ضرب الصحابة أمثلة عديدة في كيفية التعامل الحسن مع المخالفين، فقال أبو هلالٍ الطَّائِيُّ، عَنْ أُسَّق الرومي، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَا نَصْرَانِيٌّ، فَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَيَقُولُ: “إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ اسْتَعَنْتُ بِكَ عَلَى أَمَانَتِي فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَسْتَعِينَ بِكَ عَلَى أَمَانَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَسْتَ عَلَى دِينِهِمْ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي وَأَنَا نَصْرَانِيٌّ وَقَالَ: “اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ”. [الطبقات الكبرى].
وقال سيدنا يحيى بن معاذ الرازي: “اصحبوا الناس بالفضل لا بالعدل فمع العدل الاستقصاء، ومع الفضل الاستبقاء، وإني لأرجو أن يحاسب اللَّه تعالى عباده بالفضل لا بالعدل، وقد أمرهم أن يصاحب بعضهم بعضًا بالفضل، وقد عظَّم الله تعالى أمر الإحسان والإفضال فقال: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ}. [الذريعة إلى مكارم الشريعة].
-
إحسان الظن بالمخالف.. أدب كبير من آداب الاختلاف
كثيرًا ما يتعرض بعض الناس إلى الحكم على بواطن الناس ونياتهم، وليس للعبد في ذلك مدخل، بل يجب عليك أن تحمل كلام المخالف لك على أحسن محامله، وأن تلتمس له الأعذار لا عذرًا واحدًا، فقل: لعله قصد كذا، أو أراد كذا، أو نيته كذا، فعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: “لَا تَظُنَّ كَلِمَةً خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدَ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا”. [روضة العقلاء ونزهة الفضلاء].
وعن أبي حبيبة، مولى سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: “دخلت على علي مع عمر بن طلحة بعدما فرغ من أصحاب الجمل، قال: فرحب به وأدناه، قال: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} [الحجر: ٤٧]، فقال: “يا ابن أخي، كيف فلانة كيف فلانة؟» قال: وسأله عن أمهات أولاد أبيه…” [رواه الحاكم في “المستدرك، وصححه، ووافقه الذهبي].
وعن سيدنا حمدون القصَّار النبيسابوري– أحد علماء القرن الثالث الهجري- أنه قال: “إذا زل أخٌ من إخوانكم، فاطلبوا له سبعين عذرًا، فإن لم تقْبلْه قلوبُكم، فاعلموا أن المَعِيب أنفسَكم؛ حيث ظهر لمسلم سبعين عذرًا فلم تقبله”. [إحياء علوم الدين].
وقال الحافظ الذهبي: “وَلَوْ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ – مَعَ صِحَّةِ إِيْمَانِهِ، وَتَوَخِّيْهِ لاتِّبَاعِ الحَقِّ- أَهْدَرْنَاهُ، وَبَدَّعنَاهُ، لَقَلَّ مَنْ يَسلَمُ مِنَ الأَئِمَّةِ مَعَنَا، رَحِمَ اللهُ الجَمِيْعَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ”. [سير أعلام النبلاء].
-
من آداب الحوار.. حسنُ الاستماع لرأي المخالف
من حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه ووجهة نظره بما لا يؤثر على حرية الآخرين، أو يؤدي إلى إشاعة الفوضى الفكرية في المجتمع، ويؤثر سلبًا على وجدان الناس، كما أن من حقه عليك أيضًا -إذا كنت طالب حق- أن تستمع إليه حتى يفرغ من بيانه وكلامه، ثم بعد ذلك تجيبه بما يتوفقه معه أو يتخالف، وهذا مما علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى ما فيه من احترام الآخر، ومراعاة الأبعاد النفسية للمخالف، وأثر ذلك عليه في مبادلة السما بالسماع والاحترام باحترام مماثل.
فهذا عُتبة بْن رَبِيعَة حين كان يحاور النبي صلى الله عليه وسلم قال له: “قُلْ يَا أبا الوليد، أسمع، قال: يابنَ أَخِي، إنْ كنتَ إنَّمَا تُرِيدُ بِمَا جئتَ بِهِ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مَالًا جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالًا، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ شَرَفًا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا حَتَّى لَا نَقْطَعَ أَمْرًا دُونَكَ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مُلكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رَئِيًّا تَرَاهُ لَا تَسْتَطِيعُ رَدَّهُ عَنْ نفسِك، طَلَبْنَا لَكَ الطبَّ، وَبَذَلْنَا فِيهِ أَمْوَالَنَا حَتَّى نبرئَك مِنْهُ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا غَلَبَ التابعُ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُدَاوَى مِنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ لَهُ حَتَّى إذَا فَرَغَ عُتْبَةُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ، قَالَ: “أَقَدْ فَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاسْمَعْ مِنِّي؛ قَالَ: أَفْعَلُ….” [رواه ابن إسحاق في “السير والمغازي”].
فالإصغاء إلى الآخرين فن قَلَّ من يجيده ويحسنه، وأكثر الناس ربما يجيد الحديث أكثر من الاستماع، والأدب النبوي يعلمنا أنه لابد أن تستمع جيدًا، وأن تستوعب جيدًا ما يقوله الآخرون.
-
من أخلاق الإسلام.. الإنصاف والعدل عند الاختلاف
لا بد للمسلم أن يستوعب المخالف له في الرأي، وينبغي أن يتعامل معه بعدل وإنصاف وموضوعية، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: ٨].
وعَنْ سيدنا أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ خَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَكَلِمَةُ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ».[رواه البيهقي في “شعب الإيمان”].
ونقل ابن نجيم الحنفي عن “المصفى”: “إِذا سئلنا عَن مَذْهَبنَا وَمذهب مخالفنا قُلْنَا وجوبا مَذْهَبنَا صَوَاب يحْتَمل الْخَطَأ، وَمذهب مخالفنا خطأ يحْتَمل الصَّوَاب”. [الأشباه والنظائر].
قال الإمام الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: “مَا نَاظَرْت أَحَدًا إلَّا قُلْت: اللَّهُمَّ أَجْرِ الْحَقَّ عَلَى قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مَعِي اتَّبَعَنِي وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مَعَهُ اتَّبَعْته”. [قواعد الأحكام في مصالح الأنام].
وقد ذم الله تعالى التمادي في الباطل بدافع الكِبر والمجادلة، قال تعالى: {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ} [غافر: ٣٥]. وقال: {إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر: ٥٦].
وعَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: “كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وَلَا يَمْنَعْكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ لِرَأْيِكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ، أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ”. [رواه البيهقي في “السنن الكبرى”].
قال الإمام ابن قدامة المقدسي: (كَانُوا يتناظرون فِي الْأَحْكَام، ومسائل الْحَلَال وَالْحرَام بالأدلة المرضية، والحجج القوية حَتَّى كَانَ قلَّ مجْلِس يَجْتَمعُونَ عَلَيْهِ إِلَّا ظهر الصَّوَاب، وَرجع رَاجِعُون إِلَيْهِ؛ لاستدلال الْمُسْتَدلّ بِالصَّحِيحِ من الدَّلَائِل، وَعلم المنازع أَن الرُّجُوع إِلَى الْحق خير من التَّمَادِي فِي الْبَاطِل كمجادلة الصديق لمن نازعه فِي قتال مانعي الزَّكَاة حَتَّى رجعُوا إِلَيْهِ.
ومناظرتهم فِي جمع الْمُصحف حَتَّى اجْتَمعُوا عَلَيْهِ، وتناظرهم فِي حد الشَّارِب، وجاحد التَّحْرِيم حَتَّى هُدُوا إِلَى الصِّرَاط الْمُسْتَقيم وَهَذَا وَأَمْثَاله يجل عَن الْعد والإحصاء، فَإِنَّهُ أَكثر من نُجُوم السَّمَاء). ا.هـ.
-
موافقةُ الحق بعد ظهوره ولو على يد المخالف يحقق الخير ويُذهبُ الشحناء
لقد أحسن الإمام حجة الإسلام الغزالي عندما وضع لطلب الحق من الدين ثمانية شروط، وذكر منها: “أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه، ويرى رفيقه معينًا لا خصمًا، ويشكره إذا عرفه الخطأ، وأظهر له الحق، كما لو أخذ طريقا في طلب ضالته فنبهه صاحبه على ضالته في طريق آخر، فإنه كان يشكره ولا يذمه، ويكرمه ويفرح به، فهكذا كانت مشاورات الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن امرأة ردت على عمر رضي الله عنه ونبَّهته على الحق وهو في خطبته على ملأ من الناس، فقال: “أصابت امرأة وأخطأ رجل”.
وسأل رجل عليًّا رضي الله عنه فأجابه، فقال: “ليس كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا كذا”، فقال: “أصبتَ وأخطأتُ، وفوق كل ذي علم عليم”.
واستدرك ابن مسعود على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: “لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم”، وذلك لما سئل أبو موسى عن رجل قاتل في سبيل الله فقُتل فقال: “هو في الجنة”، وكان أمير الكوفة، فقام ابن مسعود فقال: “أعده على الأمير فلعله لم يفهم”، فأعادوا عليه فأعاد الجواب، فقال ابن مسعود: “وأنا أقول إن قُتل فأصاب الحق فهو في الجنة”. فقال أبو موسى: “الحق ما قال”.
وهكذا يكون إنصاف طلب الحق، ولو ذُكر مثل هذا الآن لأقل فقيه لأنكره واستبعده، وقال: لا يحتاج إلى أن يقال أصاب الحق؛ فإن ذلك معلوم لكل أحد.
فانظر إلى مناظري زمانك اليوم كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه، وكيف يخجل به، وكيف يجهد في مجاحدته بأقصى قدرته، وكيف يذم من أفحمه طول عمره ثم لا يستحيي من تشبيه نفسه بالصحابة رضي الله عنهم في تعاونهم على النظر في الحق”. [إحياء علوم الدين].
إن كان المختلفان يريدان الخير فإن الله سيهيدهما للعمل؛ قال سيدنا مَعْرُوفَ الْكَرْخِي: “إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتْحَ لَهُ بَابَ الْعَمَلِ، وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْجَدَلِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا فَتْحَ لَهُ بَابَ الْجَدَلِ، وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْعَمَلِ” [رواه البيهقي في “شعب الإيمان”].
وقال سيدنا بِلَال بْن سَعْدٍ: “إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ لَجُوجًا مُمَارِيًا مُعْجَبًا بِرَأْيِهِ فَقَدْ تَمَّتْ خَسَارَتُهُ”. [رواه البيهقي في “شعب الإيمان”].
-
الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية
من العبارات الجميلة المشهورة: “الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية”، فهذه المقولة دعوة راقية إلى التعايش الفكري والاجتماعي، وهي تعني: أن اختلاف وجهات النظر لا ينبغي أن يؤدي إلى القطيعة أو العداوة، بل يجب أن يبقي على الاحترام والمودة بين الناس رغم تباين آرائهم.
وقد روى الإمام البخاري في صحيحه صورة مشرقة لأدب الخلاف بين الصحابة الكرام، فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ» فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الخَطَّابِ شَيْءٌ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَّ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ: «يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ» ثَلاَثًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ، فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلَ: أَثَّمَ أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالُوا: لاَ، فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ، فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ، مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي» مَرَّتَيْنِ، فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا. [رواه البخاري في صحيحه].
فهذه الواقعة تعلمنا أن المسلم يجب أن لا يمتلئ غلًّا ولا حقدًا، ولا يحمل ضغينة لأحدٍ، حتى مع من يخالفه، وعندما يأتي المخطئ يطلب العفو يجب أن يقابل بالصفح والإحسان، حتى قال سيدنا الصديق رضي الله عنه عبارته الخالدة: ” يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ، مَرَّتَيْنِ”.
فهذا الكون على ما فيه من تنوعٍ واختلافٍ إلا أنك تجد فيه تناغمًا وتناسقًا بين جميع المخلوقات، قال تعالى: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: ٣].
وحتى تكتمل هذه السنة الربانية جعل الله الناس تتباين وجهات نظرهم، وتختلف أفكارهم قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} [المائدة:٤٨].
وقال سبحانه: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [هود: ١١٨].
قال الإمام ابن عطية الأندلسي: “المعنى: “لجعلهم أمة واحدة مؤمنة” قاله قتادة حتى لا يقع منهم كفر، ولكنه عز وجل لم يشأ ذلك، فهم لا يزالون مختلفين في الأديان، والآراء، والملل، وهذا تأويل الجمهور). ا.هـ. [المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز].
وقال ابن عجيبة: ({أُمَّةً وَاحِدَةً}: متفقين على الإيمان، أو الكفران، لكن مقتضى الحكمة وجود الاختلاف؛ ليظهر مقتضيات الأسماء في عالم الشهادة فاسمه “الرحيم والكريم”: يقتضي وجود من يستحق الكرم والرحمة، واسمه “المنتقم والقهار”: يقتضي وجود من يستحق الانتقام والقهرية.
وقوله: {وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ}: إن كان الضمير «للناس»: فالإشارة إلى الاختلاف، واللام للعاقبة، أي: ولتكون عاقبتهم الاختلاف خلقهم، وإن كان الضمير يعود على «من»: فالإشارة إلى الرحمة، أي: إلَّا من رحم ربك، وللرحمة خلقه.
وَعَنْ سيدنا سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رضي الله عنه قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَنْ ضَعْ أَمَرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ، فَلَا تَظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا مِنَ الْخَيْرِ مَحْمَلًا، وَمَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهْمَةِ، فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ، وَمَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدَيْهِ، وَمَا كَافَأْتَ مَنْ عَصَى اللَّهَ فِيكَ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ…”. [رواه أبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ والتنبيه].
-
إحياء معنى الروابط الإنسانية والإيمانية عند الاختلاف
لا بد من إحياء معنى الروابط الإنسانية والإيمانية عند الاختلاف، فقد تختلف الأفكار والرؤى ولكن لا تختلف القلوب، ويظل حبل الود ممدودًا، قال سيدنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي: “ما رأيت أحدًا أعقل من الشافعي، لو جمعت أمة فجعلت في عقل الشافعي لوسعهم عقله، وقد ناظرته يومًا في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي، ثم قال لي يا أبا موسى لا يستقيم أن نكون إخوانًا، وإن لم نتفق في مسألة!!”. [رواه ابن عساكر في “تاريخ دمشق”].
قال الحافظ الذهبي معلقًا: “هَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ عَقْلِ هَذَا الإِمَامِ، وَفقهِ نَفْسِهِ، فَمَا زَالَ النُّظَرَاءُ يَخْتَلِفُوْنَ”. [سير أعلام النبلاء].
فإن اختلفت مع غير المسلم فحقه المجادلة بالتي هي أحسن كما امرك القرآن.
وإن اختلفت مع مسلم فله حق الأخوة الإيمانية، فلا يصح بحال أن تُكفره أو تفسقه؛ فعَنْ سيدنا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ» [رواه البخاري].
-
اختلاف الأمة في الفروع رحمة عظيمة
لا شك أنَّ الاختلاف في أصول الإيمان وثوابت الشرع مذموم شرعًا، إذ لا محل للخلاف والاجتهاد في المقرر الثابت، فعن سيدنا عَبْد اللهِ بْن عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: “هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ» [رواه مسلم].
وعَنْ سيدنا جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا» [رواه مسلم].
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: “والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز، أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز كاختلاف في نفس القرآن، أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك. وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه، ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة، وإظهار الحق، واختلافهم في ذلك، فليس منهيًا عنه بل هو مأمور به، وفضيلة ظاهرة، وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن”. ا.هـ. [شرح النووي على مسلم].
فتبين أن الخلاف في الفروع الفقهية التي اختلفت فيها رؤى كبار علماء الأمة من لدن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إلى زماننا ليس بمذموم في الشريعة، فعَن سيدنا ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «…، إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ» [رواه البيهقي في “المدخل إلى السنن الكبرى”]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اخْتِلَاف أمتِي رَحْمَة».
قال الإمام الألوسي تعقيبًا على من ضَّعف الحديثين: “ولا يخفى أنه مما لا بأس به، نعم كون الحديث ليس معروفًا عند المحدثين أصلًا لا يخلو عن شيء، فقد عزاه الزركشي في “الأحاديث المشتهرة” إلى كتاب “الحجة” لنصر المقدسي، ولم يذكر سنده ولا صحته، لكن ورد ما يقويه في الجملة مما نقل من كلام السلف، والحديث الذي أوردناه قبل وإن رواه الطبري والبيهقي في المدخل بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أنه يكفي في هذا الباب الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما. فالحق الذي لا محيد عنه: أن المراد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، ومن شاركهم في الاجتهاد كالمجتهدين المعتد بهم من علماء الدين الذين ليسوا بمبتدعين، وكون ذلك رحمة لضعفاء الأمة، ومن ليس في درجتهم مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان، ولا يتنازع فيه اثنان، فليفهم). أ.هـ. [روح المعاني].
وقال الإمام الحجة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم: “لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيرًا منه قد عمل عمله”. [جامع بيان العلم وفضله].
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: “فإن الله برحمته وطَوْله جعل سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام، وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة). [المغني].
-
لا يُنكر الاختلاف المبني على اجتهاد مقبول..ضابط مهم
فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد الناشئ عن الاختلاف في فهم النص؛ فعَنِ سيدنا ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ”. [رواه البخاري].
وعن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثه إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ» [رواه أبو داود، وأحمد].
وعن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه لقي رجلًا، فقال له: “ما صنعت؟ قال: قضى علي وزيد بكذا، قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال: فما يمنعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأي والرأي مشترك”. [جامع بيان العلم وفضله].
فانظر- رعاك الله- إلى مدى أدب سيدنا عمر واحترامه لرأي المخالف؛ لأن مبناه الاجتهاد والنظر لا الدليل الظاهر الواضح.
ومن أروع ما جاء في قبول قول المجتهد وعدم المبالغة في قدح المخالف عند الخلاف في مسألة فرعية ما جاء عن سيدنا يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: “ما برح أولو الفتوى يختلفون، فيحلّ هذا ويحرّم هذا، فلا يرى المحرِّم أنَّ المُحِلَّ هلك لتحليله، ولا يرى المُحِلّ أنَّ المحرِّمَ هلك لتحريمه” [جامع بيان العلم وفضله].
-
أهم فوائد الاختلاف المقبول
إن الاختلاف فيه فوائد كثيرة من أهمها: أن يدرك المحاور وجهة نظر المخالف فربما يكون فيها فائدة لم تخطر لأحدهما على بال، وفي الاختلاف رياضة للأذهان، وتلاقح للآراء، وتعدد للحلول، والتأكيد على أن ثقافة الإقصاء والتهميش واستخدام العنف ضد الآخر لن تصل إلى حلول مع الأطراف موضوع الحوار، ولن تصل إلى بر الأمان، وهذا لن يكون إلا من خلال الحوار العقلاني الحر المقبول موضوعيًّا وعقليًّا، وفي كل ذلك خير.
إجرات تطبيقية للتحلي بمنهج (بالتي هي أحسن)
- استحضار النية الصالحة في كل موقف، وعرضه على معيار الإخلاص.
- تعظيم شعائر الله تعالى وحرماته والعلم بأن ذلك من تقوى القلوب.
- التحلي بمكارم الأخلاق من الحلم والصبر وسعة الصدر واحترام الآخر.
- القول الحسن، وذلك بانتقاء الكلمات، واختيار الألفاظ الحسنة التي تجمع ولا تفرق، وتؤلف ولا تنفر.
- الإنصات والاستماع الجيد قبل الرد، وهو لا شك يساعد على الفهم الصحيح وعدم التسرع في الحكم.
- الابتعاد عن الجدل العقيم الذي لا فائدة منه سوى زيادة الغضب وحصول الكراهية والعداوة.
- إحسان الظن بالآخر، وهي عبادة عظيمة قل من ينتبه إليها.
- مجالسة الصالحين والاستفادة من آدابهم وطريقة معاملتهم مع الآخرين سواء الموافق أو المخالف.
- نشر مبدأ (التي هي أحسن) والإعلاء منها لتكون شعار كل إنسان سواء في أسرته أو في عمله أو مسجده أو في تجارته.
- سؤال أهل العلم في مواطن الخلاف فيما يتعلق بالأمور الفقهية.
اللهم آلف بيننا، وأصلح فساد قلوبنا، وأجمع كلمتنا، ووحد صفنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
-
الخطبة الثانية: التحرش آفة قبيحة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن التحرش من أكثر الجرائم الأخلاقية والاجتماعية فتكًا بنسيج المجتمع وأمانه، فهو لا يمس ضحاياه فقط، بل يهدم قيم الاحترام المتبادل، ويقوّض الثقة بين أفراد المجتمع، ويزعزع الشعور العام بالأمن. وتكمن خطورته في أنه يتجاوز الفعل الجسدي أو اللفظي ليصير سلوكًا عدوانيًا ممنهجًا، يعكس انحرافًا نفسيًا وتربويًا حادًا. ومن هذا المنطلق، تولي حملة “صحح مفاهيمك” هذا الموضوع أهمية قصوى، باعتباره سلوكًا مرفوضًا دينيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، يتطلب معالجة شاملة تستند إلى الوعي والردع وإعادة بناء المفاهيم.
ويؤكد الخطاب الشرعي أن كرامة المرأة مصونة، وأن الأذى اللفظي أو الجسدي لها يُعد عدوانًا صريحًا على ما أمر الله بحفظه.
إن التحرش آفة مجتمعية يجب على المجتمع أن يتنزه عنها، ولنا في بيان ذلك عدة أمور:
-
الخلق الحسن عنوان المسلم
أرشدنا القرآن إلى أن نحسن أخلاقنا مع شركاء المجتمع، سواء كانوا مؤمنين أو غير ذلك، وسواء بادلونا بالإحسان إحسانا أم لا، ووضحنا سابقا كيف أن الله تعالى أمرنا بأن نقول للناس حسنا، ووجهنا إلى التزام هذا الأمر حتى وإن كان من نعامله على خلافه، فهناك فارق بين من يلتزم بالأمر الرباني بالخلق الحسن كما أمر الله تعالى وإن واجهنا في ذلك ما لا ترضاه نفوسنا، وبين من يلتزم الأخلاق بنا على ما تعود عليه من منافع!
وعفة المؤمن من جملة المحاسن التي ينبغي عليه أن يلتزمها وأن يسلك سبيلها كما أوضحه القرآن وبينته السنة النبوية.
-
غض البصر أمر إلهي واجب الاتباع
سواء تبرجت المرأة أم لم تتبرج فالرجل مأمور بغض بصره على الدوام، قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} الآية [النور: ٣٠] ثم قال بعدها: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ …}.
فإن اتفق أن وقع النظر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعًا، كما روي عن عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنه قَالَ : “سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ ؟ ” فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي”. [أخرجه مسلم].
وقال رسول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليس لك الآخرة».
وفي «الصحيح» عن أبى سعيد قال: قال رسول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إياكم والجلوس في الطرقات»، قالوا: يا رسول اللَّه، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها، فقال رسول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللَّه؟ قال: «غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر»، ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب، لذلك أمر اللَّه بحفظ الفروج، كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك.
-
بذاءة اللسان تغضب الرحمن
ونعني بها ما يذكره الإنسان بلسانه من الأمور المنافية للعفة والطهارة، ومن ذلك التحرش باللسان، وذكر مفاتن المرأة، والتعليقات الجنسية، والملاحقة بالإلحاح في طلب الحديث أو الصداقة، والتلميحات البذيئة مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
-
العلاج لمن ابتلي بهذه المصيبة
١- الابتعاد عن الأسباب التي تيسر لك الوقوع في هذه المعصية وتذكرك بها مثل:
- إطلاق البصر، والنظر إلى النساء، سواء في الطرق أو عبر الشاشات.
- العزلة والخلوة، فقد يزين لك الشيطان وتسول لك النفس فعل هذا المنكر.
- الجلوس مع رفقاء السوء.
٢- اشغل نفسك دائمًا بما ينفعك في دينك أو دنياك كما قال الله تعالى: {فإذا فرغت فانصب} فإذا فرغت من عمل في الدنيا فاجتهد في عمل من عمل الآخرة كذكر الله وتلاوة القرآن وطلب العلم وسماع الأشرطة النافعة …
وإذا فرغت من طاعة فابدأ بأخرى، وإذا فرغت من عمل من أعمال الدنيا فابدأ في آخر … وهكذا، لأن النفس أن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ، فلا تدع لنفسك فرصة أو وقت فراغ تفكر في هذه الفاحشة.
٣ – قارن بين ما تجده من لذة أثناء هذه الفاحشة، وما يعقب ذلك من ندم وقلق وحيرة تدوم معك طويلًا ، ثم ما ينتظر فاعل هذه الفاحشة من عذاب في الآخرة ، فهل ترى أن هذه اللذة التي تنقضي بعد ساعة يقدمها عاقل على ما يعقبها من ندم وعذاب ، ويمكنك لتقوية القناعة بهذا الأمر والرضا به القراءة في كتاب ابن القيم ( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ) فقد ألفه رحمه الله لمن هم في مثل حالك – فرج الله عنا وعنك – .
٤- العاقل لا يترك شيئًا يحبه إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه، وهذه الفاحشة تفوت عليك نعيم الدنيا والآخرة، وتفوّت محبة الله لك، وتستحق بها غضب الله وعذابه ومقته.
فقارن بين ما يفوتك من خير، وما يحصل لك من شر بسبب هذه الفاحشة، والعاقل ينظر أي الأمرين يقدّم.
٥- وأهم من ذلك كله: الدعاء والاستعانة بالله عز وجل أن يصرف عنك هذا السوء، واغتنم أوقات الإجابة وأحوالها، كالسجود، وقبل التسليم من الصلاة، وثلث الليل الآخر، ووقت نزول المطر، وفي السفر، وفي الصيام، وعند الإفطار من الصيام، وعند زيارة الصالحين.
٦- مجالسة الصالحين والإكثار من مخالطتهم سواء في المسجد أو زيارتهم في بيوتهم أو الحديث إليهم عبر الهاتف وغير ذلك من الوسائل.
ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يتوب علينا، ويجنبنا وأهلينا والناس جميعًا سوء الأعمال والأخلاق آمين.
مراجع للاستزادة:
- الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي.
- أدب الحوار في الإسلام لمحمد سيد طنطاوي.
- أدب الاختلاف لعبد الله بن بيّه.
- أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين لمحمد عوامة.
_____________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
وللإطلاع علي قسم خطبة الجمعة
وللإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف










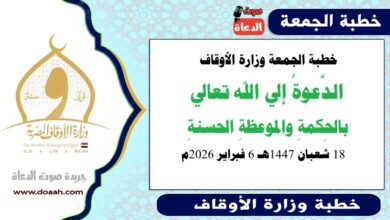


جزاكم الله خيرا على تشكيل الموضوع