خطبة الجمعة القادمة 19 سبتمبر : الرسول المعلم ﷺ ، للدكتور محروس حفظي
بتاريخ 27 ربيع الأول 1447هـ ، الموافق 19 سبتمبر 2025م

خطبة الجمعة القادمة
خطبة الجمعة القادمة 19 سبتمبر 2025م بعنوان : الرسول المعلم ﷺ ، للدكتور محروس حفظي بتاريخ 27 ربيع الأول 1447هـ ، الموافق 19 سبتمبر 2025م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 19 سبتمبر 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : الرسول المعلم ﷺ .
ولتحميل خطبة الجمعة القادمة 19 سبتمبر 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : الرسول المعلم ﷺ ، بصيغة word أضغط هنا.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 19 سبتمبر 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : الرسول المعلم ﷺ ، بصيغة pdf أضغط هنا.
___________________________________________________________
عناصر خطبة الجمعة القادمة 19 سبتمبر 2025م بعنوان : الرسول المعلم ﷺ ، للدكتور محروس حفظي :
(1) فضل العلم والتعلم.
(2) اكتشف مواهب طفلك، وارعها، واصقلها بالتدريب، ولا تجعل الفقر أو الظروف عائقاً.
(3) تحمل المشاق في سبيل طلب العلم.
(4) التزام الأدب، والتواضع في طلب العلم.
(5) سيدنا النبي – صلى الله عليه وسلم- يسأل ربه العلم النافع.
(6) أخبر القرآن الكريم عن نماذج كثيرة سخروا العلم لبناء الإنسان دينياً وحضارياً.
(7) السبل الصحيحة في تحصيل العلم.
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 19 سبتمبر 2025م بعنوان: الرسول المعلم ﷺ ، للدكتور محروس حفظي : كما يلي:
الرسول المعلم ﷺ
بتاريخ 27 ربيع الأول 1447ه = الموافق 19 سبتمبر 2025 م
الحمد لله حمداً يوافي نعمه، ويكافىء مزيده، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أما بعد ،،،
(1) فضل العلم والتعلم:
– قال الإمام الغزالي: ({إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28] فانظر كيف بدأ سبحانه بنفسه، وثنى بالملائكة، وَثَلَّثَ بأهل العلم، وناهيك بهذا شرفاً وفضلاً وجلاء ونبلاً…، العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأبرار، والدرجات العُلَى، والتفكر فيه يُعْدَلُ بالصيام، ومدارسته بالقيام به، به يطاع الله، وبه يعبد وبه يوحد وبه يمجد، وبه يُتَوَرَّعُ، وبه تُوصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، وهو إمام، والعمل تابعه، يُلْهَمُهُ السعداء، ويُحْرَمه الأشقياء). أ.ه. (إحياء علوم الدين).
– عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ» (رواه ابن ماجه).
– قال أبو الدرداء – رضي الله عنه-: “لَأَنْ أَتَعَلَّمَ مَسْأَلَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ ليلة”. وقال أيضاً: “من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد، فقد نقص في رأيه وعقله”. (إحياء علوم الدين).
– قال ابن عبد الحكم -رحمه الله-: “كنت عند مالك أقرأ عليه العلم، فدخل الظهر، فجمعت الكتب لأصلي فقال: يا هذا ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه إذا صحت النية”. (إحياء علوم الدين).
(2) اكتشف مواهب طفلك، وارعها، واصقلها بالتدريب، ولا تجعل الفقر أو الظروف عائقاً:
– “ظاهرة النبوغ”: حفلت كتب “التراجم والسِّيَر” عن ظهور ثلة مباركة من العلماء نبغوا في سن مبكرة:
(أ) الإمام مالك ابن أنس: قال الذهبي: “طلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة، وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة، وحدث عنه جماعة وهو شاب طري”. [سير أعلام النبلاء للذهبي].
(ب) الإمام الشافعي: قَالَ: “حفظت القرآن، وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ، وأنا ابن عشر سنين، وما أفتيت حتى حفظت عشرة آلاف حديث…، وأفتى وله خمس عشرة سنة”. [المنتظم في تاريخ الأمم والملوك].
– نشأ الشافعي فقيراً لا مال له، ومع ذلك لم يمنعه فقره من التحصيل والتصدر والنبوغ، والتأهل للتدريس بل في سن مبكرة، وبات “مجدِّداً” على رأس المئة الثالثة للهجرة.
قال الإمام الشافعي: “كنت يتيماً في حِجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب، وأخفف عنه”. [سير أعلام النبلاء للذهبي].
(ج) الإمام البخاري: سأـله محمد بن أبي حاتم الورَّاق: “كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال: ألهِمت حفظ الحديث وأنا في الكُتَّاب؛ قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنين أو أقل”. [تاريخ بغداد وذيوله].
(د) لم يكن النبوغ في الصغر مقتصراً على علماء الشريعة فحسب، بل كان في الأطباء والفلاسفة، ومن هؤلاء: الشيخ الرئيس “ابن سينا”: قال: “وأكملت العشر من العمر، وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كان يُقضى مني العجب…، ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسي، وأطالع الشروح حتى أحكمت “علم المنطق”، ثم رغبت في علم الطب، وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه، فلا جَرَمَ أني برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرؤون عليَّ “علم الطب”، وتعهدت المرضى، فانفتح عليَّ من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف، وأنا مع ذلك اختلف إلى الفقه، وأناظر فيه، وأنا في هذا الوقت من أبناء “سِت عشرة سنة” ثم توفرت على العلم والقراءة سنةً ونصفاً، فأعدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة”،- بل علت همته للاطلاع على سائر العلوم- حيث قال: “وأتيت على سائر العلوم، ولي إذْ ذاك إحدى وعشرون سنة من عمري”. (عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة).
(3) تحمل المشاق في سبيل طلب العلم: ركب موسى– عليه السلام-، البحر في طلب العلم، وقد بوَّب “البخاري”، “كتاب العلم”: “باب ركوب البحر في طلب العلم”، وساق حديث ابن عباس: “بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ “قَالَ مُوسَى: لاَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الحُوتِ فِي البَحْرِ، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ” (البخاري).
– حفلت كتب “التاريخ” بذكر ثلة من العلماء بذلوا أنفسهم في سبيل تحصيل العلم:
(أ) عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ المَدِينَةِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَهُوَ بِدِمَشْقَ فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي؟ فَقَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: مَا جِئْتُ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الحَدِيثِ”. (رواه البيهقي في “شعب الإيمان”).
(ب) سافر جابر بن عبد الله شهراً كاملاً في طلب حديث واحد من المدينة إلى “عَبْد اللَّهِ بْن أُنَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ” في مصر في العريش، فخرج، وعانقه، “فَقُلْتُ: حَدِيثًا بَلَغَنِي أَنَّكَ سَمِعَتَهُ مِنْ النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْمَظَالِمِ لَمْ أَسْمَعْهُ فَخَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ أَوْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ». (رواه البخاري في “الأدب المفرد”).
(4) التزام الأدب، والتواضع في طلب العلم: كان سلفنا الصالح يحثون أبناءهم على طلبه منذ نعومة أظفارهم، فكانوا يتركون لذة النوم، ويهجرون المضاجع، قالوا لابن عباس رضي الله عنهما: “كيف حصلت العلم؟ قال: “كنت أخرج في الظهيرة في شدة الحر، فأذهب إلى بيوت الأنصار، فأجد الأنصاري نائماً، فلا أطرق عليه بيته، فأتوسد بُرْدي عند باب بيته، فتلفحني الريح بالتراب، فيستيقظ الأنصاري، ويقول: يا ابن عم النبي– صلى الله عليه وسلم- ألا أيقظتني أُدْخِلك؟ فأقول: أخاف أن أزعجك”.
– قصة موسى – عليه السلام- نلمح فيها حسن الأدب، وجميل التواضع الذي يجب أن يتحلى به التلميذ مع أستاذه: {قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: 66].
قال الإمام الفخر الرازي: (دلَّت هذه الآية على أنَّ موسى- عليه السلام- راعى أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلَّم من الخضر، أحدها: أنه جعل لنفسه تبعاً له في قوله: {هَلْ أَتَّبِعُكَ}، ثانيها: أنَّه استأذن في إثباتِ هذه التبعيَّة؛ كأنَّه قال: تأذنُ لي على أن أجعل نفسي تبعاً لك، وهذه مبالغة عظيمة في التواضع. ثالثها: قوله: {عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ} وهذا إقرار منه على نفسه بالجهل، وعلى أستاذه بالعلم. رابعها: قوله: {مِمَّا عُلِّمْتَ} وصيغة «مِنْ» للتبعيض، فطلب منه تعليم بعض ما علِّم، وهذا أيضاً إقرار بالتواضع، كأنه يقول: لا أطلب منك أن تجعلني مساوياً لك في العلم، بل أطلب منك أن تعطيني جزءاً من الجزء، مما علِّمت. خامسها: قوله: {هَلْ أَتَّبِعُكَ} يدل على طلب متابعته مطلقاً في جميع الأمور غير مقيَّد بشيءٍ دون شيءٍ. سادسها: قوله: {هَلْ أتَّبِعُكَ} لم يطلب على المتابعة إلاَّ التعليم، كأنه قال: لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه، ولا عوض لي إلاَّ طلب العلم). أ.ه. (مفاتيح الغيب باختصارٍ).
(5) سيدنا النبي – صلى الله عليه وسلم- يسأل ربه العلم النافع: – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: فِي دُبُرِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا» (رواه ابن ماجه، وأحمد).
-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا» (رواه الترمذي).
– {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114].
– قال سفيان بن عُيَيْنَة: “ولم يزل- صلى الله عليه وسلم- في زيادة من العلم حتى توفاه الله”. (تفسير القرآن العظيم).
– قال الإمام الزمخشري: (متضمن للتواضع لله، والشكر له عند ما علم من ترتيب التعلم، أي: علمتني يا رب لطيفة في باب التعلم، وأدباً جميلاً ما كان عندي، فزدني علماً إلى علم، فإنًّ لك في كل شيء حكمة وعلماً. وقيل: ما أمر الله رسوله- صلى الله عليه وسلم- بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم) . أ.ه. (الكشاف عن حقائق التنزيل).
(6) أخبر القرآن الكريم عن نماذج كثيرة سخروا العلم لبناء الإنسان دينياً وحضارياً: سليمان- عليه السلام- لما استبطأ إحضاره عرش “ملكة بلقيس”، نهض جندي من جنوده هو “آصف بْن برخيا بن سمعيا”- وَكَانَ رجلاً صديقاً فِي بني إِسْرَائِيل، يعلم اسم الله الأعظم-؛ وسخر علمه لنفع البشرية {قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ} [النمل: 40].
قال مولانا أ.د/ طنطاوي: (وهو كناية عن السرعة الفائقة في إحضاره، وفي ذلك ما فيه من الدلالة على شرف العلم وفضله، وشرف حامليه، وفضلهم، وأن هذه الكرامة التي وهبها الله لهذا الرجل، كانت بسبب ما آتاه من علم). (التفسير الوسيط).
(7) السبل الصحيحة في تحصيل العلم:
– لخص الإمام الشافعي – رضي الله عنه- ذلك فقال:
أَخِي لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ إلَّا بِسِتَّةٍ… سَأُنْبِيكَ عَنْ مَكْنُونِهَا بِبَيَانِ
ذَكَاءٍ وَحِرْصٍ وَاجْتِهَادٍ وَبُلْغَةٍ … وَإِرْشَادِ أُسْتَاذٍ وَطُولِ زَمَانِ
أولاً: الإخلاص في طلب العلم: ينبغي تصحيح النية في طلب العلم بأن يكون خالصاً لوجه الله، وأن يوجه لخدمة الوطن والإنسانية {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} [العلق: 1: 3].
﴿اقرأ﴾: تعلم، واكتشف، باسم ربك لا باسم الهوى، ولا النزعة المادية الطاغية، لا باسم القوة والتسلط على البشرية.
قال الهرري الشافعي: (أمره بذلك؛ لأن ذكر اسم الله قوة له في القراءة، وأنس بمولاه، فإن الإنس بالاسم يُفضي إلى الإنس بالمسمى، والذكر باللسان يؤدي إلى الذكر بالجنان) أ.ه. (حدائق الروح والريحان).
قال سُفْيَان الثَّوْرِي: «كُنَّا نَطْلُبُ الْعِلْمَ لِلدُّنْيَا فَجَرَّنَا إِلَى الْآخِرَةِ». [جامع بيان العلم، وفضله].
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَيَأْبَى عَلَيْهِ الْعِلْمُ حَتَّى يَكُونَ لِلَّهِ» [جامع بيان العلم، وفضله].
ثانياً: انْتِقاء المادة العلمية، وعدم تضييع الوقت في قراءة كتابات مجهولة القيمة: القرآن الكريم يخبرنا أنه اشتمل على أحسن القصص، وأصدقها في زمن سادت فيه الأساطير والأباطيل {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ} [يوسف: 3]؛ ليلفت انتباه السامع إلى انتقاء ما يتلقاه من أخبار، وما يتحصل عليه من معلومات، فيعرض عمَّا لا يحقق له الثمرة المرجوة، والفائدة المنشودة .
– عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ» (رواه ابن ماجه).
– قال الإمام الشاطبي: (الطريق الثاني: مطالعة كتب المصنفين، ومدوني الدواوين وهو أيضاً نافع في بابه بشرطين:
الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب، ومعرفة اصطلاحات أهله، ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول، ومن مشافهة العلماء، أو مما هو راجع إليه. الثاني: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإنهم أَقْعَدُ به من غيرهم من المتأخرين) [الموافقات1/139].
ثالثاً: الأخذ والتلقي عن العلماء المتخصصين الذين أفنوا أعمارهم في تحصيله: قال الإمام الشاطبي: (من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به “أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام”…، وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا؟ فالإمكان مُسَلَّمٌ ولكن الواقع في مجاري العادات أن لا بد من المُعلِّم، وهو متفق عليه في الجملة…، واتفاق الناس على ذلك في الوقوع، وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه، وقد قالوا: “إِنَّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ”. وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال؛ إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم، وأصل هذا في الصحيح: “إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ”، فإذا كان كذلك فالرجال هم مفتاحه بلا شك) [الموافقات1/139].
– أخذ العلم عن أهله من أصحاب السند المتصل من أعظم المزايا التي اختص الله بها هذه الأمة.
– عبر الإمام مسلم في “صحيحه” عن أهمية ذلك، فوضع باباً كاملاً بعنوان: “باب بيان أن الإسناد من الدين”، ثم ذكر سنده في هذا القول. فقال: “وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو، قال: سمعت عبدان بن عثمان يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: “الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء”. [صحيح مسلم].
– عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ». [صحيح مسلم].
– قال ابن حجر: (وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب) أ.ه. [فتح الباري].
– ورد التحذير ممن ليسوا أهلاً للعلم؛ لأنه ينتج عنه عدم وجود منهجية علمية واضحة، تسفيه أهل العلم، والتقليل من شأنهم، ونتاجهم العلمي، والتعصب الأعمى، والإرهاب الفكري، والتصدر قبل التمكن.
– عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ – يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ – فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ، ثُمَّ حَدَّثَهُ، فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا أَدْرِي أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ، وَأَنْكَرْتَ هَذَا؟ أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ، وَعَرَفْتَ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ». [صحيح مسلم].
رابعاً: التدرج في التعلم: تبدأ بكتب المبتدئين في كل فن من فنون العلم ثم الشروح حتى تصل إلى المطولات.
– قال ابن شهاب- رحمه الله- يوصي يونس بن يزيد: “يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قُطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام، والليالي، ولا تأخذ العلم جملة؛ فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام، والليالي”. [جامع بيان العلم، وفضله].
– قال الماوردي- رحمه الله-: “إن للعلم أوائل تؤدي إلى أواخرها، ومداخل تفضي إلى حقائقها، فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها، وبمداخلها لتفضي إلى حقائقها، ولا يطلب الآخر قبل الأول، ولا الحقيقة قبل المدخل، فلا يدرك الآخر، ولا يعرف الحقيقة؛ لأن البناء على غير أساس لا يُبنى، والثمر من غير غرس لا يُجنى”. [أدب الدنيا، والدين].
– قال الإمام ابن عبد البر- رحمه الله-: “طلب العلم درجات، ومناقل، ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف – رحمهم الله – ومن تعدى سبيلهم عامداً ضل، ومن تعداه مجتهداً زل”. [جامع بيان العلم، وفضله].
خامساً: حضور الندوات واللقاءات العلمية: – نُعيم المُجْمِر- رحمه الله- جالس أبا هريرة – رضي الله عنه- عشرين سنة متوالية. [سير أعلام النبلاء للذهبي].
– عبد الله بن نافع جالس الإمام مالكًا- رحمه الله- خمسًا وثلاثين سنة. [سير أعلام النبلاء للذهبي].
سادساً: إن لم تسعفك الظروف، فتناوب مع غيرك في تحصيل العلم: بوب “الإمام البخاري”، “باب التناوب في العلم”؛ فعَنْ عُمَرَ، قَالَ: «كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ». [البخاري].
قال ابن حجر: (وفي الحديث أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه؛ ليستعين على طلب العلم وغيره مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته لما علم من حال عمر –رضي الله عنه- أنه كان يتعاطى التجارة). أ.ه. [فتح الباري].
سابعاً: لا تستصعب طلب العلم: كثير من العلماء لم يبتدئ الجد في الطلب إلا بعد كبر السن:
– أمر الله يحيى – عليه السلام- أن يأخذ “التوراة” التي أنزلها على موسى- عليه السلام- بجد واجتهاد: {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} [مريم: 12] حتى قيل: دعاه “الصبيان إلى اللعب وهو صبى فقال: ما للعب خلقنا”. (جامع البيان للطبري).
– قال الإمام الغزالي: (وأخذه بالجد أن يكون متجرداً له عند قراءته منصرف الهمة إليه عن غيره). (إحياء علوم الدين).
– قال الفخر الرازي: (قوله: “بِقُوَّةٍ”: ليس المراد منه القدرة على الأخذ؛ لأن ذلك معلوم لكل أحدٍ، فيجب حمله على معنى يفيد المدح، وهو “الجِد، والصبر على القيام بأمر النبوة، وحاصلها يرجع إلى حصول ملكة تقتضي سهولة الإقدام على المأمور به، والإحجام عن المنهي عنه). أ.ه. (مفاتيح الغيب).
– قال سيدنا عمر بن الخطاب: «تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا»، قال أبو عبد الله البخاري: «وبعد أن تُسَوَّدُوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم». [صحيح البخاري].
– “الإمام الكسائي”: كان راعياً للغنم حتى بلغ الأربعين من عمره، ثم طلب العلم، واشتهر، وصار إماماً في اللغة، والقراءات. [نزهة الألباء في طبقات الأدباء للأنباري].
– الإمام أبو بكر المروزي “القفال”: “حذق في صنعة الأقفال، فلما صار ابن ثلاثين سنة، آنس من نفسه ذكاء مفرطاً، وأحب الفقه، فأقبل على قراءته حتى برع فيه، وصار يضرب به المثل”. [سير أعلام النبلاء للذهبي].
– ومنهم أيضاً: الأعرج يحيى بن زكريا بن يحيى النيسابوري (ت 137 هـ)، وغنجار عيسى بن موسى البخاري (ت 186 هـ)، والفضيل بن موسى بن عياض (ت 187 هـ)، وحسن بن زياد حسن بن زياد اللؤلؤي (ت 204 هـ)، وأصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي (ت 225 هـ)، وأبو محمد علي بن حزم (ت 456 هـ)، والسَّكَّاكي (ت:662ه)، وسلطان العلماء “العز بن عبد السلام” (ت: 660هـ)، وأبو حيان الأندلسي (ت: 745هـ).
ثامناً: يهيئ الإنسان عقله، ونفسه؛ للاطلاع على معارف جديدة: قد تغير بعض ما لديه من مخزون علمي، وثقافي، كان يعتقد أنه من الثوابت التي لا تحتمل النقاش والجدال، فكلما أبحر المرء في العلم والمعرفة، كلما قل اختلافه وإنكاره، ويسلم – إن كان منصفاً- بصحة ما اطلع عليه، ومن ثم يتراجع عما هو عليه من أفكار ومفاهيم خاطئة.
– أخبر القرآن أن الخلق في “تحصيل العلم” درجات إلى أن ينتهي العلم للعليم {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76].
عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: “يكون هذا أعلم من هذا، وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم حتى ينتهي العلم إلى الله، منه بُدي، وتعلمت العلماء، وإليه يعود”. [تفسير القرآن العظيم لابن كثير].
تاسعاً: أن يتخير أوقات النشاط، والحيوية: ورد عن الخطيب البغدادي أنه قال: “أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداة، وحفظ الليل أحسن من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع”.
وقال إسماعيل بن أبي أويس: “إذا هممت أن تحفظ شيئاً فنم، ثم قم عند السحر، فأسرج، وانظر فيه، فإنك لا تنساه بعد”. وكان الإمام الشافعي – رضي الله عنه- “يقسم الليل ثلاثة أجزاء: ثلث للعلم، وثلث للعبادة، وثلث للنوم”.
عاشراً: عدم استعجال الثمرة، والأخذ بخبرات الآخرين: التعلم تحتاج إلى صبر قال ابْنِ مَسْعُودٍ: «فَعَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَأْدُبَةِ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ» (رواه البزار، ورجاله موثقون).
– يحتاج العلم إلى وقت طويل حتى تظهر نتيجة غرسه، فقد مكث ابن حجر في تأليف “فتح الباري” خمسة وعشرين عامًا، وابن عبد البر مكث في تأليف “التمهيد” ثلاثين عامًا، والإمام البخاري استغرق في تحرير “الجامع الصحيح” “ستة عشر عاماً”.
– لما تعجل موسى – عليه السلام- حرم من مطالعة الأسرار مع “الخَضِر” قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا» (متفق عليه).
– ما أعظم أن يضم إلى علمه علم الآخرين، ويستفيد من خبراتهم فعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ:«مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ، وَكُلُّ طَالِبِ عِلْمٍ غَرْثَانُ إِلَى عِلْمٍ». (رواه الدرامي في “سننه”، إسناده صحيح).
حادي عشر: صحبة العلماء، والاطلاع على مسيرة العظماء: مرافقة الصالحين، ينعكس إيجاباً على حال المقربين منهم.
– كلمت فترت العزيمة، فلينظر في حياة العظماء، ومن علت همته لم يقنع بالدون، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.
– حث الإسلام على مجالسة أهل العلم؛ لأنهم يحيون القلوب، ويسموا بالنفس نحو المعالي؛ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ عَلَيْكَ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ، وَاسْمَعْ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَيُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ، كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ الْمَطَرِ» (رواه الطبراني في “المعجم الكبير”، وقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: سَنَدُهُ حَسَّنَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ مَوْقُوفٌ) أ.ه.
ثاني عشر: لا تتوقف عن طلب العلم ممها عظم شأنك: الإنسان لا يكف عن طلب العلم، فأمامه الكثير ليكتشفه؛ فعن أُبَيَّ بْن كَعْبٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “…، وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ”. (رواه مسلم).
وإلا كان الاغترار بالعلم طريق للهلاك، وقد حكى الله في كتابه الحكيم عن أقوام كان عاقبتهم ذلك {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} [غافر: 83].
– قال صالح بن أحمد بن حنبل، قال: «رأى رجل مع أَبي مِحْبَرَة، فقال له: يا أَبا عبد الله، أَنت قد بلغت هذا المبلغ، وأَنت إِمامُ المسلمين. فقال: مع المِحبرة إلى المَقْبرة». (مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي).
نسأل الله أن يرزقنا حسن العمل، وفضل القبول، إنه أكرم مسؤول، وأعظم مأمول، وأن يجعل بلدنا مِصْرَ سخاءً رخاءً، أمناً أماناً، سلماً سلاماً وسائر بلاد العالمين، ووفق ولاة أُمورنا لما فيه نفع البلاد والعباد .
كتبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان د / محروس رمضان حفظي عبد العال
مدرس التفسير وعلوم القرآن – كلية أصول الدين والدعوة – أسيوط
_____________________________________
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف












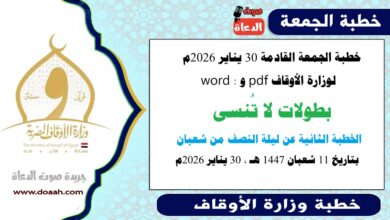



الدكتور /محروس حفظي يبذل جهدا مشكورا في إعداد خطبة الجمغة وهو يقدم معلومات قيمة وافكارا صائبة
استفتح خطبة اليوم بآية(انما يخشى الله من عباده العلماء) ثم تفضل بشرح آية اخري (شهدالله انه لا اله الاهو والملائكة واولوالعلم قائما بالقسط)
لذا لزم التنويه