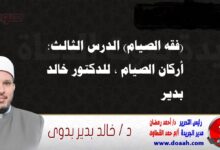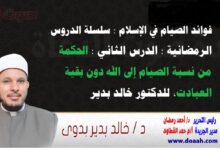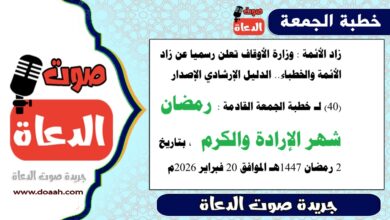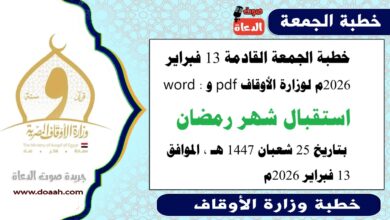خطبة الجمعة القادمة للدكتور أحمد رمضان : إدمان الأطفال السوشيال ميديا
بتاريخ 16 جمادي الأولي 1447هـ ، الموافق 7 نوفمبر 2025م
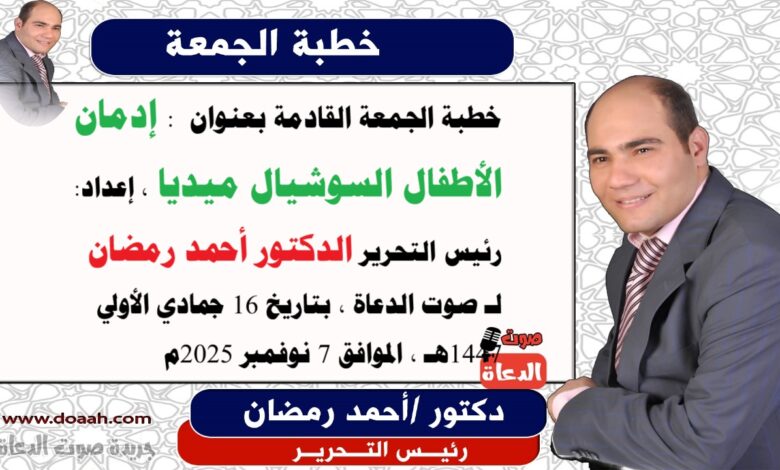
خطبة الجمعة القادمة بعنوان : إدمان الأطفال السوشيال ميديا ، إعداد: رئيس التحرير الدكتور أحمد رمضان لـ صوت الدعاة ، بتاريخ 16 جمادي الأولي 1447هـ ، الموافق 7 نوفمبر 2025م.
حصريا ل صوت الدعاة لتحميل خطبة الجمعة القادمة 7 نوفمبر 2025م بصيغة word بعنوان : إدمان الأطفال السوشيال ميديا ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان لـ صوت الدعاة.
انفراد لتحميل خطبة الجمعة القادمة 7 نوفمبر 2025م بصيغة pdf بعنوان : إدمان الأطفال السوشيال ميديا ، للدكتور أحمد رمضان.
عناصر خطبة الجمعة القادمة 7 نوفمبر 2025م بعنوان : إدمان الأطفال السوشيال ميديا ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان.
العُنْصُرُ الأَوَّلُ: الوَقْتُ أَمَانَةٌ وَمَسْؤُولِيَّةٌ أَمَامَ اللهِ
العُنْصُرُ الثَّانِي: نِعْمَةُ الأَبْنَاءِ وَمَسْؤُولِيَّةُ التَّرْبِيَةِ أَمَامَ اللهِ
العُنْصُرُ الثَّالِثُ: فِطْرَةُ الطِّفْلِ بَيْنَ الحِفَاظِ وَالتَّشْوِيهِ فِي زَمَنِ السُّوشِيَال مِيدْيَا
العُنْصُرُ الرَّابِعُ: سُبُلُ وِقَايَةِ الأَبْنَاءِ مِنَ الإِدْمَانِ وَالتَّغْرِيبِ
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة نوفمبر 2025م : إدمان الأطفال السوشيال ميديا ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان : كما يلي:
إدمان الأطفال السوشيال ميديا
16 جمادي الأولي 1447هـ – 7 نوفمبر 2025م
إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
المـــوضــــــــــوع
الحمدُ للهِ الذي سخّر لعبادِهِ ما في السماواتِ وما في الأرضِ، وأنعمَ علينا بنعمٍ لا تُحصى ولا تُعدّ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن سيّدَنا محمّدًا عبدُه ورسولُه، أدّبَه ربُّه فأحسنَ تأديبَه، وهداهُ إلى صراطٍ مستقيمٍ، صلّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ. أمّا بعدُ:
عناصر الخطبة:
العُنْصُرُ الأَوَّلُ: الوَقْتُ أَمَانَةٌ وَمَسْؤُولِيَّةٌ أَمَامَ اللهِ
العُنْصُرُ الثَّانِي: نِعْمَةُ الأَبْنَاءِ وَمَسْؤُولِيَّةُ التَّرْبِيَةِ أَمَامَ اللهِ
العُنْصُرُ الثَّالِثُ: فِطْرَةُ الطِّفْلِ بَيْنَ الحِفَاظِ وَالتَّشْوِيهِ فِي زَمَنِ السُّوشِيَال مِيدْيَا
العُنْصُرُ الرَّابِعُ: سُبُلُ وِقَايَةِ الأَبْنَاءِ مِنَ الإِدْمَانِ وَالتَّغْرِيبِ
في عصرِنا الحديثِ برزت وسائلُ التواصلِ الإلكترونيِّ ومواقعُ السوشيال ميديا، فصارت تلامسُ كلَّ بيتٍ، وتؤثّرُ في كلِّ نفسٍ، وتتدخّلُ في تفاصيلِ الحياةِ صغيرِها وكبيرِها.
وإنّه لا شكَّ أنّها نعمةٌ عظيمةٌ إذا وُظّفت في الخيرِ، ولكنّها قد تكونُ بلاءً وفتنةً إذا أسيءَ استعمالُها، وتحولت من وسيلةٍ للبناءِ إلى أداةٍ للهدمِ والضياعِ. وصارتِ الشاشةُ التي كانتْ وسيلةَ تعلمٍ ومعرفةٍ، مصدرًا للغفلةِ والإدمانِ، خاصةً لدى أطفالٍ لا يعرفونَ من الدنيا إلا ألوانَها وصورَها.
العُنْصُرُ الأَوَّلُ: الوَقْتُ أَمَانَةٌ وَمَسْؤُولِيَّةٌ أَمَامَ اللهِ
أيها المؤمنونَ… إن من أعظمِ النعمِ التي منحَ اللهُ بها الإنسانَ نعمةَ الوقتِ، فهو مادةُ العمرِ، وميدانُ العملِ، ورأسُ مالِ الحياةِ. فيه تُزرعُ البذورُ، وتُكتسبُ الدرجاتُ، وتُبنى الأعمالُ التي بها يُخلَّدُ الذكرُ أو يُمحى الأثرُ.
قالَ اللهُ تعالى: {والعصرِ * إنَّ الإنسانَ لفي خسرٍ * إلَّا الذينَ آمنوا وعملوا الصالحاتِ وتواصوا بالحقِّ وتواصوا بالصبرِ} [العصر: 1-3]. وقالَ الإمامُ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ: «لو ما أنزلَ اللهُ على خلقِهِ حجّةً غيرَ هذه السورةِ لكفتْهم؛ لأنها جمعتْ علمَ الأولينَ والآخرينَ» (تفسير الإمام الشافعي ج3، ص1461).
لقد أقسمَ اللهُ بالزمنِ ليُعلِّمَنا أنَّ إضاعتهُ خسرانٌ لا يعادلهُ شيءٌ. واليومَ ظهرَ سارقٌ جديدٌ للأعمارِ اسمهُ «الإدمانُ الرقميُّ»؛ ساعاتٌ تتساقطُ خلفَ شاشةٍ صغيرةٍ، وقلوبٌ تفرغُ من الذكرِ، وعقولٌ تُشغلُ بما لا ينفعُ، وطفلٌ يحصي «الإعجاباتِ» ولا يحصي «الصلواتِ»، ويعدُّ «المشاهداتِ» ولا يعدُّ «الحسناتِ”.
قالَ النبيُّ ﷺ: «نعمتانِ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناسِ: الصحّةُ والفراغُ» (البخاري، الرقاق، رقم 6412).
والمغبونُ هنا هو الذي باعَ وقتَهُ بثمنٍ بخسٍ، يستبدلُ دقائقَ الطاعةِ بلقطاتٍ عابرةٍ، ويُعطي قلبَهُ لخوارزميةٍ لا ترحمُ ولا تهدي.
إن الوقتَ أمانةٌ لا تُشترى، ولا تُعوَّضُ إذا فاتتْ لحظاتُها، وهو من أعظمِ ما يُسألُ عنهُ العبدُ يومَ القيامةِ. قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: “لا تزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامةِ حتّى يُسألَ عن عمرِهِ فيما أفناهُ، وعن علمِهِ ما عملَ فيهِ، وعن مالِهِ من أينَ اكتسبَهُ وفيمَ أنفقَهُ، وعن جسمِهِ فيما أبلاهُ» (الترمذي، صفة القيامة، رقم 2417، حسنٌ صحيح).
أقوال الصالحينَ تشحذُ العزمَ: قالَ الحسنُ البصريُّ رحمهُ اللهُ: «يا ابنَ آدمَ، إنما أنتَ أيامٌ، فإذا ذهبَ يومٌ ذهبَ بعضُك» (الزهد للإمام أحمد، ص357).
وكانَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يقولُ: «الليلُ والنهارُ يعملانِ فيك، فاعملْ فيهما» (المنتظم لابن الجوزي، ج8، ص144).
وقال ابن الجوزي: “رأيتُ عموم الخلق في غفلة عن قيمته، يمرّ بهم الوقت وهم في شغل لا يثمر”. (صيدُ الخاطرِ 450).
وقال ابن عقيل الحنبلي: “إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره”. (المنتظم لابن الجوزي 9/ 214) وقالَ ابنُ الجوزيِّ عن نفسِه حاثًّا على صونِ الزمنِ: “ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قُربة، ويقدّم الأفضل فالأفضل من القول والعمل”. (صيدُ الخاطرِ 449).
فانظروا – رحمكمُ اللهُ – إنَّ الطفلَ الذي يُضَيِّعُ وقتَهُ بينَ الألعابِ والمقاطعِ، يُنشئُ جيلًا يجهلُ قيمةَ الزمنِ، ويعتادُ التسويفَ، فينمو جسدُهُ ويضعفُ فكرُهُ، وتنكسرُ همّتُهُ أمامَ كلِّ واجبٍ. وهذا التضييعُ لا يُفسدُ لحظةً فقطْ، بل يُفسدُ الملكاتِ؛ إذ يتربّى القلبُ على الهروبِ إلى اللذةِ السريعةِ، ويفقدُ صبرَ المهمّاتِ.
إن الهاتفَ ليسَ حرامًا في ذاتِه، ولكنَّهُ يصبحُ حرامَ الأثرِ إذا سرقَ الفرائضَ، وأذهبَ بركةَ العمرِ، وأورثَ العقوقَ، وقطّعَ صلةَ الأرحامِ.
من جعلَ «المُحتوى» إلهًا يأمرُهُ وينهاهُ، فقد دخلَ تحتَ قولِه تعالى: {أفرأيتَ منِ اتخذَ إلهَهُ هواهُ} [الفرقان: ٤٣].
فيا أيها الآباءُ… احفظوا أوقاتَكم وأوقاتَ أولادِكم، وعلِّموهم أنَّ الساعةَ التي تمضي بلا فائدةٍ تُنقصُ من عمرِهم، وأنَّ اللهَ سائلكم عن كلِّ دقيقةٍ قضوها في غيرِ طاعةٍ أو نفعٍ. واجعلوا للشاشةِ حدودًا زمنيةً، وللقلبِ أورادًا يوميةً، وللعقلِ مهامَّ نافعةً؛ فمن عمرَ وقتَهُ بالحقِّ، حرّرَهُ من عبوديةِ الشاشةِ ومن سطوةِ الهوى.
العُنْصُرُ الثَّانِي: نِعْمَةُ الأَبْنَاءِ وَمَسْؤُولِيَّةُ التَّرْبِيَةِ أَمَامَ اللهِ
أيها المؤمنونَ… إن من أعظمِ النعمِ التي يمتنُّ اللهُ بها على عبادهِ نعمةَ الأبناءِ، فهم زينةُ الحياةِ الدنيا، وبهم تستمرُّ الرسالةُ وتُحملُ الأمانةُ، قالَ اللهُ تعالى: {المالُ والبنونَ زينةُ الحياةِ الدنيا والباقياتُ الصالحاتُ خيرٌ عندَ ربِّكَ ثوابًا وخيرٌ أملًا} [الكهف: 45].
فهؤلاءِ الأبناءُ الذين نراهم يمرحونَ في البيوتِ، هم أمانةٌ في أعناقِ والديهم، وابتلاءٌ يُظهرُ صدقَهم في الشكرِ والطاعةِ، كما قالَ اللهُ تعالى: {إنما أموالُكم وأولادُكم فتنةٌ واللهُ عندَهُ أجرٌ عظيمٌ} [التغابن: 15].
قالَ اللهُ تعالى: {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ} [الأعراف: 6]. قالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما: “يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين، ويسأل المرسلين عما بلغوا” (تفسير ابن كثير، ج3، ص417).
فإذا كانَ اللهُ يسألُ الرسلَ عن البلاغِ، فكيفَ لا يسألُ الآباءَ عن التربيةِ؟ وكيفَ لا يُسألُ المربُّونَ عن رعيتِهم؟
وقد قالَ النبيُّ ﷺ: “كُلُّكُمْ رَاعٍ ومَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ؛ فَالإِمَامُ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ في أهْلِهِ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وهي مَسْؤُولَةٌ عن رَعِيَّتِهَا…» (البخاري، 2409، ومسلم، 1829).
ويا للعجبِ!
كيفَ يغارُ الأبُ على جسدِ ابنِهِ من البردِ، ولا يغارُ على قلبِهِ من الباطلِ؟ وكيفَ تسهرُ الأمُّ خوفًا من مرضِ طفلِها، ولا تسهرُ خشيةً من مرضِ روحِهِ؟
قالَ اللهُ تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسَكم وأهليكم نارًا وقودُها الناسُ والحجارةُ} [التحريم: ٦].
قالَ عليٌّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ في تفسيرِها: “علِّموهم وأدِّبوهم” (تفسير الطبري، ج٢٣، ص104). أيْ احموا أهليكم من النارِ بالعلمِ والعملِ، فالأبُ مسؤولٌ أن يعلِّمَ ولدَهُ دينَهُ، وأن يوجِّهَهُ في صغرهِ قبلَ أن يضيعَ في كبرِه.
وقد كانَ النبيُّ ﷺ يُرَبِّي الصغارَ على التقوى والحياءِ، فيقولُ لابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما: “يا غُلامُ إنِّي أعلِّمُكَ كلِماتٍ، احفَظِ اللَّهَ يحفَظكَ، احفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تجاهَكَ، إذا سأَلتَ فاسألِ اللَّهَ، وإذا استعَنتَ فاستَعِن باللَّهِ، واعلَم أنَّ الأمَّةَ لو اجتَمعت علَى أن ينفَعوكَ بشَيءٍ لم يَنفعوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ لَكَ، ولو اجتَمَعوا على أن يضرُّوكَ بشَيءٍ لم يَضرُّوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ عليكَ، رُفِعَتِ الأقلامُ وجفَّتِ الصُّحفُ» (رواهُ الترمذي، كتاب صفة القيامة، رقم 2516، صحيحٌ). فغرسَ في قلبِه منذُ صغرهِ مراقبةَ اللهِ، قبلَ أن يعرفَ الممنوعَ والمباحَ.
وصدقَ من قالَ: “الأبُ الذي لا يُربي ولدَهُ سيبكيهُ في كبرِه، والأمُّ التي لا تُعلِّم ابنتَها ستندمُ على جيلٍ كاملٍ من الأخطاءِ”.
قالَ ابنُ القيمِ رحمهُ اللهُ: “فوصيَّةُ اللهِ للآباءِ بأولادِهم سابقةٌ على وصيَّةِ الأولادِ بآبائِهم… فمن أهملَ تعليمَ ولدِه ما ينفعُه وتركَه سُدى فقد أساءَ إليه غايةَ الإساءةِ، وأكثرُ الأولادِ إنما جاءَ فسادُهم من قبلِ الآباءِ وإهمالِهم لهم وتركِ تعليمِهم فرائضَ الدينِ وسننَه، فأضاعوهُم صغارًا فلم ينتفعوا بأنفسِهم ولم ينفعوا آباءَهم كبارًا، كما عاتبَ بعضُهم ولدَه على العقوقِ فقالَ: يا أبتِ، إنك عققتَني صغيرًا فعققتُك كبيرًا، وأضعتَني وليدًا فأضعتُك شيخًا”. (تحفة المودود بأحكام المولود، ص229).
العُنْصُرُ الثَّالِثُ: فِطْرَةُ الطِّفْلِ بَيْنَ الحِفَاظِ وَالتَّشْوِيهِ فِي زَمَنِ السُّوشِيَال مِيدْيَا
أيها الأحبةُ في اللهِ… إن اللهَ تعالى خلقَ الإنسانَ على فطرةٍ نقيةٍ، وصفاءٍ عجيبٍ، فكلُّ مولودٍ يولدُ صفحةً بيضاءَ، قلبُهُ طاهرٌ، ونفسُهُ نقيَّةٌ، وسمعُهُ وقلبُهُ وبصرُهُ أماناتٌ لم تمسَّها فتنةٌ بعدُ.
قالَ اللهُ تعالى: {فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ} [الروم: 30].
وفي الصحيحينَ عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: “ما من مولودٍ إلا يُولدُ على الفطرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِه أو يُنصِّرانِه أو يُمجِّسانِه» (رواهُ البخاري، كتاب الجنائز، رقم 1385، ومسلم، كتاب القدر، رقم 2658).
فتأملوا – رحمكمُ اللهُ – كيفَ أضافَ النبيُّ ﷺ التغييرَ إلى الوالدينِ، لأنَّ الأصلَ في الطفلِ النقاءُ والطهارةُ، وإنما الفسادُ دخيلٌ مكتسبٌ، وليسَ غريزةً مغروسةً.
إن وسائلَ السوشيال ميديا اليومَ ليستْ مجردَ أدواتٍ للتسليةِ، بل مصانعُ فكرٍ وسلوكٍ، تُعيدُ تشكيلَ وعيِ الأطفالِ في الخفاءِ، وتُبدِّلُ معاني البراءةِ بعواصفِ الشهواتِ، وتُزيِّنُ لهم صورًا من الانحرافِ تحتَ شعارِ الحريةِ والتسليةِ.
فمن ذا الذي يحمي فطرةَ هذا الجيلِ؟
ومن الذي يصونُ تلكَ الأرواحَ الطاهرةَ من زيفِ الشاشاتِ وضجيجِ الأصواتِ؟
أليسَ اللهُ قد حمَّلَ الوالدينِ مسؤوليةَ الرعايةِ؟ ألم يقلْ سبحانهُ: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسَكم وأهليكم نارًا وقودُها الناسُ والحجارةُ} [التحريم: 6].
أيها الآباءُ… إن فطرةَ أبنائِكم كالأرضِ الخصبةِ، إن زرعتَ فيها خيرًا أنبتتْ إيمانًا وتقًى، وإن تركتَها للعابثينَ، أنبتتْ فتنًا وشهواتٍ.
لقد رأى الناسُ أطفالًا في السابعةِ من عمرِهم يتكلمونَ بلسانِ منكرٍ، ويقلدونَ ما يرونهُ في الشاشاتِ دونَ تمييزٍ بينَ الحقِّ والباطلِ، والحياءِ والفجورِ، والعلمِ والتهريجِ.
وقد قالَ النبيُّ ﷺ في الحديثِ الصحيحِ: “تُعرَضُ الفِتَنُ على القُلوبِ عَرْضَ الحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فأيُّ قلبٍ أُشْرِبَها نُكِتَتْ فيه نُكتةٌ سَوداءُ، وأيُّ قلبٍ أنْكَرَها نُكِتَتْ فيه نُكتةٌ بيضاءُ، حتى يصِيرَ القلبُ أبيضَ مثلَ الصَّفا، لا تَضُرُّه فِتنةٌ ما دامَتِ السمواتُ والأرضُ، والآخَرُ أسودَ مُربَدًّا كالكُوزِ مُجَخِّيًا، لا يَعرِفُ مَعروفًا، ولا يُنكِرُ مُنكَرًا، إلا ما أُشْرِبَ من هَواه» (رواهُ مسلم، 231).
فانظروا كيفَ وصفَ النبيُّ ﷺ الفتنَ بأنها تُعرَضُ، تمامًا كما تُعرَضُ اليومَ على الشاشاتِ والهواتفِ، وأنَّ القلوبَ التي تستقبلُها بلا وعيٍ ولا إيمانٍ تُظلمُ وتتعفَّنُ حتى تموتَ.
لذلكَ كانتْ مسؤوليةُ حمايةِ الأبناءِ اليومَ ليستْ ترفًا، بل جهادًا من أجلِ بقاءِ الفطرةِ. جهادٌ لا يُرفعُ فيهِ السيفُ، بل تُرفعُ فيهِ الكلمةُ الطيبةُ، والموعظةُ الحسنةُ، والقدوةُ الصالحةُ، والرقابةُ الواعيةُ، والتعليمُ المبكرُ، والوقتُ الموجَّهُ نحوَ النافعِ والمفيدِ.
الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، قيُّومِ السمواتِ والأرضينَ، خالقِ الخلقِ أجمعينَ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبِه ومن اهتدى بهُداهُ إلى يومِ الدينِ.
العُنْصُرُ الرَّابِعُ: سُبُلُ وِقَايَةِ الأَبْنَاءِ مِنَ الإِدْمَانِ وَالتَّغْرِيبِ
أيها الإخوةُ المؤمنونَ… الوقايةُ من داءِ الإدمانِ لا تكونُ بالمنعِ فقطْ، بل بالوعيِ، والرعايةِ، والتربيةِ المتوازنةِ، لأنَّ المنعَ بلا بديلٍ يولِّدُ تمردًا، أما التوجيهُ الواعيُّ فيغرسُ انضباطًا وإيمانًا.
أولًا: غرسُ المراقبةِ الإيمانيةِ في قلبِ الطفلِ
إن أولَ درعٍ يحمي الطفلَ من الفسادِ أنْ يتعلَّمَ أنَّ اللهَ يراهُ حيثما كانَ.
قالَ اللهُ تعالى: {ألم يعلمْ بأنَّ اللهَ يرى} [العلق: 14].
فمن نشأَ على هذا الوعيِ لم يحتجْ إلى عينِ أبيهِ، ولا خوفِ أستاذِهِ، لأنَّ خوفَهُ من اللهِ أعمقُ وأدومُ.
قالَ النبيُّ ﷺ: “اتَّقِ اللهَ حيثُما كنتَ، وأتبِعِ السَّيِّئةَ الحسَنةَ تَمْحُهَا، وخالِقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسنٍ“. (الترمذي (1987)، وأحمد (21392) حسنٌ صحيحٌ).
ثانيًا: القدوةُ الصالحةُ قبلَ الموعظةِ
الأبُ الذي يُمسكُ هاتفَهُ ساعاتٍ طويلةً لا يستطيعُ أن يُقنعَ ولدَهُ بأنَّ الإدمانَ خطرٌ.
والأمُّ التي تُضيِّعُ وقتَها في المقاطعِ السطحيةِ لا تستطيعُ أن تُعلِّمَ ابنتَها ضبطَ النفسِ ولا الجدَّ في الحياةِ.
قالَ الإمامُ الغزاليُّ رحمهُ اللهُ: “والصبيُّ أمانةٌ عند والديه، وقلبُه الطاهرُ جوهرةٌ نفيسةٌ ساذجةٌ، خاليةٌ عن كلِّ نقشٍ وصورة، وهو قابلٌ لكلِّ ما نُقِش، ومائلٌ إلى كلِّ ما يُمالُ به إليه… فإن عُوِّدَ الخيرَ وعُلِّمَه نشأ عليه… وإن عُوِّد الشرَّ وأُهمِل… شقيَ وهلك” (إحياءُ علومِ الدينِ، ج8، ص120).
ثالثًا: تنظيمُ الوقتِ، وتحديدُ الاستخدامِ
إن أخطرَ ما في السوشيال ميديا أنها تسرقُ الزمنَ دونَ استئذانٍ، وتلتهمُ الساعاتِ في غفلةٍ من صاحبِها.
ولذلكَ وجبَ على الأسرةِ أن تضعَ نظامًا واضحًا في البيتِ لاستخدامِ الأجهزةِ، فتُحدَّدُ الأوقاتُ، وتُمنعُ الهواتفُ في أوقاتِ الدراسةِ والطعامِ والنومِ، وتُخصَّصُ أوقاتٌ للأسرةِ بلا شاشاتٍ.
قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: “اغتنمْ خمسًا قبلَ خمسٍ: شبابَك قبلَ هرمِك، وصحتَك قبلَ سقمِك، وغناكَ قبلَ فقرِك، وفراغَك قبلَ شغلِك، وحياتَك قبلَ موتِك» (رواهُ الحاكمُ في المستدرك، ج4، ص306، صحيح).
رابعًا: الحوارُ والتربيةُ الوجدانيةُ
أيها الآباءُ… لا تُغلقوا أبوابَ الحوارِ مع أبنائِكم، فالعالمُ كلُّهُ يتحدثُ معهم عبرَ الشاشاتِ، فإنْ لمْ تتحدثوا أنتم إليهم تكلَّمَ الباطلُ بدلاً عنكم.
استمعوا لهم، لا لتُجيبوا فقطْ، بل لتفهموا، لتطمئنوا إلى ما يجولُ في صدورِهم، فربما كلمةٌ منكم تردُّهم عن فتنةٍ، وربما إهمالٌ صغيرٌ يجرُّهم إلى هاويةٍ.
خامسًا: إشغالُ الأبناءِ بالنافعِ والمفيدِ
لا دواءَ للإدمانِ أعظمُ من ملءِ الوقتِ بالخيرِ. فعليكم بأنْ تُوجِّهوهم إلى الأنشطةِ المفيدةِ: القراءةِ، والرياضةِ، وحِفظِ القرآنِ، والمشاركةِ في الأعمالِ التطوعيةِ، فكلُّ دقيقةٍ تُشغلُ بطاعةٍ تنقذُهم من ألفِ فتنةٍ.
قالَ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ: “إني لأكره أن أري الرجلَ فارغًا لا في عملِ الدنيا ولا في عمل الآخرةٍ” (حليةُ الأولياء، ج1، ص130). أيْ أنَّ الفراغَ بابُ الشيطانِ، ومصدرُ كلِّ انحرافٍ.
أيها المؤمنونَ.. إن حمايةَ الأبناءِ مسؤوليةُ الأمةِ كلِّها، لا الأسرةِ وحدَها. فالإعلامُ مطالبٌ أن يُقدِّمَ محتوى نظيفًا، والمدرسةُ مطالبةٌ أن تُعلِّمَ رقابةَ اللهِ قبلَ رقابةِ النظامِ، والدعاةُ مطالبونَ أن يُبصِّروا الناسَ بخطرِ الغفلةِ الرقميةِ التي تهدمُ القيمَ دونَ صوتٍ.
قالَ اللهُ تعالى: {وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثمِ والعدوانِ} [المائدة: ٢]. فلنتعاونْ جميعًا على بناءِ جيلٍ سليمِ الفطرةِ، قويِّ الإيمانِ، عارفٍ بربِّه، متوازنٍ في دنياهُ، محصَّنٍ من فتنِ الشاشاتِ، مؤمنٍ أنَّ التقنيةَ خادمٌ لا سيِّدٌ.
اللهمَّ احفظْ أبناءَنا من فتنِ الشاشاتِ، واحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه.
المراجع: القرآن الكريم
كتب الحديث: صحيح البخاري، صحيح مسلم، المستدرك للحاكم، سنن أبي داود، وابن ماجه، سنن الترمذي، مسند أحمد.
ثالثًا: كتب التفسير وشروح الحديث وغيرهما: تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير الإمام الشافعي، فتح الباري لابن حجر، إحياء علوم الدين للغزالي، حليةُ الأولياء لأبي نعيم، الزهد للإمام أحمد المنتظم لابن الجوزي، تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم.
د. أحمد رمضان
خُطبةُ صوتِ الدعاةِ – إعداد رئيس التحرير: الدكتور أحمد رمضان
_______________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة