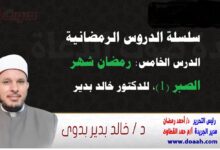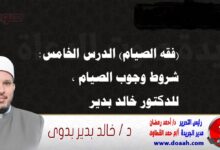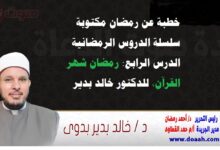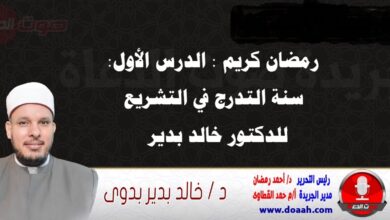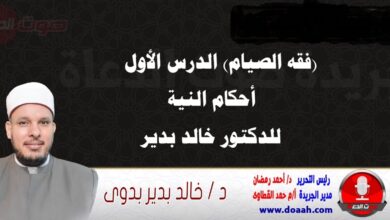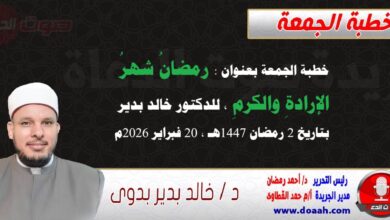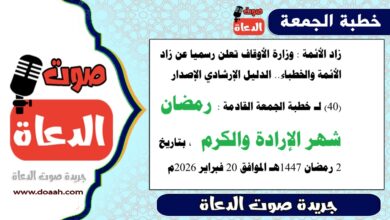زاد الأئمة : لـ خطبة الجمعة القادمة : هلا شققتَ عن قلبه
هلا شققتَ عن قلبه

زاد الأئمة : وزارة الأوقاف تعلن رسميا عن زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لـ خطبة الجمعة القادمة حول : هلا شققتَ عن قلبه، بتاريخ 23 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 14 نوفمبر 2025م.
ننفرد بنشر زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لخطب الجمعة القادمة : هلا شققتَ عن قلبه ، بصيغة WORD
ننشر زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لخطب الجمعة القادمة : هلا شققتَ عن قلبه ، بصيغة pdf
ولقراءة زاد الأئمة والخطباء.. لـ خطبة الجمعة القادمة :
هلا شققتَ عن قلبه
الهدف: التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام وأثر ذلك في مواجهة التشدد
الخطبة الثانية: خطورة الرشوة
الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، وجعل أمتنا خير أمة، والصَّلاة والسَّلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا تزال تعاليم الإسلام هي النور الهادي الذي يرسم لنا الطريق وسط ظلمات الفتن، والحصن الواقي الذي نأوي إليه من فوضى الحياة وتقلُّباتها، والملاذ الآمن الذي نجد فيه طمأنينة القلب وسكينة الروح، ففي رحابها نستشعر معاني الرحمة والسلام، والأمن والأمان، والعدل والوئام، وحين نلتزم بها نعيش في مجتمع رباني، تحوطه السكينة، وتغشاه الرحمة، وتشمله من المولى العناية.
هذا ومن جملة التعاليم التي جاء بها الإسلام، وأمر بها، ووجه إليها، وأكد عليها أن يكون المسلم مصدر أمان ورحمة وسلام لأخيه المسلم، لا منبع خوف وشدة وعنف وكراهية واستعلاء بالإيمان وإخراج من دين الله تعالى لأدنى ملابسة بلا وعي ولا فهم.
ومن مظاهر التربية الإيمانية التي تعالج هذا الأمر وتؤكد عليه؛ حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، الذي وجه النبي فيه عتابًا شديدًا له، حيث قال: “هلَّا شققت عن قلبه”. وصارت كلماته قواعد مهمة لا يستطيع أن يتجاوزها أيُّ مسلم في تعامله مع إخوانه، إذ فيه وجَّه النبي صلى الله عليه وسلم وصوَّب، وعاتب وأنَّب، وحذَّر وخوَّف، من أن يقدم المرء على عمل تجاه أخيه الإنسان تكون عاقبته وخيمة.
ومن هنا كان منهج الإسلام في توعية أتباعه بحقوق الإنسان ليكون التعامل فيما بينهم على بصيرة من الهدي الرباني، وبما لا يعود على بعضهم بما فيه إيذاء أو اعتداء، ولإعلان أن التشدد في الإسلام منهي عنه لما يترتب عليه من إخلال بمبادئه العظمى، ولنجمل لك ملامح من هذا المنهج في عدد من النقاط:
- المسلم أخو المسلم
من هذا المنطلق يربط الإسلام بين أفراد المجتمع، ويؤكد أن لهذه الأخوة حقوقًا، كما أن لها واجبات، ينبغي على المسلم أن يراعيها حال تعامله مع أخيه المسلم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، يقول الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله: “إنما المؤمنون إخوة في الدين والعقيدة، فهم يجمعهم أصل واحد وهو الإيمان، كما يجمع الإخوة أصل واحد وهو النسب، وكما ان أخوة النسب داعية إلى التواصل والتراحم والتناصر في جلب الخير، ودفع الشر، فكذلك الأخوة في الدين تدعوكم إلى التعاطف والتصالح، وإلى تقوى الله وخشيته، ومتى تصالحتم واتقيتم الله- تعالى- كنتم أهلا لرحمته ومثوبته”. [التفسير الوسيط].
وأكد هذا المعنى سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم–، حيث قال: “الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ“ [صحيح مسلم] وحدد معالم هذه الأخوة وحقوقها التي ينبغي أن يلتزم بها الطرفان، فقال:
- “لَا يَظْلِمُهُ“ وأي ظلم أشد من أن يسلب عن أخيه الإيمان ويرميه بالشرك أو الفسق أو الابتداع في الدين، دون بينة.
- “وَلَا يَخْذُلُهُ“ ولا خذلان أكبر من أن يفقده الأمان من جانبه بتسرعه في إدانته وإصدار الأحكام عليه.
- “وَلَا يَحْقِرُهُ“ بأن يستعلي عليه بإيمانه وطاعته، ولا يرى في أخيه إلا المعصية، ولا يحمل أفعاله إلا على أسوأ المحامل!
- كلمة الإخلاص وعصمة النفس الإنسانية
تعصم كلمة الإخلاص المسلم عن أن يناله أذى ولو بكلمة من أخيه المسلم، فبمجرد أن تتحرك شفتاه بهذه الكلمة فقد استوجب لنفسه هذه العصمة، وعلى المجتمع أن يراعي حرمة هذه الكلمة، يقول الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين: “ما أروع سماحة الإسلام، وما أسمى قيمه وتشريعه، كلمة واحدة تعصم وتحمي الأموال، وتمحو ما تقدم من سيئات، كلمة واحدة تجب ما قبلها، كلمة “لا إله إلا الله محمد رسول الله “.
ولا يفتأ الإسلام يغرس فينا هذا المعنى، وينبه عليه في مواطن شتى؛ لئلا يعترينا النسيان أو تلحقنا الغفلة مع تسارع أحداث الزمان، ففي البيان الخالد الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم: “كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ“ [صحيح مسلم]؛ يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ” هَذَا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَخْطُبُ بِهِ فِي الْمَجَامِعِ الْعَظِيمَةِ، فَإِنَّهُ خَطَبَ بِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَالْيَوْمَ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ” [جامع العلوم والحكم].
ولأجل هذه العصمة شدد النبي –صلى الله عليه وسلم– على أسامة بن زيد حينما بعثه إلى سرية فأدرك رَجُلًا، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قال: فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم–، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم: ” أَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَقَتَلْتَهُ؟” قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: ” أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟” فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ. [صحيح مسلم]
وفي رواية: “فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟“
يقول الإمام القرطبي رحمه الله: “وقوله عليه الصلاة والسلام لأسامة: أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَقَتَلتَهُ؟! وتكرارُ ذلك القولِ: إنكارٌ شديد، وزجرٌ وكيد، وإعراضٌ عن قبول عذر أسامة الذي أبداه بقوله: إِنَّمَا قَالَهَا خَوفًا مِنَ السِّلَاحِ…، ومعنى قوله: كَيفَ تَصنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ؟! أي: بماذا تحتجُّ إذا قيل لك: كيف قَتَلتَ مَن قال: لا إله إلَاّ الله، وقد حصلَت لدمِهِ حرمةُ الإسلام؟ ! وإنَّما تمنَّى أسامةُ أن يتأخَّر إسلامُهُ إلى يوم المعاتبة؛ لِيَسلَمَ من تلك الجناية السابقة، وكأنَّه استصغَرَ ما كان منه مِنَ الإسلامِ والعملِ الصالح قبل ذلك، في جَنب ما ارتكَبَه من تلك الجناية؛ لِمَا حصَلَ في نفسه من شدَّةِ إنكارِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لذلك، وعِظَمِهِ. [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم]
ويقول الأستاذ محمد فريد وجدي رحمه الله عند تعرضه لمقالة النبي صلى الله عليه وسلم «أفلا شققت عن قلبه»: «لا أظن أن بعد هذا غاية في التنبيه على وجوب احترام الحياة البشرية». [مجلة الرسالة]
وهذا هو المقداد بن عمرو رضي الله عنه يخبر عن نفسه أنه قال لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ” أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟
قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم: “لَا تَقْتُلْهُ“.
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَمَا قَطَعَهَا!
قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم: ” لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ“. [صحيح البخاري]
- حق الكرامة الإنسانية شاملة في الدين والدنيا.
لم يأت الإسلام ليكرّم المسلم فقط، أو العربي فقط، بل جاء بتكريم شامل للإنسانية جمعاء، في حال الحياة وبعد الممات، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، الخطاب هنا لـ “بني آدم“ بكل ألوانهم وألسنتهم وأديانهم. هذه الكرامة لصيقة بالإنسانية ذاتها، لا تُكتسب ولا تُنزع بسبب دين أو عرق أو لون. إنها منحة إلهية أصلية.
وقد جسّد النبي –صلى الله عليه وسلم– هذا المبدأ في أروع صورة. يروي الإمام البخاري أنه مرت به –صلى الله عليه وسلم– جنازة فقام لها واقفًا. فقيل له: “إنها جنازة يهودي!”. فكان رده تجسيدًا حيًا لآية التكريم: “أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟”. أي احترام هذا للنفس الإنسانية المجردة! إن هذا الموقف وحده كافٍ لنسف كل دعاوى العنصرية والتفرقة التي يروج لها المتطرفون الذين يحتقرون كل من يخالفهم.
فلم يفرق الإسلام بين المسلم وغيره في الاحترام له حتى بعد الموت، ففي الصحيحين: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، أَيْ: مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالاَ: إِنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا».
- فتبينوا.. منهج قرآني فريد
طلبُ البيان أمر قرآني وجهه الله تعالى لعباده في موطنين من كتابه، لا يتخلى عن المطالبة به حتى في أشد الظروف وأضيقها، لا بد من التبين؛ ليحفظ بذلك حقوق بعضهم على بعض، ولئلا يسارع أحدهم في اتهام أخيه بدون بينة، أو يرميه بالباطل دون أن يطلع على حقيقة الأمر، يقول تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤]، والتبين، كما يقول الطاهر ابن عاشور، شدة طلب البيان، أي: التأمل القوي، …فتبينوا.. أي: تثبتوا واطلبوا بيان الأمور فلا تعجلوا فتتبعوا الخواطر الخاطفة الخاطئة. [التحرير والتنوير].
ويقول الإمام الألوسي رحمه الله: لا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه: «لَسْتَ مُؤْمِنًا وإنما فعلت ذلك خوف القتل» بل اقبلوا منه ما أظهر وعاملوه بموجبه.
وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].
يقول الإمام النسفي رحمه الله: “﴿فَتَبَيَّنُوآ﴾ فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة ولا تعتمدوا بقول الفاسق لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب”. [مدارك التنزيل وحقائق التأويل].
- الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر
كما أوجب الله تعالى على المسلمين التثبت والتبين، أوجب عليهم أيضًا عدم التنقيب عما تحمله القلوب، بل لنا الظاهر والله تعالى هو المطلع على هذه السرائر، يقول رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ» [متفق عليه]. قال الإمام النووي رحمه الله:” معناه إني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال صلى الله عليه وسلم”. [شرح النووي على مسلم]
وأكد هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» [صحيح البخاري].
قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: «ولعل السر في قوله: «إنما أنا بشر» امتثال قول الله تعالى: ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم﴾ أي في إجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوي فيه جميع المكلفين، فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به، ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن» [فتح الباري].
وفي قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «أفلا شققت عن قلبه؟» سؤال استنكاري بلاغي، معناه: وهل تملك القدرة على شق القلوب لتعلم ما فيها؟ إنك لا تملك ذلك، ولم تُكلَّف به. إنما كُلِّفتَ بالعمل بالظاهر، هذا المبدأ هو قاعدة فقهية وأصولية كبرى: “نحن نحكم بالظواهر، والله يتولى السرائر.
قال ابن الملك:” فهلَاّ شققتَ عن قلبه”، الفاء: جواب شرط مقدَّر؛ أي: إذا عرفتَ ذلك فلِمَ لا شققتَ عن قلبه؛ لتَعلَمَ ذلك وتطَّلعَ على ما في قلبه أتعوذًا قال ذلك أم إخلاصًا؟! وشقُّ القلب: مستعار هنا للفحص والبحث عن قلبه: أنه مؤمن أو كافر؟
حاصله: أن أسامةَ ادَّعى أمراً يجوز معه القتل، والنبي –صلى الله عليه وسلم– نفاه لانتفاء سببه؛ لأن الاطلاعَ عليه إنما يمكن للباحث عن القلوب، ولا سبيلَ إليه للبشر، وهذا يدل على أن الحكمَ بالظاهر، وأما السرائرُ فتُوكَلُ الله تعالى [شرح مصابيح السنة].
– قال الإمام ابن عبد البر: ” وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن السرائر إلى الله عز وجل” [التمهيد].
وهذا المبدأ يهدم فكر الخوارج قديمًا وحديثًا، وكل جماعات الغلو والتطرف، فمنهجهم قائم على سوء الظن، والتنقيب عن النوايا، والحكم على المقاصد. يكفّرون المجتمعات بناءً على ظنونهم وتأويلاتهم، ويستحلون الدماء بناءً على تفسيراتهم الخاصة لما في قلوب الناس.
- الظن لا يغني من الحق شيئا
لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الظن، والاعتماد عليه في بناء الأحكام واتهام الناس بلا بينة، أو بشبهة، بل وصفه بأنه أكذب الحديث، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» [صحيح البخاري].
قال العلامة القسطلاني: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ» أي: اجتنبوهُ، فلا تتَّهموا أحدًا بالفاحشةِ من غيرِ أن يظهرَ عليه ما يقتضيها، «فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ» فلا تحكُموا بما يقعُ منه، كما يحكم بنفس العلمِ لأنَّ أوائلَ الظُّنون خواطر لا يملكُ دفعَها، والمرءُ إنَّما يكلَّف بما يقدرُ عليه دونَ ما لا يملكُه. «وَلَا تَحَسَّسُوا» «وَلَا تَجَسَّسُوا».. قال الحربيُّ -فيما نقله عن السَّفاقِسيِّ-: معناهما واحدٌ وهو تطلُّب الأخبار، فالثَّاني للتَّأكيد، وقال الحافظ أبو ذرٍّ: بالحاء الطَّالب لنفسه، وبالجيم لغيرهِ، وقيل: بالجيم البحث عن عورات النَّاس، وبالحاء استماعُ حديثهم، وقيل: بالجيم البحثُ عن بواطن الأمور، وبالحاء البحث عمَّا يدرك بحاسَّة العين أو الأذن، وقيل: بالجيم الَّذي يعرف الخبر بتلطُّف ومنه الجاسوس، وبالحاء الَّذي يطلب الشَّيء بحاستهِ كاستراقِ السَّمع وإبصار الشَّيءِ خفيةً. [إرشاد الساري «باختصار»]
ولم يقبل رسول الله –صلى الله عليه وسلم– من أسامة رضي الله عنه ظنه بأن الرجل إنما قال كلمة الإخلاص تخوفًا أو عندما رأى السِّلاح، وأعلمه أنه ما كان ليقدم على ما أقدم عليه لمجرد ظنه، وأن صون دم الرجل وحفظ حقه في الحياة من الأمور التي عصمتها كلمة الإخلاص، فالواجب عليه أن يركن إلى ما صانه الإسلام لا إلى ما ظنه في نفسه.
والله تعالى قد حذرنا من هذا المسلك الخطير فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢].
وأمرنا أن نحسن الظن بالمؤمنين، ففي حادثة الإفك يقول تعالى موجهًا: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ١٢] أي: “كان مقتضى الإيمان أنكم عند سماع خبر التهمة؛ أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً من العفاف والطهر، وأن يقولوا فى إنكار: هذا كذب واضح البطلان، لتعلقه بأكرم المرسلين وأكرم الصديقات” [المنتخب في تفسير القرآن].
فإذا كان سوء الظن بالمسلمين منهيًّا عنه، فكيف بمن يبني عليه حكمًا بالقتل وسفك الدم؟!
إن الحكم على النوايا هو افتئات على حق الله، وهو باب من أبواب الفساد العظيم في الأرض.
- التماس الأعذار واجب ديني وعقلي
لا تكن مترقبًا لأخطاء الخلق، وإذا صدر عن أحدهم شيئًا فيجب حمله على محمل حسن يليق به، ذلك واجب الديانة، وحق العقلانية، فعَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ» [سنن الترمذي].
قال حَمْدُونَ الْقَصَّار: “إِذَا زَلَّ أَخٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَاطْلُبُوا لَهُ سَبْعِينَ عُذْرًا، فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ قُلُوبُكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْمَعِيبَ أَنْفُسُكُمْ حَيْثُ ظَهَرَ لِمُسْلِمٍ سَبْعُونَ عُذْرًا، فَلَمْ يَقْبَلْهُ” [شعب الإيمان].
وجاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: نكتب عن محمد بن منصور الطوسي؟ قال: إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعمن يكون ذلك، فكررها مرارًا؟ فقال: إنه يتكلم فيك، فقال أحمد: رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل؟
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رضي الله عنه، قَالَ: “كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ –صلى الله عليه وسلم–: “أَنْ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ مَا لَمْ يَأْتِكِ مَا يَغْلِبُكَ، وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهُ فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا …، وَمَا كَافَأْتَ مَنْ عَصَى اللهَ فِيكَ بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللهَ فِيهِ” [شعب الإيمان].
ودخلَ الرَّبيعُ بنُ سُليمانَ على الإمام الشَّافعي -رضي اللهُ عنه- وهو مريضٌ فقالَ له: “قوَّى اللهُ ضَعفَك” -أخطأَ في التَّعبيرِ، فقال الشافعي: “لو قوَّى اللهُ ضَعفي لقتلني”، فقالَ الرَّبيعُ: “واللهِ ما أردتُ إلا الخيرَ”، قالَ الشَّافعيُّ: “أعلمُ أنك لو شَتمتني لم تُرِد إلا الخيرَ”. [آداب الشافعي ومناقبه].
وقال حجة الإسلام الغزالي: “كل ما يحتمل تنزيله على وجه حسن، ويُتصور تمهيد عذر فيه قريب أو بعيد فهو واجب بحق الأخوة، فقد قيل: “ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك سبعين عذرًا، فإن لم يقبله قلبك فردّ اللوم على نفسك، فتقول لقلبك: ما أقساك!! يعتذر إليك أخوك سبعين عذرًا فلا تقبله فأنت المعيب لا أخوك”. [إحياء علوم الدين].
- لا تبحث عن عيوب الناس قبل أن تنظر في عيوب نفسك
برز سؤال نبوي عظيم، سؤال يهدم بنيان الغلو من أساسه، ويضع حدودًا فاصلة بين مسؤولية الإنسان المخلوق وسلطان الإله الخالق. سؤال يضبط ميزان الحكم على الناس، ويعيد الأمور إلى نصابها. إنه السؤال الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لحِبّه وابن حِبّه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، بعد أن قتل رجلًا نطق بالشهادة في ساحة المعركة. قال له في غضب شديد: “يا أُسَامَةُ، أقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟” ثم أتبعها بسؤال يزلزل الكيان ويؤسس لمنهج قويم: “أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟“ [متفق عليه].
ترى كيف أسس الإسلام منظومة متكاملة لحقوق الإنسان قبل قرون من أي ميثاق دولي أو إعلان عالمي. وكيف أن التمسك بهذه الحقوق، التي مصدرها الوحي، هو الحصن المنيع والدرع الواقي الذي يحمي أمتنا ومجتمعاتنا من وباء التشدد والتطرف الذي يهدد كيانها وقيمها.
قال الحارث المحاسبي: “فَإِذا ظهر لَك من عُيُوب النَّاس مَا خَفِي عَلَيْك من عيبك استدللت بعيوب النَّاس على عيبك”. [آداب النفوس].
وقال أبو حاتم البُستي: “الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عَن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإنَّ من اشتغل بعيوبه عَن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عَلَيْهِ مَا يرى مثله من أخيه، وإن من اشتغل بعيوب الناس عَن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه، وتعذر عَلَيْهِ ترك عيوب نفسه، وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم وأعجز منه من عابهم بما فيه من عاب الناس عابوه، ولقد أحسن الذي يقول:
إذا أنت عِبْتَ الناسَ عابوا وأكثروا … عليك وأبدوا منك مَا كان يسترُ
وقد قَالَ في بعض الأقاويل قائل … له منطق فيه كلام محبر
إذا مَا ذكرت الناس فاترك عيوبهم … فلا عيب إلا دون ما منك يُذكر
فإن عبت قومًا بالذي ليس فيهم … فذلك عند اللَّه والناس أكبر
وإن عبت قومًا بالذي فيك مثله … فكيف يعيب العور من هو أعور
وكيف يعيب الناس من عيب نفسه … أشد إذا عد العيوب وأنكر
متى تلتمس للناس عيبًا تجد لهم … عيوبًا ولكن الذي فيك أكثر
[روضة العقلاء ونزهة الفضلاء].
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ»، قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ» [ابن ماجه].
– وما أجملَ ظَنَّ أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضيَ اللهُ عنه في عائشةَ رضيَ اللهُ عنها في حادثةِ الإفكِ، فعندما دخلَ على امرأتِه أمِّ أيوبَ، قالت له: “يا أبا أيوبَ، ألا تسمعُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي عَائِشَةَ؟، قَالَ: بلى، وَذَلِكَ الكذبُ، أكنتِ يا أمَّ أيوبَ فاعلةً ذَلِكَ؟ قَالَتْ: لا واللهِ مَا كنتُ لأفعله، قَالَ: فعائشةُ واللهِ خيرٌ منكِ”، فأنزلَ اللهُ: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ [النور: ١٢]”. [رواه إسحاق بن راهويه في “مسنده”].
إحياء مبدأ الحسنى في التعامل مع حقوق الخلق.
إن التشدد، الذي يُعرف في مصطلحاتنا الشرعية بـ “الغلو” و “التنطع”، هو مجاوزة الحد الذي أمر الله به ورسوله. وقد حذر منه النبي –صلى الله عليه وسلم–تحذيرًا شديدًا فقال: “هلك المتنطعون“ قالها ثلاثًا” [رواه مسلم]، وقال: “إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين“ [رواه النسائي].
أما المسلم فهو يحيي في تعاملاته قيمة الإحسان والفضل، وقد قال سيدنا يحيى بن معاذ الرازي: “اصحبوا الناس بالفضل لا بالعدل فمع العدل الاستقصاء، ومع الفضل الاستبقاء، وإني لأرجو أن يحاسب اللَّه تعالى عباده بالفضل لا بالعدل، وقد أمرهم أن يصاحب بعضهم بعضًا بالفضل، وقد عظَّم الله تعالى أمر الإحسان والإفضال فقال: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾.
وقال: “وهل يأمر الحكيم بما لا يفعله، وكيف يترك الكريم التفضل ويقتصر على العدالة، وقد بيَّنَ أنَّ الفضل أكرم وأفضل، تعالى عن أدنى المنزلتين، وكيف لا يرجى تفضله وأفعاله كلها عدل، وعدله كله تفضل، لأنه مبتدئ بما لا يلزمه، والابتداء بما لا يلزم تفضل، وهل يجوز أن يترك التفضل انتهاءً وقد تحراه ابتداءً؟!. [الذريعة إلى مكارم الشريعة].
وما أحسن قول أبي الفتح البستي
أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدْ قُلُوبَهُمْ … فَطَالَمَا أَسْتَعْبَدَ الإِنْسَانَ إِحْسَانُ
يَا خَادِمَ الْجِسْمِ كَمْ تَسْعَى لِخِدْمَتِهِ … أَتَطْلُبُ الرِّبْحَ مِمَّا فِيهِ خُسْرَانُ
أَقْبِلْ عَلَى النَّفْسِ وَاسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا … فَأَنْتَ بِالنَّفْسِ لا بِالْجِسْمِ إِنْسَانُ
وَإِنْ أَسَاءَ مُسِيئ فَلْيَكُنْ لَكَ فِي … عُروضِ زَلَّتِهِ عَفْوٌ وَغُفْرَانُ
وَكُن عَلَى الدَّهْرِ مِعْوَانًا لِذَي أَمَلٍ … يَرْجُوا نَدَاكَ فَإِنَّ الْحُرَّ مِعْوَانُ. [قصيدة عنوان الحكم].
إن مبدأ الحسنى في التعامل ليست مجرد شعار، بل هو منهج عملي، واحترام لحق الحياة، وحق الكرامة، وحق الاختلاف، وعدم الحكم على النوايا، وهو جوهر هذه الوسطية.
فكلما زاد فهمنا وتطبيقنا لحقوق الإنسان التي أقرها الإسلام، كلما ابتعدنا تلقائيًا عن شاطئ التطرف واقتربنا من مرساة الاعتدال واليسر الذي هو روح هذا الدين.
إن مبدأ “هلّا شققت عن قلبه” ليس مجرد قصة تاريخية تُروى، بل هو منهج حياة، وجدار فاصل بين الإيمان الحق والغلو بالباطل.
إنه يعلمنا التواضع أمام علم الله، والورع في التعامل مع خلقه. إن إسلامنا دين الكرامة، وحفظ الحقوق، والرحمة، والعدل. وأي فكر يدعو إلى عكس ذلك، فهو فكر دخيل على هذا الدين، وإن تزيا بلباسه وتكلم بلسانه.
- فماذا علينا أن نفعل لنحصن أنفسنا ومجتمعاتنا؟
على المستوى الفردي: أن نربي أنفسنا وأبناءنا على تعظيم حرمة الدماء والأعراض، وأن نحفظ ألسنتنا عن الخوض في نوايا الناس وتكفيرهم وتفسيقهم. أن نُحسن الظن بالآخرين ما استطعنا، وأن نكل سرائرهم إلى الله. أن يكون شعارنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “إنا كنا نؤخذ بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم”.
على المستوى المجتمعي: أن نعمل على نشر ثقافة الحوار والرحمة والتسامح المستمدة من قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأن نرجع في فهم الدين إلى أهله، إلى العلماء الموثوقين المعروفين بالوسطية والاعتدال والرسوخ في العلم، لا إلى أنصاف المتعلمين أو مجهولي الهوية على الإنترنت. علينا أن نحصّن شبابنا من المواقع والأفكار المشبوهة التي تبث سمومها ليل نهار.
والدعوة الأهم والأعظم: أن يكون كل واحد منا سفيرًا لرحمة الإسلام وعدله، في تعامله مع أهله وجيرانه وزملائه ومجتمعه، مسلمين وغير مسلمين. أن نكون نماذج حية للقيم التي ندعو إليها، ليظهر جمال هذا الدين الذي شوهه الغلاة والجهلاء بأفعالهم وأقوالهم.
فاللهم ارزقنا العلم النافع، ووفقنا إلى كل عمل صالح، واشرح صدورنا للحق واهدنا إليه بفضلك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
- الخطبة الثانية
خطورة الرشوة
الرشوة واحدة من أخطر الآفات التي تصيب بنية المجتمع وتُفسد منظومة القيم، وتهدد العدالة وتكافؤ الفرص، كما تؤدي إلى تقويض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وتمثل الرشوة سلوكًا منحرفًا يتنافى مع مبادئ الدين والقانون، وينعكس سلبًا على الاقتصاد والأخلاق العامة.
- الرشوة ليست وسيلة لإنجاز المصلحة بل وسيلة لهدم الدولة.
- من يأخذ رشوة خان الأمانة، ومن يعطيها شارك في الفساد.
- لا صلاح لمجتمع تُباع فيه القرارات وتُشترى فيه الحقوق.
- النزاهة ليست مثالية بل ضرورة لبقاء المجتمع عادلًا ومنتجًا.
- القضاء على الرشوة يبدأ من رفضها، وعدم السكوت عليها، والإبلاغ عنها.
ومن هذا المنطلق، تُدرج مبادرة “صحح مفاهيمك” موضوع الرشوة ضمن أولوياتها في إطار تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة السلوكيات الفاسدة التي تهدد كيان المجتمع، وذلك من خلال بيان ما يلي:
- حرمة الرشوة بكل صورها وأشكالها
من معاني “الرشوة” أنها “ما يبذل للغير؛ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ”. [مغني المحتاج].
وقد حرمت الشريعة الغراء “الرشوة” ؛ إذ هي عدو النزاهة، وضرب من ضروب الفساد في المجتمع، ويترتب عليها ضياع الحقوق، وتعطيل مصالح الخلق إن لم يدفعوا، ومن ثم تدمير أخلاق الأفراد، بل يفقدهم الثقة بمؤسسات الدولة، وهي ضرب من أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:١٨٨]، وقال أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].
وهي كبيرة من الكبائر، وخيانة للأمانة التي وسدت لصاحبها قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧].
قال ابن حجر الهيتمي: ([الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْأَرْبَع ِمِئَةِ]: أَخْذُ الرِّشْوَةِ وَلَوْ بِحَقٍّ، وَإِعْطَاؤُهَا بِبَاطِلٍ، وَالسَّعْيُ فِيهَا بَيْنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي، وَأَخْذُ مَالٍ عَلَى تَوْلِيَةِ الْحُكْمِ وَدَفْعُهُ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْبَذْلُ …، وقَوْله تَعَالَى: ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] يَشْمَلُ سَائِرَ وُجُوهِهِ وَيَجْمَعُهَا فِي كُلِّ مَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ…، وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْتهَا صَرِيحَةٌ فِي أَكْثَرِ ذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، وَاللَّعْنَةِ لِلرَّاشِي وَلِلْمُرْتَشِي وَلِلسَّفِيرِ بَيْنَهُمَا” [الزواجر عن اقتراف الكبائر].
وكل من يتعامل بالرشى أو يكون وسيطًا فيها ملعون على لسان رسول الله –صلى الله عليه وسلم–؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ، وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ» [أحمد، وابن حبان]، وفي رواية بزيادة: «والرائش» [المستدرك].
ومعناه: “الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا، وينتقص لهذا”.
ويبين –صلى الله عليه وسلم– لأصحابه أن من يستغل مكانه الذي استأمنه الله عليه، ويتعامل بالرشا والمجاملات على حساب الآخرين سينقلب ذلك عليه، وسيحمله عللا رقبته يوم القيامة؛ ليكون أبلغ فى فضيحته، وليتبين للأشهاد جنايته، وحسبك بهذا تعظيماً لإثم الرشوة، وتحذير أمته؛ فعن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: «اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ العَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ، أَلا هَلْ بَلَّغْتُ” ثَلاَثًا» [رواه البخاري].
قال الإمام الخطابي: “في الحديث بيان أن هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة، وإنما يهدي إليه للمحاياة، وليخفف عن المهدي، ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهو خيانة منه، وبخس للحق الواجب عليه، استيفاءه لأهله” [معالم السنن].
وقال الإمام النووي: (في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغُلول؛ لأنه خان في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته، حمله ما أهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغَال، وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية). [شرح النووي على مسلم].
ومن أبرز ما جاء في حرمة الرشوة، ويبين أنها محرمة في جميع الشرائع السماوية؛ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ، قَالَ: فَجَمَعُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَّا، وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، فَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرَّشْوَةِ، فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ» [الموطأ].
- من عقوبات أخذ الرشوة
- رفع البركة ورد الدعاء:
لما كانت الرشوة ماحقة للأرزاق، معُطلة لمصالح الخلق، تؤخر المجتهد الذكي، وتقدم الخامل البليد، تُعلِّق الناس بحب الدنيا، وتنسيهم أمر الآخرة، وتسوق المجتمعات إلى الخراب والدمار جاء الوعيد بالنهي عنها، وعن كل طريق يؤدي إليها.
- نزع البركة من حياته، وماله وولده:
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قال النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ» [رواه مسلم].
- محروم من استجابة الدعاء: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم–: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٥١] وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟» [رواه مسلم].
وقال سعد بن أبي وقاص: «يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً، وأيما عبد نبت لحمه من السُّحت والربا، فالنار أولى به» [المعجم الأوسط].
- النار أولى به: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ، أَوْلَى بِهِ» [رواه أحمد، وابن حبان].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– قال: «مَنْ وَلِيَ عَشَرَةً فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَحَبُّوا أَوْ بِمَا كَرِهُوا جِيءَ بِهِ مَغْلُولَةً يَدَاهُ فَإِنْ عَدَلَ وَلَمْ يَرْتَشِ وَلَمْ يَحِفْ فَكَّ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَارْتَشَى وَحَابَى فِيهِ شُدَّتْ يَسَارُهُ إلَى يَمِينِهِ ثُمَّ رُمِيَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ فَلَمْ يَبْلُغْ قَعْرَهَا خَمْسَمِائَةِ عَامٍ». [المستدرك].
- العيش في رعب وخوف: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا، إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرُّشَا، إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ» [رواه أحمد].
- هدايا العُمال والموظفين تدخل تحت الرشوة المحرمة شرعاً
من الحِيل المحرمة التي يستخدمها البعض تسمية “الرشى” بالهدايا أو إكراميات، فهم قلبوا الموازين، وجعلوا الباطل حقاً، وصورا الظلم عدلاً، فما هي إلا تغيير مسميات للرشوة.
أخرج الإمام مسلم عن عَدِي بْن عَمِيرَةَ الْكِنْدِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: «وَمَا لَكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى» [صحيح مسلم].
وعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– :«هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ» [رواه البيهقي في “السنن الكبرى”].
قال ابن العربي: الذي يهدي لا يخلو أن يقصد: ود المهدي إليه، أو عونه، أو ماله، فأفضلها الأول، والثالث جائز؛ لأنه يتوقع بذلك أن يرد إليه بالزيادة على وجه جميل، وقد تستحب إن كان محتاجاً، والمهدي لا يتكلف، وإلا فيكره، وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل، وهو الرشوة، وإن كان لطاعة فيستحب، وإن كان لجائز فجائز، لكن هذا إن لم يكن المهدى له حاكمًا) [فتح الباري شرح صحيح البخاري].
وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِلَى اليَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: ” أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ، ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١]، لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَامْضِ لِعَمَلِكَ» [سنن الترمذي].
وقال العلامة الدكتور موسى لاشين: “والتحقيق أن هدايا العمال تشبه الرشوة المحرمة، فالرشوة هي كل مال دفع؛ ليبتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا يحل، ويخشى من هدايا العمال، ومن الهدايا إلى جامعي الصدقات أن تدفعهم هذه الهدايا إلى التغاضي، والتساهل في حقوق الفقراء والمساكين، ومصارف الزكاة الأخرى، فهي قد تكون وسيلة إلى ما لا يحل، ووسيلة الحرام حرام، وهي وإن كانت وسيلة غير محققة الغاية، لكن “سد باب الذرائع” مطلوب، ولهذا لو تحققنا أن الهدية لن توصل إلى ما لا يحل، كأن تعطى بعد انتهاء مهمة العامل نهائياً، فلا شيء فيها”. [فتح المنعم شرح صحيح مسلم].
وقد ورد عن الصحابة التورع عن قبول الهدايا؛ خشية الوقوع في الحرام؛ فعن مَالِك، قَالَ: «أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ –صلى الله عليه وسلم–، وَكَانَ مِنْ عُمَّالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ لِامْرَأَةِ عُمَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ فَرَآهُمَا، فَقَالَ: “مِنْ أَيْنَ لَكِ هَاتَيْنِ؟ اشْتَرَيْتِهِمَا؟ أَخْبِرِينِي، وَلَا تَكْذِبِينِي”، قَالَتْ: بَعَثَ بِهِمَا إِلِيَّ فُلَانٌ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا إِذَا أَرَادَ حَاجَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا مِنْ قِبَلِي أَتَانِي مِنْ قِبَلِ أَهْلِي، فَاجْتَبَذَهُمَا اجْتِبَاذًا شَدِيدًا مِنْ تَحْتِ مَنْ كَانَ عَلَيْهِمَا جَالِسًا، فَخَرَجَ يَحْمِلُهُمَا، فَتَبِعَتْهُ جَارِيَتُهَا فَقَالَتْ: إِنَّ صُوفَهُمَا لَنَا فَفَتَقَهُمَا، وَطَرَحَ إِلَيْهَا الصُّوفَ، وَخَرَجَ بِهِمَا، فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا امْرَأَةً مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، وَأَعْطَى الْأُخْرَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ» [رواه البيهقي في “السنن الكبرى”].
- المرتشي مسؤول يوم القيامة
ليعلم كل من يتعامل بالرشوة أنه موقوف بين يدي ربه، وأنه سائله عن ماله؛ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ …، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ»[رواه الترمذي وحسنه].
أن فعله هذا يجني على الأمة؛ لأن فيه توسيد الأمر لغير أهله؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: «فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» [صحيح البخاري].
- إجراءات عملية لمواجهة ظاهرة الرشوة
فيما يلي إجراءات عملية لمواجهة ظاهرة الرشوة، وهي ظاهرة خطيرة تهدد العدالة وتفسد الضمائر وتعيق التنمية. تتوزع هذه الإجراءات على محاور: تربوية، إدارية، قانونية، إعلامية، ومجتمعية لضمان معالجة شاملة ومتوازنة.
توعية المجتمع بحرمة الرشوة وخطرها الديني: من خلال الخطب والدروس، والتأكيد على أن الرشوة ليست مكسبًا، بل أكلٌ للسحت وسبب لردّ الدعاء ومحق البركة.
- إطلاق خدمات إلكترونية لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، مثل المنصات الرقمية لتقديم الطلبات وسداد الرسوم إلكترونيًا.
- إجراء دورات تدريبية لموظفي الدولة: حول النزاهة والشفافية والمسؤولية الوظيفية، وبيان العقوبات النظامية لمن يقبل الرشوة.
- تشجيع ثقافة الإبلاغ عن الفساد: عبر قنوات آمنة وسرية تحمي المبلّغ من الانتقام الوظيفي أو الاجتماعي.
- تسليط الضوء على النماذج النظيفة في المجتمع: من موظفين ومسؤولين رفضوا الرشوة وتمسكوا بالنزاهة.
- هدف مبادرة صحيح مفاهيمك من الكلام عن “الرشوة“
- تهدف مبادرة “صحح مفاهيمك” إلى:
- تعزيز ثقافة النزاهة والأمانة في المجتمع وجعلها سلوكًا راسخًا في التعاملات اليومية، والحد من انتشار ظاهرة الرشوة في المؤسسات العامة والخاصة من خلال الوعي والردع، وبناء مجتمع يرفض الفساد ويؤمن بأن الحقوق تُنال بالعدل لا بالمال.
- توعية المواطنين والموظفين بخطورة الرشوة شرعًا وقانونًا وأثرها على ضياع الحقوق وانتشار الظلم. وغرس قيم الشفافية والنزاهة في نفوس النشء من خلال المناهج والأنشطة المدرسية.
- تعريف الناس بالطرق النظامية لإنجاز مصالحهم دون اللجوء للرشوة أو الوساطة غير المشروعة. وتشجيع الإبلاغ عن الفساد والرشوة عبر قنوات آمنة وسرية لحماية المبلّغين.
- إبراز النماذج الإيجابية من الموظفين الشرفاء والمؤسسات النظيفة كمثل يُحتذى به.
- تقوية الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية من خلال إظهار جدية الدولة في مكافحة الرشوة. وتوضيح العقوبات القانونية المترتبة على الراشي والمرتشي والوسيط (الرائش).
- تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والإعلامية والتربوية لتكوين جبهة مجتمعية ضد الفساد.
مراجع للاستزادة:
إحياء علوم الدين، الغزالي.
فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين لاشين
_____________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
وللإطلاع علي قسم خطبة الجمعة
وللإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف