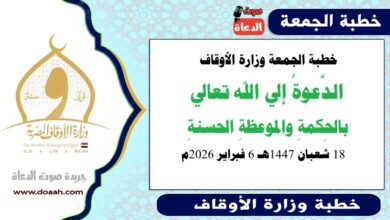خطبة الجمعة (مبادرة صحح مفاهيمك) : حُرمةِ الاعتداءِ على الجارِ ، للدكتور أحمد رمضان
حُرمةِ الاعتداءِ على الجارِ
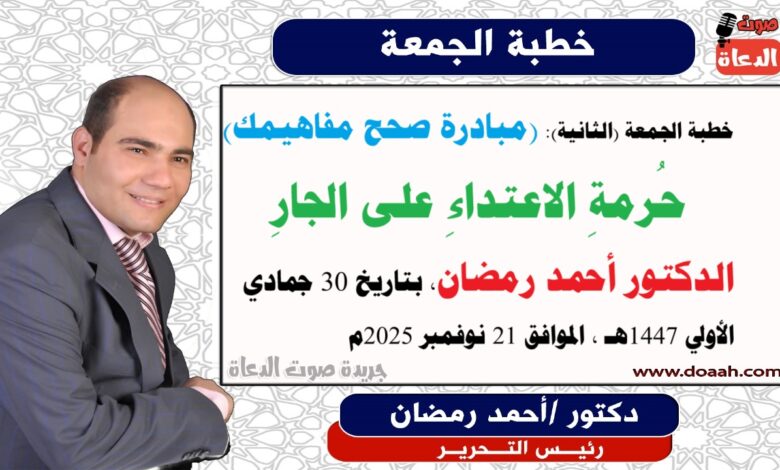
خطبة الجمعة القادمة (الثانية)، (مبادرة صحح مفاهيمك) : حُرمةِ الاعتداءِ على الجارِ ، إعداد: رئيس التحرير الدكتور أحمد رمضان لـ صوت الدعاة ، بتاريخ 30 جمادي الأولي 1447هـ ، الموافق 21 نوفمبر 2025م.
حصريا ل صوت الدعاة لتحميل خطبة الجمعة القادمة (الثانية) 21 نوفمبر 2025م بصيغة word بعنوان : حُرمةِ الاعتداءِ على الجارِ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان لـ صوت الدعاة.
انفراد لتحميل خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر 2025م بصيغة pdf بعنوان : حُرمةِ الاعتداءِ على الجارِ ، للدكتور أحمد رمضان.
لقراءة الخطبة الأولي بعنوان: كن جميلا تر الوجود جميلا
عناصر خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر 2025م بعنوان : حُرمةِ الاعتداءِ على الجارِ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان.
العنصر الأول: حُرْمَةُ التَّعَدِّي عَلَى الجَارِ فِي مِيزَانِ الشَّرْعِ
العنصر الثاني: صورُ الإحسانِ إلى الجار، ومظاهرُ الجمالِ في معاملته
العنصر الثالث: صورٌ واقعيةٌ للتعدي على الجار، ومعالمُ الإصلاحِ الشرعيِّ في واقعِنا المعاصر
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة (الثانية) 21 نوفمبر 2025م : حُرمةِ الاعتداءِ على الجارِ ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان : كما يلي:
حُرمةِ الاعتداءِ على الجارِ
30 جمادي الأولي 1447هـ – 21 نوفمبر 2025م
إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
المـــوضــــــــــوع
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، نحمدُهُ على نعمٍ لا تُحصى، وآلاءٍ لا تُستقصى، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، شهادةً نرجو بها نجاتَهُ ورحمتَهُ، وأشهدُ أنَّ سيدَنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، أرسلهُ ربُّهُ هدايةً ورحمةً، ودعوةً إلى مكارمِ الأخلاقِ، فصلّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبِه أجمعينَ تسليمًا كثيرًا.
أمّا بعدُ… فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ، واعلموا أنَّ من أعظمِ ما جاء به الإسلامُ ترسيخُ قيمِ التعاملِ الحسنِ بين الناسِ، وفي مقدمتها حُسنُ الجوارِ وكفُّ الأذى، فقد قرنَ اللهُ تعالى حقَّ الجارِ بالتوحيدِ وحقوقِ الوالدينَ والقُربى، مما يدلُّ على عِظمِ شأنِه وخطورةِ التفريطِ فيه.
عناصر الخطبة:
العنصر الأول: حُرْمَةُ التَّعَدِّي عَلَى الجَارِ فِي مِيزَانِ الشَّرْعِ
العنصر الثاني: صورُ الإحسانِ إلى الجار، ومظاهرُ الجمالِ في معاملته
العنصر الثالث: صورٌ واقعيةٌ للتعدي على الجار، ومعالمُ الإصلاحِ الشرعيِّ في واقعِنا المعاصر
وفي سياقِ توعيةِ المجتمعِ وإحياءِ القيمِ الإيمانيةِ الرفيعةِ، جاءت مبادرةُ وزارةِ الأوقافِ المصرية «صَحِّحْ مَفَاهِيمَكَ» لتعيدَ تشكيلَ الوعيِ، وتُبرزَ قيمةَ حُرمةِ الاعتداءِ على الجارِ، وما يتبعُ ذلك من آثارٍ خطيرةٍ على الفردِ والمجتمعِ. وإنّ خطبتنا اليوم تأتي دعمًا لهذه الجهودِ المباركة، وتذكيرًا للمسلمينَ بأنَّ حقَّ الجوارِ عبادةٌ، والتعدي عليه معصيةٌ، بل من كبائرِ الذنوبِ التي تُذهبُ نورَ الإيمانِ وتجرُّ على صاحبِها الوعيدَ الشديدَ.
العنصر الأول: حُرْمَةُ التَّعَدِّي عَلَى الجَارِ فِي مِيزَانِ الشَّرْعِ
أيُّهَا الإخوةُ المؤمنونَ: إنَّ مَقَامَ الجِوَارِ في دينِ اللهِ ليسَ شأنًا ثانويًّا ولا خُلُقًا فرعيًّا، بل هُوَ مِمَّا جَعَلَهُ اللهُ في سُلَّمِ العَقِيدَةِ والعبادةِ، فَقَرَنَهُ في كتابِهِ العزيزِ بأعظمِ الوصايا، وألحقَهُ بأصولِ الإيمانِ الكبرى، فقال جلَّ وعلا: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا… وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ النساء: 36. فانظروا – رَحِمَكُمُ اللهُ – إلى هذا الموضعِ الجليلِ، كيف جَاءَ حَقُّ الجَارِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ ورعايةِ الوالدينِ وصِلَةِ الأرحامِ، وهذا دليلٌ لا يَخْفَى على ما لهذا الحقِّ من عظمةٍ وما للإخلالِ به من خُطورةٍ.
ولم تكتفِ الشريعةُ بالوصيةِ القرآنيةِ، بل جاءتِ السُّنَّةُ تَصُبُّ المعنى صَبًّا يهزُّ القلوبَ ويُوقِظُ الغافلينَ؛ فعن النبي ﷺ أنه قال: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» البخاري (5668) ومسلم (2624). وهذه العبارةُ العظيمةُ تُصَوِّرُ مقدارَ تَكْرَارِ الوصايا، وتوالي التأكيداتِ من جبريلَ عليه السلام، حتى بلغ النبيَّ ﷺ الظنُّ بأنَّ الجارَ سيُجْعَلُ له نصيبٌ من الميراثِ! وهذه المبالغةُ المقصودةُ تُشِيرُ إلى أنَّ الجارَ ليسَ قريبًا في السُّكنى فحسب، بل قريبٌ في الحقِّ والرعايةِ والأمانةِ.
ولذلك حذَّر النبيُّ ﷺ تحذيرًا يقطعُ القلوبَ ويُرْعِبُ القاسي، فقال: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» مسلم (46). وفي الصحيحين: «واللهِ لا يؤمِنُ واللهِ لا يؤمِنُ واللهِ لا يؤمِنُ قالوا وما ذاكَ يا رسولَ اللهِ قال جارٌ لا يؤمنُ جارُهُ بوائقَهُ قالوا يا رسولَ اللهِ وما بوائقُهُ قال شرُّهُ». البخاري 6061، ومسلم 46 مختصرا.
سبحانَ اللهِ! أيُّ ذنبٍ أشدُّ مِنْ ذنبٍ يَنْقُضُ الإيمانَ نفسَهُ؟! وأيُّ جريمةٍ أفحشُ مِنْ أنْ يكون جارُك خائفًا من لسانِكَ أو نظرةِ عَيْنِك أو مَكْرِ يديك؟!
ومن شدةِ خطرِ هذا الأمرِ أنَّ النبيَّ ﷺ جعل سلامةَ الجارِ معيارًا يُعْرَفُ به إحسانُ الإنسانِ وصلاحُ إيمانهِ، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقال: يا رسولَ الله، كيف أعلمُ أني مُحْسِنٌ؟ قال: «إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ: إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، وَإِذَا قَالُوا: إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ» ابن حبان 525، ابن ماجه (4223)، وأحمد (3808) صحيح. فكأنَّ شهادةَ الجيرانِ هي ميزانُ القلوبِ، ودليلُ السلوكِ، ومِحَكُّ السِّرِّ والعلنِ.
أيُّهَا الأحبّةُ في اللهِ: إنَّ حرمةَ جارك تبدأ من قلبِكَ قبلَ سلوكِكَ، فمن كان قلبُهُ خبيثًا على جارهِ، لم يستقمْ لسانُهُ، ولم يَسْلَمْ يدُهُ، فالإيمانُ لا يَسْكُنُ في صدرٍ يُضْمِرُ شرًّا لمن جاورَهُ. ولهذا قال ﷺ: «لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». أحمد (13048)، وابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (9) واللفظ لهما، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (887) بلفظه مختصرًا، حديث حسن. فإذا اضطرب القلبُ انحرف اللسانُ، وإذا انحرف اللسانُ وقع الأذى، وإذا وقع الأذى ذهب الإيمانُ.
وإنَّ مِنْ بديعِ الشريعةِ أنْ جَعَلَتِ الإحسانَ إلى الجارِ بابًا من أبوابِ البركةِ في الرزقِ والعُمُرِ، ففي الحديث: «صلةُ الرحمِ، وحسنُ الخلقِ، وحسنُ الجوارِ، يَعْمُرْنَ الدِّيارَ، ويَزِدْنَ في الأَعْمَارِ» أحمد (25259) مطولاً، وابن أبي الدنيا في ((مكارم الأخلاق)) (329)، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/243) باختلاف يسير، حديث حسن.
وقد بلغَ تقديسُ الإسلامِ لِحَقِّ الجارِ أنْ جعلهُ بابًا من أبوابِ النجاةِ يومَ القيامةِ؛ ففي الصحيح: أنَّ الجارَ يتعلقُ بجارهِ يومَ الحسابِ يقول: «كم من جارٍ مُتعلِّقٍ بجارِه يقول يا ربِّ سَلْ هذا لمَ أغلقَ عَنِيَ بابَه ومنعَني فضلَ“، البخاري في الأدب المفرد(111)، حسن لغيره. فواللهِ ما أعظمَ هذا الموقفَ! جارٌ يتعلقُ بك أمامَ مليكٍ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ.
وما من خلقٍ كريمٍ إلا وللنبي ﷺ فيه القدوةُ الحسنةُ، فقد كان ﷺ يَتَعَاهَدُ جيرانهُ من المسلمينَ وغيرِ المسلمينَ، يزورُ مريضَهم، ويُهْدِي إليهم، ويَقِفُ مع ضعيفِهم، «أنَّ غلامًا يهوديًّا كان يخدُمُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمرِض فأتاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعُودُه فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أسلِمْ ) فنظَر إلى أبيه وهو جالسٌ عندَ رأسِه فقال له أطِعْ أبا القاسمِ قال: فأسلَم قال: فخرَج النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن عندِه وهو يقولُ: (الحمدُ للهِ الَّذي أنقَذه مِن النَّارِ ) البخاري(1356).
وما أجملَ وصايا النبيِّ ﷺ العمليةَ حين قال: «يا أبا ذَرٍّ إذا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فأكْثِرْ ماءَها، وتَعاهَدْ جِيرانَكَ» مسلم (2625). فليس المطلوبُ كثرةَ الأموالِ، ولا البذلُ الضخمُ، إنما المطلوبُ قلبٌ طيبٌ، ويدٌ تُحسِن، ونفسٌ تُجاملُ بالمعروفِ، ولو بقدرِ مُلْءِ كَفٍّ من مرقٍ!
فيا عبادَ اللهِ: إنَّ التعدي على الجارِ ليسَ خطأً اجتماعيًّا فحسب، بل هُوَ جريمةٌ شرعيةٌ تُعَرِّضُ صاحبَها لوعيدٍ شديدٍ، وتنزعُ عنه نورَ الإيمانِ، وتُعَرِّي قلبَهُ من التقوى، وتجعلهُ غريبًا عن روحِ الإسلامِ التي بُنِيَت على الرحمةِ والإحسانِ.
العنصر الثاني: صورُ الإحسانِ إلى الجار، ومظاهرُ الجمالِ في معاملته
إنَّ الإحسانَ إلى الجارِ ليس خُلُقًا جزئيًّا، ولا فضيلةً ثانويةً تُترَك لاجتهادِ الناسِ، بل هو بابٌ عظيمٌ من أبوابِ الإيمانِ، ورُكنٌ من أركانِ صلاحِ المجتمعِ، ومظهرٌ من مظاهرِ الجمالِ الذي يُريده اللهُ لعبادِهِ في أخلاقِهم ومعاملاتِهم، وقد كثرت نصوصُ الشرعِ التي أوضحت أن هذا الإحسانَ لا يقفُ عند حدٍّ، بل يشملُ جملةً واسعةً من الحقوقِ التي تُظهِرُ رُقيَّ الإسلامِ، وسموَّ أخلاقِ أهلِه، ومن أعظمِها أن يُحسنَ المسلمُ إلى جارِه بالقولِ والفعلِ، وبالزيارةِ، والسؤالِ، والمواساةِ، وحفظِ الغيبةِ، وكفِّ الأذى، وصيانةِ الحرمةِ، وسترِ العورةِ، وإعانةِ المحتاجِ، واحتمالِ الزلةِ، ومشاركةِ الأفراحِ والأتراحِ، وهذه المعاني كانت ظاهرةً في حياةِ النبي ﷺ وصحابتِهِ الكرامِ، حتى صارَ الجارُ يعيشُ في أمنٍ من أهلِ الإيمانِ لا يخافُ منهم ظلمًا ولا تعديًا، بل يجدُ عندهم رحمةً تُطفئُ حرَّ الشدائدِ، وبرًّا يرققُ القلوبَ، كما قال تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ البقرة: ١٩٥.
ومن صورِ الإحسانِ أن يبذلَ المسلمُ لجارهِ من طعامِه وفضلِ رزقِهِ، قالت أمُّ المؤمنين عائشةُ رضي اللهُ عنها حين سُئلت: إلى أيِّ الجيرانِ تُهدى الهديةُ؟ فقالت: «إلى أقربِهِم بابًا» رواه البخاري (5674)، إشارةً إلى أن أقربَهم ملاصقةً أولى الناسِ ببرّ الإنسانِ وإحسانِهِ.
ومن الإحسانِ أيضًا حفظُ اللسانِ عن جارِه، فلا يغتابُه، ولا يشيعُ عنه ما يكره، ولا ينقلُ حديثَهُ على وجهِ الإفساد، فإن اللسانَ سهمٌ نافذٌ، وربما كان جرحُهُ أشدَّ من جرحِ اليدِ، وقد ضرب النبي ﷺ مثالًا بليغًا حين أخبر عن امرأةٍ كثيرةِ العبادةِ لكنها تؤذي جيرانَها بلسانها، فقال ﷺ: «إنَّ فلانةَ تقومُ اللَّيلَ وتَصومُ النَّهارَ وتفعلُ، وتصدَّقُ، وتُؤذي جيرانَها بلِسانِها؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليهِ وسلم لا خَيرَ فيها، هيَ من أهلِ النَّارِ». البخاري في الأدب المفرد 119، حديث صحيح، وهذا يبينُ أن حسنَ الجوارِ ميزانٌ تُوزَنُ به حقيقةُ الإيمانِ، وأن قليلَ العملِ مع سلامةِ القلبِ مقدمٌ على كثيرِ العملِ مع فسادِ العلاقاتِ.
ومن صورِ الإحسانِ إلى الجارِ: سترُهُ إذا أخطأ، ومعونتُهُ إذا احتاج، والوقوفُ معه في مصائبِه، وتفقدُهُ عند غيابِه، وزيارتُهُ إذا مرض.
ويدخل في الإحسانِ كذلك كفُّ الأذى، فلا يرفعُ المسلمُ صوتَهُ على جارهِ، ولا يضيّقُ عليهِ في طريقٍ، ولا يحتلُّ موضعًا يخصُّهُ، ولا يفتحُ نافذةً تُشرفُ عليهِ دون إذنِهِ، ولا يُسقِطُ عليهِ ماءً أو ترابًا، ولا يُلقي القاذوراتِ قريبًا من بيته، وهذه كلها صورٌ واقعيةٌ نصَّ عليها الفقهاءُ قديمًا وحديثًا، لأن حقَّ الجارِ يشملُ صيانةَ راحتهِ وخصوصيتهِ، وقد قال ﷺ: «لا يدخلُ الجنةَ من لا يأمنُ جارُهُ بوائقَهُ» مسلم (46)، والبوائقُ تشملُ الشرَّ كلَّه، سواءً كان قولًا أو فعلًا أو اعتداءً أو تضييقًا.
ومن الإحسانِ إلى الجارِ إعانتهُ في حاجاتِه، ومشاركتهُ في أفراحِه وأتراحِهِ، والوقوفِ معه في شدائدِه، والسؤالُ عنه إذا غاب، والاهتمامُ بأمرِهِ.
ومن صورِ الإحسانِ كذلك الأمنُ النفسيُّ الذي ينتشرُ بين الجيرانِ إذا استقامت علاقتُهم، فإن البيوتَ التي يُحسِنُ أهلُها إلى جيرانِهم تكونُ أكثرَ استقرارًا، وأشدَّ مودةً، وأقربَ إلى السكينةِ.
ومن الإحسانِ أيضًا ألا يحتقرَ الإنسانُ هديةَ جارتِه ولو كانت قليلةً، فقد قال ﷺ: «يا نِساءَ المُسْلِماتِ، لا تَحْقِرَنَّ جارَةٌ لِجارَتِها، ولو فِرْسِنَ شاةٍ» البخاري (2566)، ومسلم (1030)، وهذا يدلُّ على أن الهديةَ ولو كانت يسيرةً فإنها تُنبتُ المودةَ، وتطردُ الشيطانَ، وتمنعُ البغضاءَ بين الناسِ، وأنّ قيمةَ الهديةِ ليست في حجمِها بل في أثرِها النفسيِّ والاجتماعيِّ.
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وليِّ الصالحينَ، ومُذِلِّ المعتدينَ، أحمدُهُ سبحانه على آلائِهِ ونعَمِهِ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أن سيدَنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، الداعي إلى كلِّ خلقٍ كريمٍ، والمُحذِّرِ من كلِّ إيذاءٍ وظلمٍ، صلَّى اللهُ عليه وعلى آلهِ وصحبِهِ أجمعينَ.
أمَّا بعدُ… فيا عبادَ اللهِ، إننا اليومَ مع خُطبتِنا هذه نُواكِبُ جهودَ وزارةِ الأوقافِ المصرية في مبادرتها المباركة: «صَحِّحْ مَفَاهِيمَكَ»، تلك المبادرةِ التي تُعيدُ ضبطَ المفاهيمِ على هَدْيِ الكتابِ والسنةِ، وتُواجهُ الانحرافاتِ السلوكيةَ والفكريةَ التي تُهَدِّدُ المجتمعَ وتُضعِفُ قِيَمَهُ، ومن أهمِّ موضوعاتِها التي جاء الشرعُ بتأكيدِها، وتُشدِّدُ الأوقافُ على ترسيخِها: حرمةُ التعدي على الجار، لأن الجوارَ قيمةٌ إيمانيةٌ، وركنٌ من أركانِ استقرارِ المجتمعِ، ومفتاحٌ من مفاتيحِ التلاحمِ الأسريِّ والاجتماعيِّ، ولا تصلحُ الأوطانُ إلا بصلاحِه، ولا تتهدَّمُ إلا بانهيارِه.
وفي هذا الإطارِ تأتي خطبتُنا اليومَ؛ لنجلُوَ معالمَ هذا الحكمِ الشرعيِّ العظيمِ، ونُتمِّمَ ما بدأناهُ في الخطبةِ الأولى، وننتقلَ الآن إلى العنصر الثالث.
العنصر الثالث: صورٌ واقعيةٌ للتعدي على الجار، ومعالمُ الإصلاحِ الشرعيِّ في واقعِنا المعاصر
أيُّها المؤمنون… إنَّ من أعظمِ ما ينبغي أن يُنبَّهَ عليه اليومَ، أن التعدي على الجارِ لم يَعُدْ مقتصرًا على أذى اللسانِ، أو ظلمِ اليدِ، كما كان في المجتمعاتِ البسيطةِ، بل تعدَّدت صُوَرُهُ وتشَعَّبتْ بتشعُّبِ أحوالِ الناسِ واتساعِ عمرانِهم، فصار الجارُ يُؤذَى بأصواتِ الأجهزةِ، وضوضاءِ المركباتِ، وصخبِ المناسباتِ، واحتلالِ الممراتِ، وسوءِ استخدامِ المرافقِ المشتركةِ، ورميِ المخلفاتِ، وتتبُّعِ العوراتِ بالكاميراتِ والنوافذِ، والتطفُّلِ على الخصوصياتِ عبر الهواتفِ ومواقعِ التواصلِ، وهذه كلُّها ـ عند التأملِ الشرعيِّ ـ داخلةٌ في قولِه ﷺ: «مَن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يُؤذِ جارَهُ”.
ومن أبشعِ الصورِ أيضًا ما نراهُ من بعضِ الناسِ في البناياتِ الحديثةِ: من رفعٍ مُفرِطٍ للصوتِ، وإهمالٍ في مراعاةِ وجودِ المرضى وكبارِ السنِّ، وإحداثِ ضغوطٍ على أهلِ البيوتِ بممارساتٍ تُخالِفُ أدبَ الجوارِ، وكذلك التضييقُ على الجيرانِ في مواقفِ السياراتِ، أو إلقاءُ القاذوراتِ في مواضعِ مرورِهم، أو استغلالُ غيابِ الجارِ للاعتداءِ على حقوقِهِ، أو منعُهُ من انتفاعٍ مشتركٍ لا يضرُّ صاحبه، وكلُّ ذلك داخلٌ في قولِ النبي ﷺ: «من كان له أرضٌ فأراد بيعَها فليعرضها على جارِه» ابن ماجه (2493)، وقولِه: «لا يمنعْ أحدُكم جارَهُ أن يغرِزَ خشبَتَهُ في جدارِه» البخاري (2331)، فهذه النصوصُ تثبتُ أن الشرعَ يَميلُ إلى رفعِ الضيقِ عن الجارِ، وإزالةِ ما يشقُّ عليه، ويُحمِّلُ المسلمَ مسؤوليةَ التيسيرِ لا التعسيرِ.
ومن الصورِ الخطيرةِ أيضًا التعدي اللفظيُّ الذي يسقطُ مكانةَ الإنسانِ عند اللهِ، بل قد يبلغُ التعدي ذروةَ الفسادِ حين يتحولُ إلى اعتداءٍ على الأعراضِ أو البيوتِ أو الأموالِ، وهذا من أعظمِ الكبائرِ، وقد قال النبي ﷺ: «لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليه من أن يزنيَ بامرأةِ جارِه قال ما تقولون في السَّرِقةِ قالوا حرَّمها اللهُ ورسولُه فهي حرامٌ قال لأن يسرقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ عليه من أن يسرِقَ من جارِه» أحمد (23854)، والبزار (2115)، والطبراني (20/257 (605) صحيح. وهذه المقارنةُ العجيبةُ تُظهِرُ شناعةَ الاعتداءِ على الجارِ، لأنها جنايةٌ على حرمةٍ عظيمةٍ، وعلى مأمنٍ جعلهُ اللهُ له.
وإن من صورِ التعدي كذلك ما نراهُ في زمانِنا من تتبعٍ للخصوصياتِ، أو تصويرٍ للبيوتِ، أو نشرٍ للأخبارِ الداخليةِ، أو الدخولِ في المشكلاتِ لإشعالِ الفتنةِ، وكلُّ ذلك داخلٌ في الظلمِ والبغيِ، ودخيلٌ على أخلاقِ الإسلامِ، ومنافٍ لقولِ النبي ﷺ: «من يأخذُ عني هؤلاء الكلماتِ… وأحسنْ إلى جارِكَ تكنْ مؤمنًا» الترمذي (2305)، وابن ماجه (4217) مختصراً، وأحمد (8095) حديث حسن.
فيا عبادَ اللهِ… إن الإصلاحَ يبدأُ من النفسِ قبلَ البيتِ، ومن البيتِ قبلَ الشارعِ، ومن الحيِّ قبلَ المجتمعِ، ولو أن كلَّ مسلمٍ جعلَ بينه وبين جارِهِ سياجًا من الأدبِ والاحترامِ، وتنازلَ عن بعضِ حقِّه، وأطفأ بعضَ غضبِه، ووضعَ في قلبِه مراقبةَ اللهِ، لاندثرتِ الفتنُ، واستقرَّتِ الأحياءُ، وعمَّ الأمنُ النفسيُّ والاجتماعيُّ، وما ذلك على اللهِ بعزيزٍ.
فاحذروا ـ رَحِمَكمُ اللهُ ـ من التعدي على الجارِ بأيِّ صورةٍ كانت، واحرصوا على إكرامِه، ومراعاةِ مشاعرهِ، وحفظِ كرامتِه، والقيامِ بحاجتِه، فإنَّ خيرَ الناسِ عند اللهِ خيرُهم لجارِه، وإنَّ اللهَ لا يحبُّ من كان أذًى على غيرِه، وإنَّ بيوتًا كثيرةً هلكتْ بسببِ بغيِ جارٍ، كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «ثلاثةٌ يحبُّهم اللهُ… ورجُلٌ كان له جارُ سُوءٍ، فصبَرَ على أذاهُ حتَّى يُفرِّقَ بيْنَهما موتٌ أو ظَعْنٌ» أخرجه الطحاوي في ((شرح المشكل)) (2782) بلفظه، والترمذي (2568)، وأحمد (21530)، والبزار (3908)، حديث صحيح.
اللهمَّ احفَظْ مصرَنا أمنًا وأمانًا، وسخاءً ورخاءً، وسِلْمًا وسلامًا
المراجع: القرآن الكريم.
كتب الحديث: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، وابن ماجه، وابن حبان، سنن الترمذي، مسند أحمد، سنن النسائي، المعجم الأوسط والكبير للطبراني، المستدرك للحاكم، مسند الشهاب، الأدب المفرد للبخاري، مستد البزار، مسند الشهاب للقضاعي.
إحياء علوم الدين للغزالي، المجروحين لابن حبان، الصمت لابن أبي الدنيا، مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا.
د. أحمد رمضان
خُطبةُ صوتِ الدعاةِ – إعداد رئيس التحرير: الدكتور أحمد رمضان
_______________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة