خطبة الجمعة القادمة : لا تكنْ حجابًا بينَ الناسِ وبينَ الله ، للدكتور أحمد رمضان
لا تكنْ حجابًا بينَ الناسِ وبينَ الله، بتاريخ 7 جمادي الثاني 1447هـ ، الموافق 28 نوفمبر 2025م
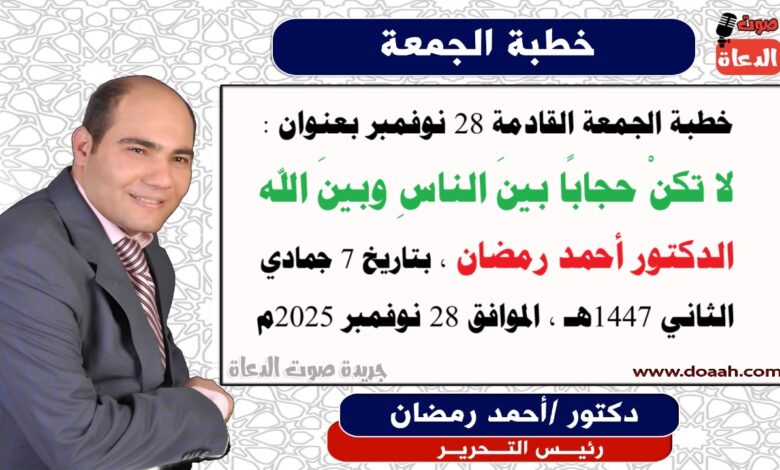
خطبة الجمعة القادمة 28 نوفمبر 2025 بعنوان : لا تكنْ حجابًا بينَ الناسِ وبينَ الله ، إعداد: رئيس التحرير الدكتور أحمد رمضان لـ صوت الدعاة ، بتاريخ 7 جمادي الثاني 1447هـ ، الموافق 28 نوفمبر 2025م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 28 نوفمبر 2025م بصيغة word بعنوان : لا تكنْ حجابًا بينَ الناسِ وبينَ الله ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان لـ صوت الدعاة.
انفراد لتحميل خطبة الجمعة القادمة 28 نوفمبر 2025م بصيغة pdf بعنوان : لا تكنْ حجابًا بينَ الناسِ وبينَ الله ، للدكتور أحمد رمضان.
عناصر خطبة الجمعة القادمة 28 نوفمبر 2025م بعنوان : لا تكنْ حجابًا بينَ الناسِ وبينَ الله، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان.
العُنْصُرُ الأَوَّلُ: مَعْنَى أَنْ تَكُونَ سَبَبًا لِلهِدَايَةِ أَوْ سَبَبًا لِلصُّدُودِ
العنصر الثاني: الدِّينُ مُعَامَلَةٌ وَرَحْمَةٌ
العنصر الثالث: القُدْوَةُ وَالرِّفْقُ جِسْرٌ لِلْهَدَايَةِ وَوَاجِبُنَا فِي رَفْعِ الحُجُبِ
العُنْصُرُ الرَّابِعُ: ثِمَارُ (نتائج) رَفْعِ الحُجُبِ وَفَتْحِ الأَبْوَابِ
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 28 نوفمبر 2025م : لا تكنْ حجابًا بينَ الناسِ وبينَ الله ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان : كما يلي:
لا تكنْ حجابًا بينَ الناسِ وبينَ الله
7 جمادي الآخرة 1447هـ – 28 نوفمبر 2025م
إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
المـــوضــــــــــوع
الحمدُ للهِ الذي جعلَ دينَهُ نورًا وهُدًى ورحمةً للعالمينَ، وأنزلَ كتابَهُ فرقانًا بين الحقِّ والباطلِ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولُه، صلواتُ ربي وسلامُهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبِه أجمعينَ.
عناصر الخطبة:
العُنْصُرُ الأَوَّلُ: مَعْنَى أَنْ تَكُونَ سَبَبًا لِلهِدَايَةِ أَوْ سَبَبًا لِلصُّدُودِ
العنصر الثاني: الدِّينُ مُعَامَلَةٌ وَرَحْمَةٌ
العنصر الثالث: القُدْوَةُ وَالرِّفْقُ جِسْرٌ لِلْهَدَايَةِ وَوَاجِبُنَا فِي رَفْعِ الحُجُبِ
العُنْصُرُ الرَّابِعُ: ثِمَارُ (نتائج) رَفْعِ الحُجُبِ وَفَتْحِ الأَبْوَابِ
أيها الأحبّةُ في اللهِ… حديثُنا في هذا اليومِ عن خطرٍ عظيمٍ، وهو أن يتحوّلَ العبدُ من جسرٍ يوصلُ الخلقَ إلى اللهِ، إلى حجابٍ يصدُّهم عن سبيلِ اللهِ. وما أعظمَ أن يكونَ الإنسانُ حاجزًا بين عبادِ اللهِ وربِّهم! (لا تكنْ حجابًا بينَ الناسِ وبينَ الله).
لقد وصفَ اللهُ حالَ الكافرينَ الذين لا يؤمنونَ بالآخرةِ فقال: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ [الإسراء: 45]. فالحجابُ هنا حاجزٌ معنويٌّ يمنعُ وصولَ أنوارِ القرآنِ إلى قلوبِهم، فلا ينتفعونَ بكلامِ اللهِ، ولا يهتدونَ بنورِه.
العُنْصُرُ الأَوَّلُ: مَعْنَى أَنْ تَكُونَ سَبَبًا لِلهِدَايَةِ أَوْ سَبَبًا لِلصُّدُودِ
أيها الإخوةُ الأكارمُ… إن مكانةَ الإنسانِ عند اللهِ تتحددُ بقدرِ أثرِه في غيرِه، فيكونُ أحيانًا مفتاحًا للخيرِ وسببًا للهدى، وقد يكونُ ـ والعياذُ باللهِ ـ سببًا للصدودِ والنفورِ. فما أسعدَ أن يكونَ العبدُ جسرًا يقبلُ الناسُ بسببه على اللهِ، وما أخطرَ أن يكونَ جدارًا يصدُّهم عنه.
أولًا: معنى أن تكونَ سببًا للهداية
الهدايةُ ـ أيها الأحبةُ ـ منحةٌ ربانيةٌ، ولكنَّ اللهَ يجعلُ لها أسبابًا، فيكونُ العبدُ مبلغًا، داعيًا، قدوةً، فيفتحُ به قلبٌ، وتُرفعُ به حجبٌ، وتُغيَّرُ به حياةٌ. قال اللهُ تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: 33].
فأفضلُ منطقٍ وأطيبُ كلامٍ هو كلامُ الداعي الذي يجمعُ بين صدقِ الدعوةِ وصلاحِ العملِ وإظهارِ الهويةِ الإيمانيةِ. وقال تعالى: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: 42]. وهذا يدلُّ على أن الواجبَ على الأمةِ إيصالُ الحجةِ وإظهارُ البينةِ، ثم يبقى الخلقُ بين هلاكٍ بإعراضٍ، أو حياةٍ بإقبالٍ.
وفي الحديثِ قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» (مسلم 1893). وقال ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ» (مسلم 1017).
ومن أبرزِ صورِ ذلك: دعوةُ النبيِّ ﷺ لهرقلَ ملكِ الرومِ في كتابِه المشهورِ: «أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ» (البخاري 4553، مسلم 1773). فبهذا الكلامِ الوجيزِ الذي يجمعُ بين الدعاءِ والبشارةِ والتخويفِ، جعلَ رسولُ اللهِ ﷺ الحجةَ بالغةً.
إسلامُ الطفيلِ بنِ عمروٍ الدوسيِّ، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ مَكَّةَ، فَاجْتَمَعَ بِهِ أَشْرَافُ قُرَيْشٍ وَحَذَّرُوهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَهَوْهُ أَنْ يَجْتَمِعَ بِهِ، أَوْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا بِي، حَتَّى أَجْمَعْتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا أُكَلِّمَهُ، حَتَّى حَشَوْتُ أُذُنِيَّ حِينَ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ كُرْسُفًا; فَرَقًا مِنْ أَنْ يَبْلُغَنِي شَيْءٌ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَسْمَعَهُ. قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَقُمْتُ مِنْهُ قَرِيبًا، فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسْمِعَنِي بَعْضَ قَوْلِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ كَلَامًا حَسَنًا. قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاثُكْلَ أُمِّي! وَاللَّهِ إِنِّي لَرَجُلٌ لَبِيبٌ شَاعِرٌ، مَا يَخْفَى عَلَيَّ الْحَسَنُ مِنَ الْقَبِيحِ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنَّ أَسْمَعَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ مَا يَقُولُ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْتِي بِهِ حَسَنًا قَبِلْتُهُ، وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا تَرَكْتُهُ. قَالَ: فَمَكَثْتُ حَتَّى انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ قَوْمَكَ قَالُوا لِي كَذَا وَكَذَا، لِلَّذِي قَالُوا. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا بَرِحُوا بِي يُخَوِّفُونَنِي أَمْرَكَ حَتَّى سَدَدْتُ أُذُنَيَّ بِكُرْسُفٍ; لِئَلَّا أَسْمَعَ قَوْلَكَ، ثُمَّ أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسْمِعَنِي قَوْلَكَ، فَسَمِعْتُ قَوْلًا حَسَنًا، فَاعْرِضْ عَلَيَّ أَمْرَكَ. قَالَ: فَعَرَضَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْلَامَ، وَتَلَا عَلَيَّ الْقُرْآنَ، فَلَا وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ قَوْلًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، وَلَا أَمْرًا أَعْدَلَ مِنْهُ. قَالَ: فَأَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ الْحَقِّ، وَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي امْرُؤٌ مُطَاعٌ فِي قَوْمِي، وَإِنِّي رَاجِعٌ إِلَيْهِمْ، وَدَاعِيهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي آيَةً تَكُونُ لِي عَوْنًا عَلَيْهِمْ فِيمَا أَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَهُ آيَةً». قَالَ: وَقَعَ نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيَّ مِثْلُ الْمِصْبَاحِ…. ، ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ غَلَبَنِي عَلَى دَوْسٍ الزِّنَا فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ. قَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ وَارْفُقْ بِهِمْ”. البداية والنهاية ابن كثير ج4، ص243- 245 باختصار.
فهنا يتبينُ المعيارُ؛ قريشٌ حجابٌ وصدٌ، والنبيُ ﷺ هدايةٌ وفتحٌ، فلا تكنْ حجابًا بين الناسِ وبين اللهِ، وكنْ جسرًا للنورِ على نهجِ النبيُ ﷺ. فكان الرفقُ والإحسانُ سببًا في رفعِ الحجابِ، وفتحِ القلبِ، وإظهارِ ثمرةِ الهدى.
ثَانِيًا: مَعْنَى أَنْ تَكُونَ سَبَبًا لِلصُّدُودِ
وعلى الضدِّ من ذلك… فقد يكونُ الإنسانُ حجابًا بين الناسِ وبين ربِّهم، بسوءِ خلقٍ، أو تعسيرٍ في الدينِ، أو رياءٍ وتصنعٍ، فيكونُ ذلك سببًا لنفورِهم وصدودِهم.
أيها الإخوةُ… لو تأملنا في السنةِ لوجدنا النبيَّ ﷺ قد حذّر من أن يكون المسلمُ سببًا في نفورِ الناسِ عن الدينِ. فعن جابرٍ رضي الله عنه قال: “أن معاذ بن جبل كانَ يُصَلِّي مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ يَأْتي قَوْمَهُ فيُصَلِّي بهِمُ الصَّلَاةَ، فَقَرَأَ بهِمُ البَقَرَةَ، قالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذلكَ مُعَاذًا، فَقالَ: إنَّه مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذلكَ الرَّجُلَ، فأتَى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بأَيْدِينَا، ونَسْقِي بنَوَاضِحِنَا، وإنَّ مُعَاذًا صَلَّى بنَا البَارِحَةَ، فَقَرَأَ البَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أنِّي مُنَافِقٌ، فَقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا مُعَاذُ، أفَتَّانٌ أنْتَ؟! -ثَلَاثًا- اقْرَأْ: والشَّمْسِ وضُحَاهَا، وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى، ونَحْوَهَا» (البخاري 6160، مسلم 465).
فهنا بيّن النبي ﷺ أن مجردَ إطالةِ القراءةِ صارت حجابًا يمنع الناسَ من أداء الصلاةِ بخشوعٍ، فكيف بالقسوةِ والظلمِ والتنفيرِ؟
وقال ﷺ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (مسلم 102). والغشُّ أنواعٌ، في البيعِ والشراءِ، وفي العملِ، وفي الكلامِ. وكم نفر أناسٌ من الدينِ لما رأوا مسلمًا يغشُّ ويخدعُ. قال ابنُ القيمِ رحمه اللهُ: “ومن أعظم الضُّرِّ: حجابُ القلب عن الرّبِّ، وهو أعظم عذابًا من الجحيم، قال تعالى: }كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ {المطففين: 15- 16 – ١٦. (مدارج السالكين، 4/106)
فالمؤمنُ ـ يا أحبةَ الإيمانِ ـ لا ينفكُّ عن أن يكونَ أحدَ اثنينِ: إمَّا جسرًا للنورِ، يقربُ الناسَ من اللهِ. وإمَّا حجابًا للظلمةِ، يصدُّهم عن رحمةِ اللهِ. فاختَرْ لنفسِك مكانَها… وكنْ سببًا للهدى لا سببًا للصدودِ
العنصر الثاني: الدِّينُ مُعَامَلَةٌ وَرَحْمَةٌ
أيُّها الإخوةُ الكرامُ… كثيرٌ من الناسِ يظنُّ أنَّ الدينَ محصورٌ في عباداتٍ شكليةٍ أو شعائرَ ظاهريةٍ، مع أنَّ جوهرَهُ الأكبرَ وأساسَه الأعمقَ هو الرحمةُ وحُسنُ المعاملةِ. فالإسلامُ ليس دينَ طقوسٍ جامدةٍ، وإنما دينُ حياةٍ كاملةٍ، يزرعُ في القلبِ خشيةَ اللهِ، ويزرعُ في السلوكِ رحمةَ الخلقِ.
قال رسولُ اللهِ ﷺ في الحديثِ الجامعِ: «إنما بُعثتُ لأتممَ مكارمَ الأخلاقِ» (أحمد، ج2/ ص381، ح/8952، حسن).
فجوهرُ الرسالةِ المحمديةِ هو مكارمُ الأخلاقِ؛ وكلُّ عبادةٍ لا تُثمرُ خُلُقًا ولا رحمةً، فثمرتُها ناقصةٌ ومقصودُها معطّلٌ.
كمال الإيمان وحُسن الخُلق
قال ﷺ: «أقربُكم منّي مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسنُكم أخلاقًا» (سنن الترمذي، ج4/ ص370، ح/2018، صحيح).
فالقربُ من رسولِ اللهِ يومَ القيامةِ لا يُنالُ بالمالِ ولا بالمظاهرِ، وإنما بحسنِ المعاملةِ مع الخلقِ.
رحمته ﷺ مع غير المسلمين
روى البخاري عن أنسٍ رضي الله عنه: “كانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَمَرِضَ، فأتَاهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقالَ له: أسْلِمْ، فَنَظَرَ إلى أبِيهِ وهو عِنْدَهُ فَقالَ له: أطِعْ أبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأسْلَمَ، فَخَرَجَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يقولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»” (صحيح البخاري: ح/1356). هذه هي روحُ الدينِ: رحمةٌ وعدلٌ وبذلٌ، لا قسوةَ ولا غلظةَ.
قال الفضيلُ بنُ عياضٍ رحمه الله: “المؤمنُ يرفقُ ويترفق، ولا يكونُ فظًّا غليظًا” (حلية الأولياء، ج8/ ص92). وقال أيضًا: “إنَّما يريدُ اللهُ عز وجل من العبادِ الرِّفقَ وحسنَ الخلق”. (حلية الأولياء، ج8/ ص93). وقال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: “إني لأكره أن أرى أحدَكم سبعًا، لا في أهلِ ولا في مال” (مصنف ابن أبي شيبة، ج6/ ص125).
الدينُ في جوهره رحمةٌ: قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]. فكلُّ ما يخالفُ الرحمةَ، وينشرُ القسوةَ والفظاظةَ، فهو خروجٌ عن مقصدِ الرسالةِ المحمديةِ.
أخلاقُ التجارِ سببُ دخولِ أممٍ كاملةٍ… إندونيسيا والملايو… أممٌ أسلمتْ بالتجارِ والأخلاقِ
أيها الإخوةُ الكرامُ… إنَّ منْ أعجبِ ما يذكرُهُ التاريخُ أنَّ أكبرَ دولةٍ إسلاميةٍ اليومَ — إندونيسيا — لمْ يدخلْها جيشٌ ولا قائدٌ، بلْ دخلَها الإسلامُ على أيدي تجارٍ مسلمينَ كانوا يتصفونَ بالأمانةِ والصدقِ والعدلِ. يذكرُ ابنُ خلدونَ “والإسلام لهذا العهد فاش فيهم، ولهم يومئذ مقاشن على البحر الهندي يعمرها تجار المسلمين”. تاريخ ابن خلدون ج6 ص265. وأنَّ أهلَ جزائرِ الملايو وإندونيسيا قدْ أسلموا طوعًا حينَ رأوا أنَّ التجارَ المسلمينَ لا يكذبونَ ولا يغدرونَ، وأنَّهمْ يتعاملونَ بالإنصافِ في البيعِ والشراءِ.
إفريقيا الشرقيّةِ: تنزانيا وكينيا وجزائرُ زنجبار
أيها الإخوةُ الأفاضلُ… إنَّ أحدَ أبهى الشواهدِ على أنَّ الأخلاقَ والمعاملةَ هيَ السرُّ في دخولِ الناسِ في دينِ اللهِ، ما حدثَ في سواحلِ إفريقيا الشرقيّةِ: تنزانيا وكينيا وجزائرُ زنجبار. ويقولُ ابنُ خلدونَ: «وأمّا بلادُ السّودان فإنّ أكثرَها لهذا العهدِ قد غلبَ عليهِ الإسلامُ، وتولَّى ملوكُها الدّخولَ فيه طوعًا، ففشا فيهمُ الدينُ، واتّصلت شعائره، وسببُ ذلك مجاورةُ المسلمين من أهل المغرب لهم وكثرةُ التّجّار الداخلين إليهم من المسلمين، فدُعوا إلى الإسلام فاستجابوا، وأذعنوا لأحكامه» (المقدمةُ، ج1، ص 191).
العنصر الثالث: القُدْوَةُ وَالرِّفْقُ جِسْرٌ لِلْهَدَايَةِ وَوَاجِبُنَا فِي رَفْعِ الحُجُبِ
أيها الإخوةُ الكرامُ… العلاجُ لا يكونُ إلا بالضدِّ: القدوةُ الصالحةُ، والرِّفقُ بالخلقِ، وتحقيقُ واجبِنا في أن نكونَ جسورًا للهدايةِ لا حجبًا عن الحقِّ.
- القُدْوَةُ أَعْظَمُ وَسَائِلِ الدَّعْوَةِ
إن أعظمَ طريقٍ يفتحُ اللهُ به القلوبَ ليس كثرةَ الجدلِ ولا طولَ المواعظِ، وإنما القدوةُ العمليةُ. قال تعالى مخاطبًا نبيَّه ﷺ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الأحزاب: 21].
فالأسوةُ الحسنةُ هي الدعوةُ الصامتةُ، وهي التي تُحوِّلُ الدينَ من أقوالٍ إلى أفعالٍ.
قال الحسنُ البصريُّ: “كونوا دعاةً إلى اللهِ وأنتم صامتونَ”. قيل: كيف؟ قال: “بأخلاقِكم” (حلية الأولياء، ج2، ص131).
النَّبِيُّ ﷺ أُسْوَةُ القُدْوَةِ وَالرِّفْقِ: أيها الأحبّةُ… لقد كان رسولُ اللهِ ﷺ المثالَ الأكملَ في القدوةِ والرفقِ: جاءه رجلٌ يجرُّ نفسَه من شدةِ المرضِ، فقال له: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ» (صحيح البخاري 1117). لم يقلْ له: لماذا قصّرت؟ بل يسّر عليه وأرشدَه. وكان ﷺ يرحمُ الصغارَ، حتى قال أنسٌ رضي الله عنه: “ما رأيتُ أحدًا أرحمَ بالعيالِ من رسولِ اللهِ ﷺ” (صحيح مسلم 2316)..
القُدْوَةُ الصَّالِحَةُ عِنْدَ السَّلَفِ: “كان ابن المبارك يقوم على خدمة أصحابه في السفر، حتى صبَّ الماء على أيديهم للوضوء، وقال: إنما الخادم من يخدم إخوانه في السفر” (سير أعلام النبلاء، ج8، ص385). عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: دخلتُ على أبي وعليَّ قميصٌ مرقوع، فقال لي: يا بني، لا يضرُّك أن تلبسَ قميصًا مرقوعًا، فإن وراءَك من هو أنعمُ منك”. (صفة الصفوة، ج2، ص128)..
- الرِّفْقُ وَالحِكْمَةُ سَبِيلُ رَفْعِ الحُجُبِ
قال النبي ﷺ: «إن اللهَ رفيقٌ يحبُّ الرفقَ في الأمرِ كلِّه» (صحيح مسلم 2165). وقال ﷺ: «الراحمونَ يرحمُهم الرحمنُ، ارحموا من في الأرضِ يرحمْكم من في السماءِ» (سنن الترمذي 1924، صحيح). قال ابن حجر: “الرفقُ سببٌ لنيلِ المرادِ بأيسرِ طريقٍ، وضدُّه العنفُ الذي قد يفوّتُ المطلوبَ” (فتح الباري، ج10، ص545).
وَاجِبُنَا فِي رَفْعِ الحُجُبِ: أيها الإخوةُ… لقد جعلنا اللهُ شهودًا على الناسِ، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 143]. وهذا يفرضُ علينا واجباتٍ واضحةً:
واجبُ الفرد: أن يكون رحيمًا صادقًا، لا يصدّ الناسَ عن اللهِ بسوءِ خلقِه.
واجبُ الأبِ والأمِّ: تربيةُ الأبناءِ بالحبِّ لا بالقسوةِ.
واجبُ العالمِ والخطيبِ: أن يكون كلامُه دعوةً باللينِ والحكمةِ.
واجبُ المجتمعِ: أن يُظهرَ الإسلامَ عدلًا ورحمةً، لا ظلمًا وفسادًا.
قال النبي ﷺ: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيّتِه» (البخاري 893، مسلم 1829).
فالمسؤوليةُ جماعيةٌ: كلُّ واحدٍ منا إما أن يكونَ جسرًا للهدايةِ أو جدارًا للصدِّ.
أيها الأحبةُ… إن القدوةَ الحسنةَ والرفقَ بالخلقِ هما أعظمُ مفاتيحِ القلوبِ. وإن واجبَنا أن نُزيلَ كلَّ حجابٍ صنعناه بسلوكِنا أو تقصيرِنا، فنكونَ دعاةً إلى اللهِ بقلوبِنا وأخلاقِنا وأفعالِنا.
الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ
الحمدُ للهِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيهِ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ ﷺ.
العُنْصُرُ الرَّابِعُ: ثِمَارُ (نتائج) رَفْعِ الحُجُبِ وَفَتْحِ الأَبْوَابِ
أيها الإخوةُ الأفاضلُ… إن رفعَ الحجبِ التي يصنعها الناسُ بينهم وبين اللهِ ليس أمرًا جانبيًا في حياةِ الإيمانِ، بل هو أصلٌ عظيمٌ تتوقفُ عليه هدايةُ القلوبِ، وصلاحُ الأممِ، ورفعةُ شأنِ الدينِ. فكما أن الشجرةَ إذا زال ما يحولُ بينها وبين الشمسِ والماءِ أخرجت أطيبَ الثمارِ، كذلك القلوبُ إذا زالت عوائقُها وحجبُها أخرجت هدى ورحمةً وعدلًا.
أولًا: هدايةُ القلوبِ: أولُ ثمرةٍ من ثمارِ رفعِ الحجبِ أن تُفتحَ أبوابُ الهدايةِ، فإذا أُزيلت الحواجزُ دخل نورُ القرآنِ إلى الفؤادِ، فيبصرُ الحقَّ كأنه بين يديهِ.
قال اللهُ تعالى: ﴿أفمن شرح اللهُ صدرهُ للإسلامِ فهو على نورٍ من ربِّهِ﴾ [الزمر: 22]، وفي الحديثِ الصحيحِ قال النبيُّ ﷺ: «إنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً، إذا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألا وهي القَلْبُ» (البخاري 52، مسلم 1599).
ثانِيًا: قُوَّةُ الوَحْدَةِ وَاجْتِمَاعُ الأُمَّةِ: من ثمارِ رفعِ الحُجُبِ أيضًا: أن تتوحّدَ القلوبُ وتجتمعَ الأمةُ، فإن الحجبَ حين تكونُ غلوًّا أو تعصّبًا تفرّق ولا تجمع. وإذا زالت بان الدينُ في رحابتِه وسموِّه.
قال اللهُ تعالى: ﴿واعتصموا بحبلِ اللهِ جميعًا ولا تفرّقوا﴾ [آل عمران: 103].
وفي الحديبيةِ لما رأى عروةُ بنُ مسعودٍ تعلّقَ الصحابةِ بنبيِّهم ﷺ، وكيف يتسابقونَ على بقايا وضوئِه، عاد إلى قريشٍ يقول: “والله ما رأيتُ ملكًا قطُّ يعظّمهُ أصحابُه كما يعظّمُ أصحابُ محمدٍ محمدًا” (ابن هشام، ج2، ص321).
فكانت الثمرةُ هنا: أمّةٌ مجتمعةٌ تَأْسِرُ القلوبَ قبل الأبصارِ، وتُظهرُ للعالمِ قوةَ الدينِ في جمعِ المختلفينَ على كلمةٍ سواء.
ثالِثًا: انْتِشَارُ الرَّحْمَةِ فِي المُجْتَمَعِ: ومن ثمارِ رفعِ الحجبِ أن يسودَ الرّفقُ وتنتشرَ الرحمةُ، فيشعرَ الناسُ أن الدينَ جنةٌ لا سوطٌ، وأنه حياةٌ للقلبِ لا عبءٌ على الروحِ، قال اللهُ تعالى في وصفِ نبيِّه ﷺ: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: 159].
وقد كان ﷺ يحملُ الحسنَ والحسينَ ويقبّلهما، فقال له الأقرعُ بنُ حابسٍ: إن لي عشرةً من الولدِ ما قبّلتُ منهم أحدًا. فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «من لا يرحم لا يُرحم» (البخاري 5997، مسلم 2318).
فالثمرةُ هنا: مجتمعٌ مرحومٌ يحبُّ دينَهُ ويثقُ به، لأنه يراهُ دينَ رحمةٍ وحنانٍ لا قسوةٍ وعنفٍ.
رابِعًا: تَعْظِيمُ شَأْنِ الإِسْلَامِ بَيْنَ الأُمَمِ” إذا رُفعت الحجبُ التي تُشوّه صورةَ الإسلامِ، برزَ الدينُ على حقيقتِه: دينُ عدلٍ ورحمةٍ وإنصافٍ. فيعظمُ في أعينِ الناسِ وترتفعُ مكانتُهُ بين الأممِ. فالثمرةُ هنا: إعلاءُ مكانةِ الإسلامِ وتعظيمُ شأنِه بين الناسِ، عبرَ البلاغِ الحكيمِ والكلمةِ الطيبةِ.
خامِسًا: رِضَا اللهِ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ: وهذه هي أعظمُ الثمارِ على الإطلاقِ. فمن جعل نفسَه جسرًا للهدايةِ ولم يكن حجابًا للصدِّ، أحبَّه اللهُ وأحبَّه أهلُ السماءِ، ووضَع له القبولَ في الأرضِ، قال النبيُّ ﷺ: « إنَّ اللَّهَ إذا أحَبَّ عَبْدًا دَعا جِبْرِيلَ فقالَ: إنِّي أُحِبُّ فُلانًا فأحِبَّهُ، قالَ: فيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنادِي في السَّماءِ فيَقولُ: إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانًا فأحِبُّوهُ، فيُحِبُّهُ أهْلُ السَّماءِ، قالَ ثُمَّ يُوضَعُ له القَبُولُ في الأرْضِ، وإذا أبْغَضَ عَبْدًا دَعا جِبْرِيلَ فيَقولُ: إنِّي أُبْغِضُ فُلانًا فأبْغِضْهُ، قالَ فيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنادِي في أهْلِ السَّماءِ إنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلانًا فأبْغِضُوهُ، قالَ: فيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ له البَغْضاءُ في الأرْضِ» (البخاري 6040، مسلم 2637).
فالثمرةُ الكبرى: رضا اللهِ في الدنيا، والجنةُ في الآخرةِ. وذلك هو الفوزُ العظيمُ.
اللهم اغفر لنا ذنوبَنا، واستر عيوبَنا، واشرح صدورَنا، ويسّر أمورَنا، واهدنا سبلَ السلامِ، وأخرجنا من الظلماتِ إلى النورِ.
اللهم احفظ مصرَ من كل سوءٍ وفتنةٍ وبلاءٍ، وأدم عليها نعمةَ الأمنِ والإيمانِ، والسلامةَ والإسلامِ.
المراجع: القرآن الكريم
كتب الحديث: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، وابن ماجه، سنن الترمذي، مسند أحمد، سنن النسائي، المعجم الأوسط للطبراني. مصنف ابن أبي شيبة
ثالثًا: كتب التفسير وشروح الحديث وغيرهما: تفسير ابن كثير، تَفْسِيرُ، فتح الباري لابن حجر، حلية الأولياء لأبي نعيم. سيرة ابن هشام، البداية والنهاية لابن كثير، مدارج السالكين لابن القيم، تاريخ ابن خلدون، سير أعلام النبلاء للذهبي، المقدمة لابن خلدون، صفة الصفوة لابن الجوزي.
د. أحمد رمضان
خُطبةُ صوتِ الدعاةِ – إعداد رئيس التحرير: الدكتور أحمد رمضان
___________________________________
خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف علي صوت الدعاة
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
و للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع
و للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف












