خطبة الجمعة القادمة 17 أكتوبر : بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، للدكتور محروس حفظي
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

خطبة الجمعة القادمة
خطبة الجمعة القادمة 17 أكتوبر 2025م بعنوان : بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، للدكتور محروس حفظي بتاريخ 25 ربيع الثاني 1447هـ ، الموافق 17 أكتوبر 2025م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 17 أكتوبر 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .
ولتحميل خطبة الجمعة القادمة 17 أكتوبر 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، بصيغة word أضغط هنا.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 17 أكتوبر 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، بصيغة pdf أضغط هنا.
___________________________________________________________
عناصر خطبة الجمعة القادمة 17 أكتوبر 2025م بعنوان : بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، للدكتور محروس حفظي :
(1) الاختلاف سنة كونية ربانية، وبيان أقسامه.
(2) آداب وأخلاقيات الاختلاف.
(3) فوائد الاختلاف المقبول وأثره على الفرد والمجتمع.
(4) ذم الاختلاف المؤدي إلى النزاع والشقاق.
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 17 أكتوبر 2025م بعنوان: بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، للدكتور محروس حفظي : كما يلي:
بالتي هي أحسن
بِتَارِيخِ 25 رَبِيعِ الثَّانِي 1447 ه = المُوَافِقِ 17 أكتوبر 2025 م
الحمد لله حمدًا يوافي نعمَه، ويكافىء مزيدَه، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهِك، ولعظيم سلطانِك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدِنا محمدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أما بعد،،،
(1) الاختلاف سنة كونية ربانية، وبيان أقسامه:
الحياةُ بدون اختلافٍ تصبح رتيبةً مملةً، تخيل أن أشكالَ الخلقِ، كلماتِهم، أفكارِهم، لباسِهم، حركاتِهم، تصرفاتِهم، الأشجارَ والأحجارَ، الليلَ والنهارَ… إلخ، جاءت على نمطٍ واحدٍ؛ لأضحت الدنيا جحيمًا لا تطيقُه النفوسُ {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} [القصص: 71-72]؛ لذلك كان “الاختلاف رحمةً بهم”.
وقد قرر القرآنُ الكريمُ أن الخلقَ يختلفون أيضًا في أذواقِهم، وصورِهم، وألسنتِهم، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ} [الروم: 22]، وقال أيضًا: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ} [فاطر: 27].
بل حتى على مستوى أصابعِ الإنسانِ، فلا يوجد شخصٌ تتطابق بصماتُه مع غيرِه ولو كان أخاه لأمه وأبيه، قال تعالى: {أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ} [القيامة: 3-4].
هذا الاختلافُ الكونيُّ لا يعني الصراعَ والصدامَ، فهذا الكونُ على ما فيه من تنوعٍ واختلافٍ إلا أنك تجد فيه تناغمًا وتناسقًا بين جميعِ المخلوقاتِ قال تعالى: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} [الملك: 3].
حتى تكتمل هذه السنةُ الربانيةُ جعل اللهُ الناسَ تتباين وجهاتِ نظرِهم، وتختلف أفكارُهم قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} [المائدة: 48]. وقال سبحانه: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [هود: 118].
قال ابن عطية: (المعنى: لجعلهم أمةً واحدةً مؤمنةً قاله قتادةُ حتى لا يقع منهم كفرٌ، ولكنه عز وجل لم يشأ ذلك، فهم لا يزالون مختلفين في الأديانِ، والآراءِ، والمللِ، وهذا تأويل الجمهور). أ.هـ [المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز].
وقال ابن عجيبة: ({أُمَّةً وَاحِدَةً}: متفقين على الإيمانِ، أو الكفرانِ، لكن مقتضى الحكمةِ وجودُ الاختلافِ؛ ليظهر مقتضياتُ الأسماءِ في عالمِ الشهادةِ، فاسمه “الرحيم والكريم”: يقتضي وجودَ من يستحق الكرمَ والرحمةَ، واسمه “المنتقم والقهار”: يقتضي وجودَ من يستحق الانتقامَ والقهريةَ.
وقوله: {وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ}: إن كان الضمير «للناس»: فالإشارةُ إلى الاختلافِ، واللامُ للعاقبةِ، أي: ولتكون عاقبتُهم الاختلافَ خلقهم، وإن كان الضميرُ يعود على «من»: فالإشارةُ إلى الرحمةِ، أي: إلا من رحم ربك، وللرحمةِ خلقه.
الإشارةُ: الاختلافُ بين الناس حكمٌ أزليٌّ، لا مَحِيدَ عنه، وقد وقع بين أهل الحقِّ وبين أهل الباطلِ، فقد اختلفت هذه الأمةُ في الفروعِ، فقد كان في أول الإسلام اثنا عشر مذهبًا، ولا تجد علمًا من “علم الفروع” إلا وبين أهله اختلافٌ …، ففي ذلك رخصةٌ لأهل الاضطرارِ؛ لأن من قلد عالمًا لقي اللهَ سالمًا). أ.هـ [البحر المديد في تفسير القرآن المجيد].
أقر النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم الاجتهادَ الناشئَ عن الاختلافِ في فهمِ النصِّ؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: قال النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزابِ: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فأدرك بعضَهم العصرُ في الطريقِ، فقال بعضُهم: لا نصلي حتى نأتيَها، وقال بعضُهم: بل نصلي، لم يُرَدْ منا ذلك، فذُكِر للنبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، فلم يعنِّف واحدًا منهم» [رواه البخاري].
عن معاذِ بن جبلٍ أن النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم لما أراد أن يبعثه إلى اليمنِ قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاءٌ؟»، قال: أقضي بكتابِ اللهِ، قال: «فإن لم تجد في كتابِ اللهِ؟»، قال: فبسنةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، قال: «فإن لم تجد في سنةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، ولا في كتابِ اللهِ؟» قال: أجتهد رأيي، ولا آلو، فضرب رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم صدرَه، وقال: «الحمدُ للهِ الذي وفق رسولَ، رسولِ اللهِ لما يرضي رسولَ اللهِ» [رواه أبو داود، وأحمد].
أقسام الاختلاف:
(أ) اختلافُ التنوعِ: الذي يتمثل في الأقوالِ المتعددةِ التي لا تضادَّ ولا تناقضَ بينها في المجملِ، وإنما تصب في معينٍ واحدٍ، وهذا ما يعرف بــ”الخلافِ اللفظيِّ”، وهو غالبُ نتاجِ الشريعةِ الغراءِ، وما تمخض عن أقوالِ الفقهاءِ والعلماءِ على اختلافِ مشاربِهم، وهذا الاختلافُ ليس مذمومًا إذا رُوعي فيه حدودُ الأدبِ والأخلاقِ، فهو نتيجةُ الاجتهادِ، وتفاوتُ الأفهامِ في مسائلَ متفاوتةٍ، بل إن صاحبَه مأجورٌ إذا كان من أهلِ العلمِ؛ فعن عمرو بن العاصِ أنه سمع النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم يقول: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ» [متفق عليه].
هذا الاختلافُ يقود إلى النجاحِ، وتثمر عنه الإنجازاتُ، ولا يفسد للودِّ قضيةً، وتحفظ فيه الحقوقُ، وتصان فيه الأعراضُ عن أن تُنتهك؛ ولهذا صنف رجلٌ كتابًا في “الاختلافِ”، فقال الإمامُ أحمدُ بن حنبلٍ: لا تسمِّه “الاختلافَ”، ولكن سمه “السعةَ”.
(ب) اختلافُ التضادِّ: وهو الأقوالُ والآراءُ المتضادةُ أو المتناقضةُ التي لا يمكن الجمعُ بينها؛ لأنها تمثل أصولَ الدينِ، وثوابتَه، أو تتعارض مع مقاصدِ الشريعةِ العامةِ، وهذا منفيٌّ ألبتةَ؛ لأن الله منزهٌ عن الخطأ والنسيانِ {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]، {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4].
قال الإمامُ السبكيُّ: (والذي نقطع به أن الاتفاقَ خيرٌ من الاختلافِ، وأن الاختلافَ على ثلاثةِ أقسامٍ: أحدُها: في الأصولِ، ولا شك أنه ضلالٌ، وسببُ كل فسادٍ، وهو المشار إليه في القرآنِ. والثاني: في الآراءِ، والحروبِ، ويشير إليه قولُه صلى اللهُ تعالى عليه وسلم لمعاذٍ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمنِ: «تطاوعا ولا تختلفا»، ولا شك أيضًا أنه حرامٌ؛ لما فيه من تضييعِ المصالحِ الدينيةِ والدنيويةِ. والثالث: في الفروعِ كالاختلافِ في الحلالِ والحرامِ ونحوِهما، والذي نقطع به أن الاتفاقَ خيرٌ منه أيضًا). أ.هـ [روح المعاني للآلوسي].
(2) آداب وأخلاقيات الاختلاف:
أتقنا فنَّ الاختلافِ في كل شيءٍ من أمورِ الحياةِ لكن افتقدنا آدابَ الاختلافِ وأخلاقياتِه، تجاوزُ هذه الآدابِ يؤدي إلى إيغارِ الصدورِ، وزرعِ الشحناءِ والخصوماتِ، وتمزيقِ الوحدةِ والاجتماعِ، قال تعالى: {وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: 46].
وعن جابرٍ قال: سمعتُ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم يقول: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ» [رواه مسلم].
“التحريشُ”: الإغراءُ على الشيءِ بنوعٍ من الخداعِ، أي: إيقاعُ الفتنةِ، والعداوةِ، والخصومةِ.
أولًا: الرجوعُ إلى كتابِ اللهِ، وسنةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم المتمثلِ في فهمِ العلماءِ المنضبطين: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].
{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].
{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [الشورى: 10].
ثانيًا: أن نحسن الظنَّ في المخالفِ: عن حمدونَ القصَّار أنه قال: «إذا زل أخٌ من إخوانِكم، فاطلبوا له سبعينَ عذرًا، فإن لم تقبلْه قلوبُكم، فاعلموا أن المعيبَ أنفسَكم؛ حيث ظهر لمسلمٍ سبعون عذرًا فلم تقبله». [إحياء علوم الدين].
عن أبي حبيبةَ، مولى طلحةَ، قالَ: «دخلت على علي مع عمر بن طلحة بعدما فرغ من أصحاب الجمل، قال: فرحب به وأدناه، قال: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله:{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} [الحجر: 47]، فقال:«يا ابن أخي، كيف فلانة كيف فلانة؟» قال: وسأله عن أمهات أولاد أبيه…» [رواه الحاكم في “المستدرك، وصححه، ووافقه الذهبي].
قال الإمامُ الذهبيُّ: “وَلَوْ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ – مَعَ صِحَّةِ إِيْمَانِهِ، وَتَوَخِّيْهِ لاتِّبَاعِ الحَقِّ- أَهْدَرْنَاهُ، وَبَدَّعنَاهُ، لَقَلَّ مَنْ يَسلَمُ مِنَ الأَئِمَّةِ مَعَنَا، رَحِمَ اللهُ الجَمِيْعَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ”. [سير أعلام النبلاءِ للذهبيِّ].
قال سيدُنا عمرُ بن الخطابِ: “لَا تَظُنَّ كَلِمَةً خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدَ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا”. [روضةُ العقلاءِ ونزهةُ الفضلاءِ لابن حِبَّانَ].
ثالثًا: الرفقُ واللينُ في التعاملِ، وخفضُ الجناحِ، وحفظُ اللسانِ، وعدمُ الخوضِ في الأعراضِ: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: 44]. قال الإمامُ القرطبيُّ: (دليلٌ على جوازِ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ، وأن ذلك يكون باللينِ من القولِ لمن معه القوةُ، وضُمِنَتْ له العصمةُ، …، فكيف بنا فنحن أولى بذلك، وحينئذٍ يحصل الآمرُ أو الناهي على مرغوبةٍ، ويظفر بمطلوبِه، وهذا واضحٌ…، فإذا كان موسى أُمر بأن يقول لفرعون قولًا لينًا، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابِه، وقد قال اللهُ تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة: 83]). أ.ه. [الجامعُ لأحكامِ القرآنِ].
قال يونسُ بن عبدِ الأعلى الصدفيُّ:”ما رأيت أحدًا أعقلَ من الشافعيِّ، لو جُمِعَتْ أمةٌ فجُعِلَتْ في عقلِ الشافعيِّ لوسعهم عقلُه، وقد ناظرتُه يومًا في مسألةٍ ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي، ثم قال لي يا أبا موسى لا يستقيم أن نكون إخوانًا، وإن لم نتفق في مسألةٍ”. [رواه ابن عساكرَ في “تاريخِ دمشقَ”].
قال الإمامُ الذهبيُّ: “هَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ عَقْلِ هَذَا الإِمَامِ، وَفِقْهِ نَفْسِهِ، فَمَا زَالَ النُّظَرَاءُ يَخْتَلِفُونَ”. [سيرُ أعلامِ النبلاءِ للذهبيِّ].
مهما وصلتْ في الاختلافِ فلا تنسْ أن الذي تختلفُ معه مسلمٌ له احترامُه وتوقيرُه، ولا يصح بحالٍ أن تُكفِّرَه أو تُفَسِّقَه؛ فعن أنسِ بن مالكٍ، قالَ: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ» [رواه البخاريُّ].
استيعابُ المخالفِ في الرأي ينبغي أن نتعاملَ معه بعدلٍ وإنصافٍ وموضوعيةٍ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8].
رابعًا: الحذرُ من اتباعِ التشهيِ، والهوى، وأن يكون القصدُ ظهورَ الصوابِ ولو على يدِ صاحبِه: غيابُ ثقافةِ الاختلافِ يؤدي إلى شخصنةِ المسائلِ، بل قد لا يقبل الرأيَ الآخرَ حتى وإن كان صوابًا، ويعتبر أن عدمَ الأخذِ برأيه هزيمةٌ شخصيةٌ؛ لذا يسعى للانتصارِ لقولِه، ومذهبِه، بل قد يزعم أنه يملك الحقيقةَ المطلقةَ.
{وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُم لْفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ} [المؤمنون: 71]، {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ} [ص: 26].
عن أنسٍ قالَ: قال النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم: «ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ خَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَكَلِمَةُ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ».[رواه البيهقيُّ في “شعبِ الإيمانِ”].
قال الإمامُ الحَصكَفيُّ الحنفيُّ: “إِذا سُئِلْنَا عَن مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ مُخَالِفِنَا قُلْنَا وجوبًا: مَذْهَبُنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، وَمَذْهَبُ مُخَالِفِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ”. أ.ه. [إرشادُ النقادِ إلى تيسيرِ الاجتهادِ، محمدُ بن إسماعيلَ الصنعانيُّ].
قال الإمامُ الشافعيُّ – رحمه اللهُ -: “مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إِلَّا قُلْتُ: اللَّهُمَّ أَجْرِ الْحَقَّ عَلَى قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مَعِي اتَّبَعَنِي، وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مَعَهُ اتَّبَعْتُه”. [قواعدُ الأحكامِ في مصالحِ الأنامِ للعِزِّ بن عبدِ السلامِ].
خامسًا: الرجوعُ إلى الحقِّ إذا تبيَّنَ: ذمَّ اللهُ التماديَ في الباطلِ بدافعِ الكِبرِ والمجادلةِ {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ} [غافر: 35]. {إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر: 56].
عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وَلَا يَمْنَعْكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ لِرَأْيِكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ، أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ». [رواه البيهقي في “السنن الكبرى”].
إن كان المختلفان يريدان الخير فإن الله سيهديهما للعمل؛ قال مَعْرُوفَ الْكَرْخِي: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتْحَ لَهُ بَابَ الْعَمَلِ، وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْجَدَلِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا فَتْحَ لَهُ بَابَ الْجَدَلِ، وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْعَمَلِ» [رواه البيهقي في “شعب الإيمان”]. قال بِلَال بْن سَعْدٍ: «إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ لَجُوجًا مُمَارِيًا مُعْجَبًا بِرَأْيِهِ فَقَدْ تَمَّتْ خَسَارَتُهُ». [رواه البيهقي في “شعب الإيمان”]. السلفُ الصالحُ كان من أجل صفاتِهم إذا اختلفوا ثم ظهر الصوابُ يرجعون إليه ولا تأخذهم الحميّةُ والعصبيّةُ لردِّه.
قال الإمامُ ابنُ قدامةَ المقدسيُّ: (كانوا يتناظرون في الأحكام، ومسائل الحلال والحرام بالأدلة المرضية، والحجج القوية حتى كان قلَّ مجلسٍ يجتمعون عليه إلا ظهر الصواب، ورجع راجعون إليه؛ لاستدلال المستدل بالصحيح من الدلائل، وعلم المنازع أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل كمجادلة الصديق لمن نازعه في قتال مانعي الزكاة حتى رجعوا إليه.
ومناظرتهم في جمع المصحف حتى اجتمعوا عليه، وتناظرهم في حد الشارب، وجاحد التحريم حتى هُدوا إلى الصراط المستقيم، وهذا وأمثاله يجل عن العد والإحصاء، فإنه أكثر من نجوم السماء). أ.ه.
سادسًا: انتظار الآخر حتى يفرغ من كلامه: هذا عتبةُ بنُ ربيعةَ حين كان يحاور النبي صلى الله عليه وسلم قال له: “قُلْ يَا أبا الوليد، أسمع، قال: يابنَ أَخِي، إنْ كنتَ إنما تريد بما جئتَ به من هذا الأمر مالًا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالًا، وإن كنت تريد به شرفًا سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمرًا دونك، وإن كنت تريد به ملكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك، طلبنا لك الطبّ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوى منه أو كما قال له، حتى إذا فرغ عتبةُ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال: “أقد فرغتَ يا أبا الوليد؟”، قال: نعم. قال: “فاسمع مني”، قال: أفعل….“. [رواه ابن إسحاق في “السير والمغازي”].
سابعًا: توقير كلٍّ من المختلفين للآخر: حق كل إنسان أن يعبّر عن رأيه، ووجهة نظره بما لا يؤثر على حرية الآخرين، أو يؤدي إلى إشاعة الفوضى الفكرية في المجتمع، ويؤثر سلبًا على وجدان الناس.
عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «…، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ». [رواه أبو داود]، وفي رواية: «وليس بخارج» [رواه الطبراني في “المعجم الأوسط”].
اختلف سيدُنا عبد الله بن عباس، وزيدُ بن ثابت رضي الله عنهم في مسائل كثيرة ومع ذلك كان يجل ويوقّر كل منهما الآخر؛ عن الشعبي قال: «صلّى زيد بن ثابت على جنازة، ثم قُرّبت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خلِّ عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: «هكذا يُفعل بالعلماء والكبراء»، فقبّل زيد بن ثابت يده، وقال: هكذا أُمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم». [إحياء علوم الدين].
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلتُ لأبي: “أيَّ رجلٍ كان الشافعي، فإني سمعتك تُكثر من الدعاء له؟”، قال: يا بُنيّ كان كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلفٍ، أو منهما عِوَض؟”. [سير أعلام النبلاء للذهبي].
قال الشافعي رضي الله عنه: “إذا جاءك الحديث عن مالك فشدّ به يديك، وإذا جاء الأثر فمالك النجم، وعنه مالك بن أنس معلّمي، وعنه أخذنا العلم”. [عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني].
ثامنًا: أن يكون الاختلاف عن دليل، وصادرًا عن أهل الاجتهاد مما يُعتد برأيهم: الخطاب القرآني لم يُقدَّم خاليًا عن البراهين والأدلة؛ لذا ينبغي أن يكون الاختلاف عن دليل وبينة، ويصدر عن أهل الاختصاص {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
قال الإمام الشاطبي: “الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: أحدهما: الاجتهاد المعتبر شرعًا، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر الاجتهاد إليه، والثاني: غير المعتبر، وهو الصادر عمن ليس بعارفٍ بما يفتقر الاجتهاد إليه؛ لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي، والأغراض، وخبط في عماية، فكل رأي صادر عن هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره؛ لأنه ضد الحق الذي أنزله…” [الموافقات].
تاسعًا: ليعذرْ بعضُنا بعضًا، ولنوقنْ أن «اختلافَ الأمةِ رحمةٌ»: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «…، إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ». [رواه البيهقي في “المدخل إلى السنن الكبرى”]، وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: «اختلافُ أمتي رحمةٌ».
قال الإمامُ الآلوسيُّ تعقيبًا على من ضَعَّفَ الحديثينَ: (ولا يخفى أنه مما لا بأسَ به، نعم كونُ الحديثِ ليس معروفًا عند المحدثين أصلًا لا يخلو عن شيءٍ، فقد عزاه الزركشيُّ في “الأحاديثِ المشتهرةِ” إلى كتابِ “الحجةِ” لنصرِ المقدسيِّ، ولم يذكرْ سندَه ولا صحتَه، لكن ورد ما يقويه في الجملةِ مما نُقل من كلامِ السلفِ، والحديثُ الذي أوردناه قبلُ وإن رواه الطبريُّ والبيهقيُّ في المدخلِ بسندٍ ضعيفٍ عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ تعالى عنهما على أنه يكفي في هذا البابِ الحديثُ الذي أخرجه الشيخانِ وغيرُهما. فالحقُّ الذي لا محيدَ عنه: أن المرادَ اختلافُ الصحابةِ رضي اللهُ عنهم، ومن شاركهم في الاجتهادِ كالمجتهدينَ المعتدِّ بهم من علماءِ الدينِ الذين ليسوا بمبتدعينَ، وكونُ ذلك رحمةً لضعفاءِ الأمةِ، ومن ليس في درجتِهم مما لا ينبغي أن ينتطحَ فيه كبشانِ، ولا يتنازعَ فيه اثنانِ، فليُفْهَمْ). أ.ه. [روحُ المعاني].
قال الإمامُ الحُجَّةُ القاسمُ بنُ محمدِ بنِ أبي بكرٍ الصديقِ رضي اللهُ عنهم: «لقد نفع اللهُ باختلافِ أصحابِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم في أعمالِهم، لا يعملُ العاملُ بعملِ رجلٍ منهم إلا رأى أنه في سَعَةٍ، ورأى أن خيرًا منه قد عمل عملَه». [جامعُ بيانِ العلمِ وفضلِه لابنِ عبدِ البرِّ].
وقال ابنُ قدامةَ: (…، فإن اللهَ برحمتِه وطولِه جعل سَلَفَ هذه الأمةِ أئمةً من الأعلامِ مُهِّدَ بهم قواعدُ الإسلامِ، وأُوضِحَ بهم مشكلاتُ الأحكامِ، اتفاقُهم حجةٌ قاطعةٌ، واختلافُهم رحمةٌ واسعةٌ). [المغني].
عاشرًا: ضرورةُ مراعاةِ المصالحِ، والمفاسدِ «فقهُ المآلاتِ»:
{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108].
قال الإمامُ الزمخشريُّ: «ربَّ طاعةٍ عُلِم أنها تؤدي إلى مفسدةٍ، فتخرجَ عن أن تكونَ طاعةً، فيجبَ النهيُ عنها؛ لأنها معصيةٌ لا لأنها طاعةٌ كالنهيِ عن المنكرِ هو من أجلِّ الطاعاتِ، فإذا عُلِم أنه يؤدي إلى زيادةِ الشرِّ انقلب إلى معصيةٍ، ووجب النهيُ عن ذلك كما يجبُ النهيُ عن المنكرِ». [الكشافُ عن حقائقِ التنزيلِ].
وكذا الاختلافُ إذا ترتب عليه مفسدةٌ أعظمُ، وجب إغلاقُ بابِه، وعدمُ الاسترسالِ فيه، عملًا بقاعدةِ «سدِّ الذرائعِ»، ونظرًا لآثارِه السلبيةِ التي يجنيها الأفرادُ والمجتمعاتُ من خلالِه.
(3) فوائدُ الاختلافِ المقبولِ وأثرُه على الفردِ والمجتمعِ.:
أ- يتيحُ إذا صدقتِ النوايا التعرُّفَ على جميعِ الاحتمالاتِ التي يمكن أن يكونَ الدليلُ رمى إليها بوجهٍ من وجوهِ الأدلةِ.
ب- رياضةٌ للأذهانِ، وتلاقحٌ للآراءِ، وفتحُ مجالاتِ التفكيرِ للوصولِ إلى سائرِ الافتراضاتِ التي تستطيعُ العقولُ المختلفةُ الوصولَ إليها.
ج- تعددُ الحلولِ أمام صاحبِ كلِّ واقعةٍ ليهتديَ إلى الحلِّ المناسبِ للوضعِ الذي هو فيه بما يتناسبُ ويسرُ هذا الدينُ الذي يتعاملُ مع الناسِ من واقعِ حياتِهم. [أدبُ الاختلافِ في الإسلامِ، د/ طه جابر فياض العلواني].
(4) ذمُّ الاختلافِ المؤدي إلى النزاعِ والشقاقِ: اعتبر اللهُ الاختلافَ الذي يسبِّب الافتراقَ مُجانبًا لهديِ النبوةِ قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159].
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو قال: «هجَّرتُ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يومًا، قال: فسمع أصواتَ رجلينِ اختلفا في آيةٍ، فخرج علينا صلى اللهُ عليه وسلم يُعرَف في وجهِه الغضبُ فقال: «إنما هلك من كان قبلكم، باختلافِهم في الكتابِ»» [رواه مسلم].
عن جندبِ بنِ عبدِ اللهِ البجليِّ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: «اقرءوا القرآنَ ما ائتلفتْ عليه قلوبُكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا» [رواه مسلم].
قال الإمامُ النوويُّ: (والأمرُ بالقيامِ عند الاختلافِ في القرآنِ محمولٌ عند العلماءِ على اختلافٍ لا يجوزُ أو اختلافٍ يوقعُ فيما لا يجوزُ كاختلافٍ في نفسِ القرآنِ، أو في معنى منه لا يسوغُ فيه الاجتهادُ، أو اختلافٍ يوقعُ في شكٍّ أو شبهةٍ أو فتنةٍ وخصومةٍ أو شجارٍ ونحوِ ذلك. وأما الاختلافُ في استنباطِ فروعِ الدينِ منه، ومناظرةُ أهلِ العلمِ في ذلك على سبيلِ الفائدةِ، وإظهارِ الحقِّ، واختلافُهم في ذلك، فليس منهِيًّا عنه بل هو مأمورٌ به، وفضيلةٌ ظاهرةٌ، وقد أجمع المسلمونَ على هذا من عهدِ الصحابةِ إلى الآن). أ.ه. [شرحُ النوويِّ على مسلمٍ].
عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ، قال: صلَّى عثمانُ بمنى أربعًا، فقال عبدُ اللهِ: «صلَّيتُ مع النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم ركعتينِ، ومع أبي بكرٍ ركعتينِ، ومع عمرَ ركعتينِ»، فقيل له: عِبْتَ على عثمانَ ثم صليتَ أربعًا؟ قال: «الخلافُ شرٌّ». [رواه أبو داود].
الألفةُ، والتئامُ الصفوفِ، والبعدُ عن الاختلافِ، وكلُّ ما يفرِّقُ الكلمةَ، ويُوهِنُ الأمةَ مأمورٌ به؛ فعن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: «يدُ اللهِ مع الجماعةِ» [رواه الترمذيُّ وحسَّنه].
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال: قام فينا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فقال: «…، فمن أراد منكم بُحبوحةَ الجنةِ فليلزمِ الجماعةَ، فإن الشيطانَ مع الواحدِ، وهو من الاثنينِ أبعدُ» [رواه أحمدُ، وابنُ حبَّانَ].
نسألُ اللهَ أن يرزقَنا حسنَ العملِ، وفضلَ القبولِ، إنه أكرمُ مسؤولٍ، وأعظمُ مأمولٍ، وأن يجعلَ بلدَنا مِصرَ سخاءً رخاءً، أمنًا أمانًا، سِلْمًا سلامًا وسائرَ بلادِ العالمينَ، ووفَّق ولاةَ أمورِنا لما فيه نفعُ البلادِ والعبادِ.
كُتِبَهُ: الفَقِيرُ إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ الحَنَّانِ المَنَّانِ د/ مَحْرُوسٌ رَمَضَانُ حِفْظِي عَبْدُ العَالِ
مُدَرِّسُ التَّفْسِيرِ وَعُلُومِ القُرْآنِ كُلِّيَّةُ أُصُولِ الدِّينِ وَالدَّعْوَةِ – أَسْيُوطُ
_____________________________________
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف










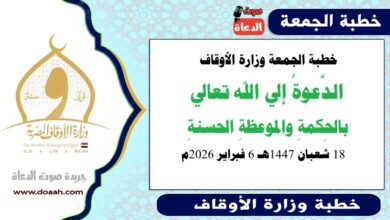


لاحظت في الآونة الأخيرة منذ خطبة (اليقين) أن خطب الدكتور/محروس حفظي يغلب عليها الطابع الأكاديمي وليس الوعظي بيد أن الخطبة الموحدة لابد أن تخاطب مستويات الفهم كلها فليس من الجائزان ندخل المستمع في فكر فلسفي وتعقيدات اصطلاحية لأناس بلغت الأمية فيهم 60٪أو يزيد في بعض المناطق.
نرجو من معاليكم مراعاة ذلك مستقبلا وتقبلوا خالص شكري وتقديري سلفا.