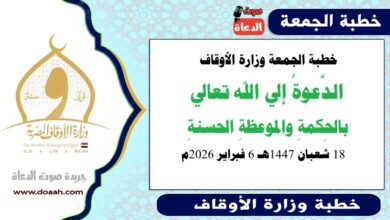خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر : كُن جميلًا تَرَ الوجودَ جميلًا، للدكتور محروس حفظي

خطبة الجمعة القادمة
خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر 2025م بعنوان : كُن جميلًا تَرَ الوجودَ جميلًا ، للدكتور محروس حفظي بتاريخ 30 جمادي الأولي 1447هـ ، الموافق 21 نوفمبر 2025م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : كُن جميلًا تَرَ الوجودَ جميلًا.
ولتحميل خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : كُن جميلًا تَرَ الوجودَ جميلًا ، بصيغة word أضغط هنا.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : كُن جميلًا تَرَ الوجودَ جميلًا، بصيغة pdf أضغط هنا.
___________________________________________________________
عناصر خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر 2025م بعنوان: كُن جميلًا تَرَ الوجودَ جميلًا ، للدكتور محروس حفظي :
1- اخْتِلَافُ طِبَاعِ وَأَسَالِيبِ الخَلْقِ فِي التَّعَامُلِ سُنَّةٌ رَبَّانِيَّةٌ.
2- لَا تَفْجُرْ فِي الخُصُومَةِ وَالِاخْتِلَافِ.
3- خُطُوَاتٌ عَمَلِيَّةٌ فِي احْتِرَامِ الآخَرِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ.
4- وُجُوبُ الإِحْسَانِ إِلَى الجِيرَانِ.
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 21 نوفمبر 2025م بعنوان: كُن جميلًا تَرَ الوجودَ جميلًا ، للدكتور محروس حفظي : كما يلي:
.
كُنْ جَمِيلًا تَرَى الوُجُودَ جَمِيلًا
بِتَارِيخِ 30 جمادي الأولي 1447 ه = المُوَافِقِ 21 نوفمبر 2025 م
الحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ، وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ، لَكَ الحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ، وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الأَتَمَّانِ الأَكْمَلَانِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَّا بَعْدُ،،،
(1) اخْتِلَافُ طِبَاعِ وَأَسَالِيبِ الخَلْقِ فِي التَّعَامُلِ سُنَّةٌ رَبَّانِيَّةٌ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].
وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالحَزْنُ وَالخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ» [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ].
وَلِلَّهِ دَرُّ القَائِلِ:
النَّاسُ كَالْأَرْضِ وَمِنْهَا هُمُ *** مِنْ خَشِنٍ فِي اللَّمْسِ أَوْ لَيِّنِ
فَجَنْدَلٌ تَدْمِي بِهِ أَرْجُلٌ *** وَإِثْمِدٌ يُوضَعُ فِي الأَعْيُنِ
(2) لَا تَفْجُرْ فِي الخُصُومَةِ وَالِاخْتِلَافِ.
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ» [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ].
وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لِاتِّقَاءِ فُحْشِهِ» [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ].
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].
قالَ أ.د/ موسى شاهينَ لاشينَ: (وأمَّا المخاصمةُ فهي لجاجٌ في الكلامِ ليستوفَى به مالٌ أو حقٌّ، والفجورُ فيها يكونُ بمحاولةِ الوصولِ إلى مالِ الغيرِ وإلى غيرِ الحقِّ، فالمخاصمةُ تكونُ على ثلاثةِ أحوالٍ: مخاصمةٌ للوصولِ إلى حقٍّ، ومخاصمةٌ بغيرِ علمٍ، ومخاصمةٌ للوصولِ إلى حقِّ الغيرِ، أمَّا المخاصمةُ للوصولِ إلى حقٍّ: فالأولى تركُها حيثُ أمكنَ الوصولُ إليه بغيرِها؛ لأنَّها تشوِّشُ الخاطرَ، وتنغِّصُ القلوبَ، وتوغرُ الصدورَ، وتهيجُ الغضبَ؛ إذْ فيها تعريضٌ بالطعنِ والتجهيلِ والتكذيبِ، وفيها تفويتٌ لطيبِ الكلامِ، ولينُ الخُلُقِ مفتاحُ بابِ الجنَّةِ، وأمَّا المخاصمةُ بغيرِ علمٍ فهي مذمومةٌ لما فيها من الأضرارِ السابقةِ، وزيادةِ عدمِ الهدفِ والغرضِ الصحيحِ، وأمَّا المخاصمةُ للوصولِ إلى حقِّ الغيرِ: فهي الحالةُ المقصودةُ من الحديثِ «إذا خاصمَ فجرَ» أي مالَ عن الحقِّ قصدًا، وتلك سِمَةُ المنافقِ). أ.ه. [فتحُ المنعمِ شرحُ صحيحِ مسلمٍ].
*كُنْ جميلًا: عاملِ الناسَ بأخلاقِك لا بأخلاقِهمْ:
عنْ حذيفةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: “لا تكونوا إمَّعةً، تقولونَ: إنْ أحسنَ الناسُ أحسنَّا، وإنْ ظلموا ظلمْنا، ولكنْ وطِّنوا أنفسَكمْ، إنْ أحسنَ الناسُ أنْ تحسنوا، وإنْ أساءوا فلا تَظْلِموا» [رواهُ الترمذيُّ وحسَّنَهُ].
“الإمَّعةُ” عندَ أهلِ اللغةِ: “الرجلُ الذي يكونُ لضعفِ رأيهِ معَ كلِّ أحدٍ، والمرادُ هنا: من يكونُ معَ ما يوافقُ هواهُ، ويلائمُ أَرَبَ نفسِهِ وما يتمناهُ. وقيلَ: المرادُ هنا الذي يقولُ: أنا أكونُ معَ الناسِ كما يكونونَ معي؛ إنْ خيرًا فخيرٌ، وإنْ شرًّا فشرٌّ”.
قالَ الطيبيُّ: (معنى الحديثِ: أوجبوا على أنفسِكمُ الإحسانَ بأنْ تجعلوها وطنًا للإحسانِ). أ.ه.
عنِ الشعبيِّ قالَ: “كانَ عيسى بنُ مريمَ عليهِ السلامُ يقولُ: «إنَّ الإحسانَ ليسَ أنْ تُحسِنَ إلى من أحسنَ إليكَ، إنما تلك مكافأةٌ بالمعروفِ، ولكنَّ الإحسانَ أنْ تُحسِنَ إلى من أساءَ إليكَ»” [رواهُ الإمامُ أحمدُ في “الزهدِ”].
*ضبطُ النفسِ في المواقفِ الحرجةِ والصعبةِ:
{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آلُ عِمْرَانَ: 134].
عنْ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: “ليسَ الشديدُ بالصُّرَعةِ، إنما الشديدُ الذي يملكُ نفسَهُ عندَ الغضبِ» [رواهُ البخاريُّ].
عنْ معاذٍ بنِ جبلٍ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ: “منْ كظمَ غيظَهُ، وهو يقدرُ على أنْ ينتصرَ دعاهُ اللهُ على رؤوسِ الخلائقِ حتى يخيِّرَهُ في حورِ العينِ أيَّتَهُنَّ شاءَ» [رواهُ الإمامُ أحمدُ في “المسندِ”]. وفي روايةٍ عنِ ابنِ عمرَ: “… ومنْ كفَّ غضبَهُ سترَ اللهُ عورتَهُ، ومنْ كظمَ غيظَهُ، ولو شاءَ أنْ يُمْضِيَهُ أمْضاهُ ملأَ اللهُ قلبَهُ رجاءً يومَ القيامةِ» [رواهُ الطبرانيُّ في “المعجمِ الكبيرِ”].
*قبولُ الاعتذارِ لمنْ اعتذرَ إليكَ صادقًا أو كاذبًا:
قالَ الحسنُ بنُ أبي العباسِ البيهقيِّ: قيلَ لي: قدْ أساءَ إليكَ فلانٌ … ومقامُ الفتى على الذلِّ عارُ، قلتُ: قدْ جاءَنا فأحدثَ عذرًا … ديةُ الذنبِ الاعتذارُ
قالَ عبدُ اللهِ بنُ منازلٍ يقولُ: “المؤمنُ يطلبُ عذرَ إخوانِهِ، والمنافقُ يعتِبُ عثراتِهمْ”. [آدابُ الصحبةِ لأبي عبدِ الرحمنِ السلميِّ].
*لا ترفعنَّ صوتكَ حالَ الاختلافِ، ولا تكشفنَّ سترًا:
{وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} [لقمانَ: 19].
قالَ مجاهدٌ بنُ جبرٍ: “أيْ: غايةُ منْ رفعَ صوتَهُ أنَّهُ يُشَبَّهُ بالحميرِ في علوِّهِ ورفعِهِ، ومعَ هذا هو بغيضٌ إلى اللهِ، وهذا التشبيهُ في هذا بالحميرِ يقتضي تحريمَهُ، وذمَّهُ غايةَ الذمِّ”. [تفسيرُ القرآنِ العظيمِ لابنِ كثيرٍ].
ومنْ صفاتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كما جاءَ في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرو: “ولا سخَّابٍ في الأسواقِ» [رواهُ البخاريُّ].
“السخبُ”: يقالُ فيهِ “الصخبُ”: بالصادِ المهملةِ بدلَ السينِ، وهو رفعُ الصوتِ بالخصامِ.
وقدْ أُخذتِ الكراهةُ منْ نفيِ الصفةِ المذكورةِ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كما نُفيتْ عنهُ صفةُ الفظاظةِ والغلظةِ، وهذا القيدُ معتبرٌ في النفيِ احترازًا منْ رفعِ صوتِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في القراءةِ والخطبةِ في المساجدِ وغيرها، فما بالُنا بمنْ يرفعُ صوتَهُ، ويشوشُ على غيرِهِ حالَ الاختلافِ والنزاعِ. [فتحُ الباري].
ومنْ منهاجِ النبوةِ أنَّهُ كانَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يسترُ على الخلقِ إذا صدرَ عنهم خطأٌ: «ما بالُ أقوامٍ»
ولمْ يكنْ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُشهِّرُ بهمْ، ويكني عمَّا اضطرَّهُ للكلامِ مما يكرهُ استقباحًا للتصريحِ بهِ.
عنْ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: “كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا بلغهُ عنِ الرجلِ الشيءُ لمْ يقلْ: ما بالُ فلانٍ يقولُ؟ ولكنْ يقولُ: ما بالُ أقوامٍ يقولونَ كذا وكذا؟” [رواهُ أبو داود].
*ركزْ على مواطنِ الاتفاقِ والإيجابياتِ، ودعْكَ منَ السلبياتِ:
أنْ نكونَ منصفينَ فلا نجاوزَ الحدَّ، فإذا أخطأَ أحدٌ في أمرٍ ما، فلنعذرْهُ، ولا نعددْ مثالِبَهُ، ولا نهملْ مواطنَ الاتفاقِ والجمالِ فيما قالَهُ، ولا نتهمْهُ بما ليسَ فيهِ. {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعرافِ: 85].
قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ- رحمهُ اللهُ-: «إنَّهُ ليسَ مِنْ شريفٍ ولا عالِمٍ ولا ذي فضلٍ إلَّا وفيهِ عيبٌ، ولكن منَ الناسِ من لا ينبغي أن تُذْكَرَ عيوبُهُ، ومن كان فضلُهُ أكثرَ من نقصِهِ وُهِبَ نقصُهُ لفضلِهِ». [صفةُ الصفوةِ لابنِ الجوزيِّ].
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: «…، ومَنْ قالَ في مؤمنٍ ما ليسَ فيهِ أسكنهُ اللهُ رَدْغَةَ الخبالِ حتى يخرجَ ممَّا قالَ» [رواهُ أبو داودَ، وأحمدُ].
“رَدْغَةَ الخبالِ”: عصارةُ أهلِ النارِ.
عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما، قالَ: قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «…، فمَنْ وليَ شيئًا من أمةِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فاستطاعَ أن يضرَّ فيهِ أحدًا أو ينفعَ فيهِ أحدًا، فليقبلْ من مُحْسِنِهِمْ ويتجاوزْ عن مُسِيئِهِمْ» [رواهُ البخاريُّ].
(3) خطواتٌ عمليَّةٌ في احترامِ الآخرِ عندَ الاختلافِ:
احذرْ من النقدِ المباشرِ. لا تتعاملْ مع الذي أمامكَ بكِبْرٍ واستعلاءٍ، وأنَّهُ ينبغي أن ينصاعَ لفكرِكَ أو قولِكَ {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [البقرةُ: 272]، {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشيةُ: 23].
احترمْ آراءَ الآخرينَ، ولا تقلِّلْ من وجهاتِ نظرِهِمْ. {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوتُ: 46].
صحِّحْ أخطاءَ الآخرينَ بلُطْفٍ ولا تجرحْ مشاعرَهُمْ.
سمِّه بأحبِّ الأسماءِ والألقابِ إليهِ: هذا عتبةُ بنُ ربيعةَ حينَ كان يحاورُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لهُ: “قُلْ يا أبا الوليدِ، أسمعْ …، قالَ: أَقَدْ فرغتَ يا أبا الوليدِ؟، قالَ: نعمْ، قالَ: فاسمعْ منِّي؛ قالَ: أفعلُ….”. [رواهُ ابنُ إسحاقَ في “السِّيَرِ والمغازي”].
ابتسمْ في وجهِ مَنْ يخالفُكَ: عن أبي ذرٍّ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «تبسُّمُكَ في وجهِ أخيكَ لكَ صدقةٌ» [رواهُ الترمذيُّ، وابنُ حِبَّانَ].
تحلَّ بالصبرِ والحِلْمِ، ولا تتسرعْ في الردِّ: عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «الأناةُ منَ اللهِ والعَجَلَةُ منَ الشيطانِ» [رواهُ الترمذيُّ].
عن يوسفَ بنِ الحسينِ، قالَ: سمعتُ ذا النونِ، يقولُ: “أربعُ خِلالٍ لها ثمرةٌ: العَجَلَةُ، والعُجْبُ، واللَّجاجةُ، والشَّرَهُ، فثمرةُ العَجَلَةِ: النَّدامةُ، وثمرةُ العُجْبِ: البُغْضُ، وثمرةُ اللَّجاجةِ: الحَيْرَةُ، وثمرةُ الشَّرَهِ: الفاقةُ”. [رواهُ البيهقيُّ في “شعبِ الإيمانِ”].
إن أمكنكَ في النهايةِ أن تقدِّمَ لهُ هديةً ولو بسيطةً فافعلْ: عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «تَهَادَوْا فإنَّ الهديَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصدرِ، ولا تحقرنَّ جارةٌ لجارتِها ولو شِقَّ فِرْسِنِ شاةٍ» [رواهُ الترمذيُّ، وأحمدُ].
الاتفاقُ على ما يحقِّقُ المصلحةَ العامةَ للبلادِ والعبادِ، وإبقاءُ الودِّ والاحترامِ المتبادلِ.
لا تتهمْ النيَّاتِ، ولا تُسِئِ الظنَّ بالذي أمامكَ.
إذا ظهرَ الحقُّ مع مخالفِكَ فاقبَلْهُ، وإذا قبِلهُ منك فاشكُرْهُ، ولا تَمُنَّ عليهِ.
عن أبي العوَّامِ البصريِّ، قالَ: «كتبَ عمرُ إلى أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنهما: ولا يمنعْكَ من قضاءٍ قضيتَهُ اليومَ فراجعتَ فيه لرأيِكَ، وهُدِيتَ فيه لرشدِكَ، أن تُراجِعَ الحقَّ؛ لأنَّ الحقَّ قديمٌ لا يُبطِلُ الحقَّ شيءٌ، ومراجعةُ الحقِّ خيرٌ منَ التمادي في الباطلِ». [رواهُ البيهقيُّ في “السننِ الكبرى”].
أرجِئِ النقاشَ والخلافَ إلى وقتٍ آخرَ إذا كان الاستمرارُ فيه يؤدي إلى النزاعِ والعراكِ والنفورِ.
(4) وجوبُ الإحسانِ إلى الجيرانِ:
أوجبَ الإسلامُ على المسلمِ الإحسانَ إلى الجارِ، والتوددَ معهُ، والعطفَ عليهِ، وأولى رعايةً بهِ، وأعلى شأنَهُ، وجاءت الوصيَّةُ بهِ في كثيرٍ من آي الذكرِ الحكيمِ قالَ تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} [النساءُ: 36].
وعن مجاهدٍ: «أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرو ذُبِحَتْ لهُ شاةٌ في أهلِهِ، فلما جاءَ قالَ: أَهدَيْتُمْ لجارِنا اليهوديِّ؟ أَهْدَيْتُمْ لجارِنا اليهوديِّ؟ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: «ما زالَ جبريلُ يُوصيني بالجارِ حتى ظننتُ أنَّهُ سيورِّثُهُ». [الترمذيُّ وحسَّنهُ].
وعن أبي ذرٍّ، قالَ: قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «يا أبا ذرٍّ إذا طبختَ مرقةً، فأكثِرْ ماءَها، وتعاهدْ جيرانَكَ» [رواهُ مسلمٌ].
اهتمَّ الفقهاءُ بمبحثِ الجارِ اهتمامًا كبيرًا، فقسَّموهُ إلى أنواعٍ، وبيَّنوا حقَّ كلِّ نوعٍ منها، ومن خلالِ استقراءِ النصوصِ تبيَّنَ أنَّ الجيرانَ ثلاثةٌ:
1 ـ جارٌ لهُ ثلاثةُ حقوقٍ: وهو الجارُ المسلمُ القريبُ ذو الرحمِ، لهُ حقُّ الجوارِ، وحقُّ الإسلامِ، وحقُّ القرابةِ.
2 ـ جارٌ لهُ حقَّانِ: وهو الجارُ المسلمُ، لهُ حقُّ الجوارِ، وحقُّ الإسلامِ.
3 ـ جارٌ لهُ حقٌّ واحدٌ: وهو الجارُ غيرُ المسلمِ، لهُ حقُّ الجوارِ، وأمرنا الإسلامُ بحسنِ معاملتِهِ، وعدمِ التعرضِ لهُ بأيِّ نوعٍ منَ الإيذاءِ قولًا كانَ أو فعلًا، قالَ تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنةُ: 8].
وضربَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أروعَ الأمثلةِ في حسنِ الجوارِ مع غيرِ المسلمينَ، فلم يُؤثَرْ عنهُ أن تعدَّى عليهم أو تعرَّضَ لهم بأيِّ لونٍ من ألوانِ الأذى أو المضايقةِ، بل كان يتفقَّدُ حالَهم إذا غابوا، أو يقدِّمُ لهم العونَ إن احتاجوا؛ فعن أنسٍ: “أنَّ غلامًا من اليهودِ كان يخدمُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمرضَ، فأتاهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعودُهُ، فقعدَ عندَ رأسِهِ فقالَ: «أسلِمْ»، فنظرَ إلى أبيهِ، وهو عندَ رأسِهِ، فقالَ لهُ: أطِعْ أبا القاسمِ، فأسلَمَ، فخرجَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو يقولُ: «الحمدُ للهِ الذي أنقذَهُ منَ النارِ» [رواهُ البخاريُّ].
قد وضع الإمامُ “الحسنُ البصريُّ” رضي اللهُ عنه قاعدةً عريضةً حينما: «سُئِلَ عَنِ الْجَارِ، فَقَالَ: أَرْبَعِينَ دَارًا أَمَامَهُ، وَأَرْبَعِينَ خَلْفَهُ، وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَسَارِهِ» [رواهُ البخاريُّ في “الأدبِ المفردِ”].
وإذا كانَ تحديدُ الجوارِ أربعينَ دارًا، وكلُّها داخلةٌ في الوصيَّةِ بالجارِ؛ فهذه الأربعونَ تتفرَّعُ، فأقصى بيتٍ من الأربعينَ يُراعي حقوقَ أربعينَ بيتًا أخرى، وهكذا، فتكونُ النتيجةُ: تتموَّجُ حقوقُ الجوارِ، وتنتشرُ كتموُّجِ موجاتِ الأثيرِ حتى تعمَّ العالمَ كلَّه، ولا يبقى شبرٌ على وجهِ الأرضِ إلَّا ودخلَ في وصايا النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ولو راعينا حُرمةَ الجوارِ بينَ المدنِ والأقطارِ لحصلَ خيرٌ كثيرٌ، فكلُّ دولةٍ تُراعي حقوقَ جارتِها؛ فالجوارُ بهذا المفهومِ يشملُ الجميعَ، وبهذا يعمُّ السلامُ، وتُحفَظُ الإنسانيَّةُ من الاعتداءِ على أرضِها وعِرضِها ومالِها، وهذا مقصدٌ ربَّانيٌّ حفلت به الشرائعُ السماويَّةُ.
الاقتصادُ في العملِ الصالحِ مع كفِّ الأذى عنِ الجيرانِ، خيرٌ من كثرةِ العملِ مع أذى الجيرانِ؛ فعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا، وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، وَصَلَاتِهَا، وَإِنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ، وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ» [رواهُ أحمدُ].
ومن أرادَ أن يعرفَ أنَّه مُحسنٌ، فلينظرْ إلى حالِهِ مع جيرانِهِ، هل يُحسنُ إليهم أم لا؟ فعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الجَنَّةَ. قَالَ: كُنْ مُحْسِنًا. قَالَ: كَيْفَ أَعْلَمُ أَنِّي مُحْسِنٌ؟ قَالَ: سَلْ جِيرَانَكَ؛ فَإِنْ قَالُوا: إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، وَإِنْ قَالُوا: إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ» [رواهُ البيهقيُّ في “شُعَبِ الإيمانِ”].
حُرمةُ التعدِّي على الجِيرانِ: التعدِّي على الجِوارِ من علاماتِ السَّاعةِ؛ فعنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: «إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخَوَّنَ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ، وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ، وَسُوءُ الْجِوَارِ» [رواهُ أحمدُ].
وقد حرَّم الإسلامُ التعدِّي على الجارِ بأيِّ شكلٍ من الأشكالِ، سواءٌ بالقولِ أو الفعلِ، بل يرتقي الإحسانُ إليه إلى درجةِ عبادةِ اللهِ، ويُعَدُّ إيذاؤه جريمةً أخلاقيَّةً واجتماعيَّةً؛ فعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ» [متفقٌ عليه].
وعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» [رواهُ مسلمٌ]. وعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ». قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْجَارُ، جَارٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». قَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: «شَرُّهُ» [رواهُ أحمدُ].
قالَ أ.د/ موسى شاهين لاشين: “إنَّ الأمنَ على النفسِ والمالِ والعِرضِ مِن نِعَمِ اللهِ الكبرى، وأقربُ الناسِ تهديدًا لهذا الأمنِ هو الجارُ؛ لأنَّ الحذرَ منه أصعبُ من الحذرِ من غيرهِ، والضررَ منه أشدُّ خطرًا من الضررِ من غيرهِ؛ إنَّه يعرفُ كثيرًا من الخفايا، ويكشفُ كثيرًا من الأستارِ، ويطَّلعُ على كثيرٍ من العيوبِ، إنَّه أعلمُ بمواطنِ الضعفِ، وأقدرُ على توصيلِ الأذى.
والإسلامُ يحرصُ على استتبابِ الأمنِ، ونشرِ الطمأنينةِ والاستقرارِ بينَ أبناءِ المجتمعِ الواحدِ؛ ولهذا جعل مسالمةَ الجارِ من الإيمانِ، وجعل حَبْسَ النفسِ عن أذى الجارِ من الإيمانِ، بل جعل خوفَ الجارِ من الجارِ دليلًا على ضعفِ إيمانِ الجارِ الذي بعث الخوفَ، وإنْ لم يصلْ ضرره فعليًّا إلى جارِه.
نعم، هذا التشريعُ الحكيمُ لو أَمِنَ كلُّ جارٍ جارَه، وكفَّ كلُّ جارٍ ضررَه، وحمى كلُّ جارٍ محارمَ جارِه، لكانت المدينةُ الفاضلةُ، ولكان المجتمعُ الموادِعُ الأمينُ، ولعاش الناسُ سعداءَ آمنينَ» أ.ه. [فتحُ المُنْعِمِ شرحُ صحيحِ مسلمٍ، 1/170].
*التعدي بالقول: كشتمه وسبابه، وغِيبته، والافتراء عليه، وتشويه سمعته، والواجب إحسان القول له وفيه، وستر عيوبه، فعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: “ثَلَاثٌ مِنَ الْفَوَاقِرِ: …، وَجَارٌ إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا، وَزَوْجَةٌ إِنْ حَضَرْتَ آذَتْكَ وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا”. [رواه وكيع بن الجراح في “الزهد”].
وتعدي بالفعل: كثير سواء آذاه في نفسه بالاعتداء عليه، أو آذاه في ماله بسرقته أو إتلافه، أو آذاه في بيته أو التجسس عليه، وإذا بلغت تعدي الجار مبلغًا حتى فارق بيته لأجل ما يلقى من أذى، فالمؤذِي على خطر عظيم من نزول العقوبة العاجلة به أو بولده أو تلف ماله؛ قَالَ ثَوْبَانُ رضي الله عنه: «ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام، فيهلك أحدهما، فماتا وهما على ذلك من المصارمة، إلا هلكا جميعًا، ومَا مِنْ جَارٍ يَظْلِمُ جَارَهُ وَيَقْهَرُهُ، حَتَّى يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، إِلَّا هَلَكَ». [رواه البخاري في “الأدب المفرد”].
*ديننا الحنيف كما ينهى عن التعدي على الجار، كذلك يُرغب في الصبر على أذاه، وتحمل ما يصدر منه، فمن تصبَّر عليه نال محبة الله؛ فعَنْ أَبِي ذَرٍّ قال، قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ…، وَرَجُلٌ لَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ، فَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُ وَيَحْتَسِبُهُ حَتَّى يَكْفِيَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ». [رواه أحمد].
والتعدي على الجار يجلب اللعنة لصاحبه؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاصْبِرْ» فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ» فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ: فَعَلَ اللَّهُ بِهِ، وَفَعَلَ، وَفَعَلَ، فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ». [رواه أبو داود].
*لا تتعدى على حرمات جارك: ربَّى الإسلام المسلم حفظ حرمات الجار، وعدم التطلع إلى عورته؛ فعن الْمِقْدَاد قال: «سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ عَنِ الزِّنَا؟ قَالُوا: حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: لِأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ؟ قَالُوا: حَرَامٌ، حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: لِأَنْ يَسْرِقَ مِنْ عَشَرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ» [رواه أحمد].
ولله در حاتم الطائي حيث قال:
نَارِي وَنَارُ الجَارِ وَاحِدَةٌ … وَإلَيهِ قَبلي تَنزِلُ القِدرُ
مَا ضَرَّ جَارًا إِلَيَّ أُجَاوِرُهُ … أَنْ لَا يَكُوْنَ لِبَيْتِهِ سِتْرُ
أَعْمَى إِذَا مَا جَارَتي ظَهَرَتْ … حَتَّى يُغَيِّبَ جَارَتِي الخِدْرُ
ويَصَمُّ عمَّا كانَ بينَهما … سَمْعي وما بي غيْرَهُ وَقْر
*تنشئة الأولاد على احترام الجيران: يجب تربية الأولاد على تعظيم حق الجار، وكف الأذى عنه، وإخبارهم بما في إكرامه من عظيم الأجر، وما في أذيته من الوعيد الشديد؛ إذ الأذية قد تصدر من زوج الرجل أو ولده، فلا يتساهل معهم، بل يظهر غضبه عليهم؛ ليعلموا أن هذا الأمر شنيع فلا يتهاونون، ولا يستخفون به؛ ولذا كان العرب في الجاهلية يتفاخرون بحسن الجوار، وعلى قدر الجار يكون ثمن الدار، وقد باع أحدهم منزله فلمَّا لاموه في ذلك قال:
يلومونني أَنْ بِعتُ بالرخص منزلي *** ولم يعرفوا جاراً هناك ينغــِّصُ
فقلتُ لهم: كفوا الملام فإنمــا *** بجيرانها تغلوا الديار وترخصُ
قال ابنُ العربيِّ المالكيُّ: (على المرءِ أنْ يوقِظَ جارَهُ منَ الغَفَلاتِ، وينقلهُ إلى الطَّاعاتِ، ويأمرهُ بإقامةِ الصَّلواتِ، وهذا من حقوقِ الجِوارِ. وقيلَ: إنَّ الجارَ الصالحَ يشفعُ يومَ القيامةِ في جيرانهِ ومعارِفِهِ وقَرابَتِهِ.
وأنشدني بعضُ الأصحابِ:
يا حافِظَ الجارِ يَرْجُو أنْ يَنالَ بِهِ … عفْوَ اللهِ وعَفْوُ اللهِ مذكورُ
الجارُ يشفعُ للجيرانِ كلِّهم … يومَ الحِسابِ وذنبُ الجارِ مغفورُ). أ.ه. [المسالِك في شرح مُوطَّأ مالك، 7/ 395].
*الفقهاءُ ذكروا أحكاماً فقهياً كثيرةً متعلِّقةً بجيرانِ الدورِ، وجيرانِ المزارعِ … إلخ، وذكروا ما يُمنَعُ الإنسانُ من فعلهِ في ملكهِ أو في مشتركٍ بينه وبينَ جارهِ كالطريقِ ونحوهِ، وضابطُ ذلك: “أنه ليسَ للإنسانِ أنْ يتصرَّفَ في ملكهِ بما يتعدَّى على جارهِ”؛ عملاً بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ، من ضارَّ ضَرَّهُ اللهُ، ومن شاقَّ شقَّ اللهُ عليه» [رواهُ الدارقطني في “سننه”، والبيهقيُّ في “السنن الكبرى”].
وإذا احتاجَ الجارُ إلى منفعةٍ في دارِ جارهِ أو حائِطهِ، فلا يمنعهُ منها إذا كانَ ذلك لا يضرهُ، ومنعهُ منها يوقعُ الأذى عليه؛ عن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «لا يمنَعْ أحدُكم جارَهُ أن يغرزَ خشبَةً في جدارهِ»، قالَ: ثمَّ يقولُ أبو هُرَيْرَةَ: «ما لي أراكم عنْها مُعرِضين، واللهِ لأرمينَّ بها بينَ أكتافكم» [متفقٌ عليه].
وكي يمنعَ وقوعَ التعدّي على الجارِ، بيّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ “الجارَ أحقُّ بالشُّفعةِ”، وأنَّه يحتاجُ إلى إذنهِ قبلَ بيعِ ما يلاصقهُ من أرضٍ أو زرعٍ حفظاً لحقِّ الجوارِ؛ فعن ابن عباسٍ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «من كانت له أرضٌ فأرادَ بيعَها، فليعرضْها على جارِهِ» [رواهُ ابن ماجه].
وعن جابرِ بْنِ عبدِ اللَّهِ رضيَ اللهُ عنهما، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «الجارُ أَحقُّ بشُفعةِ جارِهِ يَنتظِرُ بها وإنْ كانَ غائبًا إذا كانَ طَريقُهُما واحدًا» [رواه أبو داود، وأحمد].
*منظومةُ الأخلاقِ عندَنا بحقِّ الجِوارِ تحتاجُ إلى إعادةِ هيكلةٍ من جديد: من صورِ التعدّي على الجار أنْ تكونَ عالمًا بحالِ اضطرارهِ، وقِلَّةِ اقتدارهِ، ولكنك تتغافلُهُ وتتجاهلهُ؛ فعن ابنِ عباسٍ، قالَ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: «ليسَ المؤمنُ الذي يشبعُ وجارُهُ جائعٌ إلى جانِبهِ» [رواه البيهقي في “شعب الإيمان”]
قالَ الإمامُ المناويُّ القاهريُّ: (المُرادُ نفيُ الإيمانِ الكاملِ، وذلك لأنهُ يدلُّ على قسوةِ قلبه، وكثرةِ شحه، وسقوطِ مروأته، ودناءةِ طبعه). أ.ه. [التيسير بشرح الجامع الصغير، 2/ 337].
وعن ابنِ عمرٍ قالَ: سمِعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: «كم مِن جارٍ متعلِّقٍ بجارهِ يومَ القيامةِ يقولُ: يا ربِّ، هذا أغلقَ بابَهُ دونِي، فمَنَعَ معروفَهُ» [رواه البخاري في “الأدب المفرد”].
قالَ محمدُ بنُ إسماعيلَ الصنعانيُّ: (فيه تأكيدٌ عظيمٌ لرعايةِ حقِّ الجار، والحثِّ على مواساتِه، وتغليقِ البابِ كنايةً عن عدمِ خروجِ خيرٍ منهُ إليهِ). أ.ه. [التنوير شرح الجامع الصغير، 8/ 236].
وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو قالَ: قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «خيرُ الجيرانِ عندَ اللهِ خيرُهم لجارهِ» [رواه الترمذي وحسنه].
نسألُ اللهَ أنْ يرزقنا حسنَ العملِ، وفضلَ القبولِ، إنهُ أكرمُ مسؤولٍ، وأعظمُ مأمولٍ، وأن يجعلَ بلدَنا مصرَ سخاءً رخاءً، أمنًا أمانًا، سلْمًا سلامًا، وسائرَ بلادِ العالمين، ووفقَ ولاةَ أُمورِنا لما فيه نفعُ البلادِ والعبادِ.
أعدّه: الفقيرُ إلى عفوِ ربهِ الحنانِ المنانِ د / محروس رمضان حفظي عبد العال
مدرسُ التفسير وعلومِ القرآن كليةُ أصولِ الدينِ والدعوة – أسيوط
_____________________________________
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف