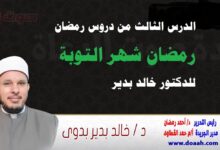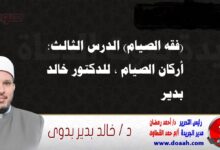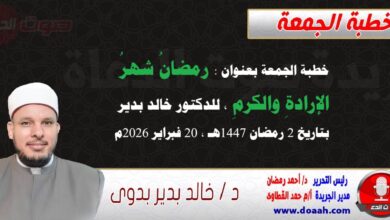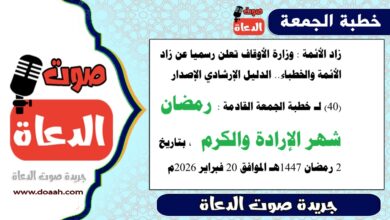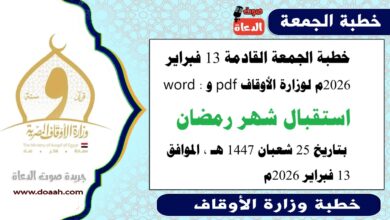خطبة الجمعة القادمة 8 أغسطس : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. ومَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، للدكتور محروس حفظي
بتاريخ 14 صفر 1447هـ ، الموافق 8 أغسطس 2025م
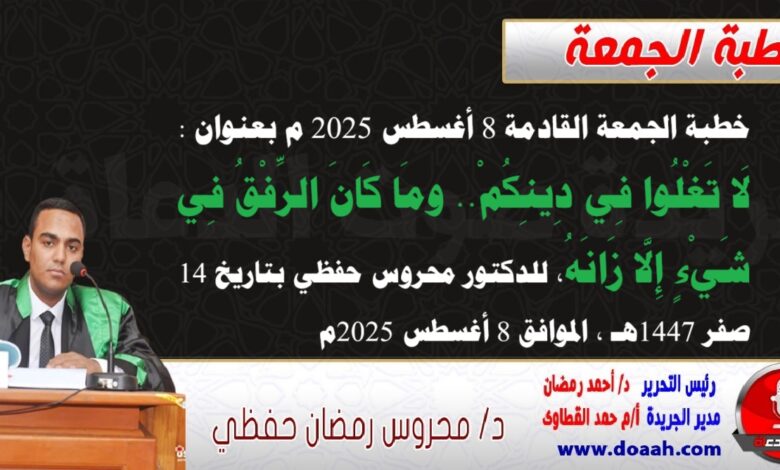
خطبة الجمعة القادمة
خطبة الجمعة القادمة 8 أغسطس 2025 م بعنوان : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. ومَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، للدكتور محروس حفظي بتاريخ 14 صفر 1447هـ ، الموافق 8 أغسطس 2025م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 8 أغسطس 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. ومَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ.
ولتحميل خطبة الجمعة القادمة 8 أغسطس 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. ومَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، بصيغة word أضغط هنا.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 8 أغسطس 2025م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. ومَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، بصيغة pdf أضغط هنا.
___________________________________________________________
عناصر خطبة الجمعة القادمة 8 أغسطس 2025م بعنوان : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. ومَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، للدكتور محروس حفظي :
(1) ذَمَّ القرآنُ الكريمُ “الغلُوَّ” في أكثرَ مِن موضعٍ.
(2) نحنُ أمةُ “الوسطِ”.
(3) “الرفقُ والوسطيةُ” منهجٌ واقعِيٌّ، وعملِيٌّ، يتجاوبُ مع النفسِ والفطرةِ.
(4) آثارُ “الغلُوِّ والتشددِ” على النفسِ.
(5) صورٌ مِن “الغلُوِّ” المنهِيِّ عنهُ.
(6) خطواتٌ عمليّةٌ لمواجهةِ “الغلُوِّ والتشددِ”.
(7) أهميةُ الصداقةِ في الإسلامِ.
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 8 أغسطس 2025م بعنوان: لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.. ومَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، للدكتور محروس حفظي : كما يلي:
لا تغلُوا في دينِكُم؛ فإنَّ الرفقَ ما كان في شيءٍ إلَّا زانَهُ الماءِ
بتاريخ 14 صفر 1447هـ = الموافق 8 أغسطس 2025 م
الحمدُ للهِ حمداً يُوافِي نعمَهُ، ويُكافِىءُ مزيدَهُ، لكَ الحمدُ كمَا ينبغِي لجلالِ وجهِكَ، ولعظيمِ سلطانِكَ، والصلاةُ والسلامُ الأتمانِ الأكملانِ على سيدِنَا مُحمدٍ ﷺ، أمَّا بعدُ ،،،
(1) ذَمَّ القرآنُ الكريمُ “الغلُوَّ” في أكثرَ مِن موضعٍ، وجاءَ التعبيرُ عنهُ بألفاظٍ متعددةٍ في سياقاتٍ متنوعةٍ:
– تارةً يذمُّهُ صراحةً قالَ تعالَى: {لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} [النساء: 171].
قال الزمخشرِيُّ: (أي: غلواً باطلاً؛ لأنَّ الغلوَّ في الدينِ غلوَّان: “غلوٌّ حقٌّ”: وهو أنْ يفحصَ عن حقائقِهِ، ويفتشَ عن أباعدِ معانيِهِ، ويجتهدَ في تحصيلِ حججِهِ، “وغلوٌّ باطلٌ”: وهو أنْ يتجاوزَ الحقَّ، ويتخطاهُ بالإعراضِ عن الأدلةِ، واتباعِ الشبهِ كما يفعلُ أهلُ الأهواءِ والبدعِ) أ.ه. (الكشاف عن حقائق التنزيل).
– تارةً أُخرَى يعبرُ عنهُ بلفظِ “الطغيانِ: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي} [طه: 81].
والنهيُ في الآيتينِ يدخلُ فيهمَا جميعُ المللِ والشرائعِ السماويةِ، قال مولانا الشيخُ/ مُحمد رشيد رضا: (وَفِي هَذَا النَّهْيِ اعْتِبَارٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالِانْتِهَاءِ عَنِ الْغُلُوِّ بِأَنَّ دِينَهُمْ دِينُ الرَّحْمَةِ وَالْيُسْرِ، وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي نَهْيِ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْغُلُوِّ فِي الْعِبَادَةِ وَعَنْ تَرْكِ الطَّيِّبَاتِ مُبَيِّنَةٌ لِهَذِهِ الْآيَاتِ، وَهِيَ مِصْدَاقُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَهُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ) أ.ه. (تفسير القرآن الحكيم “تفسير المنار”).
– أحياناً يأتي التعبيرُ عنهُ بلفظِ: “البغيِ”: {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90].
(2) نحنُ أمةُ “الوسطِ”:
“الوسطيةُ” أعظمُ خصائصِ هذه الأمةِ حتى صارت مضربَ الأمثالِ، قال الْمَاوَرْدِيُّ: «سألَ رجلٌ الْحُسَيْنَ بْنَ الْفَضْلِ فقال: إِنَّكَ تُخْرِجُ أَمْثَالَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ مِنَ الْقُرْآنِ، فَهَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ: “خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا”؟، قَالَ: نَعَمْ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: قَوْلُهُ:﴿لَا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾، وَقَوْلُهُ:﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾، وقولُهُ: ﴿وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾، وَقَوْلُهُ:﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴾» أ.ه.
قال ابنُ جريرٍ الطبرِي في قولِه تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]: (وأرى أنَّ اللهَ- تعالَى- ذكرَهُ إنَّمَا وصفَهُم بأنَّهُم”وسَطٌ”؛ لتوسطهِم في الدينِ، فلا هُم أهلُ غُلوٍّ فيهِ، ولا هُم أهلُ تقصيرٍ فيهِ، تقصيرَ اليهودِ الذينَ بدَّلُوا كتابَ اللهِ، وقتلُوا أنبياءَهُم، وكذبُوا على ربِّهِم، وكفرُوا بهِ، ولكنّهُم أهلُ توسطٍ واعتدالٍ فيهِ، فوصفَهُم اللهُ بذلكَ، إذ كان أحبَّ الأمورِ إلى اللهِ أوْسطُهَا) أ.ه. (جامع البيان في تأويل القرآن).
– خاطبَ اللهُ نبيَّهُ ﷺ: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [هود: 112].
قال الإمامُ البقاعيُّ: (والاستقامةُ: الاستمرارُ في جهةٍ واحدةٍ، ولمَّا كانت وسطاً بينَ إفراطٍ وتفريطٍ، وكان التفريطُ لا يكادُ يسلمُ منهُ إلَّا الفردُ النادرُ، وهو في الأغلبِ يورثُ انكسارَ النفسِ، واحتقارهَا، والخوفَ مِن اللهِ، وكان الإفراطُ يورثُ إعجاباً، وربّمَا أفضَى بالإنسانِ إلى ظنٍّ أنَّهُ شارعٌ، فينسلخُ لذلكَ مِن الدينِ، طوى التفريطَ، ونهىَ عن الإفراطِ فقالَ: {وَلَا تَطْغَوْا} أي تتجاوزُوا الحدَّ فيمَا أُمرتُم بهِ أو نُهيتُم عنهُ بالزيادةِ إفراطاً، فإنَّ اللهَ إنّمَا أمرَكُم ونهاكُم؛ لتهذيبِ نفوسِكُم لا لحاجتِهِ إلى ذلكَ، ولن تطيقُوا أنْ تقدرُوا اللهَ حقَّ قدرِهِ، والدينُ متينٌ لن يشادَّهُ أحدٌ إلّا غلبَهُ، فقد رضيَ منكُم – سبحانَهُ- الاقتصادَ في العملِ مع حسنِ المقاصدِ) أ.ه. (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور).
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا خُيِّرَ النبي ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا» (متفق عليه).
(3) “الرفقُ والوسطيةُ” منهجٌ واقعِيٌّ، وعملِيٌّ، يتجاوبُ مع النفسِ والفطرةِ:
إذا أرادَ المسلمُ أنْ يقتديَ بأكملِ الخلقِ ﷺ لم يشقَّ عليهِ ذلكَ، ولم يمنعْهُ عن مصالحِ دنياهُ، بل يمكنُ أداءُ الحقوقِ: “حقُّ اللهِ، وحقُّ النفسِ، والعبادِ” برفقٍ دونَ مزاحمةٍ بينهَا، أمَّا مَن شدّدَ على نفسِهِ، فإنَّ الدينَ سيغلبُهُ، وسيرجعُ القهقرِيَّ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النبي ﷺ:«سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، …، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا» (رواه البخاري).
– وقد زجرَ النبيُّ ﷺ مسلكَ”الغلوِّ والتشددِ” وحاربَهُ في أكثرَ مِن موقفٍ عملِيٍّ، فنراهُ يُعلنُ ﷺ أنَّ منهجَهُ ورسالتَهُ التي جاءَ بهَا لا تقبلُ المغالاةَ بحالٍ مِن الأحوالِ، فعن أَنَسٍ قالَ: «جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا …، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه البخاري).
قال ابنُ حجرٍ: (المرادُ بالسنةِ الطريقةُ لا التي تقابلُ الفرضَ، والمرادُ مَن تركَ طريقتِي، وأخذَ بطريقةِ غيرِي، ولمّحَ بذلكَ إلى الذينَ ابتدعُوا التشديدَ، وطريقةُ النبيِّ ﷺ الحنيفيةُ السمحةُ، فيفطرُ؛ ليتقوَّى على الصومِ، وينامُ؛ ليتقوَّى على القيامِ، ويتزوجُ؛ لكسرِ الشهوةِ، وإعفافِ النفسِ، وتكثيرِ النسلِ. وقال الطبريُّ: فيهِ الردُّ على مَن منعَ استعمالَ الحلالِ مِن الأطعمةِ والملابسِ، وآثرَ غليظَ الثيابِ، وخشنَ المأكلِ) أ.ه. (فتح الباري).
ولذا وردَ عن النبيِّ ﷺ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي»، دلالةً على أنّهُ يحبُّ الأمرَ، ولكنّهُ يخشَى الفتنةَ على الأمةِ، فلم يؤخرْ ﷺ صلاةَ العشاءِ إلى منتصفِ الليلِ، وامتنعَ عن الخروجِ إلى “التهجدِ” في رمضانَ مخافةَ أنْ يُفرَضَ، وتأخرَ في الردِّ على مَن سألَ عن تكرارِ الحجِّ في كلِّ عامٍ خشيةَ فرضيتِهِ، فكان رفيقاً بالأمةِ، عَنْ جَابِرٍ قالَ: قالَ: ﷺ:«إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا، وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا» (رواه مسلم).
– النهيُّ عن تعذيبِ النفسِ: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا} [النساء: 147] . {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟»، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ»، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ» (متفق عليه).
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» (البخاري).
(4) آثارُ “الغلُوِّ والتشددِ” على النفسِ:
– التشددُ يولدُ في النفسِ الكِبرَ والغرورَ، والتعالِي على الخلقِ، ووصفَ الناسِ بالفسقِ، بل ورميَهُم بالكفرِ، وتأملُوا صفةَ “الخوارجِ” التي جاءت في السنةِ سيتبينُ لكُم يقينًا أنَّ مَن تعبدَ اللهَ على غيرِ منهجِ “الرفقِ الاعتدالِ” سيضلُّ، وحتمًا سيزولُ هذا الستارُ، وتسقطُ عنه الأقنعةُ المزيفةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ» (رواه أبو داود).
قال سيدُنَا عمرُ بنُ الخطابِ – رضي اللهُ عنه-: “أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تُبَغِّضُوا اللهَ إِلَى عِبَادِهِ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَاكَ أَصْلَحَكَ اللهُ؟، قَالَ: يَكُونُ أَحَدُكُمْ إِمَامًا، فَيُطَوِّلُ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى يُبَغِّضَ إِلَيْهِمْ مَا هُوَ فِيهِ، وَيَقْعُدُ أَحَدُكُمْ قَاصًّا فَيُطَوِّلُ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى يُبَغِّضَ إِلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ” (شعب الإيمان للبيهقي، وصححه الحافظ ابن حجر في “فتح الباري”).
– حذَّرَ ﷺ مِن “الغلُوِّ”؛ لمَا ينشأُ عنهُ مِن مخاطرَ جسيمةٍ، وأضرارٍ عظيمةٍ، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ» (رواه النسائي في “سننه”).
– إذا حلَّ “الغلُوُّ والتشددُ” في حياةِ المسلمِ يترتبُ عليهِ أحدُ أمرينِ: أولهُمَا: الانقطاعُ عن العملِ بسببِ تزاحمِ الأعباءِ، مِمَّا تضيعُ الحقوقُ معهُ، وحينمَا رأَى سلمانُ أنَّ أبَا الدرداءِ ليسَ لهُ حاجةٌ في الدنيا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: «إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فقال ﷺ: «صَدَقَ سَلْمَانُ» (رواه البخاري).
وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ» (متفق عليه).
قال ابنُ المنيرِ- رحمَهُ اللهُ-: (رأينَا ورأَى الناسُ قبلَنَا أنَّ كلَّ متنطعٍ في الدينِ ينقطعُ، وليس المرادُ منعَ طلبِ الأكملِ في العبادةِ، فإنّهُ مِن الأمورِ المحمودةِ، بل المرادُ منعُ الإفراطِ المؤدِّي إلى الملالِ، أو المبالغةِ في التطوعِ المفضِي إلى تركِ الأفضلِ، أو إخراجِ الفرضِ عن وقتِهِ) أ.ه.
قال الإمامُ الشاطبيُّ: (إنَّ الشريعةَ جاريةٌ في التكليفِ لمقتضاهَا على الطريقِ الوسطِ العدلِ، الآخذِ مِن الطرفينِ بقسطٍ لا ميلَ فيهِ، فإذَا نظرتَ إلى كُليِّةٍ شرعيةٍ، فتأمَّلهَا تجدهَا حاملةً على التوسطِ والاعتدالِ، ورأيتَ التوسطَ فيها لائحًا، ومسلكَ الاعتدالِ واضحاً، وهو الأصلُ الذي يُرجعُ إليهِ، والمعقِلُ الذي يُلجأُ إليهِ) أ.ه.
ثانيهُمَا: وقوعُ الخللِ في العملِ حيثُ يدخلُ السآمةُ والمللُ في العبادةِ، قالَ الإمامُ الأوزاعِيُّ: “ما مِن أَمْرٍ أَمَرَ اللهُ بهِ إلَّا عارضَ الشيطانُ فيهِ بخصلتينِ، ولا يُبالِى أيُّهمَا أصابَ: الغلوَّ، أو التقصيرَ”. (المقاصد الحسنة للسخاوي).
ولذا نهَى ﷺ عن الصلاةِ «بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (متفق عليه)، ونهَى عن الصلاةِ وقتَ التعبِ، ورغَّبَ فيهَا وقتَ النشاطِ، فعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، فَقَالَ:«حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ» (متفق عليه).
إنَّ”الغلُوَّ والتشددَ”: انسلاخٌ عن الطبيعةِ البشريةِ، وخرقٌ لفطرةِ اللهِ: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [الروم: 30]، وإنْ تحملَهُ البعضُ؛ لانتكاسِ فطرتِهِم، فلن يطيقَهُ غالبيةُ البشرِ، وهذا ما عاتبَ بهِ النبيُّ ﷺ سيدَنَا معاذَ بنَ جبلٍ، فعن جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ- أَوِ النِّسَاءِ- فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ص ﷺ: «يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ»- أَوْ «أَفَاتِنٌ»- ثَلاَثَ مِرَارٍ: «فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الحَاجَةِ» (رواه البخاري).
“بِنَاضِحَيْنِ”: “ناضحٌ”: وهو البعيرُ الذي يُسقَى عليهِ النخلُ والزرعُ.
قال ابنُ هبيرةَ: (وفيهِ مِن الفقهِ ما يدلُّ على أنَّ تطويلَ الإمامِ للصلاةِ، تعريضٌ للمأمومينَ بالفتنةِ، ووجهُ الفتنةِ أنّهُ يعرضُ العبادةَ للضجرِ منهَا، فينبغِي للإنسانِ أنْ يجتنبَ ذلكَ) أ.ه. (الإفصاح عن معاني الصحاح).
إنَّ اللهَ لا يريدُ أجساداً تركعُ وتسجدُ، بينما القلوبُ ساهيةٌ غافلةٌ ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً﴾ بل يريدُ عبادةً يظهرُ أثرُهَا على سلوكِ الفردِ والمجتمعِ وحتى وإنْ كانت قليلةً، قال ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّ» (متفق عليه) .
لا يقدرُ أحدٌ على القيامِ بالدينِ كلِّهِ، ويجتمعُ فيهِ فضائلُهُ وكمالاتُهُ، لم يجتمعْ هذا في شخصٍ بعدَ النبيِّ ﷺ، والناسُ لهُم في دينِهِم أرزاقٌ، كما أنَّ لهُم في مالِهِم أرزاقاً، فخُذْ مِن الدينِ برفقٍ، ولا تكلفْ نفسَكَ ما لا تطيقُ مِن الأعمالِ.
(5) صورٌ مِن “الغلُوِّ” المنهيِّ عنهُ:
أولاً: الغلوُّ في الكلامِ، والمناقشاتِ؛ ليلفتَ الأنظارَ إليهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» قَالَهَا ثَلَاثًا»(رواه مسلم).
أي: “المتعمقونَ، الغالونَ، المجاوزونَ الحدودَ في أقوالِهِم وأفعالِهِم”. (شرح النووي على مسلم، 16/220).
قال الهرويُّ: (إنّمَا ردّدَ القولَ ثلاثاً؛ تهويلاً وتنبيهاً على ما فيهِ مِن الغائلةِ، وتحريضاً على التيقظِ والتبصرِ دونَهُ، وكم تحتَ هذه الكلمةِ مِن مصيبةٍ تعودُ على أهلِ اللسانِ والمتكلفينَ في القولِ، الذين يرومون بسبكِ الكلامِ سبيَ قلوبِ الرجالِ، نسألُ اللهَ العافيةَ مِن الدخولِ في الأوحالِ) أ.ه. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 7/3012).
ثانياً: النهيُ عن الغلوِّ في الدعوةِ: بعضُ الناسِ يريدُ أنْ يحولَ المجتمعَ إلى مجتمعٍ ربانيٍّ ملائكيٍّ، أنتَ لستَ سيفاً مسلطاً على رقابِ الخلقِ: {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشية:22]، {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} [يوسف:103].
عَنِ محجنِ بْنِ الْأَدْرَعِ قَالَ: قال النَّبِيَّ ﷺ: «إِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا هَذَا الْأَمْرَ بِالْمُغَالَبَةِ» (رواه أحمد).
ولذا كان النبيُّ ﷺ يأمرُ دعاتَهُ ورسلَهُ باليسرِ والتيسيرِ {فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه:44]. وعن أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى اليَمَنِ قَالَ: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا» (متفق عليه).
قال النوويٌّ: (إنّمَا جمعَ في هذه الألفاظِ بينَ الشيءِ وضدِّهِ؛ لأنّهُ قد يفعلهُمَا في وقتينٍ، فلو اقتصرَ على “يسّرُوا”؛ لصدقَ ذلكَ على مَن يسّرَ مرةً أو مراتٍ، وعسّرَ في معظمِ الحالاتِ، فإذا قال: “ولا تعسرُوا”، انتفَى التعسيرُ في جميعِ الأحوالِ مِن جميعِ وجوهِهِ، وهذا هو المطلوبُ وكذا يُقالُ في: ” وَلاَ تُعَسِّرَا، وتطاوعَا ولا تختلفَا”؛ وفي هذا الحديثِ الأمرُ بالتبشيرِ بفضلِ اللهِ، وعظيمِ ثوابِهِ، وجزيلِ عطائِهِ، وسعةِ رحمتِهِ، والنهيُ عن التنفيرِ بذكرِ التخويفِ، وأنواعِ الوعيدِ مِن غيرِ ضمِّهَا إلى التبشيرِ، ومتى يُسِّرَ على الداخلِ في الطاعةِ أو المريدِ للدخولِ فيهَا، سهلتْ عليهِ، وكانت عاقبتُهُ غالباً التزايدَ منها، ومتى عُسِّرَتْ عليهِ أو شكَّ أنْ لا يدخلَ فيهَا، وإنْ دخلَ أو شكَّ أنْ لا يدومَ أو لا يستحليهَا) أ.ه. (شرح النووي على مسلم).
ثالثاً: مِن أعظمِ فشوِّ “الغلوِّ والتشددِ”: الجهلُ بأحكامِ الشريعةِ السمحةِ، وعدمُ الفقهِ في الدينِ:
– عدمُ الإحاطةِ بمقاصدِ الإسلامِ، وجوهرِهِ الصافِي، السهلِ اللينِ، وجعلُ المقيسِ الوحيدِ للتدينِ هو “التمسكُ بالمظاهرِ، والسمتِ الخارجِي، أساسُ كلِّ بليةٍ، وأصلُ كلِّ رزيةٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: “لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَخَذُوا الْعِلْمَ عَنْ أَكَابِرِهِمْ وَعَنْ عُلَمَائِهِمْ وَأُمَنَائِهِمْ، فَإِذَا أَخَذُوهُ مِنْ أَصَاغِرِهِمْ، وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا”. (حليلة الأولياء، وطبقات الأصفياء).
– نجدُهُم يأخذونَ بالأشدِّ مِن أقوالِ الفقهاءِ، ويشددونَ على الخلقِ مع تضافرِ أسبابِ التيسيرِ والرفقِ، قالَ الإمامُ سفيانُ الثورِي: “إنَّمَا الفقهُ الرخصةُ مِن ثقةٍ، أمَّا التشددُ فيحسنُهُ كلُّ أحدٍ” أ.ه.
– مِن الكلماتِ التي جرتْ على ألسنةِ هؤلاءِ المتطرفينَ “البدعةُ”، ووسمُ كلِّ ما لم يكنْ معروفاً أيامَ النبيِّ ﷺ بهَا، فقسَّمُوا المسلمينَ شيعاً وأحزاباً، ورموهُم بالفسقِ والكفرِ والعصيانِ، {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36]، مع أنَّ “البدعةَ” يعتريهَا “الأحكامُ الشرعيةُ الخمسُ”.
(6) خطواتٌ عمليّةٌ لمواجهةِ “الغلُوِّ والتشددِ”:
– اغرسْ في ولدِكَ التدينَ الوسطيَّ، البعيدَ عن الإفراطِ والتفريطِ، وذكرْهُ دوماً بعواقبِ “الغلُوّ.ك والتشددِ” في الدنيا والآخرةِ.
– احرصْ أنْ تأخذَ العلمَ والفقهَ مِن أهلِ الاختصاصِ، قال سفيانُ الثورِيُّ: “لا يأمرُ بالمعروفِ، ولا ينهَى عن المنكرِ إلّا مَن كان فيهِ خصالٌ ثلاثٌ: رفيقٌ بمَا يأمرُ، رفيقٌ بمَا ينهَى، عدلٌ بمَا يأمرُ، عدلٌ بمَا ينهَى، عالمٌ بمَا يأمرُ، عالمٌ بمَا ينهَى” أ.ه.
– احذرْ متابعةَ الصفحاتِ الإلكترونيةِ المشبوهةِ التي تتبنَّى منهجَ “الغلُوِّ والتشددِ”، أخذاً بقاعدةِ “سدِّ الذرائعِ”.
– راقبْ عن كثبٍ صحبةَ ولدِكَ– دونَ أنْ تنتهِكَ خصوصيتَهُ-.
– دربْ نفسَكَ مع الأسرةِ ومَن حولَكَ أنْ تأخذَ بأوسطِ الأمورِ في العباداتِ والطاعاتِ، وابتعدْ قدرَ الإمكانِ عن التشددِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ». (شعب الإيمان للبيهقي).
– ما أحوجَ الناسَ اليومَ إلى مَن يكونُ قريبًا منهُم، ويجالسُهُم ويلاطفُهُم، ويرفقُ بهِم في كلِّ أمرٍ، يسعَى في قضاءِ حوائجِهِم، وتمشيةِ أمورِهِم وإعانتِهِم، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «حُرِّمَ عَلَى النَّار كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِنَ النَّاسِ» (أحمد)، والواقعُ يؤكدُ أنَّ المتشددَ على نفسِه والناسِ، والذي يُلزمُ نفسَهُ وإيَّاهُم ما يصعبُ ويشقُّ، يفقدُ لذَّةَ العبادةِ والأنسِ بهَا، وحلاوةَ الدينِ والعملَ بهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» (مسلم).
(7) أهميةُ الصداقةِ في الإسلامِ:
– القرآنُ الكريمُ يأمرُنَا بانتقاءِ الأصدقاءِ: حيثُ يخبرُنَا أنَّ أصدقاءَ السوءِ والشرِّ في الدنيا، يصيرُ بعضُهُم لبعضٍ يومَ القيامةِ أعداءً؛ لأنّهُم كانوا يجتمعونَ على الآثامِ في الدنيا، وكانوا يتواصونَ بالبقاءِ على الفسوقِ والعصيانِ، فلمَّا جاءَ يومُ القيامةِ، وانكشفت الحقائقُ، انقلبت صداقتُهُم إلى عداوةٍ، أمَّا “الصداقةُ” المبنيةُ على الحقِّ، والخيرِّ والبرِّ، فإنَّ صداقتَهُم في الدنيا تنفعُهُم في الآخرةِ فقالَ تعالى: {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [الزخرف: 67].
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ النبي ﷺ:«خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ» (رواه الترمذي).
– أوصافُ الصديقِ: عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ” مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً”. (متفق عليه).
قال الإمامُ النوويُّ: (مثَّلَ النبيُّ ﷺ الجليسَ الصالحَ بحاملِ المسكِ، والجليسَ السوءَ بنافخِ الكيرِ، وفيه فضيلةُ مجالسةِ الصالحينَ، وأهلِ الخيرِ والمروءةِ، ومكارمِ الأخلاقِ، والورعِ والعلمِ والأدبِ، والنهيُ عن مجالسةِ أهلِ الشرِّ، وأهلِ البدعِ، ومَن يغتابُ الناسَ أو يكثرُ فجرُهُ، وبطالتُهُ ونحو ذلكَ مِن الأنواعِ المذمومةِ). أ.ه.
– يحشرُ مع محبوبِهِ، ويكونُ رفيقًا لمطلوبِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ» (رواه أبو داود).
– ثمراتُ الصداقةِ الحسنةِ: هي كالشجرةِ تؤتِي أكلَهَا كلَّ حينٍ، ومِن أثرِهَا على الإنسانِ في الدينا والآخرةِ:
*توجبُ محبةَ اللهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ” أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ، عَلَى مَدْرَجَتِهِ، مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ “
*في ظلِّ اللهِ يومَ القيامةِ: قال رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ» (رواه أحمد).
*استجابةُ الدعاءِ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ” مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ “ (رواه مسلم).
– الأصلُ في علاقةِ البشرِ فيمَا بينَهُم أنْ تقومَ على الاحترامِ المتبادلِ، ومراعاةِ الذوقِ العامِّ، وقد وضّحَ الإسلامُ علاقةَ الرجلِ بالمرأةِ أيَّما وضوحٍ، ولم يتركْهَا للهوَى والتشهِي خاصةً فيمَا يتعلقُ بالمعاملاتِ والمحادثاتِ، فلم يغلقْ بابَ التعاملِ بالكليةِ كيلَا تُعْزلَ المرأةُ عن الانخراط طِ في مجالاتِ الحياةِ المتعددةِ كالتعليمِ والعملِ وغيرِهِ، ولم يفتحْ البابَ على مصراعيهِ، بل ضبطَ المسألةَ بسياجٍ مِن الحشمةِ والوقارِ، والقيمِ الأخلاقيةِ والمعاييرِ والأعرافِ الاجتماعيةِ، يُعلمُ ذلكَ مِن الآتِي:
أولاً: إذا كانت الصداقةُ قائمةً على العلمِ وتبادلِ المعرفةِ والخبراتِ والثقافاتِ، فهذا لا شيءٌ فيهِ خيرٌ طالمَا يلتزمُ الطرفانِ بالضوابطِ الشرعيةِ، والأخلاقِ المهنيةِ، أمَّا إذا كان ذلك بقصدِ التسليةِ وقضاءِ بعضِ الوقتِ للمتعةِ، وتفريغِ المشاعرِ والدوافعِ النفسيةِ والجنسيةِ، فهذا يأباهُ الشرعُ الحنيفُ، وترفضُهُ العقولُ السليمةُ، ولا تستسيغهُ الفطرُ النقيةُ، ولذا تجدُ الشابَّ والفتاةَ يمارسَا ذلكَ على حينِ غفلةٍ، وصدقَ رسولُنَا حيثُ قالَ كما رواهُ النَّوَّاسُ بْنُ سِمْعَانَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» (رواه مسلم) .
وتكوينُ صداقاتٍ بينَ الرجالِ والنساءِ بقصدٍ غيرِ مشروعٍ، يُعدُّ مِن اتخاذِ الأخْدانِ الذي كان منتشراً في الجاهليةِ، فنهَى اللهُ عنهُ في كتابِه الحكيمِ، قالَ تعالى: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾.
ثانياً: الإسلامُ قطعَ كلَّ طريقٍ يُعَدُّ مدخلاً مِن مداخلِ وساوسِ الشيطانِ في العلاقةِ بينَ الرجلِ والمرأةِ، ولذا وضعَ الفقهاءُ قاعدةً مهمةً ألَا وهي «قاعدةُ سدِّ الذرائعِ»، فكلّ ما سبيلهُ أنْ يجلبَ للطرفينِ الفتنةَ، وينشرُ الرذيلةَ، ويُقَطِّعُ أوصالَ المودةِ بينَ أفرادِ المجتمعِ فسدُّ بابِهِ أولَى، وفي التعبيرِ القرآنِي ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً﴾، فيلاحظُ أنَّ اللهَ عبَّرَ بلفظِ: ﴿وَلا تَقْرَبُوا﴾، ولم يقلْ: «ولا تزنُوا» للمبالغةِ في الزجرِ عن مباشرةِ هذه الفاحشةِ؛ لأنَّ قربانهَا قد يؤدِّي إلى الوقوعِ فيهَا، فمَن حامَ حولَ الحِمَى يوشكُ أنْ يقعَ فيهِ، وعليهِ فكلُّ قولٍ أو فعلٍ بينَ الرجلِ والمرأةِ لا طائلَ مِن ورائِه ولا منفعةَ مِن ممارستِهِ فهو محرمٌ شرعاً وعقلاً وطبعاً وذوقاً، وسدُّ بابِهِ أولَى؛ لأنَّ علمَ النفسِ يؤكدُ أنَّ التعلقَ الروحِيَّ والنفسِيَّ بينهمَا حتماً سيحدثُ.
نسألُ اللهَ أنْ يرزقنَا حسنَ العملِ، وفضلَ القبولِ، إنّهُ أكرمُ مسؤولٍ، وأعظمُ مأمولٍ، وأنْ يجعلَ بلدَنَا مِصْرَ سخاءً رخاءً، أمناً أماناً، سلماً سلاماً وسائرَ بلادِ العالمين، ووفقْ ولاةَ أُمورِنَا لِمَا فيهِ نفعُ البلادِ والعبادِ.
كتبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان د / محروس رمضان حفظي عبد العال
مدرس التفسير وعلوم القرآن – كلية أصول الدين والدعوة – أسيوط
_____________________________________
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف