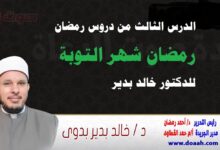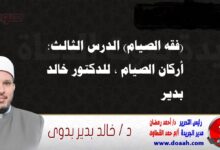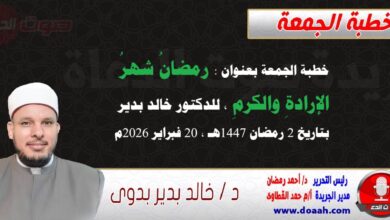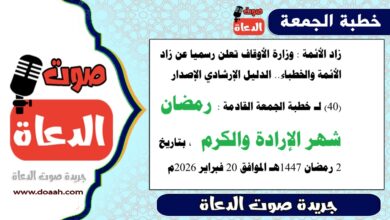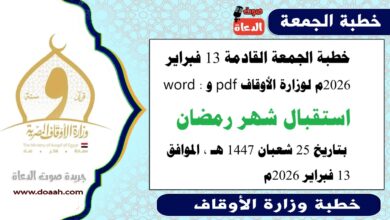خطبة الجمعة بعنوان : البيئَةُ هي الرَّحِمُ الثَّانِي وَالأُمُّ الكُبرَى ، للدكتور خالد بدير
بتاريخ 2 جمادي الأولي ربيع الآخر 1447هـ ، الموافق 24 أكتوبر 2025م

خطبة الجمعة بعنوان : البيئَةُ هي الرَّحِمُ الثَّانِي وَالأُمُّ الكُبرَى ، للدكتور خالد بدير ، بتاريخ 2 جمادي الأولي ربيع الآخر 1447هـ ، الموافق 24 أكتوبر 2025م.
تحميل خطبة الجمعة القادمة 24 أكتوبر 2025م ، للدكتور خالد بدير بعنوان : البيئَةُ هي الرَّحِمُ الثَّانِي وَالأُمُّ الكُبرَى :
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 24 أكتوبر 2025م ، للدكتور خالد بدير بعنوان : البيئَةُ هي الرَّحِمُ الثَّانِي وَالأُمُّ الكُبرَى ، بصيغة word أضغط هنا.
ولتحميل خطبة الجمعة القادمة 24 أكتوبر 2025م ، للدكتور خالد بدير بعنوان : البيئَةُ هي الرَّحِمُ الثَّانِي وَالأُمُّ الكُبرَى، بصيغة pdf أضغط هنا.
عناصر خطبة الجمعة القادمة 24 أكتوبر 2025م ، للدكتور خالد بدير ، بعنوان : البيئَةُ هي الرَّحِمُ الثَّانِي وَالأُمُّ الكُبرَى : كما يلي:
أولًا: نظافة البيئة سلوك إسلامي وإنساني.
ثانيًا: علاقة الإنسان بالبيئة.
ثالثًا: واجبنا نحو البيئة .
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 24 أكتوبر 2025م ، للدكتور خالد بدير ، بعنوان : البيئَةُ هي الرَّحِمُ الثَّانِي وَالأُمُّ الكُبرَى: كما يلي:
خطبةٌ بعنوان: البيئَةُ هي الرَّحِمُ الثَّانِي وَالأُمُّ الكُبرَى.
2 جمادى الأولى 1447هـ – 24 أكتوبر 2025م
المـــوضــــــــــوعُ
الحمدُ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونتوبُ إليهِ ونستغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شرورِ أنفسِنَا وسيئاتِ أعمالِنَا، ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له وأنَّ سيِّدَنَا مُحمدًا عبدُهُ ورسولُهُ ﷺ. أمَّا بعدُ:
أوّلًا: نظافةُ البيئةِ سلوكٌ إسلاميٌّ وإنسانيٌّ.
لقد حثَّ الإسلامُ على نظافةِ البيئةِ وجمالِها ونضرتِها والعنايةِ الفائقةِ بها، واعتبرَها من صميمِ رسالتِه؛ وذلك لأنَّ أثرَها عميقٌ في تزكيةِ النفسِ وتمكينِ الإنسانِ من النهوضِ بأعباءِ الحياةِ، كما اهتمَّ الإسلامُ بنظافةِ الأجسامِ اهتمامًا كبيرًا، وقد بيّن رسولُ اللهِ ﷺ أنَّ الرجلَ الحريصَ على نضارةِ بدنِه، ووضاءةِ وجهِه، ونظافةِ أعضائِه يُبعثُ على حالِه تلك يومَ القيامةِ، فعن أبي هريرةَ قال سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: “إنَّ أُمتي يُدعونَ يومَ القيامةِ غُرًّا مُحجَّلينَ من آثارِ الوضوءِ، فمنِ استطاع منكُم أن يُطيلَ غُرَّتهُ فلْيفعل” (البخاري).
إنَّ كثيرًا من الناسِ يظنّون أنَّ الدينَ الإسلاميَّ ليس له علاقةٌ بالنظافةِ، وهذا ما اعتقده مشركو العربِ؛ بل وتعجّبوا من ذلك متسائلين، فعن سلمانَ قال: قال له بعضُ المشركين وهم يستهزئون به: إنّي أرى صاحبَكم يعلّمكم كلَّ شيءٍ حتى الخراءةَ؟ قال: “أجل، أمرنا أن لا نستقبلَ القبلةَ، وأن لا نستنجِيَ بأيمانِنا، ولا نكتفيَ بدونِ ثلاثةِ أحجارٍ، ليس فيها رجيعٌ ولا عظمٌ” (ابن ماجة).
بل جعل الإسلامُ الطهارةَ والنظافةَ جزءًا من الإيمانِ، ففي صحيح مسلم عن أبي مالكٍ الأشعريِّ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: “الطهورُ شطرُ الإيمان“.
ومظاهرُ النظافةِ والطهارةِ في الإسلامِ كثيرةٌ ومتعدّدةٌ منها:
نظافةُ الرأسِ والأسنانِ والفمِ: وهي من السننِ المؤكّدةِ، فعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: “لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواكِ عند كلِّ صلاةٍ” (الشيخان).
وكذلك تمشيطُ الشعرِ وحلقُه، كلُّ ذلك يضفي على المؤمنِ حسنَ الشكلِ والمظهرِ، فعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ ﷺ قال: “مَن كان له شعرٌ فليكرمْه” (أبو داود).
ومنها: نظافةُ البيوتِ والأفنيةِ والمساجدِ ونظافةُ الأماكنِ العامةِ والطرقاتِ: وذلك بتنظيفِها من كلِّ الأقذارِ والأخباثِ التي يسوءُ منظرُها، فعن سعيدِ بنِ المسيبِ مرسلًا قال ﷺ: “إنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نظيفٌ يُحِبُّ النظافةَ، كريمٌ يُحِبُّ الكرمَ، جَوادٌ يُحِبُّ الجُودَ؛ فنظِّفوا أفنيتَكم؛ ولا تشبَّهوا باليهودِ” (الترمذي).
وعن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه عن النبيِّ ﷺ قال: (الإيمانُ بضعٌ وسبعون – أو بضعٌ وستون – شعبةً، فأفضلُها قولُ لا إله إلا الله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريقِ، والحياءُ شعبةٌ من الإيمانِ) (متفق عليه).
ومنها: نظافةُ الثيابِ والتخلّصُ من الروائحِ الكريهةِ: ففي صحيحِ مسلم قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ». وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ ﷺ قال: “مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ” (مسلم).
ومنها: نظافةُ البدنِ وغسلُه: فقد أُمِر المسلمُ بالغسلِ يومَ الجمعةِ، حتى عُبِّر عنه في بعضِ الأحاديثِ بلفظة (واجب)، فعن أبي سعيدٍ الخدريِّ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: ”غُسْلُ يومِ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ” (الشيخان).
ومنها: الاهتمامُ بسننِ الفطرةِ: وتكملةً لذلك جاءت الأحاديثُ بما عُرف باسم (سننِ الفطرةِ) التي تدلُّ رعايتُها على مدى حرصِ الإنسانِ على النظافةِ والتجمّلِ، والمحافظةِ على نعمةِ الصحةِ والزينةِ، فعن عائشةَ قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ”عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، يَعْنِي الاِسْتِنْجَاءَ. قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.” (مسلم).
ومنها: نظافةُ الطعامِ والشرابِ: فقد حثّت السنةُ على نظافةِ الطعامِ والشرابِ وحمايتِهما من التلوثِ، فعن جابرٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ”أَغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً.” (مسلم).
ومنها: نظافةُ المياهِ: وذلك بالمحافظةِ على تنقيتِها وطهارتِها، وعدمِ إلقاءِ القاذوراتِ والمخلفاتِ فيها، باعتبارِ أنَّ الماءَ أساسُ الحياةِ، وقد جاءت أوامرُه ﷺ ناهيةً عن أن يُبالَ في الماءِ الراكدِ، فعن جابرٍ عن رسولِ اللهِ ﷺ ”أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ” (مسلم). كما يشملُ النهيُ البولَ في الماءِ الجاري وفي أماكنِ الظلِّ باعتبارِها أماكنَ يركنُ إليها المارّةُ للراحةِ من وعثاءِ السفرِ، وربما لأنَّ الشمسَ لا تدخلُها فلا تتطهرُ فتصبحُ محطَّ الأوبئةِ وموضعَ الأمراضِ، وفي الحديثِ: ”لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ” (متفق عليه).
ثانيًا: علاقةُ الإنسانِ بالبيئةِ.
للإنسانِ علاقةٌ وطيدةٌ بالبيئةِ تتمثلُ في أمورٍ كثيرةٍ منها:-
علاقةُ خلافةٍ وتسخيرٍ وحقٍّ وواجبٍ: فقد قبلَ الإنسانُ استخلافَه في الأرضِ؛ فهي علاقةُ حقٍّ وواجبٍ، فالحقُّ هو الحقُّ المشتركُ بين الناسِ في الاستمتاعِ والانتفاعِ بعطاءِ اللهِ ورزقِه. أما الواجبُ فهو واجبُ الرعايةِ والمحافظةِ على الكونِ والوجودِ؛ لأنَّ هذا هو مقتضى الخلافةِ والأمانةِ التي حملَها الإنسانُ.
ومنها: علاقةُ العبوديةِ والتسبيحِ: فكلُّ شيءٍ يقرُّ بعبوديتِه للهِ الخالقِ البارئِ المصوِّرِ، فيسبِّحُ بحمدِه ويسجدُ له: {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا}. (الإسراء: 14).
وقال: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}. (الحج: 15).
ومنها: علاقةُ تدبرٍ وتفكّرٍ: فالإسلامُ حضَّ على العملِ والتفكرِ والبحثِ عن أسرارِ الكونِ؛ استدلالًا على الوجودِ الإلهيِّ، ووصولًا إلى اليقينِ، قال تعالى:
{وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ}. (النحل: 20).
وفي كلِّ شيءٍ له آيةٌ … تدلُّ على أنَّه الواحدُ.
وكم من علماءَ غربيين أسلموا نتيجةَ بحوثِهم في الآياتِ الكونيةِ والإنسانيةِ، وأُلفتْ في ذلك مؤلفاتٌ وكتبٌ ومنها كتابٌ تحت عنوان: “لماذا أسلم هؤلاء؟!”، وليس هنا مجالُ لذكرِ أمثلةٍ منهم.
ومنها: علاقةُ العقيدةِ والتوحيدِ: فاللهُ واحدٌ لا شريكَ له، وخلق جميعَ الأشياءِ زوجين، قال تعالى:
{وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}. (الذاريات: 49).
قال ابنُ كثيرٍ – رحمه الله – في تفسيرِه: {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} أي: جميعُ المخلوقاتِ أزواجٌ: سماءٌ وأرضٌ، وليلٌ ونهارٌ، وشمسٌ وقمرٌ، وبرٌّ وبحرٌ، وضياءٌ وظلامٌ، وإيمانٌ وكفرٌ، وموتٌ وحياةٌ، وشقاءٌ وسعادةٌ، وجنّةٌ ونارٌ، وجنٌّ وإنسٌ، ذكورٌ وإناثٌ، حتى الحيواناتُ والنباتاتُ، ولهذا قال: {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} أي: لتعلموا أنَّ الخالقَ واحدٌ لا شريكَ له. أ.هـ.
وقال القرطبي: “لتعلموا أنَّ خالقَ الأزواجِ فردٌ، فلا يقدَّرُ في صفتِه حركةٌ ولا سكونٌ، ولا ضياءٌ ولا ظلامٌ، ولا قعودٌ ولا قيامٌ، ولا ابتداءٌ ولا انتهاءٌ؛ إذ عزَّ وجلَّ وترٌ {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}”. (الشورى: 11). أ.هـ.
فالعاملُ المشتركُ بين الإنسانِ وعناصرِ البيئةِ هو التوحيدُ في الكلِّ، لأنَّ جميعَ عناصرِ البيئةِ مزدوجةٌ، واللهُ واحدٌ.
ثالثًا: واجبنا نحو البيئة .
إن واجبنا نحو البيئة يتمثل في أمور كثيرة منها:
استخدام موارد الطبيعة وعناصر البيئة فيما خلقت له: لأن شكر هذه النعم استخدامها في طاعة الله، وكفرها استخدامها في الفساد والإفساد، وقد وعدنا الله بالمزيد إن شكرنا، وبالعذاب إن قصرنا حيث قال: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}.(إبراهيم: 7).
ومنها: المحافظة على الماء: لأن الماء يعد أساس الحياة ومصدر كل شيء، يقول الله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ}. (الأنبياء:30)، فالنبات والحيوان والإنسان يرتبط وجودهم بوجود الماء، واستمرار حياتهم متوقف على توافر الماء، لذا تجب محاربة كل المحاولات التي تهدف إلى الإسراف والتبذير للمياه أو تلوثها، لأن التلوث بحد ذاته تعطل وظيفة الماء في كونه أساس الحياة.
ومنها: عدمُ الفسادِ والإفسادِ في البيئةِ: لأنَّنا نخلقُ الفسادَ بأيدينا، قال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}. (الروم: 41).
ومن صورِ الفسادِ والإفسادِ في الأرضِ: تخريبٌ وتدميرٌ للمنشآتِ العامةِ، وقطعُ الأشجارِ وإتلافُ الحدائقِ والزينةِ وحرقُها، وإذا كان الإسلامُ قد نهانا أن نفعلَ ذلك مع الأعداءِ؛ فمن بابِ أولى أن نحافظَ على حرماتِ المسلمين. كذلك من صورِ الفسادِ: تجريفُ الأرضِ الزراعيةِ أو التعدي عليها أو زرعُها بألوانِ الزرعِ المحرَّمِ من المسكراتِ والمخدراتِ.
ومنها: كثرةُ الاستغفارِ واللجوءُ إلى اللهِ: فهذا عاملٌ مهمٌّ في زيادةِ مواردِ البيئةِ ونمائِها، قال تعالى على لسانِ نوحٍ عليه السلام: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا}. (نوح: 10-12).
وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}. (الأعراف: 96).
فالطاعةُ والحسناتُ سبيلٌ للخيرِ والبركةِ، والمعصيةُ والسيئاتُ سبيلٌ لمحقِ البركةِ وضيقِ الرزقِ، وما أجملَ مقولةَ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ: “إنَّ للحسنةِ ضياءً في الوجهِ، ونورًا في القلبِ، وسعةً في الرزقِ، وقوةً في البدنِ، ومحبَّةً في قلوبِ الخلقِ، وإنَّ للسيئةِ سوادًا في الوجهِ، وظلمةً في القلبِ، ووهنًا في البدنِ، وضيقًا في الرزقِ، وبغضًا في قلوبِ الخلقِ”.
ومنها: طهارةُ الباطنِ قبلَ طهارةِ الظاهرِ: فلابدَّ من طهارةِ الباطنِ من المعصيةِ والرذيلةِ والحقدِ والحسدِ والكفرِ والنفاقِ والشقاقِ وسوءِ الأخلاقِ، وذلك لأنَّ طهارةَ الظاهرِ للدنيا، وطهارةَ الباطنِ للآخرةِ.
فعن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: “إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ”. (متفق عليه).
وسلامةُ الباطنِ شرطٌ لدخولِ الجنةِ قال تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ}. (الحجر: 47).
وهكذا يجبُ علينا نظافةُ البيئةِ وعدمُ تلويثِها بأيِّ صورةٍ من صورِ التلوثِ، لننعمَ بجمالِ الظاهرِ. كما يجبُ علينا نظافةُ الباطنِ مع الظاهرِ، لأنَّ الظاهرَ محلُّ نظرِ المخلوقِ، والباطنُ محلُّ نظرِ الخالقِ جلَّ وعلا.
اللهم طهِّر قلوبَنا من النفاقِ، وأعمالَنا من الرياءِ، وألسنتَنا من الكذبِ، وأعينَنا من الخيانةِ، إنك تعلمُ خائنةَ الأعينِ وما تُخفي الصدورُ.
الدعاءُ،،،، وأقم الصلاةَ،،،، كتبه : خادم الدعوة الإسلامية
د / خالد بدير بدوي
_____________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف