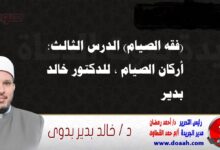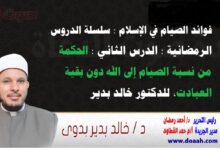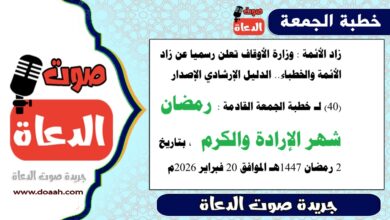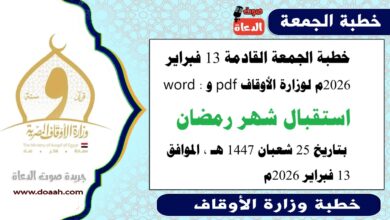زاد الأئمة : وزارة الأوقاف تعلن عن زاد الأئمة والخطباء.. لـ خطبة الجمعة القادمة : الْيَقِينُ
الْيَقِينُ الْيَقِينُ ، بتاريخ 4 ربيع الثاني 1447هـ ، الموافق 26 سبتمبر 2025م
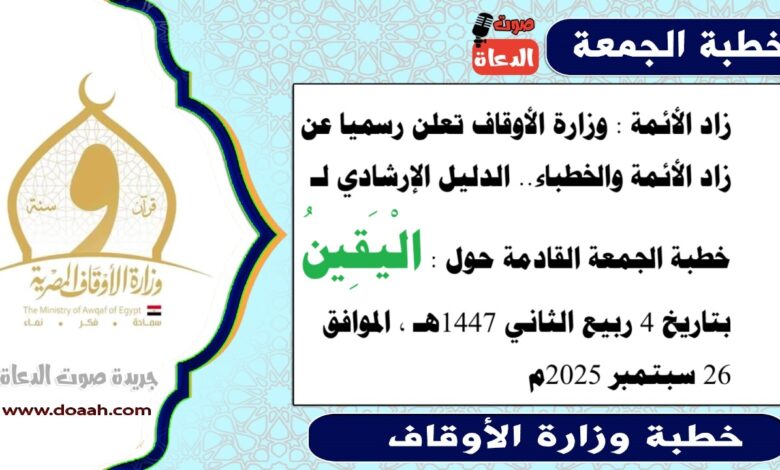
زاد الأئمة : وزارة الأوقاف تعلن رسميا عن زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لـ خطبة الجمعة القادمة حول : الْيَقِينُ ، بتاريخ 4 ربيع الثاني 1447هـ ، الموافق 26 سبتمبر 2025م.
ننفرد بنشر زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لخطب الجمعة القادمة : الْيَقِينُ ، بصيغة WORD
ننشر زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لخطب الجمعة القادمة : الْيَقِينُ ، بصيغة pdf
ولقراءة زاد الأئمة والخطباء.. لـ خطبة الجمعة القادمة : الْيَقِينُ ، كما يلي:
زاد الأئمة (19)
زاد الأئمة (19)
اليقين
بتاريخ 4 ربيع الثاني 1447هـ – 26 سبتمبر 2025م
بسم الله الرحمن الرحيم
اليقين
الهدف: التوعية بالأسباب النفسية والفكرية للإلحاد وكيفية المواجهة والعلاج
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمين؛ أما بعد:
فإن أعمال القلوب كلها من اليقين، والإيمان في النفوس يكون على قدر اليقين عند العبد، واليقين هو الحائط الأعظم لصد الإلحاد، وهو أقوى أسلحة مواجهته، لذلك كان هو أفضل ما اهتم الإنسان بتحصيله، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: “إنَّ أَعْظَمَ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ، وَخَيْرَ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَخَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، وَرَأْسَ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ، وَخَيْرَ مَا أُلْقِيَ فِي الْقُلُوبِ الْيَقِينُ“. [الزهد لهناد].
- معنى اليقين وأثره العميق على الإيمان
اليقين في اللغة له معان كثيرة منها:
١ – الموت: ومنه قوله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر: ٩٩]، قَالَ الحسن البصري: “الْمَوْتُ”، ولما استشهد سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ اليَقِينُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الخَيْرَ» [صحيح البخاري].
٢ – اليقين في مقابل الشك: كما في حديث: «إذا شكَّ أحَدُكُم في صلاته فَلْيُلق الشَّكَّ، وليَبْنِ على اليقين»[سنن أبي داود].
٣ – اليقين بمعنى العلم والإيمان: كما في الحديث: «وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا» [سنن الترمذي وحسنه].
إلى غير ذلك من المعاني اللغوية.
أما تعريف اليقين في كلام العلماء، فلهم فيه أقوال كثيرة، تدور في مجموعها حول الإيمان الذي لا يداخله شك، ولا يزعزعه ريب، ولا تدخله شبهة:
قال الحكيم الترمذي: “هو نور يحدث على قلبك من نور معرفتك، ونور إلهك الذي هو نور السماوات والأرض ونور كل شيء، فإذا أقبلت على الله تبارك اسمه، أشرق القلب بالنور، فذلك اليقين“. [أدب النفس].
وقد قال العلماء في الفرق بين العلم واليقين: إن العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة، أما اليقين فهو سكون النفس وثلج الصدر بما علم، ولهذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى باليقين، ويقال: ثلج اليقين وبرد اليقين، ولا يقال: ثلج العلم وبرد العلم. [الفروق اللغوية].
وقد أكثر الله تعالى من ذكره في القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} [البقرة: ٤]، وقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: ٢٤]، وقوله تعالى: {هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [الجاثية: ٢٠].
- مراتب اليقين
لليقين مراتب ثلاث، تتدرج فيها النفس في مدارج الإيمان:
١. علم اليقين: وهو المعرفة النظرية للحقائق، كمعرفة أوامر الله ونواهيه والإيمان بالغيب، ويتمثل ذلك في معرفة الشيء عن طريق الخبر الصادق أو الاستدلال العقلي، فمثلاً، عندما نقرأ في القرآن الكريم عن الجنة والنار، فإننا نؤمن بهما إيمانًا جازمًا بناءً على خبر الله تعالى ورسوله الصادق، وهذا هو علم اليقين.
٢. عين اليقين: وهو المشاهدة المباشرة لحقائق الأمور، أي: رؤية الحقائق بالعين أو إدراكها إدراكًا حسيًّا، وهو أعلى من علم اليقين؛ لأنه يضيف المشاهدة إلى العلم، فمثلًا، عندما يرى الإنسان دلائل قدرة الله تعالى في الكون، كخلق السماوات والأرض والجبال والبحار، فإن هذا يورثه عين اليقين.
٣. حق اليقين: وهو المستوى الأخير والأعلى من اليقين، حيث يصبح اليقين جزءًا لا يتجزأ من ذات الإنسان، ويتجلى في التجربة العملية والذوق الروحي، وهو أعلى مراتب اليقين، حيث يتحد العلم والرؤية والتجربة. فمثلًا، عندما يدخل أهل الجنة الجنة، فإنهم يرون الجنة ويذوقون نعيمها، وهذا هو حق اليقين.
- كيفية تحصيل اليقين الصادق
ذكر العلماء لذلك أشياء كثيرة منها:
قال سَريُّ بن المغلّس: “ثلاث يستبين بهن اليقين، القيام بالحق في مواطن الهلكة، والتسليم لأمر اللَّه عزّ وجلّ عند نزول البلاء، والرضا بالقضاء عند زوال النعمة نعوذ باللَّه منه“. [قوت القلوب].
وذكر الحكيم الترمذي عندما تعرض لليقين: “فبماذا يوجد اليقين؟ قال: بطهارة القلب؛ لأن اليقين طاهر، فيطهر مكانه ومستقره.
قيل له: وما طهارته؟ قال: ترك ما اضطرب القلب عليه ورابك منه تورعًا، دقّ أو جلّ، ثم تطهره من التعلق بالشهوات، والاشتغال بها، فإذا أنت فعلت ذلك صَقَلْتَ قلبك، فصار لك مرآة بالتورع؛ فكلما تفكرت شيئاً من أمر الآخرة، تمثل في مرآتك، حتى تصير الآخرة لك معاينة، فإذا منعت قلبك عن حريق الشهوات، كما تصون مرآتك عن حرارة أنفاسك، تمثل في قلبك الملكوت، حتى يصير أمر السماوات إلى العرش لك معاينة، تبصره بعيني قلبك، كأنك تنظر إليه، كما قال حارثة رضي الله عنه: يا رسول الله، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً، وإلى أهل الجنة كيف يتزاورون، وإلى أهل النار كيف يتعاوون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عرفت فالزم، عبد نوّر الله الإيمان في قلبه». [أدب النفس].
وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: “قرأتُ في بعض الكتب: إنْ سرّك أن تحيا وتبلغ علم اليقين، فاحتلْ في كل حين أن تغلب شهوات الدنيا، فإنه من يغلب شهوات الدنيا يفرق الشيطان من ظله” [أدب النفس].
وقال الفضيلُ بن عياض: “إني لأستحي من الله أن أقولَ توكلت على الله، ولو توكّلت عليه حقَّ التوكُّل، ما خفتُ ولا رَجَوْتُ غيرَه“. [العقد الفريد].
- اليقين سعادة وطمأنينة
إن أفضل ما يورث اليقين الجازم عند العبد أن يـتأمل قدرة الخالق وعظمته سبحانه، وأن يتأمل في مخلوقات الله تعالى وأولها نفسه، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} [الذاريات: ٢١].
قال أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله تعالى: “فَإِذَا تَفَكَّرَ الْعَبْدُ فِيِ ذَلِكَ اسْتَنَارَتْ لَهُ آيَاتُ الرُّبُوبِيَّةِ، وَسَطَعَتْ لَهُ أَنْوَارُ الْيَقِينِ، وَاضْمَحَلَّتْ عَنْهُ غَمَرَاتُ الشَّكِّ، وَظُلْمَةُ الرَّيْبِ“. [كتاب العظمة لأبي الشيخ].
وعَنْ سيدنا جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: “سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الآيَةَ: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ} [الطور: ٣٥: ٣٦] “قَالَ: كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ“. [رواه البخاري].
وقال الحكيم الترمذي: “فمن نوّر الله قلبَه بالإيمان قويت معرفته، واستنارت بنور اليقين، فاستقام به قلبه، واطمأنت به نفسه، وسكنت ووثقت وأيقنت، وائتمنته على نفسها، فرضيت لها به وكيلًا، وتركت التدبير عليه، فإنْ وسوس له عدو بالرزق والمعايش، لم يضطرب قلبه ولم يتحير، لأنه قد عرف ربه أنه قريب، وأنه لا يغفل ولا ينسى، وأنه رؤوف رحيم، وأنه رب غفور رحيم، وأنه عدل لا يجور، وأنه عزيز لا تمتنع منه الأشياء، وأنه يجير ولا يجار عليه“. [أدب النفس للحكيم الترمذي].
فإذا استقر اليقين في القلب أضاء بنور الإيمان، وخرج من ظلمات الشك، حتى قال سيدنا إبراهيم بن أدهم رحمه الله: “لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور والنعيم إذن لجالدونا عليه بالسيوف، وليس ذلك إلا للمؤمن العارف بالله، فإن ضعيف الإيمان لا يجد هذه الحياة الهنيّة، ولو فُصد دمه لخرج حزنًا وشقاءً، ضُربت عليه الحسرة والوحشة“ [حلية الأولياء].
- اليقين يقطع حبال الشك عند المؤمن
ما من مسلم إلا ويغلبه الشيطان بالتفكر فيما يعكر صفو إيمانه، ولكن المؤمن فطن يقطع على الشيطان حيله، والمنافق يروح ويجيء حيثما أراد شيطانه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ» [متفق عليه].
قال الإمام ابن بطال: “إن هذا السؤال: من خلق الله؟ لا ينشأ إلا عن جهل مفرط، فإن الموسوس إن قال: ما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له: هذا ينقض بعضه بعضاً؛ لأنك أثبت خالقاً، وأوجبت وجوده، ثم قلت: يخلق نفسه، فأوجبت عدمه، والجمع بين كونه موجوداً معدوماً فاسد لتناقضه؛ لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله، فيستحيل كون نفسه فعلاً له“ [فتح الباري].
قال الإمام الخطابي: “كلام متهافت ينقض آخره أوله؛ لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقاً، ثم لو كان السؤال متجهاً لاستلزم التسلسل وهو محال، وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث، فلو كان هو مفتقراً إلى محدث لكان من المحدثات” [فتح الباري].
- الإلحاد وشرائح الملحدين
إن الإلحـاد كلمة واسعة الاشتمالات، حيث تشمل أنماطًا فكرية واختياراتٍ عقليةً وفلسفيةً متعددة، وعند محاولة تصنيفها تصنيفًا منهجيًّا نجد أنها تدور حول أربعِ شرائحَ من الملحدين.
الشريحة الأولى: هم أصحـاب الإلحـاد المطلق ممن يجزمون بنفي وجود الإلـه وأي قوة غيبية أو خالق للكون، فيرون أنه لا يوجـد في هذا الوجود إلا العالم المادي (الكون من مجرات، وشموس، وثقوب سوداء، وسُدُم جبارة تُخلق فيها النجوم والمذنبات)، وهذا العالم -الذي هو الكون- هو الشـيء الوحيد الموجود في نظرهم وليس هناك قوةٌ غيبيةٌ أصلًا تدخَّلت فيه وأوجدته وتتعهده بالعناية والإمداد والإيجـاد، فهو بذلك يفصل الخلق عن الخالق تمامًا، ويرى أنه لا وجود لإله أصلًا.
ويبرر هؤلاء موقفهم بالفيزياء الكونية، فاستندوا إلى النظريات الفزيائية والتي أشهرها نظرية الانفجار العظيم.
ويعـد أشهر منظري الإلحـاد بهذا المفهـوم هـو العـالم الفيزيائي “ستيفين هوكنج“، وهو الأكثر قدرة على تحويل البحـوث الفيزيائية إلى ثقافة شائعة، وعلى الرغم من أنه بدأ حياته العلمية من فكرة وجود الإله والخالق للكون، وقد ألف في ذلك كتـابه “موجز تاريخ الزمن”: إلا أنه تحول إلى إنكار الإله.
وبِناءً عليه: فمن العيب والخطأ الفادح أن يكتفي الباحث بميدان التشريع الديني أو يقتصر على علوم الشـريعة، ولا يستطيع إيجادَ حلول مناسبة تقنع العقول وتريح القلوب.
الشريحة الثانية: هم أصحاب فكرة “الإلحاد الربوبي”، وهو الذي وصـل بعــد بحثٍ كبيـرٍ إلى وجود قوة غيبيـة أوجـدت العالم، ثم يتوقف بعد ذلك، أي: أنه يعتقدُ بوجود إله، ويعتبر ذلك بسبب احترامه لقوانين العلم أيضًا، ولكن كل المنظومة المتفرعة بعد ذلك سواء الوحي أو النبوة أو المعجزات أو التشـريعات أو العناية الإلهية التي تحيط بالكون على مدار اللحظة لا يعترف بها، فـالإيمان بفكرة الإلـه متحقق لديهم، ولكنه لا يتدخل في الكون من وجهة نظرهم، فيثبتون الإله وينفون صفات الكمال عنه، ومنهم”وليام لين كريج” صاحـب كتاب “الحجة الكونية الكلامية”، ومن هذه الشـريحة أيضًا “أنتوني فلو” الـذي ظلَّ زمنًا يقـول: لا يوجد إله، حتى إنه ألَّف كتابًا اسمه “ليس هنـاك إله”، ثم رجع هو بنفسه بعد بحثٍ ودراسة اعترف بوجود الإله في آخرِ حيـاته وأعاد طباعة الكتاب وشطب (ليس) ليصبح العنوان: “هناك إله”.
الشريحة الثالثة: هم أصحاب فكرة التوقف عند تساوي الأدلة فلا يقولون بنفي الإله ولا بإثبات وجوده، وهو مذهب “اللاأدرية”.
الشريحة الرابعة: هم أصحاب الانفجار النفسـي ممن يُعلنون غضبهم من الإله الذي لا ينكرون وجوده، وأصحاب هذا المذهب يعترضون على وجود الشـر في الكون من براكينَ وزلازلَ وأمراضٍ وغيرِ ذلك مما يفترض به أن يكون محـضَ إرادةٍ إلهية حرة، وهم الأكثرُ عددًا وانتشارًا، وهو يختلف عن الملحد الخائف في تصنيف “أليكس ماكفريلاند” الذي يدخل في منطقة النقاش العقلي.
- أكثر شرائح الإلحاد وجودًا وانتشارًا
إن هذه الشـريحةَ -شريحةَ المنفجر نفسيًّا- قد تكون هي الأكثرَ عـددًا من بين شرائح الملحدين، والأكثرَ انتشارًا، ويمكن تقديرها بنسبة ٨٠%، وهي الأقربُ اعتمادًا على معنًى عاطفي وشعوري أكثر بكثير من كونه معضلةً عقليةً، فالملحد المنفجر نفسيًّا يندرج تحته ثـلاثةُ أرباع الأصناف التي ذكرها “أليكس ماكفريلاند”.
وأزمةُ هذه الشـريحةِ -وإن كانت تعتمدُ على تناقضٍ فلسفي معين أو مشكلةٍ عقلية- إلا أنها أقلُّ اعتمادًا على الحجج العقلية، وأكثرُ اعتمادًا على المعنى الوجدانيّ والنفسيّ، فمهما بذلنا له من حجج فإننا لن نستطيع أن نلمَسَ نفسه أو عقله، خاصةً من الشباب المشغولِ والمهموم بمآسٍ عاشها أرهقتْ وجدانه، ودمَّرت اليقين عنده، وأحدثت شرْخًا عميقًا في نفسه جعله في حالة احتقان مزمنٍ مع كل شئ، صَعِدت إلى قضية الإله.
إن هذا الواقعَ يجعلُ المعاملة والمعالجة تختلف، فهذه الشـريحة قبل احتياجها إلى الحجج والبراهينِ والأدلة، والجدل العلمي والمعرفي، هـي أقربُ احتياجًـا إلى من يُوصل إليهم الشعور بالتضامن المعنوي، والشعورِ العميق بمدى فداحةِ الأزمة القاسية التي مَرّ بها، وإشعارِ الإنسان بأن هناك من يقف إلى جواره ويشاطره هـذا الحزن، ويتألم لكل ألم يصيبه، وأن هناك من يدرك كونه متألـمًا ومتوجعًا ويَئِنُّ وينفجر، وأننا ندرك شعوره بوجود احتمالاتٍ مروعة وصلت به إلى أن صار غاضبًا من الإله.
إن شعور هذه الشـريحةِ أن هناك من يتفهَّمُها ويشعر بها ويدرك ما تشعر به: يَمَسُّ وجدانها بشكل كبيرٍ جدًّا، ولا ينفي هذا وجودَ غطاء وشِقٍّ فِكريٍّ ومعرفيٍّ، لكن هذا الباب هو المدخل الأكبر، فمهما جادلنا وأقنعنا بالحجج من غير إزالة هذا الحمل القاسي عن قلبه فلن ننجح معه.
- أسباب وجود الإلحاد تاريخيًّا وحديثًا
إن هذه الشـرائح الأربع موجودةٌ في المجتمع المصـري من بعض الأشخاص الذين ضاقوا ذرعًا بالتخلف الحضاري للأمة العربية، وكان نتيجةً لانبهارهم بالمجتمعات الغربية.
والملاحظ أن القضيةَ لدى الملحدِ من الشـرائح الثلاثِ الأُول صاحبِ الموقف الفلسفي المعرفي: قضية “علم ومعرفة”، وإننا نُكِنُّ لكل صاحبِ فكرٍ كلَّ التقديرِ والاحترام، وقبحُ الخطاب الصادر عن التيارات السلفية والإخوانية وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة يسوق كثيرًا من الشباب إلى الإلحـاد، نتيجةً لقلَّة معرفتهم بالدين والواقع.
ومـن المؤكَّـد أن الموقـفَ السلفيَّ يتمثل في المعاداة التامة لعلوم الكلام والمنطق والفلسفة وغيرها من العلوم العقلية ونَبْذِها بالكلية، وفاتهم أنها علومٌ إسلامية أصيلةٌ ضروريـة لبناء العقل وفَهْمِ الفلسفات المخالفة والردِّ عليها، ونَتَج عن هذه التيارات فجوةٌ هائلةٌ بين الشـريعة والعلوم الطبيعية، مما أدى إلى الإخلال بِفَهْم الشـريعة ومناصبةِ العداء للعلوم الخادمة لها.
ومن هنا يتضح أن التياراتِ المتشددةَ لم تكتفِ بإراقة الدماء، بل دمَّرتِ المنهجية العلمية والمعرفيةَ بنفس المنزلة، ولا يزدادُ أتباعُهم إلا جهلًا بالدين.
إن أيَّ إنسان حتى ولو لم يُصَب بأزمة، وجلس وراء مكتبه أو على شاطىء النيل، أو في خضـرة حديقته، وبدأ يَرْصُد المشهد، ووجد كتاباتٍ تنظّر الإلحاد فتولَّدت عنده أسئلةٌ وجودية عميقة تُلْقِي به في واحد من هذه الشرائح الأربعة، من حقه المحاورة والنقاش بلا قيود.
ويمكننا أن نقول لهذا الإنسان ولكل من يقدم أُطْرُوحة فكرية نفسية أو عقلية أو معرفية أو غيرها: ليس هناك أدنى حَجْرٍ على حقك في أن تسأل، وتفكر، وترفض، وتطرحَ الأُطروحـة، وإذا لم تنجحِ الهيئةُ العلمية بـالمؤسسات الدينية في تقديم أجوبة علمية مُقْنِعَةٍ بُرهَانية جدليةٍ مبنيةٍ على أصول وأسسٍ عقلية راجحة وبَيِّنَةٍ، والاشتباكِ عـلى هذا المستوى المعرفي والفلسفي والفكري والوجداني مع أطروحـة الإلحاد: فالتقصير عند المؤسسة أنها لم تنجح في توليد جدل علمي رفيع، وليس عندك في أنك سألت.
وفي هذا الحين نؤصل لفكر الإلحاد وتـداعياته وما أنتجه من ثمار مُرَّة في المجتمعات المتنوعة، حيث بـدأ الإلحاد يتصاعد في بداية الألفية الثانية، وبدأ ينفجر بصورة واضحة عام ٢٠١١م.
وتاريخيًّا أقدم من تحدَّث عن ظاهرة الإلحاد والإيمان عند اليونانيين القدمـاء هو أفلاطون، الذي قسم الملحدين إلى ثلاثة أنواع: من ينكرون وجود الآلهة من الأساس (مثل ثيودويس الإلهي)، ومن ينكرون عناية الآلهة بـالبشـر (مثل إبيقور)، ومن يعتقدون أنه يمكن استمالة الآلهة بالقرابين والنذور.
- الأصول الفلسلفية التي يرجع إليها الإلحاد
إن هذا يمكن إدراجُه ومرجعيته إلى أصول فلسفية ثلاثة:
الأول (Cosmology) أي علم الكون أو الفيزياء الكونية التي ترى القانون الفيزيائي موجدًا للكون، والتي تولـد عنها عدة شبهات حول وجود الله جل جلاله.
الثاني (Biology) أي علم الأحياء والدارونية الحديثة.
الثالث (Neuroscience) أي علم الأعصاب أو فلسفة الوعي والذكاء والإدراك.
ومن هذا المنطلق نجد أن الشباب الملحد في السنوات العشـر الأخيرة له سمات نفسية مستحدثة؛ أهمها: الافتخار، والانتشار، والاستفزاز؛ وقد ساعد على ذلك قبح الخطاب الصادر من تيارات التطرف التي صدَّرت خطابًا صريحًا صارخًا دمويًّا أدى إلى ردة فعل عنيفة أفرزت النفور لدى بعض الشـرائح من قضية الدين بـالكُلّية، وفي المقابل: الأميَّة الدينية عند البعض التي جعلت الأولياتِ من شئون الإسلام وعقائـده مجهولةً أو غائبةً، وكذا المنظور من التخلف الحضاري الذي جعل بعض الشباب ينبهر بحضارة أخرى، ولم يجدوا منا إسهامًا حضاريًّا يعزز قضية الإيمان، وساعد على ذلك عالم “السوشيال ميديا” المفتوح، الذي هو منبر لنشر العـلم والهداية، لكن يمكن أن يكون مصـدرًا للخـطر أيضًا.
وهنا يستلزم الأمرُ تقديمَ خطـاب يناسب شرائـح الملحدين وأهمية دراسة المدخل النفسـي للإلحـاد، فالموجة المعاصرة من الإلحاد الحديث هي أشدُّها خطرًا لوجودها في زمن “السوشيال ميديا” الواسعـة الانتشار، وأعطت دفعًا كبيرًا في اتجاه النفور من الدين، حتى قال الواهمون: “أنا لا أنكر وجود الله لكنني غاضبٌ من الله لكثرة ما رأيت من الشـر في الكون”، حتى صار إلى معضلة وجود الشـر في الكون التي عاشتها أوروبا في القرنِ الثامنَ عشـر، والتي ولَّدت موجة النزعة التشاؤمية التي ترى أن كله شر عند “فولتير” والنزعة التفاؤلية، والنزعة الشكية عند غيره.
وهناك مقولة شهيرة للكاتب الفرنسـي الشهير “فولتير” الذي قدم نصيحـة إلى الملحدين فقال: “لو لم يكن الله موجودًا لكان عليكم إيجاده؛ لأن العالم غيرُ قـابلٍ لأن يساس لو لم يكن هناك إلهٌ يعاقب الأشرار في العالم الآخر بعد الموت”.
والملاحظ أن القضايا المثارةَ والتي نتناقش فيها مع الفكر المناوئ، لا نتبنَّى فيها موقفًا شخصيًّا؛ بـل ننتهج مع أفكارهم منهجًا علميًّا معتبرًا؛ فنسق القرآن الكريم والهدي النبوي الشـريف يعلَّمنا نـكرانَ الذات والتجرد، وهذا الكلام ليس محاكمة للأشخاص، فالأشخاص يحاسبهم رب العالمين، وقد أفضَو إلى ما قدموا؛ لأن الذي بقي بين أيدينا هي الأفكارُ والمناهج التي أسسوا عليها مذهبهم؛ إذ إننا لسنا أسرى للماضي، بل دَورُنا أن نتطلع إلى حماية الحاضر، وصناعـة المستقبل، واعتبار ذلك هو الشغلَ الشاغلَ الذي نوليه الاهتمام، ومن أجل ذلك ننافحُ وندافع لنوضح المنهج العلمي الوسطي المعتبر.
- التسلح بالعلم هو الملاذُ الآمن للخروج من دائرة الفكر اللاديني
إن الملاذ الآمن نحو الخروج من بُوتَقة الفكر اللاديني هو التسلحُ بالعلم؛ لأنه السبيل الأكيد لمواجهة الإلحاد، وتشكيلُ فريقِ عمل من علماء الشـريعة والفيزياء؛ لدراسة الإلحاد، وأهمية وجود منصات على السوشيال ميديا؛ ولأنه الميدان الحقيقي للمواجهة، ولبيان ما يثمره الدين من حضارة وابتكار واختراع.
والمؤمَّل أن يكون لـدى عالمِ الدين تكوينٌ فكري مختلف يعتمد على النقد والتفكير والاستماعِ إلى ما يقوله الناس، كما ينبغي أن يكون منفتحًا على العصـر والاكتشافات الحديثة، وذا عقلية منهجية؛ لأن الملحد ينتظر ردًّا منطقيًّا مُقنعًا يجيب عن أفكاره وتساؤلاته، وليس الدخولَ معه في صراع.
وهناك نقطة فـارقة في التعامل مع ملف الإلحاد المعاصر، وهي: أن الإصرار على مناقشة إلحاد اليوم بطرق التعامل مع إلحاد السبعينيات والثلاثينيات سيؤدي إلى الفشل، ولن يجد أبناء هذا الجيل ما يستحق أن يسمعه؛ لأنـه غير مشتبك مع إشكالياته الحقيقية التي ألحد بسببها.
وهنا لنا إشارتان:
الأولى: أن المـلحد له كـامل الحـق في طرح كل ما يجول في ذهنه من أسئلةٍ في مختلف المسائل مهما كانت حدتها، وإذا لم تُقدم إجابة علمية منطقية قابلة للتصديق ومقنعة للعقل، فليس الخطأ عنده أنه سأل، وإنما الخطأ عند المؤسسة الدينية أنها لم تنجح في توليد واستخراج إجابة قابلة للتصديق منطقيًّا تَثْبُت بالدليل والبرهان.
الثانية: أن الملحدين أطياف، لكل طائفة مـدخل وطريق في الأسلوب والخطاب، ومراعاة ذلك من العالم يظهر احترامًا للمدخل للنقاش العلمي الذي يستأنس هو به، فقد يكون الملحد عنده شكوك مبنية على أصولٍ معرفية وعلمية، كبحث فلسفي، أو بحث فيزيائي، أو غير ذلك، فيكون خطابه خطابًا علميًّا شرعيًّا حافًلا بالدليل متسع الصدر قابًلا للبرهنة.
وقد يكون الملحد منفجرًا نفسيًّا، وهذا لا يأبه بالحجج، ولكن إن أراد هو أن يقدم انفجاره في صورة سؤال، فيجب أن نخاطبه بخطاب هادئ ومنهج علمي محفوفٍ بإطار أخلاقي وإنساني.
- المنهج السلوكي في التعامل مع الملحدين
لا يرتكز التعامل مع الملحد والاشتباك معه على المحور العلمي والمعلوماتي فحسب، بل لابد وأن يحاط بمنهجية التعامل بالحسنى، والواضحة في قوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت: ٤٦] ، فقرن الله تعالى بين المسلك الجدلي المرتكز على المنهج العلمي وبين المسلك الأخلاقي في التعامل مع أهل الكتاب، وهذا المنطق ليس خاصًّا بأهل الكتاب فحسب، بل ذكرهم تعالى كنموذج؛ لأنهم الأقرب، فهم يعترفون معنا بقضية الألوهية وقضية النبوة، ثم يحدث خلاف داخلي بيننا وبينهم بعد ذلك، فالأَوْلى بالمعاملة المترفقة من هو أبعد شُقَّة ممن أهدر قضية الألوهية بالكلية، فالجدل بالتي هي أحسن هو القانون الحاكم مع الجميع، فإن المؤمن المعظم لشعائر الله يحب الخير للجميع، ويتمنى لكل إنسان أن يلهمه الله الإيمان به، وليس بينه وبين أي إنسان عداء شخصي، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه.
إضافة إلى ذلك: أن المؤمن من رُقِيِّه أن يدعو لغير المسلم، فإن الدعاء لغير المسلم من الشريعة، ومن آداب التعامل معه، وهذا له مستند قوي من الأدلة شرعية، منها: أن الإمام البخاري (رحمه الله) عنون بالدعاء لغير المسلم، وأن الجناب النبوي العظيم كان يدعو لغير المسلمين أن يوفقهم الله وأن يهديهم، أما ما يقوم به البعض من تحجير التعامل مع غير المسلم، فالأولى به أن يعود إلى المنهج النبوي الشريف، حيث كان صلى الله عليه وسلم في أشد أوقات الأذى يأبى أن يُنزِل بعدوه ما يسوؤه.
فالمؤمن الراقي يرى أن التعامل المسيء والمتغطرس مع الملحد غير مقبول، وأن احترام الإنسان والتعامل معه بالتقدير جاذب للقلب؛ لما فيه من الأدب والإنصاف، وفتح باب للحوار والقبول، وأن هذا الموقف مع كل مختلف، وأن المنطق الفكري المختلَّ الذي حمل السلاح وأراق الدماء واعتدى وروع الآمنين لا بد من التعامل معه بشدة، إذ إنه لو كان صاحب رؤية فكرية لفتح باب الحوار، وتعامل مع الجميع بميزان واحد.
وكما نؤكد: إن قضيتنا مع الأفكار لا مع الأشخاص سواء مع الإرهابي أو مع الملحد، فخطورة الفكرة تجعلنا نتصدى لها بقوة، والصراع الفكري لا بد أن يعلوَ فيه صوتُ الدليل والبرهان وصوت العلم والمعرفة، وألا تأبى النفوسُ الحقَّ متى تبين.
وبالمتابعة نجد أن المنحى السلفيَّ أزَّم القضية ولا يزيد الإشكال إلا تَفَاقُمًا، فتَعَامل مع الملحد بمنطق السب والتهكم والتنكر له بدلًا من مناقشته، وهذا يُعقّد الأمر ويُفاقم الأزمة، فهناك إشكالاتٌ لا بد من الاشتباك معها، وتقديم أجوبة علمية سديدة، ومحكَمة ودقيقة ومقنعة، إذا لم تقدمها فلا علاقة لك بأي إنسان أيا ما كان اختياره.
إن الحديث الشريف الذي وقف فيه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي وخلفه راعٍ للإبل؛ يظل طوال نهاره يرعى الإبل في الصحراء، ثم يعود بعد غروب الشمس مُنْهَكًا يريد الصلاة، لينام ثم يبدأ يومه من جديد، ففوجيء بسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه مُنطَلِقًا يستفتح بسورة البقرة في الصلاة، مُستَأنِسًا ومُسْتَمتِعًا بالقرآن، وليس بغاضب ولا متجهمٍ على أحد، ولكنه غَفَل عن احتياج الذي يصلي خلفه ويسمعه، فَقَصَّر الرجلُ الصلاةَ وفارق سيدنا معاذ بن جبل (رضي الله عنه)، فقال سيدنا معاذ بن جبل: “نافق الرجل”، فَعَزَّ ذلك على نفس الرجل الذي يُعَظِّم اللهَ ورسولَه، ويعبد الله، ويريد أن يصلي بمقدار الإجزاء والكفاية أن يكون نافق بذلك، فخرج مُسْرِعا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعبِّرًا عن تألمه لتهجم سيدنا معاذ على تدينه واتهامه بالنفاق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذًا ولم يُرَ صلى الله عليه وسلم غاضبًا قطُّ كهذا اليوم، وهو يقول لمعاذ ” أفتَّان أنت يا معاذ” ثم يقول له ” أين أنت من “والشمس وضحاها”، ومن “والليل إذا يغشى”.
إن الشاهد من الكلام أن الأمر ليس مقتصرًا على الإنسان الغاضب، والمتجهم، والتكفيري، والمنفعل، والمتسلط على الناس الذي يُهدِر حُرْمَة القرآن الكريم في هذه المشاعر الغاضبة السلبية النارية فقط، فسيدنا معاذ رضي الله عنه صحابي جليل يتعبد ويُصلي، ويحب الله ورسوله، بل يقول له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له: «يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ» [رواه أبو داود].
فكأن هذا الموقف العابر لفت النظر إلى أن: القرآن الكريم نزل رحمةً فلا تُحَوِّلُوا نظرة الناس بانفعالاتكم النفسية، أو باستئثاركم لأنفسكم، ولا تجعلوا تعاملكم مع القرآن وعرضكم له يشكل حجابًا يحجب الناس عنه، فيصبح القرآن لا يُرَى إلا من وراء حُجُب نفسياتكم المحتقنة المتسلطة الغاضبة، فيُلصَق هذا الاتهام بالقرآن نفسه.
إن الله تعالى عندما قال: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت: ٤٦] لم يكن النهي متعلقًا بمجادلة أهل الكتاب فحسب، بل شمل كلَّ مختلَفٍ معه، فقد أمر رب العالمين سيدنا موسى وأخاه هارون ( عليهما السلام) أن يخاطب فرعون -مُدَّعي الألوهية-، فقال: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: ٤٤]، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام الأكرم والأعظم جودًا ووفاءً وسخاوةً في كل شيء، فكانت تَفِدُ المرأة وهي ليست على الإسلام فيكرمها ويقول: «خَلُّوا عَنْهَا، فَإِنَّ أَبَاهَا كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وَاللهُ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» [رواه البيهقي]، وفي صُلح الحديبية نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رغبة وفد قريش، وقبل شروطهم المجحفة فكان عاقبته النصر والتوفيق، وقد أنزل رب العزة جل وعلا في صلـح الحـديبية قـوله تعالى: {إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحًا مُّبِينًا} [الفتح: ١]
إن هذا الأدب النبوي والفهم الواضح للنص الشرعي مُرِيحٌ للنفس، ويحفظ حرمة الحق والغيرة عليه، ويحفظ حق الجدل العلمي والمعرفي، ويكفي الشاهدُ في قوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [لقمان: ١٥] فهناك طرف يبذل كلَّ وسعه لصد الطرف الآخر عن دينه وإقناعه بالكفر، فكان التوجيه بالتعامل معه من خلال موقف عملي يظهر في قوله تعالى {فَلَا تُطِعْهُمَا}، وموقف إنساني قال الله تعالى فيه: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}، ومقتضى هذا الموقفِ أن يصاحب الإنسان والديه في الدنيا معروفًا، وفي نفس الوقت لا يكفي إحسان التعامل بل لا بد من التوازن لرسم معالم المنهج.
وعلى هذا المنهج الراقي -الذي دلنا إليه الشـرع الحنيـف- سـار علماؤنا الثقات.
ومن أخلاقيات العلماء في التعامل مع المخالف “الأمانة في طرح الآراء ووجهات النظر“، فمنهج علماء الإسلام أُسِّس على الأمانة في حكايـة مقـولة الخصـم الفكـري، والصـبر على قـراءة نظـريته وتلخيصها واستخـراج مقولاتها الكلـية، والأفكـار الكـبرى، ومفاتيح النظرية، بحيث تُعْتَصَر في مقولات محددة، ويطمئن على الدقة في حكاية ما يقوله الخصم، كما في كتاب:“مقالات الإسلاميين للأشعري“، و“مقالات الملاحدة للأشعري” أيضًا، و“تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي“، و“الملل والنحل” للإمام الشهرستاني.
إذن -وكما ذكر العلماء- فلابد من تفنيد المسائل من بعد: فهذا الإنسان الإرهابي خارجي قاتل، ضال، متسلط، داعشي، شخص رَوَّعَ الخلق، وارتكب أسوء الموبقات، وفي وسط هذا الضلال وهذه الموبقات، لا يزال يقرأ القرآن الكريم يوميًّا، بل ويُحْدِثُ له -أحيانًا- تبصرة، فينظر لأمر مُعيّن فيرى نهاية هذا الأمر ومآلاته، فجعلت تلاوة القرآن له حالةً نورانية، وهذا النور قد يتزايد ويدخل إلى القلب فيتحول، ويكون إنسانًا رحيمًا يعامل الناس بالرحمة واللطف والحكمة، وقد ينير له القرآن الطريق، فيرى زاوية من الزوايا، إلا أنه يَحجُبُ نفسه عنها، ويظل محجوبًا بظلمات التكفير والقتل، فهذا الكلام يساعدنا في فَهْم حال من اندهش وتَتَبَّع كلام هؤلاء لكلمة صادقة رآها من أحدهم -من الدواعش مثلًا- ظَانًّا أنه ما دام قال كلمة وصدقت، فكل ما عنده حق، فيُغوى به ويتبعه، أو يرى إنسانٌ آخر ما عليه هذا الشخص من الإرهاب والضلال، فتسقط من قلبه حرمةُ القرآن العظيم، فلا بد من تفنيد هذه الأشياء المعروضة بإيجاز شديد.
وفي المقابل: نجد أن العقل العلمي الذي تشبع بالجمال والحكمة يقدم نموذجَ الجمال الجاذب للنفوس الذي يجعل قضية الدين تبدو للناس متوازنة، وفي منتهى العقلانية والروحانيـة، والإنسانية والأمان، والعجيب أن هذا القانون أشار إليه المولى -سبحـانه وتعالى- إشارة في منتهى العجب في قوله سبحانه: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين} [آل عمران: ١٥٩]
إن قـوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} تؤكد على أن سمات الدين: لين ورحمة، وقولـه تعالى: {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ} توصيف للخطاب المتطرف في كلمتي الغلظة والفظاظة، فهناك نمط أصيل من التدين شعاره الرحمة واللين، وهناك نمط عـدواني من التدين شعاره الغلظة والفظاظة فينبني على الغلظة والفظاظة، {لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} ينصـرفون عن التدين، وينفرون منه.
فكل نمط تدين موصوف بالغلظة والفظاظة يؤدي إلى الإلحاد الذي عبر الله عنه بقـوله تعالى: {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ}، وكل نمط تدين موصوف باللين والرحمة تجـد القرآن يسكت عن النتيجة، ولكن يُفهَم أنه جاذب للقلوب، هاد للأرواح.
ولابد أن ندرك أن ثَمَّ انفكـاكًا بين الغِلْظـة والفظاظـة والـشـدة والقسوة، وبين الصدق والانتماء الحقيقي والغَيْرة، فمهما كانت الغَيْرة وصدقُ الانتماء والحماس للأمر يجبُ ألا يجور على مقدار الرحمة، بل يكون مغلَّفًا بـالرحمة، نابعًا من عين الرحمة، لا يزعج ما في نفوس الناس من ظمأ إلى الرحمة، مثل: شدة الأب على الابن المغلفة بحنان الأبوة، التي تجعل الولد يدرك أنها ليست كراهيةً مهما احتدَّ الأمر، وليست انتقاصًا أو عدوانًا عليه، فهي شدة نابعةٌ من عين الرحمة، يقول الشاعر:
قسا ليزدجروا ومن يك حازمًا * فليقسُ أحيانًا على من يرحم
فهذه الشدة مغموسة في عين الرحمة، فتجعل الإنسان حتى لو احتدَّ، فاحتدادُه يكون رحيمًا، فلا يكسـر ولا يقتل ولا يؤذي، فهذه تسمى غَيرةً محمودة، أما الثاني فيقتل ويستخف به ويستهزئ به، فهذا يؤدي إلى الإلحاد، وشتانَ بين هـذا وذاك.
- خلاصة مركزة حول أسباب الإلحاد وكيفية المواجهة والعلاج
أولًا: من رحم التطرف والإرهاب يـولد الإلحـاد، فالفكر المتطرف -فضلًا عن الإرهاب- لا يعالج قضية الإلحاد، بل يؤزمها ويفاقمها.
ثـانيًا: تظهر أزمة الإلحاد عند البعض عند فقدان المقدرة على تقديم الإجابات العلمية والمنطقية على الأسئلة الفلسفية أو التجريبية التي تؤرق عقولهم، وتؤلب مضاجع أفكارهم.
ثـالثًا: على الباحثين أن يحيطوا علما بـأنواع وشرائح الملحدين، وبالآلية الحواريـة والمنهجية العلمية المناسبة لكل نمط من أنماط الملحدين، حتى ينتج الحوارُ الراشد أثرًا صالحًا.
رابعًا: لابد وأن يكون حديثنا مع الملحـدين متضمنًا معنىً مهمًّا وأصيلًا في الشـرع الحنيف، وهو: أن الله ما خلقنا ليشقينا، وإنما خلقنا لنحيا حياة كريمة هانئة مطمئنة {فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً} [النحل: ٩٧]، وأرسل لنا رسولًا هـاديًا ورؤوفًا ورحيمًا بالإنسانية، ومتى بدا للإنسان غير هذا، فليتأكد أن فهمًا خاطـئًا اقتحم المنظومة، إما في طرح مراد الله، أو في فهم هذا الطرح.
خامسًا: العقلية المسلمة المستنيرة: عقلية موسوعية ذات مكون معرفي متكامل، تنهل من كافة العلوم (من العلوم الدينية، وثقافات اللغة، وعلوم الطبيعة، والمعقول) بـقدر ما يفيد، ومع المكون المعرفي، تمتلك مكونًا إدراكيًّا يتمثل في فهم الواقع بعوالمه، ومتطلباته من الأدوات المعرفية المناسبة، مع مكون ثالث يُمَكِّنُه من حسن تطبيق النص وتنزيله على الواقع بكيفية تتناسب مع الفهم المستقيم لمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
سادسًا: لابد وأن ندرك أثناء معالجة قضية الإلحاد أننا نخاطب العالم أجمع، وأننا نقدم الحلول ومعـالجاتِ القضايا لأكثر من ثمانية مليارات إنسان على مستوى العالم، لهم ثقافات وعادات وأديان ومذاهب مختلفة ومتنوعة، وأننا -كـدعاة- رحمة للناس لا كدرٌ ولا لعنة.
سابعًا: على الأسرة أن تقدم نموذجًا تربويًّا وعلميًّا وسلوكيًّا يقي النشء من الإلحاد ومقدماته منذ صغرهم، وأن تقدم العقلية الدينية المستنيرة، وكذا الأسرة الواعية الإجابات العلمية المنطقية على كل ما يجول بعقل النشأ من تساؤلات.
كما نوصي السادة العلماء والباحثين من الأصدقاء والأبناء الأعزاء أن يكثروا من الاطلاع على تجارب الآخرين، سواء من ألحد ثم عاد، أو ألحد وبقي على إلحاده، وأساب إلحادهم، ورصد كل جديد في هذه الجزئية الخطيرة، ليتسنى لنا إدراك الواقع جيدًا وما يتطلبه من جهود لنكون على قدرها، وهي خطوة على الطريق، لعلها تكون بداية لبذرة صالحة نحو طريق الله تعالى.
- كلمة للأسرة الواعية
تقع على الأسرة مسئولية كبيرةٌ لتحصين النشء المسلم من ظاهرة الفكر الإلحادي، فلابد من سعة صدر الآباء والأمهات، وحسن توجيههم للأطفال، خاصة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والألعاب الإلكترونية التي تغـرس في الأطفال قدرًا كبيرًا من العنف من خلال نفي القيم والمبادئ السمحة بطريقة غير مباشرة، فهذه الألعاب تشكل جذورًا لفكرة التطرف والإرهاب والإلحاد، فلا بد من وجود الوعي الديني لدى أرباب الأسرة وتوجيه أطفالهم إلى العلم واتباع العلماء والمؤسسات الدينية الموثوقة المتمثلة في الأزهر والإفتاء.
إن الطفل له الحق أن يسأل عن كل ما يشغل فكره، وأن يجد إجابةً من والده أو من أهل العلم؛ لأنها مسئولية الجميع، فلا بد من وجود مِنَصّات آمنةٍ تقدم الوعيَ والدعمَ الفكريَّ والمعرفي لجميع المواطنين، بحيث تتمُّ الإجابة عن جميع المسائل والاستفساراتِ بكل منطقية.
وأخيرا: إن اليقين هو زادنا في هذه الحياة، وهو نور يضيء لنا دروب الظلمات في زمن كثرت فيه الشبهات وتلاطمت فيه أمواج الفتن، ولا نملك إلا أن نتمسك بيقيننا بالله، وأن نثبت على الحق الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم.
- الخطبة الثانية: تنظيم الأسرة والتنمية البشرية
أما بعد:
فلما كان الحديث عن اليقين والتربية الإيمانية لشبابنا وأولادنا، وأنه يجب علينا أن نوثق علاقتنا جميعًا بالله جل جلاله، حتى لا يشرد أولادنا إفراطًا ولا تفريطًا، كان من حُسْنِ الطالع أن يكون يوم الجمعة ٢٦ من سبتمبر اليوم العالمي لتنظيم الأسرة.
وقد رغَّب الإسلام في الأولاد والذرية، ونصوص الشرع في ذلك كثيرة، ولكن لا بد من مراعاة مقتضى الحال، ففي الوقت الذي دعا إلى الذرية أوجب على الوالدين حسن التعاهد بالتربية والتعليم، فقال تعالى: {قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: ٦].
ورتب على عدم التعاهد الجزاء الأخروي الشديد، فقال صلى الله عليه وسلم: «كفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». [رواه أحمد وغيره].
أي: يكفي العبد ذنبًا يوم القيامة أن يكون سببًا لدخوله النار: أن يضيع أولاده ولا يعلمهم ولا يربيهم.
وجاء في الحديث من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «افْتَحُوا عَلَى صِبْيَانِكُمْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». [رواه البيهقي في الشعب].
وكان سيدنا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ» [سنن ابن ماجه].
وعن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه قال: “حافظوا على أولادكم في الصلاة، وعلموهم الخير؛ فإنما الخير عادة“ [معرفة السنن والآثار].
ومما لا شك فيه أننا إذا أردنا مجتمعًا راقيًا، وأمة قوية، وتدينًا حقيقيًّا، وشبابًا يحملون الرسالة، وتنمية في المجتمع، فلا بد من القيام بالواجب تجاههم، وتؤكد نصوص الشريعة أن الذي يكثر من الأولاد مدعيًا التواكل دون الأخذ بالأسباب الشرعية دون أن يؤدبهم أو أن يعلمهم، أو أن ينشئهم تنشئة صالحة أنه مخالف للهدي النبوي الشريف، فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والعيلة. [رواه الطبراني]. أي: الفقر مع كثرة الأولاد، ولما دعا صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس رضي الله عنه قال: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ». [صحيح البخاري].
فلك أن تدرك أنه لما دعا بالذرية قرن ذلك بالمال والبركة، قال العلماء: “لِأَنَّ كَثْرَةَ الْأَوْلَادِ عِنْدَ قِلَّةِ الْمَالِ تُؤَدِّي إِلَى الْمَعَاصِي وَتَرْكِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ” [حاشية السندي على سنن ابن ماجه].
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ» [مصنف عبد الرزاق وفيه انقطاع] وقد فهم بعض الناس أن المراد بالولود التي تلد كثيرًا، وهو غير صحيح، كما نقل المُناوي عن الحافظ أبي زرعة العراقي أنه قال: “الحق أنه ليس المراد بالولود كثرة الأولاد؛ بل من هي مظنة الولادة“. [طرح التثريب].
وقد ذم الله تعالى الكثرة مع فساد الدين والخلق في آيات كثيرة منها قوله تعالى: {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} [الحاقة: ٨]. قال الإمام الماتريدي: “فأخبر تعالى أن كثرة الأولاد لا تغني من اللَّه شيئًا؛ إذ قد كانت لهم أهالٍ وأولاد فأهلكوا عن آخرهم، وانقطع التناسل منهم؛ ليعلموا أنه يبقى ذكر لمن أطاع اللَّه تعالى ورسوله، كان ثَمَّ أولاد، أو لم يكن“. [تفسير الماتريدي].
وذم الكثرة في حنين فقال تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ} [التوبة: ٢٥].
وفي الحديث الصحيح عَنْ سيدنا ثَوْبانَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم-: «يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَداعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَداعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِها». فَقالَ قائِلٌ: أوَ مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ المَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الوَهَنَ. فَقالَ قائِلٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ وَما الوَهَنُ؟ قالَ: حُبُّ الدُّنْيا وَكَراهِيَةُ المَوْتِ».
وقد قال دعبل الخزاعي معبرًا عن هذا المعنى:
ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم* الله يعلم أني لم أقل فندا
إني لأفتح عيني حين أفتحها* على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدا
فلا يريد الإسلام كثرة الأولاد مع التدني في الدين والخلق، ولكنه يريد أولادًا يعرفون حق الله وحقوق الخلق، يراعون حق الدين وحق الوطن، وتلك الذرية هي محل الشفاعة لكم في الآخرة بين يدي الله تعالى، فنسأل الله تعالى ان يحفظ أولادنا بحفظه، وأن يحوطهم بعنايته، وأن يتولاهم برعايته، وأن يجعل خير البلاد والعباد على أيديهم، وأن يحفظ بهم الأوطان ويصون بهم الأعراض، إنه على كل شيء قدير.
اللهم أصلح بيوتنا، واجعلها بيوت إيمان وسكينة ورحمة، يا رب العالمين. وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
مراجع للاستزادة:
– الحق المبين في مناقشة فكر الملحدين، د. أسامة الأزهري.
_____________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
وللإطلاع علي قسم خطبة الجمعة
وللإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف