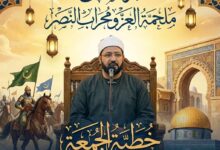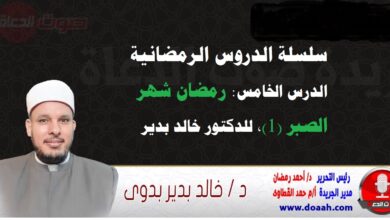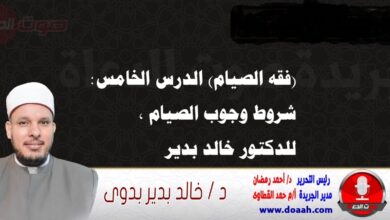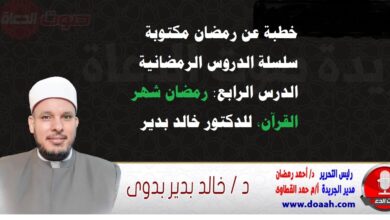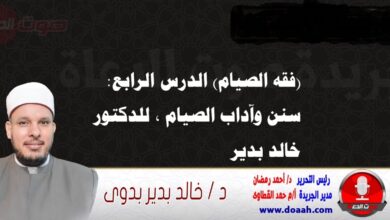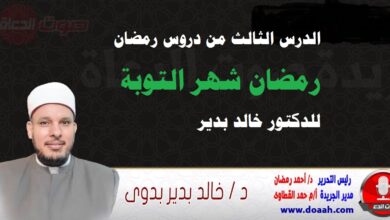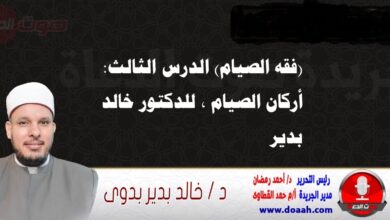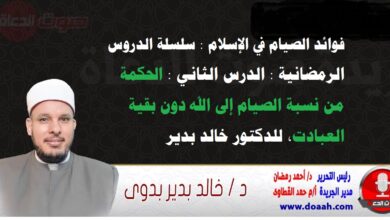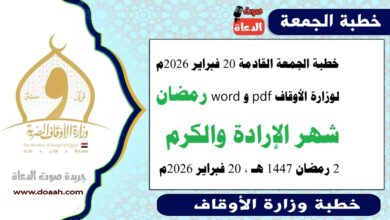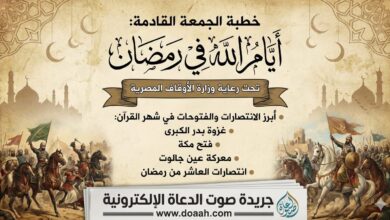خطبة الجمعة للدكتور أحمد رمضان : ميزانُ الشَّرِيعةِ فِي النَّوايَا: لَا تَفتيشَ ولَا اتِّهام (هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟)
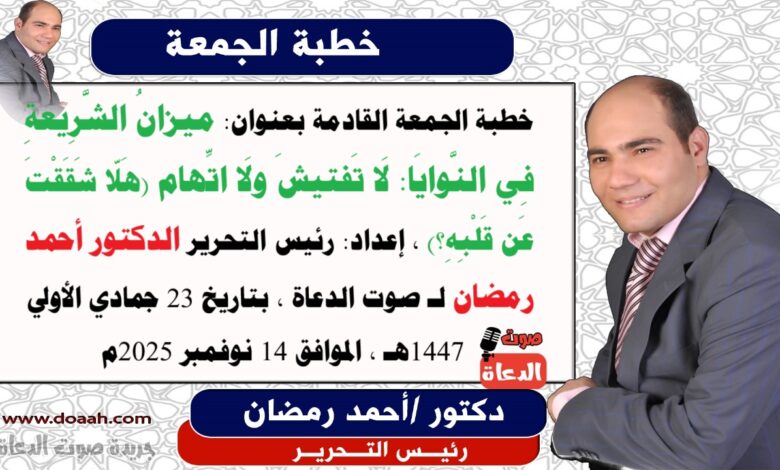
خطبة الجمعة القادمة بعنوان : ميزانُ الشَّرِيعةِ فِي النَّوايَا: لَا تَفتيشَ ولَا اتِّهام (هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟) ، إعداد: رئيس التحرير الدكتور أحمد رمضان لـ صوت الدعاة ، بتاريخ 23 جمادي الأولي 1447هـ ، الموافق 14 نوفمبر 2025م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 14 نوفمبر 2025م بصيغة word بعنوان : ميزانُ الشَّرِيعةِ فِي النَّوايَا: لَا تَفتيشَ ولَا اتِّهام (هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟) ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان لـ صوت الدعاة.
انفراد لتحميل خطبة الجمعة القادمة 14 نوفمبر 2025م بصيغة pdf بعنوان :ميزانُ الشَّرِيعةِ فِي النَّوايَا: لَا تَفتيشَ ولَا اتِّهام (هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟) ، للدكتور أحمد رمضان.
ولقراءة الخطبة الأولي عن هلا شققت عن قلبه من هنا
ولقراءة الخطبة الثانية عن خطورة الرشوة من هنا
عناصر خطبة الجمعة القادمة 14 نوفمبر 2025م بعنوان : ميزانُ الشَّرِيعةِ فِي النَّوايَا: لَا تَفتيشَ ولَا اتِّهام (هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟)، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان.
العُنْصُرُ الأَوَّلُ: مَعْنَى «هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ» وَدَلَالَتُهُ الكُبْرَى
العُنْصُرُ الثَّانِي: حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ
العُنْصُرُ الثَّالِثُ: الدِّينُ المُعَامَلَةُ… وَمَبْدَأ التَّعَامُلِ بِالحُسْنَى
العُنْصُرُ الرَّابِعُ: هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ… مِعْيَارُ الرَّحْمَةِ وَفِقْهُ التَّبَيُّنِ
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 14 نوفمبر 2025م : ميزانُ الشَّرِيعةِ فِي النَّوايَا: لَا تَفتيشَ ولَا اتِّهام (هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟) ، إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان : كما يلي:
ميزانُ الشَّرِيعةِ فِي النَّوايَا: لَا تَفتيشَ ولَا اتِّهام
(هَلّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟)
23 جمادي الأولي 1447هـ – 14 نوفمبر 2025م
إعداد: رئيس التحرير د. أحمد رمضان
المـــوضــــــــــوع
الحمدُ للهِ الَّذي خَلَقَ فَهَدَى، ووهبَ العقلَ لِيُدرِكَ، وأنزلَ الشريعةَ لِتَكونَ رحمةً للناسِ وعدلًا وقِسطًا بينهم، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، جعلَ حقوقَ العبادِ حرماتٍ مصونةً لا تُستباحُ بظنٍّ ولا شُبهة، وأشهدُ أن سيدَنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبِهِ، ومَنِ اهتدى بهديهِ إلى يومِ الدين. أمّا بعدُ،
عناصر الخطبة:
العُنْصُرُ الأَوَّلُ: مَعْنَى «هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ» وَدَلَالَتُهُ الكُبْرَى
العُنْصُرُ الثَّانِي: حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ
العُنْصُرُ الثَّالِثُ: الدِّينُ المُعَامَلَةُ… وَمَبْدَأ التَّعَامُلِ بِالحُسْنَى
العُنْصُرُ الرَّابِعُ: هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ… مِعْيَارُ الرَّحْمَةِ وَفِقْهُ التَّبَيُّنِ
فيا عبادَ اللهِ، إنّ من أعظمِ ما تميّزت به هذه الشريعةُ المباركةُ أنّها صَانَت الدماءَ والأعراضَ، وأغلقت أبوابَ الفوضى والغلو. وقد ضربَ لنا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم أروعَ الأمثلةِ في هذا الباب، وفي مقدّمتها قصتُهُ الخالدةُ مع أسامةَ بنِ زيدٍ رضي اللهُ عنهما حين قال لهُ قولتَهُ المزلزِلة: «هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟».
العُنْصُرُ الأَوَّلُ: مَعْنَى “هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ» وَدَلَالَتُهُ الكُبْرَى
روى الإمامُ البخاري (4269)، ومسلمٌ (96) : “بعثَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سريَّةً إلى الحُرقاتِ فنَذروا بنا فَهَربوا فأدرَكْنا رجلًا فلمَّا غشيناهُ قالَ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فضَربناهُ حتَّى قتلناهُ فذَكَرتُهُ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: من لَكَ بِ ( لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ يومَ القيامةِ فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّما قالَها مَخافةَ السِّلاحِ. قالَ: أفلا شقَقتَ عن قلبِهِ حتَّى تعلمَ مِن أجلِ ذلِكَ قالَها أم لا؟ مَن لَكَ بلا إلَهَ إلَّا اللَّهُ يومَ القيامةِ؟ فما زالَ يقولُها حتَّى وَدِدْتُ أنِّي لم أُسلِم إلَّا يومئذٍ“.
قَالَ النَّوَوِيُّ: الْفَاعِلُ فِي قَوْلِهِ: أَقَالَهَا هُوَ الْقَلْبُ، وَمَعْنَاهُ أَنَّكَ إِنَّمَا كُلِّفْتَ بِالْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ وَمَا يَنْطِقُ بِهِ اللِّسَانُ وَأَمَّا الْقَلْبُ فَلَيْسَ لَكَ طَرِيقٌ إِلَى مَا فِيهِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْكَ الْعَمَلِ بِمَا ظَهَرَ مِنَ اللِّسَانِ فَقَالَ: أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ لِتَنْظُرَ هَلْ كَانَتْ فِيهِ حِينَ قَالَهَا وَاعْتَقَدَهَا أَوْ لَا، وَالْمَعْنَى أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ لَسْتَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ فَاكْتَفِ مِنْهُ بِاللِّسَانِ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَثْبَتَ الْكَلَامَ النَّفْسِيَّ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَرَتُّبِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ دُونَ الْبَاطِنَةِ. فتح الباري ج12، ص196.
الحكمُ بالظاهر… أصلٌ شرعيٌّ لا يُعارضه ظنٌّ ولا شبهة
دلّ هذا الحدثُ على قاعدةٍ كليةٍ في الشريعة: أنَّ اللهَ لم يُكلّف العبادَ بمعرفة البواطن، وإنما أناط الأحكامَ بالظواهر، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36]. قَالَ قَتَادَةُ: “لَا تَقُلْ سَمِعْتُ وَلَمْ تَسْمَعْ وَرَأَيْتُ وَلَمْ تَرَ وَعَلِمْتُ وَلَمْ تَعْلَمْ”. تفسير الطبري (14/594)، وابن كثير (5/75)، القرطبي (10/257)، والرازي (20/339)، والبغوي (3/132).
وقالَ النبيُّ ﷺ: “… إنِّي لَمْ أُومَرْ أنْ أنْقُبَ عن قُلُوبِ النَّاسِ ولَا أشُقَّ بُطُونَهُمْ...”. البخاري (4351)، ومسلم (1064). قالَ النَّوَوِيُّ: «مَعْنَاهُ إِنِّي أُمِرْتُ بِالْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ» (شرح النووي على مسلم، ج7، ص163).
ومنْ هنا كانَ معنى قولِ النبيِّ ﷺ: «هلا شققت عن قلبه؟» أيْ: ألديكَ قدرةً على معرفةِ ما فيهِ؟ وهلْ كُلِّفتُ أنا بذلكَ حتى أُكلَّفكَ أنتَ؟
حمايةُ الدماءِ… أوّلُ مقاصدِ الحديثِ: إنَّ أعظمَ مقصودٍ من هذا الحديثِ هو سدُّ بابِ القتلِ بالظنِّ، وهو بابٌ إذا فُتحَ خُرّبتِ الأممُ وانتشرَ الغلوُّ. ولذلكَ غضبَ النبيُّ ﷺ غضبًا شديدًا. فالنبيُّ ﷺ لم ينكرْ على أسامةَ مجردَ التصرفِ، بل أنكرَ منهجًا خطيرًا كان يمكنُ أن يصيرَ أصلًا للغلوِّ والاعتداءِ لو تُركَ دونَ بيانٍ.
خطورةُ الظنِّ… وكيفَ يمنعُهُ الحديثُ: لقدْ جاءَ الشرعُ بإغلاقِ هذا البابِ من جهاتٍ متعددةٍ: قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾ [الحجرات: 12]، وقال ﷺ: «إياكم والظنَّ فإن الظنَّ أكذبُ الحديث”. البخاري (رقم 5143)، مسلم (رقم 2563).
وقد كان الصحابةُ يدركون خطورةَ هذا الباب، ففي الصحيحين أن المقدادَ بنَ الأسودِ سألَ النبي ﷺ: “يا رسولُ اللهِ أرَأَيْتَ إنْ لَقِيتَ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَتْ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولُ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ”. البخاري (رقم 4019)، مسلم (رقم 95)..
أثرُ الحديثِ في قطعِ جذورِ الغلوّ: إنَّ أوَّلَ بُذورِ الغلوِّ تبدأ هكذا: ظنٌّ بالقلبِ…، سوءُ تأويلٍ لعملٍ…، اتِّهامٌ بغيرِ بيِّنةٍ…، ثمَّ تكفيرٌ وعدوانٌ. وجاء هذا الحديثُ العظيمُ ليضعَ بينَ المسلمِ وبينَ هذه الهاويةِ سدًّا منيعًا: لا تتَّهمْ… لا تظنَّ… لا تقطعْ… لا تحكمْ على ما لا تعلمُ. ولو تربَّى الشبابُ على هذا الأصلِ لانطفأتْ نارُ التكفيرِ، ولما وجدتْ الجماعاتُ المتشدِّدةُ مدخلًا إلى عقولِهم؛ لأنَّ بابَها الأكبرَ هو: الظنُّ بالناسِ والحكمُ على نيَّاتِهم.
ولهذا قالَ الماورديُّ تعليقًا على هذا الأصلِ الجليلِ: لَمْ يَفْتِشْ سَرائرَهم، وَلَمْ يُؤاخِذْهم بما يُخفونَهُ في ضمائرِهم، فإنَّ ضمائرَ القلوبِ لا يُؤاخَذُ بها إلَّا علَّامُ الغيوبِ”. تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك للماوردي ص284.
وهذا هو جوهرُ الحديثِ: “هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ”، أي: أأُمرتَ بذلكَ؟ أم تُركتَ للظاهرِ الذي أظهرَهُ؟رإنهُ منهجٌ يُقيمُ العدلَ، ويحفظُ الأنفسَ، ويجعلُ المجتمعَ سليمًا من الظنونِ، بعيدًا عن الغلوِّ، قائمًا على الرحمةِ التي جاءَ بها الإسلامُ.
العُنْصُرُ الثَّانِي: حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ
أصلُ الأخوة في القرآن والسنة: يُّها المؤمنون، إنَّ اللهَ تعالى جعلَ رابطةَ الإيمانِ أقوى من رابطةِ النَّسَبِ، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10]. وقال ابنُ كثيرٍ في تفسيره: “الجميعُ إخوةٌ في الدينِ، كما قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم: “المسلمُ أخو المسلمِ، لا يظلمُهُ، ولا يسلِمُهُ“. البخاري (2442)، ومسلم (2580). [تفسير ابن كثير، ج7، ص375].
وفي الصحيح قال النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ» [البخاري (2442)، ومسلم (2580). مسلم بشرح النووي ج16 ص120].
فهي ثلاثةُ أسسٍ تحفظُ كيانَ المجتمع: منعُ الظلمِ، ومنعُ الخذلانِ، ومنعُ الاحتقارِ، وكلٌّ منها جدارٌ أمام الغلوّ وسوء الظن.
أعظمُ حقوقِ الإيمان: ومن أعظمِ الحقوقِ قولُه صلى اللهُ عليهِ وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» [البخاري (13)، مسلم 45].
قَالَ النَّوَوِيّ وَالْمرَاد يحب لَهُ من الطَّاعَات والأشياء الْمُبَاحَات وَيدل عَلَيْهِ رِوَايَة النَّسَائِيّ حَتَّى يحب لِأَخِيهِ من الْخَيْر. قَالَ بن أبي زيد الماكي جماع آدَاب الْخَيْر تتفرع من أَرْبَعَة أَحَادِيث (1) حَدِيث لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى يحب لِأَخِيهِ مَا يحب لنَفسِهِ (2) وَحَدِيث من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلْيقل خيرا أَو لِيَسْكُت (3) وَحَدِيث من حسن إِسْلَام الْمَرْء تَركه مَا لَا يعنيه (4) وَقَوله للَّذي اختصر لَهُ وَصِيَّة لَا تغْضب وهذا الحقّ يعالجُ جذورَ الغلظةِ والحسدِ والتنافسِ، ويؤسِّسُ لرحمةٍ تُغلقُ منافذَ التكفيرِ والعداوة”. شرح السيوطي علي مسلم ج1، ص61.
الحقوقُ الستةُ في تعاملِ اليومِ والليلةِ: وفصّلَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم حقوقَ المسلمِ في الحديثِ المتفقِ عليهِ: «حَقُّ المُسْلِمِ علَى المُسْلِمِ سِتٌّ قيلَ: ما هُنَّ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: إذا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عليه، وإذا دَعاكَ فأجِبْهُ، وإذا اسْتَنْصَحَكَ فانْصَحْ له، وإذا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وإذا مَرِضَ فَعُدْهُ وإذا ماتَ فاتَّبِعْهُ» [البخاري (1240)، مسلم (2162)].
قصةُ سعدِ بنِ الربيعِ وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ: ومن أروعِ المشاهدِ ما كان يومَ آخى النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم بين المهاجرين والأنصارِ، فجاءَ سعدُ بنُ الربيعِ فقالَ لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ: «إني أكثرُ الأنصارِ مالًا، فخذْ نصفَ مالي…” والقصةُ في [السيرةِ النبويةِ لابنِ هشامٍ، ج2، ص108].
نصرةُ المسلمِ ومنعُ الظلمِ: ومن الحقوقِ العظيمةِ قولُهُ صلى اللهُ عليهِ وسلم: «انصرْ أخاكَ ظالمًا أو مظلومًا» [البخاري 6952]. فسّرَها النبيُّ بقولِهِ: «تَحْجُزُه أو تَمْنَعُه من الظلمِ فذلكَ نصرُه» [البخاري 6952].
فهذهِ النصرةُ ليست تحزّبًا ولا عصبيّةً، بل قيامٌ بميزانِ العدلِ، وهو ما يمنعُ جذورَ العنفِ والغلوِّ.
بابُ السَّترِ وإطفاءِ الفتنِ: ومن الحقوقِ الجليلةِ: السَّترُ؛ قالَ صلى اللهُ عليهِ وسلم: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ في الدُّنيا والآخرةِ» [البخاري (2442)، ومسلم (2580) ]. وهو بابٌ لو فُتحَ لانطفأتْ نارُ الفتنِ التي يُشعلُها أهلُ التشهيرِ والتجسّسِ.
قصةُ الرجل الذي أحبَّ رجلًا في اللهِ: وفي الصحيحِ: “زارَ رجُلٌ أخًا لَهُ في قريَةٍ فأرْصَدَ اللهُ لَهُ ملَكًا علَى مَدْرَجَتِه، فقال: أينَ تُرِيدُ؟ قال: أخًا لِي في هذِهِ القرْيَةِ، فقال: هل لَّهُ عليكَ مِنْ نعمةٍ ترُبُّها؟ قال: لَا؛ إلَّا أنِّي أُحِبُّه فِي اللهِ، قال: فإِنَّي رسولُ اللهِ إليكَ أنَّ اللهَ أحبَّكَ كمَا أَحْبَبْتَهُ» [مسلم 2567، والبخاري في الأدب المفرد 350]. إنها محبّةٌ خالصةٌ لا مصلحةَ فيها، تُزكّي القلوبَ وتُطفئُ نارَ الغلوِّ.
فضلُ اتباعِ الجنازةِ: وفي الصحيحِ: “من صلَّى على جنازةٍ فلَهُ قيراطٌ ومنِ انتظرَها حتَّى توضعَ في اللَّحدِ فلَهُ قيراطانِ والقيراطانِ مثلُ الجبلينِ العظيمينِ» [البخاري (1325)، مسلم 945].
وما ذاكَ إلّا لأنها رابطةٌ آخرَ الحياةِ، تُذكّرُ بالموتِ، وتُربّي على الرحمةِ، وتكسِرُ الغرورَ الذي يقودُ إلى الغلوِّ.
أخوّةٌ تمنعُ الغلوَّ: هذهِ الحقوقُ كلُّها—سلامٌ ونصيحةٌ وسترٌ ونُصرةٌ وعيادةٌ وجنازةٌ—ليستْ مجردَ مكارمَ، بل “حُصونٌ” تمنعُ دخولَ الغلوِّ إلى المجتمعِ؛ لأنَّ القلبَ الذي يعتادُ الرحمةَ لا يعرفُ التكفيرَ، والنفسَ التي تستحي من اللهِ في حقِّ أخيها لا تتجرّأُ على اتهامِ نيّتِه، والمجتمعَ الذي يُقيمُ الحقوقَ لا يسمحُ بظلمٍ ولا بشبهةٍ ولا بسوءِ ظنٍّ.
فحقوقُ المسلمِ هي السورُ الحامي من الفكر المتشدد، وهي التطبيق العملي لمعنى: «هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟
العُنْصُرُ الثَّالِثُ: الدِّينُ المُعَامَلَةُ… وَمَبْدَأ التَّعَامُلِ بِالحُسْنَى
أيُّها المؤمنون، إنَّ الشريعةَ الغرّاءَ لم تجعل العباداتِ مقصودةً لذاتها فقط، بل جعلتها سبيلًا لتزكيةِ النفوسِ وتقويمِ الأخلاقِ. ومن هنا جاءت قاعدةُ «الدينُ المعاملةُ» وإن لم تردْ بلفظٍ صحيحٍ، فإنَّ معناها ثابتٌ بآياتٍ محكمةٍ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: 83]، وقالَ تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [فصلت: 34]. هذه الآياتُ تُقيمُ خُلُقَ المسلمِ على الحُسنى، وتُنزّلُه منازلَ الإحسانِ في كلِّ معاملةٍ.
وقد لخّص النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم هذا الأصلَ الشريفَ بقوله: «إنما بُعثتُ لأتمّمَ مكارمَ الأخلاقِ» [البزار (8949)، والبيهقي (21301). وأحمد (8952)، والحاكم (4221)، صحيح]. فالأخلاقُ ليست تحسيناتٍ اجتماعية، بل هي روحُ العبادةِ، وميزانُ الامتثالِ، ودليلُ صدقِ العبدِ مع ربّهِ ومع الناسِ.
ومن أظهرِ شواهدِ التعاملِ بالحسنى ما جاء في الصحيحين في قصةِ الأعرابيِّ الذي بالَ في المسجدِ، فرفقَ به النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم، وقالَ للقومِ: «دعوهُ» ثم علّمه برفقٍ. ففي هذا الموقفِ تتجلّى الحكمةُ النبويةُ في تحويلِ الخطأ إلى هداية، والعنفِ إلى رحمة.
ومثل ذلك ما وقع مع صفوانَ بنِ أميّة، فقد أكرمه النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم بالعطاءِ والصفحِ حتى قال: «ما طابتْ نفسُ أحدٍ بمثلِ ما طابتْ به نفسُ محمدٍ» [السيرة النبوية لابن هشام، ج4]. لقد فَتَحَ الخلقُ ما أغلقته الحروبُ، وأسلمتْ قلوبٌ قاسيةٌ حين رأتِ الحلمَ والصفحَ.
وفي الصحيحِ أيضًا أن جبريلَ قالَ للنبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلم: «إِنَّهُ لم يكنْ نبيٌّ قبلي، إلَّا كان حقًا عليْهِ أنْ يَدُلَّ أمتَهُ على ما يعلَمُهُ خيرًا لهم، ويُنْذِرَهُمْ ما يعلَمُهُ شرًا لهم… فمَنْ أحبَّ منكم أنْ يُزَحْزَحَ عنِ النارِ، ويَدْخُلَ الجنةَ، فلْتَأْتِهِ منيتُهُ وهوَ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، وليأْتِ إلى الناسِ، الذي يُحِبُّ أنْ يُؤْتَى إليه» [مسلم 1844]. فدلَّ على أن الإيمانَ الذي لا يُنتجُ خُلُقًا، ولا يخلّف إحسانًا، إيمانٌ ناقصٌ لا يزحزحُ صاحبهُ عن النارِ.
وليست الحُسنى ضعفًا؛ بل هي قوّةُ الحكمةِ، وشدّةُ الرحمةِ، وعمقُ الفقهِ. فمن تخلّق بالحُسنى نجا من الغلوّ؛ لأن الغلوَّ يعيشُ في بيئةٍ قاسيةٍ، ويموتُ في بيئةٍ رحيمةٍ. ولذلك كان «هلا شققتَ عن قلبه» ميزانًا للتعاملِ مع الخلقِ: لا حكمَ على النياتِ، ولا عدوانَ على السرائرِ، بل إحسانٌ ظاهرٌ، ودعوةٌ بالحكمةِ، ورحمةٌ تهدي ولا تجرح.
وإذا اجتمع التعاملُ بالحسنى مع حقوقِ المسلمِ ومع قاعدةِ «هلا شققتَ عن قلبه» نشأ جيلٌ سليمُ القلبِ، طاهرُ اللسانِ، بعيدٌ عن العنفِ والظنونِ وسرعةِ التكفيرِ. فالحسنى تُطفئ نارَ الغضب، وتُزكّي النفوس، وتُقيم المجتمعَ على العدلِ والرحمةِ التي جاء بها الإسلام.
الخُطْبَةُ الثَّانِيَة
الحمدُ للهِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحبُّ ربُّنا ويرضى، نحمدُه على نعمة الإسلام، ونعمة الهداية، ونعمة السكينة التي يُلقيها في قلوب عباده المؤمنين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً تُنير الطريق، وتُقوّم الأعمال، وترفع صاحبها عند الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمامُ المتقين، وقدوةُ العالمين، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمّا بعد؛ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن دينَكم دينُ رحمةٍ وعدلٍ وإنصافٍ، لا يعرفُ الظلم، ولا يقبل الغلوّ، ولا يرضى بالاعتداء على حقوق الناس؛ لأن الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة، والغلوَّ يُطفئ نور القلب، ويُعمّي البصر، ويفتح أبواب الفتن.
العُنْصُرُ الرَّابِعُ: هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ… مِعْيَارُ الرَّحْمَةِ وَفِقْهُ التَّبَيُّنِ
فِقْهُ التَّبَيُّنِ وَمَنْعُ الظَّنِّ: إنَّ أوَّلَ مبدأٍ يُواجهُ به الإسلامُ الغلوَّ وسُرعةَ الاتهام، هو مبدأُ التَّبَيُّنِ الذي وَرَدَ في قولهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا﴾ [النساء: 94]. قالَ القرطبي في تفسيره: «وَفِي هٰذَا مِنَ الْفِقْهِ بَابٌ عَظِيمٌ، وَهُوَ أَنَّ الْأَحْكَامَ تُنَاطُ بِالْمَظَانِّ وَالظَّوَاهِرِ لَا عَلَى الْقَطْعِ وَاطِّلَاعِ السَّرَائِرِ» (تفسير القرطبي، ج5، ص291).
ومعنى التَّبَيُّنِ هنا ليس مجرّد النظر، بل هو منعُ تُجّارِ الشُّبَهِ، وإغلاقُ أبوابِ الظنّ، وتحكيمُ الظاهر الذي جعلَه الشرعُ ميزانًا في التعاملِ مع الناس. ولذلك قالَ النبيُّ ﷺ لأسامةَ بْنِ زَيْدٍ — لَمَّا استعجلَ في قتلِ رجلٍ نطق بالشهادة —: «هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ»؛ وفي رواية أخري لمسلم: “أَقَتَلْتَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَكَيفَ تَصْنَعُ بلَا إلهَ إلَاّ اللهُ، إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ؟» قَالَ: يَا رَسُول الله، اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: «وكَيفَ تَصْنَعُ بِلا إلهَ إلَاّ الله إِذَا جَاءتْ يَوْمَ القِيَامَةِ؟» فَجَعَلَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: «كَيفَ تَصْنَعُ بِلَا إلهَ إلَاّ الله إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ”. مسلم (97). أي: لِمَ لَمْ تحكم بالظاهرِ وتتركِ السرائرَ للهِ؟
, قالَ النبيُّ ﷺ: “… إنِّي لَمْ أُومَرْ أنْ أنْقُبَ عن قُلُوبِ النَّاسِ ولَا أشُقَّ بُطُونَهُمْ...”. البخاري (4351)، ومسلم (1064). قالَ النَّوَوِيُّ: «مَعْنَاهُ إِنِّي أُمِرْتُ بِالْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ» (شرح النووي على مسلم، ج7، ص163).
سُوءُ الظَّنِّ وَبِنَاءُ مُجْتَمَعِ الرَّحْمَةِ: إنَّ أخطرَ ما يُفسدُ القلوبَ ويُولِّدُ الغلظةَ والغلوَّ هو سُوءُ الظَّنِّ، وقد نهى اللهُ تَعَالَى عنهُ نهيًا صريحًا فقالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: 12]. وقالَ البُخَارِيُّ عن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «إيَّاكُمْ والظَّنَّ فإنَّ الظَّنَّ أكذبُ الحديثِ» البخاري (رقم 5143)، ومسلم (2563).
حُرْمَةُ الإِنْسَانِ فِي الإِسْلَامِ… قِيمَةٌ لَا تُسْقِطُهَا دِيَانَةٌ وَلَا لَوْنٌ: إنَّ الإسلامَ لم يأتِ ليصنعَ طبقاتٍ بشرية، ولا ليرفعَ إنسانًا بلونٍ أو نسبٍ، بل جاءَ بتكريمٍ شاملٍ يعمُّ الخليقةَ كلَّها؛ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وهذا التكريمُ — كما يقولُ الإمامُ الفخرُ الرازي في “التفسير الكبير” (ج21، ص26، دار الكتب العلمية) — «تشريفٌ مطلقٌ يشملُ المؤمنَ والكافرَ، والبرَّ والفاجرَ، لأن الأصلَ هو الإنسانيةُ التي خلقها اللهُ بيدهِ ونفخَ فيها من روحه”.
وقد جسّدَ النبيُّ ﷺ هذا المبدأَ في موقفٍ جليلٍ رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ: مرّت جنازةٌ يهوديّ، فقامَ لها النبيُّ ﷺ، فقالوا: إنها جنازةُ يهوديّ، فقالَ ﷺ: «أليسَتْ نفسًا؟» البخاري (رقم 1312)، ومسلم (رقم 961).
ولم يكن هذا التكريمُ نظريًا، بل كانَ واقعًا عمليًا؛ فقد روى الطبراني في “المعجم الكبير” (ج6، ص136، رقم 5769) عن عبدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضيَ اللهُ عنهما أنهُ رأى غلامًا أسودَ يعملُ عندَ قومٍ، وكان معهُ كلبٌ جائعٌ، فكان الغلامُ يُقسّم رغيفَهُ بينه وبين الكلب، فقالَ له عبدُ الله: “لِمَ تُطعِمُهُ وهو ليسَ لك؟” فقال الغلامُ: “إنهُ جائعٌ، ولا أحبُّ أن يحسّ مخلوقٌ بالجوعِ وأنا أقدرُ على إطعامِهِ”. فاشترى عبدُ اللهِ الغلامَ والبستانَ وأعتقهُ لله. قال الذهبيُّ في “سير أعلام النبلاء” (ج3، ص133): «وكان هذا الغلامُ مثالًا في الرحمةِ التي يغرسها الإسلامُ في النفوس، حتى يرحمَ الإنسانُ الحيوانَ فكيفَ بآدميٍّ مثله”.
أيُّها المؤمنون، إنَّ حديثَ «هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ» ليس قصةً تُروى، بل منهجُ حياةٍ يُبنى: منهجُ رحمةٍ، وعدلٍ، وتثبّتٍ، وتركٍ للحكمِ على النّيات، وإقامةٍ للناسِ على ظاهرهم، وتركٍ لسرائرهم لربِّهم الذي خلقهم. وهذا هو الذي دلّت عليه النصوص المحكمة، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36]، وقال ﷺ: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ» متفقٌ عليه: البخاري (رقم 4351)، مسلم (رقم 1064).
اللَّهُمَّ يا رَبَّنَا، طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنَ الغِلِّ، وَصُدُورَنَا مِنَ الشَّحْنَاءِ، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الزُّورِ، وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ.
اللَّهُمَّ احْفَظْ أَبْنَاءَنَا مِنْ أَفْكَارِ التَّطَرُّفِ، وَزَيِّنْ قُلُوبَهُمْ بِنُورِ الْقُرْآنِ.
واحفظ مصر من كل سوء وفتنة
المراجع: القرآن الكريم
كتب الحديث: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، وابن ماجه، سنن الترمذي، المستدرك للحاكم، مسند أحمد. شعب الإيمان للبيهقي، المعجم الكبير للطبراني، مسند البزار.
ثالثًا: كتب التفسير وشروح الحديث وغيرهما: تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تَفْسِيرُ القرطبي، تفسير الرازي، تفسير البغوي، فتح الباري لابن حجر، شرح النووي على مسلم، شرح السيوطي علي مسلم، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك للماوردي، السيرةِ النبويةِ لابنِ هشامٍ، سير أعلام النبلاء للذهبي.
د. أحمد رمضان
خُطبةُ صوتِ الدعاةِ – إعداد رئيس التحرير: الدكتور أحمد رمضان
_____________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
وللإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف